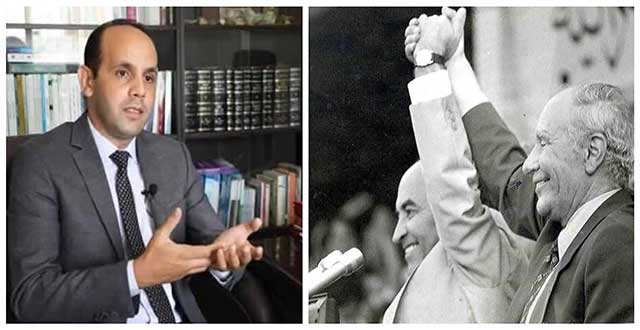تختزل هذه المقولة التوتر الأخلاقي الذي يعصف بالدبلوماسية المعاصرة بين واجب الحماية وإغراء غضّ الطرف.
الملخص
تشهد الدبلوماسية المعاصرة توتراً عميقاً بين المسؤولية الأخلاقية واللامبالاة الإستراتيجية. فقد وُلدت "دبلوماسية المسؤولية" من مآسي القرن العشرين، وتبلورت في إطار مبدأ "المسؤولية في الحماية"، الذي سعى إلى جعل الكرامة الإنسانية وحماية الفئات الضعيفة في صميم العمل الدولي. غير أن تراكم الأزمات، وتصاعد التنافسات الجيوسياسية، والضغوط الاقتصادية، أسهمت جميعها في بروز "دبلوماسية اللامبالاة"، التي تتجسد في العجز المتعمّد عن التحرك إزاء انتهاكات حقوق الإنسان.
يحاول هذا البحث تحليل جذور هذا الانحراف ومظاهره، من خلال دراسة كيفية شلّ الآليات الدولية بفعل المصالح الوطنية والاختناقات المؤسسية. كما يدعو إلى إعادة إحياء دبلوماسية أخلاقية وتضامنية قادرة على الجمع بين العدالة والوقاية والتعاون المتعدد الأطراف، من أجل استعادة الشرعية الأخلاقية والفعالية العملية للفعل الدولي.
المقدمة
تُعَدّ الدبلوماسية، بوصفها فنّ التفاوض وحفظ السلام، أحد الأعمدة الأساسية للتوازن العالمي. وقد جُرحت الإنسانية بعمق جرّاء مآسي القرن العشرين — من الحروب العالمية إلى الإبادات الجماعية — مما دفع المجتمع الدولي إلى البحث عن آليات تمنع تكرار الكوارث الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ومن رحم هذا الوعي الجماعي وُلدت فكرة الدبلوماسية القائمة على المسؤولية، المؤسسة على مبادئ التضامن والتعاون والواجب الأخلاقي في التحرك.
في صميم هذا التصوّر تقف عقيدة "المسؤولية في الحماية" التي أقرّتها الأمم المتحدة سنة 2005، وتنصّ على أنّه "إذا فشلَت الدولة أو كانت متواطئة في مواجهة جرائم جماعية، فإنّ على المجتمع الدولي واجب التدخل". تمثّل هذه العقيدة الإطار القانوني، بينما تتجاوزه الدبلوماسية المسؤولة لتجسّد مبدأً أخلاقيًا وسياسيًا أعمق، إذ لم تعُد السيادة تُفهم بوصفها امتيازًا مطلقًا، بل التزامًا بحماية الشعب.
غير أنّ هذا المثال الإنساني أخذ في التآكل تدريجيًا أمام التحوّلات السياسية والاقتصادية والإستراتيجية المعاصرة. ففي عالمٍ متعدّد الأقطاب تتزايد فيه المنافسات القومية والنزعات الوطنية، برز شكل مقلق من الدبلوماسية اللامبالية، التي تقوم على الامتناع المحسوب عن الفعل، بدافع الحذر السياسي والمصلحة المادية.
ومن هنا يثور تساؤل جوهري: كيف انزلقت الدبلوماسية الدولية من منطق المسؤولية الأخلاقية إلى منطق اللامبالاة الإستراتيجية، وما هي النتائج المترتّبة على ذلك بالنسبة للنظام العالمي؟
سنسعى في هذا البحث إلى إظهار أنّ الدبلوماسية القائمة على المسؤولية كانت مثلاً أعلى بُني على أنقاض القرن العشرين، ثم تحليل جذور ومظاهر تراجعه لصالح دبلوماسية اللامبالاة، قبل أن نؤكد في الختام على ضرورة إحياء دبلوماسية أخلاقية وتضامنية.
وقبل التطرّق إلى مظاهر الانحراف المعاصر، من الضروري فهم أصول فكرة الدبلوماسية المسؤولة ولماذا تمّ استحداثها عقب المآسي الكبرى التي شهدها القرن العشرون.
- الدبلوماسية القائمة على المسؤولية – مثال وُلد من رماد القرن العشرين
لقد غيّرت الحرب العالمية الثانية جذريًا التصوّر السائد حول الدور الدبلوماسي للدول. فقد كشفت الفظائع التي ارتُكبت خلالها عن العيوب القاتلة في النظام الدولي الذي كان يُقدّس مبدأ السيادة المطلقة للدولة. وأدرك مهندسو النظام الدولي لما بعد الحرب أنّ غياب الالتزام الجماعي لا يمكن إلا أن يقود إلى الكارثة. وهكذا جاءت ولادة منظمة الأمم المتحدة سنة 1945، ثم إعلان حقوق الإنسان العالمي سنة 1948، لترسي أسس عصرٍ جديد، يجعل السلام والتعاون والكرامة الإنسانية في قلب الفعل الدولي.
استندت هذه الدبلوماسية الناشئة إلى إعادة تعريف جوهرية لمفهوم السيادة: فلم تعُد السيادة امتيازًا مطلقًا، بل أصبحت التزامًا بالحماية. وقد تمّ تكريس هذا المبدأ في إطار عقيدة "المسؤولية في الحماية" التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2005، والتي تنصّ على أنه في حال عجز الدولة عن حماية شعبها أو تواطؤها في ارتكاب جرائم جماعية، فإنّ للمجتمع الدولي واجب التدخل. يمثّل هذا التحوّل قطيعة مفاهيمية عميقة مع التصوّر الكلاسيكي للعلاقات الدولية.
وإلى جانب المبادئ النظرية، حمل هذا المثال الإنساني دبلوماسيون رمزيون جسّدوا الالتزام الأخلاقي بالفعل. من بينهم غسّان سلامة، المفكر والدبلوماسي اللبناني الذي اضطلع بمهام سلام وإعادة بناء الدولة في مناطق الأزمات، وراؤول فالينبرغ السويدي الذي أنقذ عشرات الآلاف من يهود المجر خلال الحرب العالمية الثانية، وسيرجيو فييرا دي ميلو البرازيلي، مهندس السلام في تيمور الشرقية والعراق، الذي قُتل في الهجوم على مقرّ الأمم المتحدة في بغداد في 19 أغسطس 2003. تمثّل هذه الأسماء جميعها القناعة بأنّ للدبلوماسية وجهًا إنسانيًا، وأنّ الالتزام الأخلاقي يمكن أن يسمو فوق الحسابات السياسية ويترك أثرًا خالدًا في تاريخ العلاقات الدولية.
وفي السياق نفسه، شكّل صعود المجتمع المدني العالمي رافعة قوية لهذه الدبلوماسية المسؤولة. فقد لعبت المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة العفو الدولية وأطباء بلا حدود، دورًا حاسمًا في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم العون للضحايا، وممارسة الضغط المستمر على الحكومات. وساهم عملها في تكوين رأي عام دولي يجبر الدبلوماسيين على تحمّل المسؤولية ووضع الاعتبارات الإنسانية في صلب المفاوضات.
وقد تجسّد هذا الطموح الأخلاقي في تدخلات إنسانية محددة، مثل كوسوفو وتيمور الشرقية في تسعينيات القرن الماضي. ورغم ما أثارته هذه التدخلات من جدل، فإنها عبّرت عن إرادة جماعية لتحمّل مسؤولية منع المأساة، وأظهرت أن الدبلوماسية يمكن أن تكون أداة أخلاقية بقدر ما هي أداة قوة.
كما تبنّت هذه الدبلوماسية منطقًا وقائيًا وتعاونيًا، يقوم على الحوار المتعدد الأطراف والوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية. وقد جسدت مؤسسات مثل اليونسكو والمحكمة الجنائية الدولية هذا الطموح الأخلاقي. وبوضع الكرامة الإنسانية في مركز الاهتمام الدولي، أرادت الدبلوماسية القائمة على المسؤولية أن تكون سداً منيعًا أمام تكرار انحرافات الماضي.
غير أنّ هذا المثال لم يصمد طويلاً أمام تناقضات عالمٍ تمزّقه المنافسة الجيوسياسية. فقد أدّت عودة المصالح القومية، والحسابات الاقتصادية، والشلل المؤسسي إلى تحويل الدبلوماسية تدريجيًا إلى أداة صمتٍ وعجزٍ متعمّد، فكانت النتيجة ولادة ما يمكن تسميته بـ دبلوماسية اللامبالاة.
وهكذا، فإنّ فكرة الدبلوماسية التي تضع حماية الشعوب الضعيفة في صميم عملها نشأت وتطوّرت بفضل شخصيات ملهمة ومنظمات مدنية فاعلة، لكنها تظلّ هشّة أمام ضغوط الواقع السياسي والاقتصادي.
- من الالتزام الأخلاقي إلى اللامبالاة الإستراتيجية – تراجع القيم الكونية
يشكّل الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994 نقطة تحوّل حاسمة في الوعي الدبلوماسي المعاصر. ففي غضون مئة يوم فقط، تمّت إبادة نحو مليون إنسان تحت أنظار المجتمع الدولي الصامت. وقد اختارت القوى الكبرى الانسحاب بدلًا من التدخل، متأثرةً بفشلها السابق في الصومال، فكان الصمت بديلاً للفعل. كشفت هذه المأساة الهوّة السحيقة بين المبادئ الإنسانية المعلنة وبين واقع دبلوماسية مشلولة بفعل الحسابات السياسية والحذر والخوف من التورّط.
ويبرز مثال آخر دالّ يتمثل في السياسة الفرنسية إبان رئاسة فرانسوا ميتران تجاه حرب البوسنة (1992–1995)، التي وُصفت بأنها اتسمت بـ قدرٍ كبير من اللامبالاة المأساوية. فبينما كانت سراييفو تعيش حصارًا طويلًا ويُقصف المدنيون يوميًا، تمسّك الرئيس الفرنسي بمبدأ الحياد الصارم ورفض أي تدخل عسكري مباشر من القوى الغربية. وبينما تمّ تقديم هذا الموقف بوصفه خيارًا عقلانيًا وحذرًا، فقد اعتُبر في الواقع تخلّيًا أخلاقيًا عن المسؤولية.
لقد كان هذا التحفظ متجذرًا في حذرٍ ثقافي وأيديولوجي، إذ خشي ميتران أن يُفهم دعم البوسنة باعتباره تأييدًا لقيام "دولة مسلمة" في قلب أوروبا، في وقتٍ كان فيه الإسلام السياسي يثير مخاوف العواصم الغربية. كان الرئيس الفرنسي يؤمن بفكرة البوسنة المتعددة الإثنيات والعلمانية، غير أنّ هذا التوازن النظري تحوّل إلى جمود سياسي قاتل. وكما كتب آلان ريبتيه في لوموند بتاريخ 23 أبريل 2021: "لم يكن ميتران دائمًا على موعد مع التاريخ حين واجه الاختيار بين الضحايا والجلادين". لقد كانت تلك حيادية إنسانية ظاهرية، تخفي وراءها امتناعًا عن الفعل ساهم في إطالة أمد إحدى أكبر المآسي الأوروبية في نهاية القرن العشرين.
ومع ذلك، لا يمكن تحميل القوى الغربية وحدها مسؤولية هذه اللامبالاة. فقد ساهم صعود القوى التعديلية والتي تسعى إلى إعادة النظر في النظام الدولي القائم مثل الصين وروسيا في تقويض الإجماع حول القيم والمعايير الدولية. تقوم رؤيتهما للدبلوماسية على سيادة مطلقة ورفضٍ لما تعتبرانه تدخّلًا غربياً، وهو ما منح شرعية فكرية جديدة للانسحاب من الالتزامات الدولية. ومع تبلور عالمٍ منقسم إلى مناطق نفوذ متنافسة، تمارس كل قوة هيمنتها دون مساءلة، عادت العلاقات الدولية إلى تصور ما قبل الحداثة القائم على منطق القوة لا القانون.
وإلى جانب البُعد السياسي، هناك ما يمكن تسميته بـ اقتصاد اللامبالاة، وهو عامل حاسم في هذا الانحراف. فقد أوجدت الترابطات التجارية والمالية العالمية شبكة من تضارب المصالح البنيوي تُقيد أي إرادة سياسية حقيقية. فالدول الأوروبية، على سبيل المثال، اعتمدت طويلًا على الغاز الروسي، مما جعلها تُخفف انتقاداتها لسياسات الكرملين.
وبالمثل، فإن الاستثمارات الصينية الضخمة في إفريقيا دفعت العديد من الحكومات إلى تجاهل قمع الإيغور في الصين. وهكذا أصبحت الواقعية الاقتصادية تتغلّب على الاعتبارات الأخلاقية، فتحوّلت الدبلوماسية إلى إدارة براغماتية للمصالح المادية.
وقد كشفت الأزمات المتلاحقة – من سوريا إلى اليمن مرورًا بـ القضية الفلسطينية – عن عجز المجتمع الدولي وتواطؤه الصامت. فالدول كثيرًا ما تتذرّع بـ مبدأ عدم التدخل لتبرير سكونها، في حين تُخفي وراء هذا الغطاء القانوني مصالح إستراتيجية أو تحالفات اقتصادية أو مكاسب من تجارة السلاح.
وتتجلّى هذه الدبلوماسية اللامبالية بوضوحٍ في إدارة أزمات الهجرة، حيث اختارت العديد من الدول الأوروبية الانغلاق على الذات بدلًا من التضامن، فتبدّل منطق الاستقبال الإنساني إلى منطق الرفض والصدّ. في هذا السياق، تحوّلت الدبلوماسية إلى أداة دفاع هوياتي، وانكمشت على مصالحها القُطرية، لتتراجع الإنسانية أمام البراغماتية القومية.
وهكذا تبرز ملامح ما يمكن تسميته بـ دبلوماسية اللامبالاة الإستراتيجية: إرادة متعمّدة للامتناع عن الفعل، مبرّرة بالمصالح الوطنية والتوازنات الجيوسياسية، ولكنها ذات نتائج إنسانية وسياسية مدمّرة. وتتفاقم هذه الظاهرة بسبب الشلل المؤسسي للأمم المتحدة، حيث يُعطّل حق النقض (الفيتو) أي تحرك في مواجهة الأزمات الكبرى. لقد جعلت التنافسات بين القوى الكبرى العمل الجماعي شبه مستحيل، فترسّخت صورة دبلوماسية عاجزة، منفصلة، تكتفي بالمشاهدة بدل المبادرة.
في النهاية، تمثّل دبلوماسية اللامبالاة نوعًا من الاستسلام الأخلاقي والسياسي : اختارت الدول راحة الصمت على مخاطر الفعل، مما قَوّض الاستقرار الدولي وخان المبادئ التي بُني عليها النظام متعدد الأطراف. فالامتناع عن الفعل ليس حيادًا بريئًا، بل خيارٌ إستراتيجي تمليه حسابات وطنية وخشية من التكاليف السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية لأي التزام حقيقي.
إنّ هذه الأمثلة تبرهن على أنّ الدبلوماسية العالمية، رغم شعاراتها الإنسانية، فضّلت في كثير من الأحيان الصمت على الفعل، والحياد على الالتزام، فحلّت محلّ الأخلاق لامبالاةٌ محسوبة.
- نحو إحياء الدبلوماسية القائمة على المسؤولية – ضرورة القرن الحادي والعشرين
إنّ إعادة إحياء الدبلوماسية القائمة على المسؤولية تقتضي إعادة بناء آليات اتخاذ القرار الدولي من جذورها. فالنظام المؤسسي الموروث عن عام 1945 أصبح متقادمًا وغير ملائم للتحولات الجارية. ومن ثمّ، تبرز الحاجة الملحّة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي من خلال توسيع قاعدة التمثيل وتقليص استخدام حق النقض (الفيتو) في حالات الجرائم الفظيعة. وحدها حوكمة دولية أكثر شمولًا وأقل هرمية يمكن أن تعيد الثقة والشرعية إلى العمل الجماعي الدولي.
ويجب أن يترافق هذا الإصلاح مع تعزيز دور القضاء الدولي. فـالمحكمة الجنائية الدولية، رغم ما يعتريها من نقائص، تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الإفلات من العقاب. ومن الضروري تزويدها بالإمكانات القانونية والمالية اللازمة، والتغلّب على ممانعة الدول التي ترفض الخضوع لاختصاصها. فإرساء عدالة جنائية دولية فعالة ومصدّقة هو شرط أساسي لردع مرتكبي الجرائم الكبرى وتقديم الإنصاف للضحايا، وبذلك يُستعاد الإيمان بنظامٍ دولي قائمٍ على القانون لا على القوة.
كما يتعيّن على دبلوماسية المستقبل أن تنفتح على فاعلين جدد ومواضيع جديدة. فالتحديات العابرة للحدود – كالتغيّر المناخي، والجريمة السيبرانية، والأوبئة – تتطلّب استجابات جماعية لا يمكن أن تحتكرها الدول وحدها. لقد أصبحت المدن والمناطق والشركات والجامعات فاعلين دبلوماسيين، غالبًا ما يتمتّعون بمرونة وقدرة ابتكارية تفوق تلك التي لدى الحكومات. إنّ إدماج هؤلاء الفاعلين ضمن ائتلافات متعدّدة الأطراف من شأنه تجاوز الجمود الحكومي وابتكار صيغٍ جديدة للتعاون العملي تُعيد تركيز الدبلوماسية على حلّ المشكلات الفعلية بدل الدفاع عن الامتيازات السيادية.
وتقتضي الدبلوماسية المسؤولة أيضًا تبنّي أخلاق الوقاية. فالمطلوب لم يعد التدخل بعد الكارثة، بل الاستباق والاحتواء المبكر للأزمات من خلال التعاون، والتنمية المستدامة، والوساطة الاستباقية. ويجب على الدبلوماسيين أن يستعيدوا دورهم كصنّاع للحوار، قادرين على استشعار التوترات قبل انفجارها.
وفوق ذلك، ينبغي لهذه الدبلوماسية أن تتّسم بالبعد الإنساني الشامل. ففي عالم مترابط، لا تعترف الأزمات – سواء كانت حروبًا أو أوبئة أو كوارث بيئية – بالحدود الجغرافية. ومن ثمّ، يجب أن تقوم الدبلوماسية الأخلاقية على مفهوم الأمن الإنساني والعدالة المناخية والتضامن غير المشروط. وهي تستند إلى مبدأ بسيط وعالمي مفاده أنّ كل حياة بشرية لها قيمة متساوية.
وأخيرًا، فإن العودة إلى مبدأ المسؤولية تستلزم الإقرار بأنّ اللامبالاة ليست حيادًا، بل خيار سياسي ذو عواقب وخيمة. فهي تُعمّق الظلم وتُضعف الاستقرار العالمي. وعلى العكس، فإن دبلوماسية قائمة على تقاسم المسؤوليات من شأنها أن تعزّز الشرعية الأخلاقية للدول وتُسهم في بناء سلامٍ دائم.
إنّ القوة الحقيقية للدولة تُقاس بقدرتها على حماية الكرامة الإنسانية والدفاع عنها، لا بترسانتها العسكرية أو نفوذها الاقتصادي.
إنّ الخروج من هذا المأزق يمرّ عبر إعادة التفكير في المؤسسات الدولية وإعادة إحياء البعد الأخلاقي والتضامني للدبلوماسية، بحيث تصبح حماية الشعوب أولوية حقيقية لا شعارًا نظريًا.
الخاتمة
إنّ تحوّل الدبلوماسية من مبدأ المسؤولية إلى منطق اللامبالاة لا يمثّل مجرّد انزلاقٍ إستراتيجي، بل يُجسّد أزمة أخلاقية عميقة يعيشها العالم المعاصر. فحين تُضحّي الدول بالمثال الإنساني على مذبح الواقعية السياسية، تتحوّل الحكمة إلى جمود، والحياد إلى تخلٍّ عن الواجب. غير أنّ اللامبالاة ليست موقفًا بريئًا، بل هي انتصارٌ للانتهازية على الضمير، وللمصلحة على الكرامة.
أمام المآسي الإنسانية، فإنّ الامتناع عن الفعل هو شكل من أشكال التواطؤ مع الشرّ. وقد وُجّهت إلى فرانسوا ميتران انتقادات حادّة من قبل دومينيك موازي الذي قال إنه "خاف من مواجهة التاريخ"، وهو ما يُجسّد تلك اللحظة الفاصلة التي يختلط فيها الصمت بالتواطؤ، والحياد بالتنصّل من المسؤولية. وما زال هذا الامتناع المتكرر يتكرّر اليوم، في المخيّمات المنسية للاجئين، وفي المدن المحاصَرة في الشرق الأوسط، وفي قضية غزة، ومأساة الإيغور وغيرهم من ضحايا التجاهل الدولي.
إنّ إحياء الدبلوماسية القائمة على المسؤولية ليس خيارًا أخلاقيًا فحسب، بل هو ضرورة وجودية وسياسية. فحين يتخلى المجتمع الدولي عن واجب الحماية، فإنه يتخلى عن إنسانيته ذاتها. وإعادة المعنى إلى الفعل الدبلوماسي تقتضي إعادة الروح إلى العمل الدولي، وترسيخ قناعة بأنّ القوة الحقيقية لا تُقاس بترسانة الأسلحة، بل بقدرة الدولة على تفضيل العدالة على المصلحة، والرحمة على اللامبالاة.
إنّ الرحمة حين تتحول إلى سياسة، والمسؤولية حين تصبح مبدأً موجِّهًا للعلاقات الدولية، يمكن عندها فقط أن تستعيد الدبلوماسية جوهرها الإنساني، وأن يُعاد التوازن بين الواقعية السياسية والضمير الأخلاقي في خدمة السلم والكرامة البشرية.
الأستاذ الدكتور عبد الواحد غَيَات
أستاذ باحث في العلوم السياسية