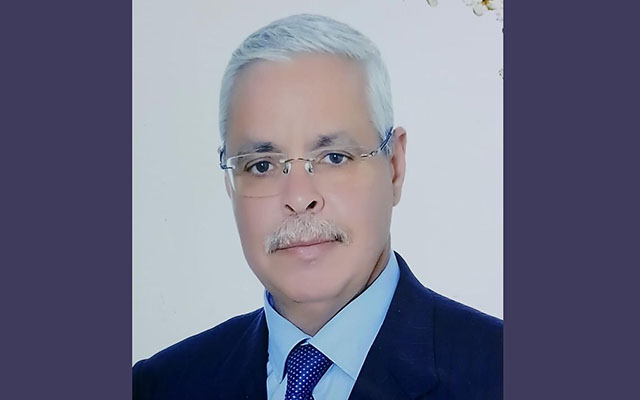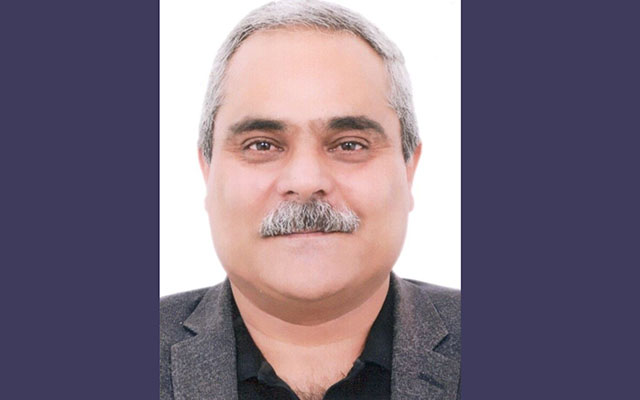صدر مؤخرا كتاب: «البرلمان وحقوق الإنسان: مرجعيات وممارسات» للباحث عبدالرزاق الحنوشي، وقد حظي المؤلف باهتمام لافت عكسته اللقاءات المتعددة التي نظمت في عدة مدن (نحو 20 لقاء في ظرف أربعة أشهر)، وكذا القراءات النقدية والتحليلية التي أنجزتها العديد من الفعاليات الأكاديمية والحقوقية. وسبق لنا في «الوطن الآن» و«أنفاس بريس» أن نشرنا بعضها. ومواكبة للدخول الثقافي الجديد، نواصل نشر مساهمات جديدة. في هذا العدد ننشر مساهمة يوسف اليحياوي، أستاذ بكلية الحقوق بوجدة
الإصدار الأخير للباحث والفاعل المدني والحقوقي عبد الرزاق الحنوشي "البرلمان وحقوق الإنسان: مرجعيات وممارسات" أول مؤلف يخرج عن المسار العام الذي تعرفه الأبحاث والدراسات بحيث تركز على الحصيلة العامة للبرلمان. كما أنه الأول من نوعه الذي يغوص في حصيلة جزئية، أو في مجال واحد من العديد من اختصاصات البرلمان.
لذلك أعتقد أن هذه المنهجية ستأجج شغف الباحثين الجدد في الغوص في مواضيع مستجدة في البحث الأكاديمي..وهنا أشخص، نقطة اختصاصات البرلمان بصفة عامة في الفصل 71، فهناك أكثر من ثلاثين مجالا وميدانا، وطبعا أول هذه المجالات هي الحقوق...
كما أن هذا النوع من الدراسات والأبحاث يعتبر من جهة أخرى، تقييما لعمل مؤسسة دستورية سامية وهي البرلمان. وإذا كان من اختصاص البرلمان تقييم عمل المؤسسات الدستورية ابتداء من الحكومة فمن سيتولى تقييم عمل البرلمان؟
بالتأكيد، المهتمون، الباحثون. وهذا العمل يندرج في هذا المضمار، من أجل مساءلة الأداء والفعالية في عمل البرلمان والفعالية في طبيعة إنتاجه الحقوقي، وهو المجال الذي تحكمه العديد من المداخل: داخلية وخارجية على حد سواء، فحقوق الإنسان ذات مرجعيات دولية وأخرى وطنية.
ويظهر حضور المرجعية الدولية، بشكل قوي جدا، عكس العديد من الاختصاصات أو الميادين المنصوص عليها دستوريا للبرلمان مثلا: النظام الأساسي، المهام الوظيفية العمومية.
ضمانات العمل البرلماني وأخلاقياته
إن ضمانات العمل البرلماني وأخلاقياته موضوع مهم جدا، يحيل على وضعيات وحالات مهمة جدا وهي الحصانة، الاستقلالية، وحرية التعبير. فالصفحة 88 من المؤلف تورد مقتبس مهم: "تمثل حماية حقوق البرلمانيين شرطا لازما لا غنى عنه لتمكينهم من حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بلدانهم...".
هذا المجال يوجد تحت مظلة الحصانة البرلمانية، وخاصة تجاه القوى النافذة من قبيل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، الأمر يمكن ضبطه بكل سهولة.
وفعلا نجد التجربة المغربية قد أقرت ضمانات كثيرة ومهمة لفائدة أعضاء البرلمان، من الناحية المالية والموضوعية. ولكن الضمانة الأساسية التي ركزت عليها الديمقراطيات العريقة هي الاستقامة قبل الترشيح وبعده، وهو الأمر الذي يندرج في خانة شرعية المجلس وعدم إمكانية خضوع أعضائه للتهديد أو الابتزاز، مع عدم السماح لتجار المخدرات بالدخول لمعترك التنافس السياسي... لأن مثل هؤلاء البرلمانيين هم دائما محل تهديد خفي.
وهنا نتحدث عن حضانة المجلس بأكمله وهو الأمر الذي سارت عليه الديمقراطيات العريقة (بريطانيا- أمريكا)، ومن تم يمكن التساؤل هل القيمة القانونية لمدونات الأخلاقيات والسلوك البرلمانية بإمكانها أن تلزم الأعضاء بالتزام الأخلاقيات البرلمانية المساهمة في تجويد العمل البرلماني؟ ف "مثلا مدونة السلوك لرجال القضاء: يمكنها التسبب في عزل القاضي المخل بها". ص 206-207-208
مناقشة الفصل 160 من الدستور
"على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 في هذا الدستور تقديم تقرير على أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان".
فأول ملاحظة يمكن ابداؤها تتمثل في أن هذا المقتضى ظل معطلا لحد الساعة وتقييد القضاء الدستوري لتوسع النظام الداخلي 829-12 في تفسير هذا الفصل (تقديم التقارير من طرف مسؤوليها إلى اللجان الدائمة المختصة..). ثم تأويل القاضي للدستور، لهذا المقتضى بضرورة حضور الحكومة، وليس مباشرة مع المسؤولين عن هذه المؤسسات والهيئات (2012 و 2019) 19/39.
كما يلاحظ في الصفحة 208 من الكتاب هناك خلاصات هي أن: النتيجة "ولاية بيضاء" /الاكتفاء بإيداع التقارير والإحجام من مناقشتها. وهذه إشكالية مهمة جدا، تكاد تصل إلى أهمية لجان تقصي الحقائق
فمن وجهة نظري، فإن القضاء الدستوري فهم وأول النصوص تأويلا صحيحا، مادام أن المشرع الدستوري غابت لديه الإرادة السياسية في منح البرلمان اختصاص رقابي تجاه مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية..
فهذه الهيئات لها وظائف استشارية أساسا لمساعدة البرلمان والحكومة، وبعضها يملك بعض الاختصاصات التقريرية، وهذه التقنية ليس فقط المعني بها تلك الواردة في الفصل 161-170، بل أيضا تلك المنصوص عليها بموجب فصول خاصة، كالمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (ف 151). من هنا سبب "الولاية البيضاء"، ليس هو موقف القضاء الدستوري، بل طبيعة النص الدستوري وصياغته..
فهذا المقتضى يندرج ضمن آليات المراقبة البرلمانية وهنا نورد الملاحظات التالية:
• التشدد الدائم للقاضي الدستوري في مسألة توسيع آليات المراقبة الدستورية (عدم الخروج عن حرفية النص الدستوري) ولنا في ذلك نموذج تاريخي (لجان البحث وتقصي الحقائق).
• اقتناع البرلمان بعدم جدوى هذه التقنية، مادام المشرع الدستوري ربطها فقط بمناقشة دون تحديد آثارها.
• غموض عبارة "تقديم تقرير عن أعمالها..." ولم يستعمل المشرع "تقديم عرض عن أعمالها..." عكس الفصل 148 بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات الذي ينص على: "يقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس..
وبالتالي تكون النتيجة: أن النص الدستوري أفرغ هذه التقنية من محتواها وفعاليتها الرقابية.
ص 165-166-190 من الكتاب.
الأسئلة البرلمانية
صراحة، إحصائيات مهمة وردت في الكتاب ونسب تدل على جوانب الاهتمام البرلماني بحقوق الإنسان ما بين مجلسيه.. ص 172 جاء بها نتيجة فارقة وتسائل دور مجلس النواب مقابل دور مجلس المستشارين. لكن وددت لم تم في هذا الصدد الإشارة إلى الأسئلة ذات الارتباط بالسياسة العامة للدولة.