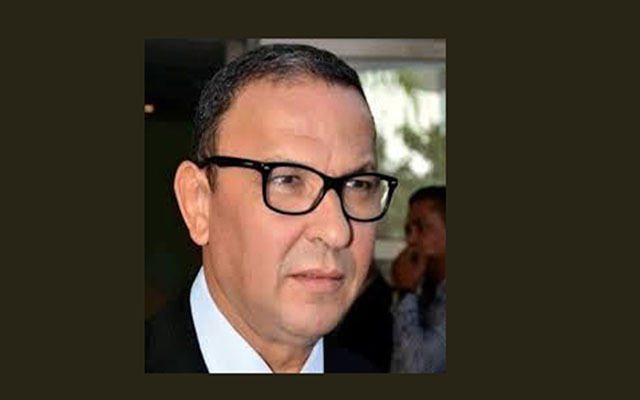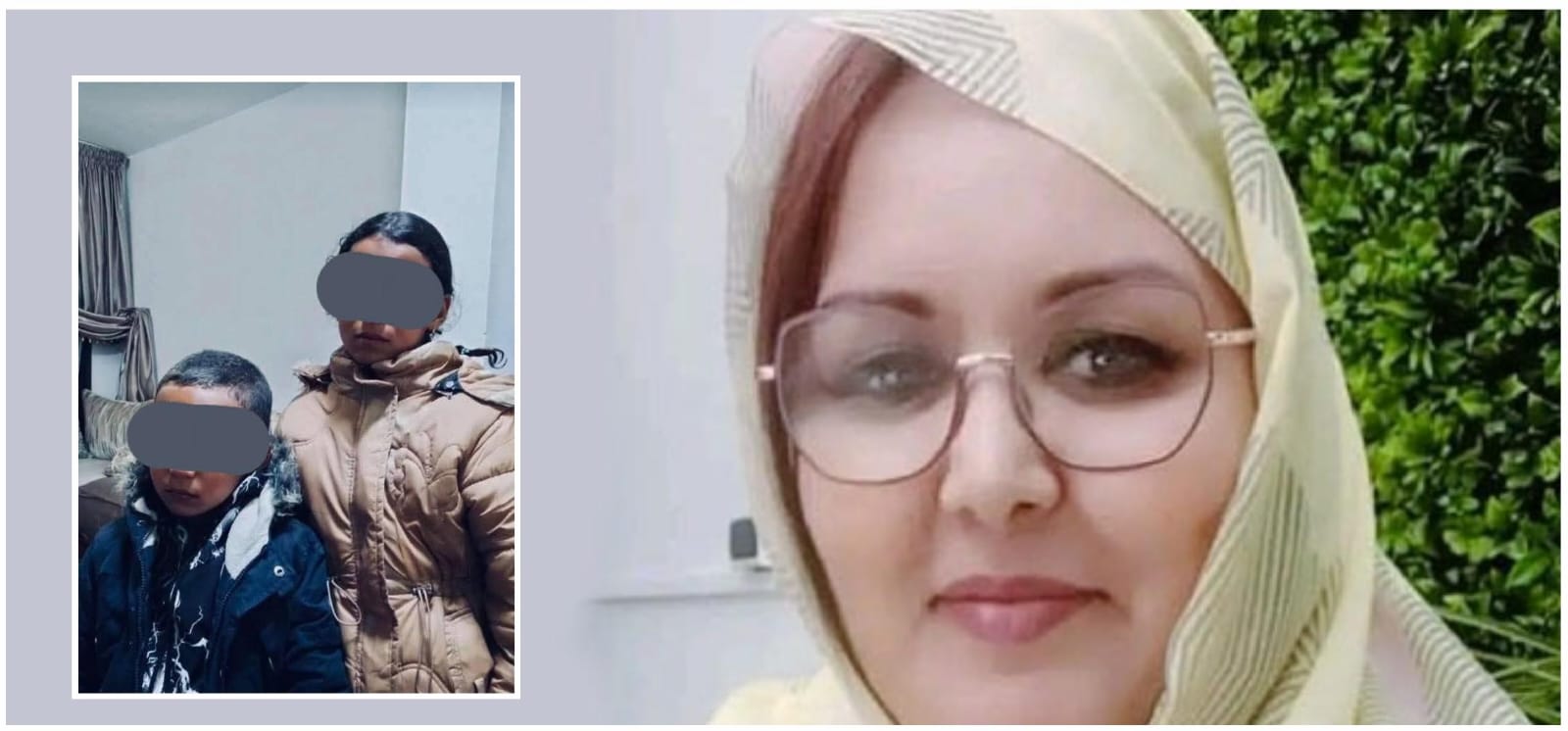تُشكّل قضية الصحراء المغربية ميدانًا مركزيًا لفهم ديناميات التحوّل في الفكر الأممي الحديث، حيث لا يقتصر صراع المصطلحات والممارسات على حدود القضية نفسها، بل يمتد ليشمل إعادة تعريف مقاصد القانون الدولي ومآلاته التطبيقية في مرحلة ما بعد التدويل وما بعد تصفية الاستعمار.
في هذا السياق تهدف هذه المداخلة إلى تفكيك التحول المعياري الذي طرأ على مفهوم تقرير المصير (Self-Determination) من منطقٍ انفصالي تقليدي بات يترنّح أمام قيود الواقع، إلى مفهومٍ تنموي يزاوج بين السيادة والشرعية والفعالية الميدانية، وذلك من خلال قراءةٍ نقدية ونصّية لتقارير الأمناء العامين للأمم المتحدة (2007–2025) وما ترتّب عليها من انعكاسات في قرارات مجلس الأمن وفي الاجتهاد القضائي الدولي.
إن أهمية هذه المداخلة تنبع من موقفه الوسطي: فهو لا يقدّم وصفًا ميدانيًا متحيزًا، ولا يكتفي ببيان الخطاب؛ بل يسعى إلى رصد آليات إنتاج المعنى داخل المنظمة الأممية وكيف تتحوّل اللغة إلى معيارٍ يضفي مشروعية فعلية على ممارسات دولية.
تُبنى هذه الدراسة على منهجٍ مركّب يجمع بين التحليل السيميائي للخطاب القانوني (discourse analysis) والمنهج المقارن للنصوص القانونية والقرارات والاجتهادات القضائية، كما تعتمد على مصادر أولية (تقارير أمناء عامين، قرارات مجلس الأمن، آراء محكمة العدل الدولية) ومراجع ثانوية فقهية وتحليلية.
تسكن هذه الدراسة إشكالية مركزية مفادها: هل مثّلت الممارسة الأممية في ملف الصحراء، من خلال تقارير الأمين العام وقرارات مجلس الأمن، تحوّلاً معياريًا في مفهوم تقرير المصير يشرعن لآليات حكم ذاتي داخل إطار السيادة؟
وتنبني عليها فرضيات رئيسية:
أولًا، أن الخطاب الأممي قد انزاح دلاليًا من الإجرائية إلى السياسية لصالح حلول واقعية؛
ثانيًا، أن ترسخ مفردات مثل «الواقعية» و«الجدية» في التقارير صارت تؤسس لشرعيةٍ معياريةٍ جديدة تُخدم خيارات التنمية والحكم الذاتي؛
ثالثًا، أن هذا التحول لا ينعكس نصًا فحسب بل يتجسد مؤسساتيًا عبر ممارسات مجلس الأمن واجتهادات المحاكم الدولية.
في ضوء ذلك، يتوزّع العمل على مبحثين أساسيين: يكرّس المبحث الأول الانزياح الدلالي والتحول الأسلوبي في الخطاب الأممي، بينما يخصّص المبحث الثاني لتحليل الأبعاد القانونية والمؤسساتية لهذا التحول.
المبحث الأول: الانزياح الدلالي والتحول الأسلوبي
يمثل تطور الخطاب الأممي بشأن قضية الصحراء المغربية منعرجًا مفصليًا في تاريخ الممارسة الأممية المعاصرة، إذ انتقل من لغة الحياد القانوني المجرّد إلى لغةٍ أكثر نضجًا وواقعية، تراعي توازن الشرعية الدولية مع اعتبارات الاستقرار الإقليمي والسيادة الوطنية.
فمنذ سنة 2007، ومع بروز المبادرة المغربية للحكم الذاتي، أخذت تقارير الأمناء العامين للأمم المتحدة تتخلّى تدريجيًا عن الطابع الوصفي البارد الذي كان يميزها خلال حقبة سابقة، لتتبنى نهجًا تحليليًا–توجيهيًا يستحضر التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. وقد انعكس هذا التحول في نَسَق اللغة والمصطلحات المستعملة داخل التقارير، حيث تراجع حضور مفاهيم "تصفية الاستعمار" و"الاستفتاء" لصالح مصطلحات جديدة تعبّر عن مقاربة واقعية بناءة مثل "الحل السياسي الواقعي والدائم" و"المبادرة المغربية الجادة وذات المصداقية" و"الانخراط البنّاء للأطراف". وهكذا تحوّل التقرير الأممي من مجرد وثيقة إحاطة إلى أداة لصناعة المعنى المعياري داخل الأمم المتحدة، تُعيد من خلالها المنظمة إنتاج فهمها لمبدأ تقرير المصير في سياق متحوّل تهيمن عليه دينامية التنمية والشرعية بالنتائج.
المطلب الأول — الانزياح الدلالي: تهميش المصطلحات الإجرائية وتكريس المصطلحات السياسية
شهد الخطاب الأممي المتعلق بالصحراء المغربية منذ سنة 2007 انقلابًا دلاليًا منهجيًا يمكن تسميته انزياحًا دلاليًا (Semantic Shift)؛ هذا الانزياح يتمثّل في عملية إحلال مفرداتٍ سياسيةٍ مكان مفرداتٍ إجرائية/تقنية كانت تسود الممارسة السابقة. على سبيل المثال، صار مصطلح الاستفتاء (Referendum) الذي اصطف لسنوات كآلية محورية لتفعيل مبدأ تقرير المصير أقل حضورًا، بل يكاد أن يختفي تدريجيًا من نصوص التقارير والقرارات الأممية الحديثة، وهو صمت له أكثر من دلالة: فهو لا يعني إلغاء النص القانوني، بل يُعبّر ضمنيًا عن إدراك المنظمة لصعوبات التطبيق الميداني لتلك الآلية (مشكلات تعريف الهيئة الناخبة، تركيبات ديموغرافية متحركة، اغلاق قنوات التطبيق بسبب ظروف أمنية وإقليمية). بهذا المعنى، فإن الصمت الأممي عن الاستفتاء يوازي إعلانا ضمنيا بعدم الجدوى العملية لهذه الآلية في سياق الحالة المغربية، وبالتالي يوجّه البحث إلى اعتماد وسائل تفاوضية أخرى.
في المقابل، برزت في التقارير مفردات ومقولات جديدة ذات حمولة تطبيقية وسياسية: «العملية السياسية»، «المفاوضات الجادة»، «الحل السياسي الواقعي والدائم»، و«المبادرة المغربية الجادة وذات المصداقية»... هذه المصطلحات ليست مفردات جوفاء بل أدوات فعل: فهي تعيد تأطير النزاع كميدان تفاوضي ذي شروط واقعية، لا كمجال تطبيقي محض لإجراء استفتائي تقني. ومن ثمّ تبدو مبادرة الحكم الذاتي ليست مجرّد مقترح دبلوماسي، بل خيارًا منهجيًا يستجيب لهذه اللغة الجديدة. كما يجدر الانتباه إلى أن إدراج أطراف إقليمية إشارات إلى الدول المجاورةNeighbouring States) في تقارير لاحقة يشير إلى توسّع المرجعية من ثنائية القضية إلى بنية إقليمية أوسع، وهو تحول دبلوماسي يخدم مبدأ إشراك الفضاء الإقليمي في الحلّ ويخفف من ثنائية المواجهة الثنائية.
هذا الانزياح يُقرأ أيضًا كمحصلة تراكمية لممارسات ميدانية وتنموية (مشروعات بنية تحتية، استثمارات، قنصليات) تَغذي خطابًا عمليا يجعل التنمية مقياسًا لشرعية الإدارة الفعلية؛ فحين تتكرر الدلالة التنموية عبر نصوص أممية، يتحول الوصف إلى معيار يُستند إليه في تقييم المشروعية، وهنا يكمن جوهر «التحول المعياري» الذي تنظر هذه الدراسة في أبعاده.
الملحق 1 — تطور مفهوم تقرير المصير (1945–2025)
|
المرحلة |
الإطار المرجعي |
المفهوم السائد |
الآلية التطبيقية |
السند القانوني |
|
1945–1960 |
ميثاق الأمم المتحدة، قرارات تصفية الاستعمار |
تقرير المصير الانفصالي |
الاستفتاء أو الانفصال |
القرار 1514 (XV) |
|
1960–1990 |
الحرب الباردة |
تقرير المصير السياسي |
المفاوضات المحدودة |
القرار 2625 (XXV) |
|
1990–2000 |
ما بعد الحرب الباردة |
تقرير المصير الديمقراطي |
الانتقال المؤسساتي |
قضايا تيمور الشرقية وكوسوفو |
|
2007–2025 |
الواقعية السياسية والتنمية |
تقرير المصير التنموي |
الحكم الذاتي الموسع |
قرارات مجلس الأمن (1754–2703) |
المطلب الثاني : التحول الأسلوبي من اللغة الوصفية إلى اللغة التقييمية
الملحق 2 — تطور الخطاب الأممي حول الصحراء المغربية (2007–2025)
|
السنة |
الأمين العام |
المفاهيم الغالبة |
الصياغات الأساسية |
الأثر القانوني |
|
2007–2016 |
بان كي مون |
الحياد، الإنسانية، المفاوضات |
"دون شروط مسبق"، "الأطراف المعنية"... |
تكريس الحياد الإجرائي |
|
2017–2020 |
أنطونيو غوتيريش (مرحلة أولى) |
الواقعية السياسية |
"واقعي"، "عملي"، "دائم"... |
بداية التحول المفاهيمي |
|
2021–2025 |
أنطونيو غوتيريش (مرحلة نضج) |
الشرعية بالتنمية |
"المقاربة التنموية"، "الاستقرار والتعاون" |
تأصيل الشرعية المعيارية الجديدة |
إلى جانب الإزاحة الدلالية، حدث تحول أسلوبي واضح في طريقة عرض التقارير: فاللغة الأممية لم تعد تتصف بالحياد التقريري الجامد، بل اتخذت طابعًا تقويميًا ومحدداً في توصيف السلوكيات والوقائع. التجلي الأبرز لهذا الأسلوب يكمن في ما أسميناه "الموازنة الإيجابية" لصالح الطرف المتعاون، حيث تتضمن النصوص ملاحظاتٍ تفصيلية عن تعاون المغرب مع بعثة المينورسو ومع مؤسسات الأمم المتحدة، وسجلات عن التسهيلات المقدمة، والاستثمار في البنى التحتية والتنمية المحلية، وكلها صيغ تُفهم كشرعنة إدارية وسياسية لفعالية إدارة المغرب للأقاليم الجنوبية.
مقابل ذلك، تزايد استعمال مصطلحاتٍ ذات حمولة اتهامية ضمنية تجاه الطرف الآخر: (قيود،عرقلة، تعديات ميدانية…) هذه العبارات — وإن صيغت بصياغة دبلوماسية — تؤدي وظيفة قانونية: فهي تشكّل سجلًا يُمكن الاستناد إليه لإثبات اختلالات أو انتهاكات تمس بنود اتفاق وقف إطلاق النار أو التزامات قانونية دولية أخرى. ومن ثم، لم تعد التقارير مجرد سردٍ وقائعٍ محايدة، بل تحولت إلى سجلاتٍ تقويميّةٍ قد تستخدمها الأمم المتحدة نفسها أو الأطراف في المسارات القانونية والدبلوماسية.
هذا الأسلوب التقييمي يترجم كذلك تقبّلًا أمميًا لمقولة "الشرعية بالتنمية"؛ إذ إن تضمين عناصر التنمية (مشروعات طرق، موانئ، مشاريع طاقة متجددة، برامج اجتماعية) في الحقل التقييمي يُسهم في تحويل الأداء التنموي إلى سند شرعي يمكّن الدولة من دعوى سيادتها وشرعيتها في المجتمع الدولي. وهكذا يصبح التقرير وسيلة للتقنين العملي للشرعية، ومرآة لواقعية السياسة الأممية التي تفضّل النتائج الاستقرارية على التصريحات النظرية.
المبحث الثاني التأصيل القانوني والمؤسساتي للتحوّل: من الاجتهاد القضائي إلى الممارسة الأممية
إذا كان المبحث الأول قد تناول تحوّل اللغة الأممية من الحياد إلى الواقعية السياسية، فإن هذا المبحث يهدف إلى توطين ذلك التحوّل في الإطار القانوني والمؤسساتي، من خلال تتبّع السوابق القضائية والقرارات الأممية التي منحت التقاريرَ الأمميةَ بعدًا معياريًا، وحوّلتها من وثائق إجرائية إلى أدواتٍ لصياغة القواعد الناعمة (Soft Law) داخل منظومة الأمم المتحدة.
المطلب الأول: الاجتهاد القضائي الدولي من التفسير إلى التأسيس المعياري
لقد شكّلت الاجتهادات القضائية الدولية، وفي مقدمتها آراء محكمة العدل الدولية، الأساس الذي أضفى على تقارير الأمين العام للأمم المتحدة قيمة معيارية متنامية في بنية القانون الدولي المعاصر. ففي القضية التاريخية الخاصة بناميبيا سنة 1971، اعتمدت المحكمة على تلك التقارير بوصفها مرآة تعكس إرادة المنظمة وتعبّر عن ممارستها القانونية في مواجهة الانتهاكات الواقعة على قراراتها، معتبرة أن تقارير الأمين العام ليست مجرد بيانات وصفية أو تقارير إدارية، بل أدوات تأويلية تكشف عن نية الأمم المتحدة في تطبيق القانون الدولي. وقد أقرّت المحكمة في ذلك السياق بأن هذه الوثائق «تجسّد الممارسة القانونية للمنظمة في مواجهة الانتهاكات للقرارات الدولية»، وهو ما أسّس لقاعدة فقهية قوامها أن التقرير الأممي يمكن أن يكون سندًا في التفسير المعياري وليس مجرد وثيقة مرافقة.
وتكرّس هذا التوجه بصورة أوضح في الرأي الاستشاري المتعلق بالجدار العازل عام 2004، حينما أكدت المحكمة مجددًا أن تقارير الأمين العام والمبعوثين الخاصين تمثّل «عناصر إثبات موثوقًا بها في القانون الدولي المعاصر»، وأن تكرار المفاهيم والمصطلحات داخل هذه التقارير يمنحها قوة معيارية متراكمة تجعلها جزءًا من الممارسة المؤسسية المولّدة للأعراف القانونية داخل منظومة الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق، فإن تواتر استعمال تعبير "الحل السياسي الواقعي والدائم" في التقارير المتعلقة بالصحراء المغربية لا يُعدّ صدفة لغوية أو تكرارًا بيروقراطيًا، بل يعكس تطورًا في الفقه المؤسسي الأممي باتجاه تثبيت هذا المفهوم كممارسة معيارية دائمة في معالجة النزاعات.
وقد عززت محكمة العدل الدولية هذا الفهم في رأيها الاستشاري حول كوسوفو سنة 2010، حيث أكدت أن الممارسة المؤسسية للأمم المتحدة، بما في ذلك تقارير الأمناء العامين، تُسهم إسهامًا جوهريًا في استجلاء نية المنظمة إزاء مفهومي تقرير المصير والسيادة، وهو ما يرسّخ مشروعية اعتماد هذه التقارير كأساسٍ لتفسير التحول الأممي من مفهوم تقرير المصير الانفصالي إلى تقرير المصير التنموي القائم على السيادة الواقعية. وهكذا، فإن الخط القضائي لمحكمة العدل الدولية يُظهر بوضوح أن التقرير الأممي لم يعد وثيقة وصفية، بل أصبح وعاءً للمعيار الأممي الجديد، الذي يُعيد عبره القانون الدولي إنتاج نفسه من خلال الممارسة المؤسسية للأمم المتحدة ذاتها.
تأسيسا على ما سبق، تشكل التقارير المتعاقبة حول الصحراء المغربية مجموعة/ corpus متكاملًا من الممارسة الأممية، إذ تعكس تدرّجًا في المفاهيم القانونية من "تصفية الاستعمار" إلى "الواقعية السياسية”. وقد أصبح هذا corpus يُستخدم بوصفه مرجعًا تفسيرياً للسوابق الأممية (UN Practice)، حيث لا تُتخذ قرارات مجلس الأمن إلا بعد الإحالة إليه، مما يرفع من قيمته القانونية ضمن منظومة ما يُعرف بـ القانون الأممي اللين.
ويمكن القول إن التقارير الأخيرة، خاصة تقرير سنة 2025 (S/2025/612)، تمثّل المرحلة الأعلى من هذا التطور، إذ لم تعد تكتفي بتوصيف الحالة، بل تؤسّس لنظام لغوي–قانوني جديد يجعل من الواقعية السياسية إطارًا للشرعية، ومن التنمية أداة لترسيخ السيادة.
وعطفا على ما سبق، يُستنتج أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، في ضوء الميثاق واجتهاد محكمة العدل الدولية، ليست وثائق تقنية محايدة، بل أدوات معيارية تترجم الإرادة المؤسسية للمنظمة. وفي حالة الصحراء المغربية، أصبحت هذه التقارير جزءًا من بنية الاعتراف التدريجي بالسيادة المغربية، عبر إدخال الواقعية السياسية والتنمية الاقتصادية في صميم الخطاب الأممي. إن هذا التحول لا يعبّر فقط عن تغيّر في اللغة، بل عن تغيّر في الفلسفة القانونية للأمم المتحدة نفسها، من حيادٍ شكلي إلى شرعية واقعية تُعلي من الاستقرار والتنمية بوصفهما تعبيرًا عن السيادة المشروعة.
المطلب الثاني: التحول المؤسساتي في مجلس الأمن من قرارات الإحالة إلى قرارات التبني
الملحق 3: مصفوفة المفاهيم الجديدة في القانون الدولي المعاصر
|
المفهوم القديم |
المفهوم الجديد |
الأداة التنفيذية |
المرجع الأممي |
|
تقرير المصير الانفصالي |
تقرير المصير التنموي |
الحكم الذاتي |
قرارات مجلس الأمن |
|
الشرعية بالنص |
الشرعية بالنتيجة |
التنمية والاستقرار |
تقارير الأمناء العامين |
|
السيادة المغلقة |
السيادة المنفتحة |
التعاون الإقليمي |
المبادرة الأطلسية المغربية |
يُشكّل مجلس الأمن الإطار المؤسسي الذي تتفاعل داخله تقارير الأمين العام لتتحوّل إلى قرارات تحمل قوة تنفيذية. من هذا المنطلق، فإن تطور قرارات المجلس حول الصحراء المغربية يُجسد انتقالًا من منطق "الإحالة على التقارير" إلى منطق "الاستناد إليها" كمرجع تأسيسي في صنع القرار الأممي.
بدأ هذا التحوّل مع القرار 1754 (2007) الذي شكّل لحظة انعطاف تاريخية؛ إذ أدرج المجلس للمرة الأولى في ديباجته العبارة: "بعد الاطلاع على تقرير الأمين العام..."، مع الإشادة بمبادرة الحكم الذاتي المغربية بوصفها "جادة وذات مصداقية" (serious and credible). منذ تلك اللحظة، تحولت التقارير من مجرد وسيلة إجرائية لتنوير المجلس إلى سندٍ معياريٍّ في اتخاذ القرار، الأمر الذي يتضح في استمرارية الصياغة في القرارات اللاحقة (1783، 1813، 1871، 2440، 2654... وصولًا إلى 2726 لعام 2024- S/RES/2756-)
إن هذا التكرار اللغوي – المؤسسي لا يُعد مصادفةً، بل هو تثبيت لمبدأ "الاستمرارية اللغوية المؤسسية" (Institutionalized Language) التي تجعل المصطلحات الأممية ذات طبيعة عرفية، أي أنها تكتسب وزنًا معياريًا من كثرة تداولها. وهنا يمكن القول إن عبارة "الحل السياسي الواقعي، العملي، الدائم، القائم على التوافق" قد تحولت إلى صيغة معيارية تضاهي في أهميتها أي قاعدة قانونية غير مكتوبة ضمن القانون الدولي اللين (Soft Law).
يُضاف إلى ذلك أن القرار 2703 (2023) وسّع من دائرة الفاعلين، إذ أشار إلى "أهمية مساهمة الدول المجاورة في دعم العملية السياسية" — وهي صياغة قانونية تُخرج المغرب من موقع الطرف الوحيد وتعيد تأطير المسؤولية على المستوى الإقليمي. هذا البعد المؤسسي يُعد مكسبًا دبلوماسيًا للمغرب لأنه يرسّخ منطق "الإشراك" بدل "الازدواجية"، ويحوّل الملف من نزاعٍ ثنائي إلى مسألة إقليمية ذات بعد تنموي وأمني.
كما أن التقرير S/2025/612 يُتوج هذا المسار بتبنيه مقاربة جديدة تجمع بين التحليل السياسي والحقوقي، إذ لم يكتفِ بوصف الأوضاع بل ربط صراحة بين التنمية في الأقاليم الجنوبية والاستقرار الإقليمي. بذلك أصبحت الواقعية السياسية إطارًا للشرعية، والتنمية وسيلةً لتكريس السيادة، وهو جوهر التحول المعياري الذي يرصد هذا البحث.
يُظهر التحليل أن التحول الأممي لم يكن مجرد تبدّل لغوي بل انتقال مؤسساتي متكامل، قوامه التفاعل بين القضاء الدولي ومجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة. هذا التفاعل أنتج نوعًا من "التشريع المؤسسي غير المكتوب" الذي حوّل المفاهيم السياسية إلى أدوات قانونية. ومن خلال تكرار المفردات المعيارية وإدماجها في القرارات التنفيذية، تحولت الواقعية السياسية إلى قاعدة استرشادية، وأصبحت التنمية ركيزة في ممارسة السيادة.
وبناءً عليه، يمكن القول إن المغرب لم يعد موضوعًا للقرارات بل أصبح فاعلًا في صياغة اللغة التي تُبنى عليها هذه القرارات، عبر سياسة واقعية متناغمة مع اتجاه القانون الدولي الجديد نحو "الشرعية بالنتائج" بدل "الشرعية بالتصريحات".
خاتمة
من الشرعية بالنص إلى الشرعية بالنتيجة: نحو تجديد فلسفة القانون الدولي من الجنوب
لقد ظلت الشرعية الدولية، عبر قرنٍ من الزمن، تُقاس بالنصوص لا بالنتائج؛ بمدى احترام القواعد لا بمدى تحقيق العدالة أو التنمية أو الأمن. غير أن الممارسة المغربية في الأقاليم الجنوبية، كما عكستها التقارير الأممية الحديثة، دشّنت مرحلة جديدة من التفكير القانوني الأممي يمكن وصفها بـ"الشرعية بالنتيجة"(Legitimacy by Outcome). إنها الشرعية التي لا تُقاس بما كُتب في المواثيق فحسب، بل بما تحقق ميدانيًا من استقرار وازدهار واندماج إقليمي.
في ضوء ذلك، يتبدّى المغرب ليس كمجرد حالة إقليمية ناجحة، بل كنموذجٍ مفهوميٍّ لتجديد الفكر القانوني الدولي من الجنوب، حيث يُعيد تعريف العلاقة بين السيادة والتنمية والشرعية. فقد استطاعت المملكة المغربية أن تُحوّل مفاهيم القانون الدولي من صيغتها الدفاعية إلى صيغتها الإنشائية، أي من الانفعال إلى الفعل، ومن التلقي إلى المساهمة. وهذا ما يجعل تجربة الصحراء المغربية، في بعدها الدبلوماسي والقنصلي والتنموي، نموذجًا يحتذى به في كيفية توظيف القانون الدولي لصالح التنمية والسيادة الوطنية، دون تعارض مع المبادئ الأممية، بل من داخلها.
من هنا فإن الرهان المغربي في المرحلة المقبلة يجب ألا يقتصر على الدفاع عن شرعية مكتسبة، بل على ترسيخ نظرية مغربية في تجديد القانون الدولي، قوامها الشرعية المعيارية والنتائج الواقعية، أي بناء قانون دولي جديد تتحدث لغته عن الجنوب لا عنه، ويقيس الشرعية بمقدار ما تحققه من أمنٍ واستقرارٍ وتنميةٍ مشتركة.
د. حكيم التوزاني
أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية
جامعة ابن زهر بأكادير