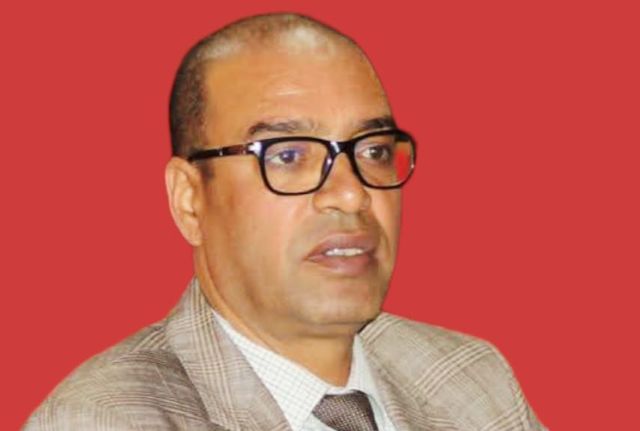كانت المفتشية الجهوية التخصصية لمادة الفلسفة قد نظمت بشراكة مع الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، المكتب الوطني، تحت إشراف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس درسا افتتاحيا تحت عنوان: تاريخ الدرس الفلسفي بالمغرب، ألقاه الاستاذ والمفتش المتقاعد عبد المجيد الانتصار.
في سياق متصل تتقاسم جريدة "أنفاس بريس" مع القراء كلمة المفتشية الجهوية التخصصية لمادة الفلسفة بأكاديمية الدار البيضاء سطات، والتي ألقاها عبد الكريم سفير المفتش المنسق الجهوي التخصصي لمادة الفلسفة، والتي وسمت بـ "الدرس الفلسفي في المغرب بين رهانات التجويد والتحولات الرقمية: نحو تربية نقدية في زمن الذكاء الاصطناعي".
ملخص كلمة عبد الكريم سفير:
تستعرض هذه الورقة وضعية الدرس الفلسفي في المغرب في ظل التحولات المجتمعية العميقة، وتسائل إمكانيات تجويده بما يتلاءم مع رهانات المجتمع الرقمي والديمقراطية وحقوق الإنسان والتربية على القيم والتفكير النقدي، وخاصة في ضوء تطلعات جيل زد. وتعرض الورقة منظور المقاربة العبر- مناهجية كإطار لإعادة بناء الدرس الفلسفي وجعله فضاءً نقديًا قادرًا على مواجهة تحديات العصر.
مقدمة:
لم يعد الدرس الفلسفي في المغرب مجرد لحظة تربوية مخصصة لتلقين مفاهيم أو تدريب المتعلمين على تحليل نصوص مدرسية. إنه اليوم يقف على مفترق حاسم: بين ذاكرة تربوية تشدّه إلى نماذج التلقين والتصنيف، وآفاق جديدة تفرضها التحولات الجذرية التي يعيشها العالم الرقمي وجيل ما بعد الحداثة. فالتعليم لم يعد شأنًا مؤسساتيًا صرفًا، بل أصبح ميدانًا للصراع بين أنماط الوعي والإدراك والمعنى.
في هذا الأفق المتحوّل، لم يعد السؤال هو هل ما تزال الفلسفة ضرورية في المدرسة؟، بل أيّة فلسفة تصلح لمدرسة تحيا داخل زمن الخوارزميات؟ جيل زد لا يعيش في عالم النص بل في فضاء الصورة والتدفق، لا يتعلم بالمحاضرة بل بالتفاعل، ولا يبحث عن الحقيقة في الكتب بل في التجربة الرقمية نفسها. أمام هذا الواقع، يبدو الدرس الفلسفي مهددًا بالانفصال عن زمنه، ما لم ينجح في تحويل ذاته من درس في الفلسفة إلى تفكير فلسفي في الدرس، أي إلى ممارسة نقدية تسائل شروط إمكان المعرفة والتربية والإنسان في العصر الرقمي. هنا بالضبط يبرز راهن المقاربة العبر- مناهجية كأفق للخروج من ثنائية التخصص والانغلاق. فالفكر الفلسفي لا يتجدد إلا عندما يتقاطع مع حقول أخرى: السوسيولوجيا، علوم الأعصاب، الذكاء الاصطناعي، الإعلام، والبيوإتيقا. ليس لأن الفلسفة تحتاج إليها لتبرير وجودها، بل لأنها لا تفكر إلا في حدود ما يعبرها ويتجاوزها. فالعبر- مناهجية ليست ترفًا معرفيًا، بل شرطًا لتجويد الدرس الفلسفي وجعله أداة لفهم الذات والآخر والمجتمع في زمن متسارع الإيقاع ومتعدد الأصوات.
من هنا، تتجه هذه الورقة إلى مساءلة وضعية الدرس الفلسفي بالمغرب، في أفق تجويده والارتقاء به بما ينسجم مع رهانات المجتمع الرقمي والديمقراطية وحقوق الإنسان. إنها محاولة للتفكير في كيف يمكن للمدرسة المغربية أن تستعيد المعنى الفلسفي للتربية، لا باعتبارها عملية نقل للمعرفة، بل باعتبارها فعل تحرير للعقل من القوالب الجاهزة، وتربية على العيش المشترك في زمن اللاتماثل والتنوع والاختلاف.
ـ الدرس الفلسفي وسياق التحولات المجتمعية:
إنّ كلّ إصلاح للتربية دون وعيٍ بالتحوّلات المجتمعية الراهنة يظلّ تجميلاً لشكلٍ مهترئ أكثر منه تجديدًا في الجوهر. والدرس الفلسفي، بحكم طبيعته التأملية والنقدية، لا يمكن أن يُعاد بناؤه إلا في ضوء قراءة عميقة لما يعيشه المجتمع من اهتزازات قيمية ومعرفية وتكنولوجية.
1 ـ جيل زد: تحوّل في الوعي لا في السنّ فقط:
ينتمي جيل زد إلى زمن يختلف جذريًا عن الأجيال السابقة. إنه جيل لا ينتظر المعلومة، بل يصنعها ويعيد تشكيلها لحظة بلحظة داخل شبكات مفتوحة لا تعترف بالتراتبية. هذا التحول من الإنصات إلى السلطة نحو التحرّك داخل اللانظام جعل المدرسة تفقد جزءً من سلطتها الرمزية، وجعل الفلسفة تبدو في نظر كثير من المتعلمين، خطابًا بطيئًا في عالم سريع. غير أن هذا التحدي هو أيضًا فرصة. فجيل زد، رغم غرقه في الشاشات، يعيش عطشًا دفينًا إلى المعنى. إنه جيل يعاني من فرط التواصل ونقص الفهم، من تعدد الحقائق وضياع الحقيقة. هنا، يمكن للدرس الفلسفي أن يستعيد دوره كفضاء لاستعادة البطء، لتعلم الإصغاء والتفكير النقدي في زمن الضجيج الرقمي.
2 ـ الثورة الرقمية وتفكك مفهوم الحقيقة:
لم يغيّر التحول الرقمي أدوات المعرفة فقط، بل أعاد تشكيل بنيتها العميقة. ففي العالم الرقمي، لا توجد حقيقة واحدة بل تغذية راجعة مستمرة تصنعها الخوارزميات. كل فرد يعيش داخل فقاعة إدراكية لا يرى فيها سوى ما يشبهه. بهذا المعنى، لم يعد التحدي هو الوصول إلى الحقيقة، بل تجاوز تشتت الحقائق. لذلك فإذا ظلّ الدرس الفلسفي سجين التصورات القديمة عن المعرفة، سيصير غريبًا في هذا العصر. أما إذا انفتح على المقاربة العبر- مناهجية، فإنه يستطيع أن يطرح سؤال الحقيقة من جديد، مستعينًا بما تكشفه علوم الإدراك، والإعلام، والذكاء الاصطناعي حول حدود الإنسان وعلاقته بالمعرفة.
3 ـ الديمقراطية وحقوق الإنسان كأفق قيمي للدرس الفلسفي:
إن التحولات التكنولوجية، رغم ما تحمله من وعود، تحمل أيضًا تهديدات لجوهر الإنسان وحريته. فالرقمنة المطلقة يمكن أن تنزلق إلى مراقبة شاملة، والذكاء الاصطناعي يمكن أن يتحول إلى سلطة غير مرئية تتحكم في السلوك والاختيار. وفي مواجهة هذا الخطر، تصبح الفلسفة تربية على المواطنة النقدية، أي على الوعي بالحقوق لا كمكتسبات قانونية، بل كقيم تتجدد بالممارسة والفكر.
إن الدرس الفلسفي، هنا، مدعو إلى أن يربط التفكير في الإنسان بالمساءلة حول التقنية، في أفق دمقرطة الوعي ذاته. فالديمقراطية ليست نظامًا سياسيًا فحسب، بل أسلوب تفكير في الذات والآخر، وتربية على الاختلاف والحوار داخل عالم متصل لكنه منقسم.
ـ حدود النموذج الحالي لتدريس الفلسفة بالمغرب:
رغم ما راكمه تدريس الفلسفة في المغرب من تجربة غنية منذ إصلاحات الثمانينيات، فإن النموذج القائم ما زال يحمل في عمقه أثر مرحلة كان يُنظر فيها إلى الفلسفة كـ«مادة» مدرسية أكثر منها تجربة تفكير. ولعل المفارقة الكبرى تكمن في أن الدرس الذي وُجد لتحرير العقل صار هو نفسه أسيرًا لمنطق التلقين والتقويم.
1 ـ بنية البرنامج: الغزارة في المفاهيم والفقر في الأسئلة.
رغم ما يتضمنه المنهاج المغربي من مفاهيم ومجزوءات غنية، ما زال يتعامل مع الفلسفة بمنطق التجزئة. فالمتعلم يُطلب منه أن يعرف المفهوم لا أن يفكر فيه، أن يستعيد ما قيل لا أن يجرّب القول. هذه المقاربة تُنتج كفايات معرفية شكلية، لكنها لا تخلق متعلّمًا يتفلسف بالمعنى الحقيقي؛ لأن السؤال يُقدَّم له جاهزًا، والجواب محدد سلفًا ضمن شبكة المقاربات الرسمية. وهنا يفقد الدرس طاقته التحويلية، أي قدرته على جعل الفكر ممكنًا داخل القسم.
2 ـ الامتحان كقيدٍ على التفكير.
إن امتحانات الفلسفة، كما هي اليوم، تُقوّم مهارات الفهم والتحليل والمناقشة والتركيب والإنشاء، لكنها قلّما تُقوّم فعل التفكير ذاته، بل تغيبه بالمطلق. فالمتعلم يتعلم كيف ينجح في الفلسفة لا كيف يفكر فلسفيًا مما يجعل التجربة الفلسفية تُختزل إلى شكل لغوي منضبط، وتُكافأ الإجابة التي تُرضي التصحيح أكثر من تلك التي تُزعج السؤال. وهكذا يصبح الامتحان لحظة انغلاق بدل أن يكون لحظة انفتاح، وتتحول الفلسفة إلى مهارة بلاغية خالية من رهانها الوجودي والأنطولوجي.
3 ـ الزمن المدرسي وضيق الفضاء التربوي
لا يمكن لفكر يتنفس السؤال أن يعيش داخل إكراه الزمن المدرسي. فالحصص المحدودة، والضغط الزمني للامتحانات، والبرامج المكثفة، تجعل من الصعب خلق حوار فلسفي حقيقي. فيصبح القسم مسرحًا للعرض لا ورشة للتفكير. كما أن الفضاء المدرسي نفسه، بصرامته الإدارية، لا يتيح كثيرًا من المبادرات الفلسفية: النوادي، المختبرات الفكرية، الحوارات المفتوحة… كلها إمكانات بقيت هامشية رغم حضورها في الخطاب الرسمي.
4 ـ الحاجة إلى تجديد العلاقة بين الفلسفة والواقع المغربي
منذ عقود، ظل الدرس الفلسفي يتغذى من الفكر الغربي الكلاسيكي والحديث، وهو أمر مشروع معرفيًا، لكنه خلق مسافة بين الفلسفة والمجتمع المغربي. فنادرًا ما يتم التفكير في قضايا المواطن اليومية ـ الدين، البيئة، الجسد، الهجرة، الرقمنة، العدالة الاجتماعية، الحب.. بوصفها موضوعات فلسفية. الرهان اليوم ليس فقط أن ندرّس الفلاسفة، بل أن نجعل الفلسفة تفكر في مغربها وبلغتها وبهمومها. والمقاربة العبر-مناهجية يمكن أن تكون الجسر لذلك: تربط الفلسفة بعلم الاجتماع وبالتاريخ وبالجغرافيا وبالعلوم الرقمية وبالتحولات البيئية، لتستعيد معناها الحيّ في حياة الناس.
ـ نحو تجويد الدرس الفلسفي في زمن التحول الرقمي.
لا يعني تجويد الدرس الفلسفي تحسين الأداء أو تحديث الأدوات فقط، بل إعادة النظر في فلسفة الدرس نفسه. فالتغيير الحقيقي لا يحدث عندما نستبدل السبورة بالحاسوب، بل عندما يتحول المتعلم من متلقٍ إلى ذاتٍ مفكّرة، ومن مستهلك للمعرفة إلى منتج للمعنى.
1 ـ من التقنية إلى الثقافة الرقمية.
تكتفي الكثير من المبادرات التربوية بإدماج الوسائل الرقمية كوسائط تعليمية، لكنها لا تتساءل عن أثرها في بناء الوعي. إن المطلوب هو الانتقال من التعامل التقني مع الرقمنة إلى التفكير الفلسفي في الرقمنة. فالدرس الفلسفي مطالب اليوم بأن يجعل من العالم الرقمي نفسه موضوعًا للتفكير: كيف تغيّر الشاشات علاقتنا بالذات؟ كيف تعيد الخوارزميات تشكيل الحقيقة؟ وما معنى الحرية في فضاء تُراقبه البيانات؟ بهذا المعنى، يصبح إدماج الرقمي في الدرس الفلسفي تمرينًا على التفكير في التقنية بوصفها قدرًا إنسانيًا، لا أداة محايدة.
2 ـ المقاربة العبر-مناهجية: من التخصص إلى التكامل.
لا يعيش التفكير الفلسفي إلا في حدود التماس مع غيره. فالعبر- مناهجية ليست شعارًا، بل ممارسة تعيد للدرس الفلسفي حيويته. عندما يفتح المدرّس نقاشًا حول الذكاء الاصطناعي مستعينًا بمفاهيم الأخلاق، أو يناقش قضايا البيئة من زاوية فلسفة الطبيعة، أو يتأمل في الجسد انطلاقًا من علم النفس العصبي، فإنه لا يغادر الفلسفة، بل يعيدها إلى أصلها: السؤال. إنّ تجويد الدرس الفلسفي يمرّ عبر هذا الانفتاح المنظّم على الحقول المعرفية الأخرى، دون أن يذوب فيها. فالعبر-مناهجية لا تُلغِي التمايز، بل تحرره من العزلة.
3 ـ التربية النقدية كرهان قيمي.
في عالم يفيض بالمعلومات ويقلّ فيه الفهم تصبح التربية النقدية أهم من أي محتوى. والدرس الفلسفي هو المدرسة الطبيعية لهذا النمط من التربية. ينبغي أن نعلّم المتعلم كيف يشكّل موقفا لا كيف يتبنى رأيًا جاهزًا، كيف يُحسن السؤال قبل أن يسرع إلى الجواب، وكيف يربط بين التفكير والعمل. ففي زمن الأخبار الزائفة والخطابات الشعبوية، يصبح الدرس الفلسفي فضاءً لحماية الوعي الديمقراطي نفسه، لأنه يعلّم الإنصات والتفنيد والتعاطف الفكري والأخلاقي إزاء القضايا العادلة.
4 ـ من تجويد الدرس إلى تجديد المعنى.
ليست الغاية أن نجعل درس الفلسفة حديثًا، بل أن نجعله ذو معنى في عالم متحوّل. المعنى هنا لا يُفرض من فوق، بل يُبنى جماعيًا داخل القسم. حين يتحول الدرس إلى تجربة وجودية صغيرة — لحظة تفكير حر، أو نقاش مفتوح، أو كتابة تأملية — فإنه يصبح فعل مقاومة ضد التبسيط وضد الاستهلاك المعرفي. فالرهان هنا ليس تقنيًا ولا بيداغوجيًا فقط، بل أنطولوجي: كيف نُعيد للإنسان قدرة التفكير في ذاته وفي مصيره داخل عالم مبرمج؟
خاتمة مفتوحة: من الدرس إلى الوجود المفكِّر
الحديث عن تجويد الدرس الفلسفي بالمغرب ليس دعوة إلى إصلاح تقني أو تحديث شكلي، بل إلى إعادة ابتكار معنى التربية نفسها في زمن يتسارع فيه كلّ شيء عدا التفكير. فالتحوّل الرقمي، مهما بدا حتميًا، لا يختصر الإنسان في معطى رقمي؛ ما زال ثمة حاجة إلى ذاك الكائن القادر على الدهشة وعلى الشك وعلى قول لا عندما يصمت الجميع.
إذا استطاع الدرس الفلسفي أن يُصغي إلى هذا النداء فإنه سيستعيد مكانته كأفق للتحرر لا كحصة مدرسية. وسيصبح الفضاء التربوي مختبرًا للعيش المشترك، ومجالًا للتربية على الاختلاف بوصفه ثروة لا تهديدًا. في هذا المعنى، يكون تجويد الدرس الفلسفي دعوة إلى تجديد العلاقة بين الإنسان والفكر، بين التعليم والحياة وبين التقنية والروح.
ربما يكون التحدي الأكبر اليوم هو أن نُعلّم الأجيال القادمة كيف تفكر داخل الفوضى، وكيف تحتفظ ببصيص المعنى وسط زحام الصور والمعطيات. ذلك أن الفلسفة، في النهاية، ليست ترفًا ثقافيًا، بل تمرين على أن نكون إنسانا في عالمٍ يتغير بوتيرة الآلة.