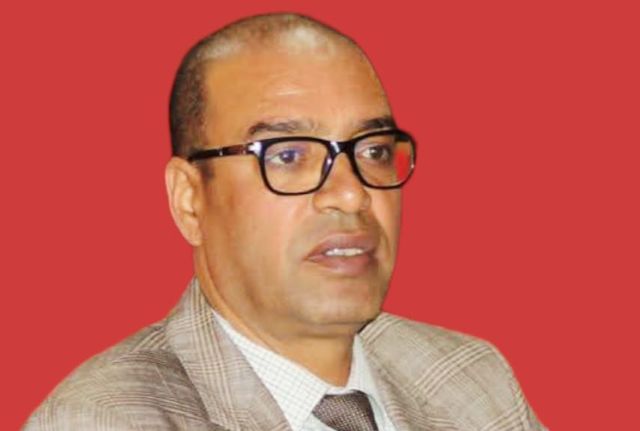منذ بداية التسعينات، دخلت بلادنا في مرحلة جديدة من تاريخها السياسي والإداري، عنوانها السعي لإعادة الثقة بين الدولة والمواطن. ففي خطاب سنة 1990، قال الملك الحسن الثاني رحمه الله: «العالم يتغير، وعلينا أن نتغير»، وهو النداء الذي تزامن مع إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في لحظةٍ كانت البلاد فيها تعيد النظر في علاقتها بذاتها وبمواطنيها، وتفتح أفقًا جديدًا للمصالحة مع المجتمع.
في هذا السياق، بدأت الوزارات المغربية في إحداث وتنشيط مصالح وأقسام، ثم مديريات للتواصل المؤسساتي، هدفها أن تتحدث الإدارة بلغةٍ يفهمها المواطن، وأن تشرح أفعالها قبل أن تطلب الطاعة لها. لم يكن ذلك ترفًا إداريًا، بل خطوةً سياسية واستباقية ؛سياسية لأنها تعبّر عن إرادة الانفتاح بعد زمنٍ من الجفاء، واستباقية لأنها أدركت مبكرًا أن زمن المعلومة المغلقة قد انتهى، وأن شرعية الدولة الحديثة لا تُبنى فقط على القرار، بل على الشرح والمشاركة والشفافية.
تعزز هذا المسار سنة 2001 بإحداث ديوان المظالم / الوسيط ،كآلية جديدة للإصغاء إلى المواطنين وإنصافهم من تجاوزات الإدارة. كان الهدف منه إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن والإدارة، فتم نقل التواصل من “البلاغ الإداري” إلى “الإصغاء المؤسسي”.
لقد أدرك الفاعل حينها أن التواصل العمومي ليس ترفًا، بل وظيفة سيادية في إنتاج الحقيقة. فوجود مصالح للتواصل لم يكن مجرد إجراءٍ تنظيمي، بل وسيلة لتحصين الثقة العامة وحماية المجتمع من الإشاعة. لكن هذا الوعي تراجع تدريجيًا، لتحل محله ممارسة شكلية تكتفي بالبلاغات الجافة والبيانات البروتوكولية.
تحوّل الخطاب في مواقع عدد من الوزارات إلى لغة متكرّرة تبدأ وتنتهي بالاسم نفسه:
استقبل الوزير (مبتسمًا أمام العدسات)،
دشّن الوزير (مُقبلاً على من يسلّمه الورد)،
شارك الوزير (محاطًا بالتصفيق)،
غادر الوزير (مستعجلًا نحو وجهة جديدة)،
هنّأ الوزير (بوجهٍ عريضٍ تتقدمه الكاميرات)،
وتفقّد الوزير (متجهّمًا كما تقتضي هيبة التفقد).
وكأنّ الزمن الإداري كله يدور حول فاعلٍ واحدٍ لا يتغير.
استقبل الوزير (مبتسمًا أمام العدسات)،
دشّن الوزير (مُقبلاً على من يسلّمه الورد)،
شارك الوزير (محاطًا بالتصفيق)،
غادر الوزير (مستعجلًا نحو وجهة جديدة)،
هنّأ الوزير (بوجهٍ عريضٍ تتقدمه الكاميرات)،
وتفقّد الوزير (متجهّمًا كما تقتضي هيبة التفقد).
وكأنّ الزمن الإداري كله يدور حول فاعلٍ واحدٍ لا يتغير.
هكذا تحوّلت وحدات التواصل داخل الوزارات إلى صالونات لتلميع الحضور الذاتي للوزير أكثر من كونها فضاءاتٍ لشرح السياسات العمومية للوزارة وفتح النقاش حولها باعتبارها منتجة لها ومسؤولة على تنفيذها.
والمفارقة أن المواطن، الذي أُنشئت هذه الوحدات لأجله، لم يعد يجد نفسه في ما يُنشر.
وحكى لي صديق ان وزيره في حكومة سابقة اشتد غضبه ارعد وأزبد من مسؤول التواصل بقطاعه بدرجة مدير مركزي لأنه نشر له صورة في نشاط رسمي بدت فيها واحدة من أزراره مفتوحة وبدلته غير مرتّبة كما يشتهي.
لم تكن المسألة في اللباس، بل في النظرةٍ ترى أن هيبة المسؤول تُصنع بزوايا العدسات والكاميرات لا بالفعل والسياسة.
والمفارقة أن المواطن، الذي أُنشئت هذه الوحدات لأجله، لم يعد يجد نفسه في ما يُنشر.
وحكى لي صديق ان وزيره في حكومة سابقة اشتد غضبه ارعد وأزبد من مسؤول التواصل بقطاعه بدرجة مدير مركزي لأنه نشر له صورة في نشاط رسمي بدت فيها واحدة من أزراره مفتوحة وبدلته غير مرتّبة كما يشتهي.
لم تكن المسألة في اللباس، بل في النظرةٍ ترى أن هيبة المسؤول تُصنع بزوايا العدسات والكاميرات لا بالفعل والسياسة.
في الفلسفة السياسية الحديثة، يُعتبر التواصل العمومي أحد أعمدة العقد الاجتماعي الجديد. لان "الشرعية لا تقوم على السلطة، بل على الحوار” حسب هابرماس ولأن المجتمع الذي تُحتكر فيه الكلمة يفقد تدريجيًا قدرته على الفهم المشترك. فالتواصل ليس ترفًا لغويًا، بل هو شكل من أشكال العدالة، حيث تُمنح المعلومة للجميع بالقدر نفسه.
ولعلّ التجارب الأوروبية في هذا المجال تُظهر أن الشفافية ليست خُلقًا فرديًا، بل سياسة عمومية. ففي السويد مثلًا، سُنّ أول قانون لحرية الوصول إلى المعلومات منذ سنة 1766، وهو ما جعل الثقة بالمؤسسات من أعلى المعدلات في العالم. وفي فرنسا، تُعد خلايا التواصل داخل الوزارات “إدارات مواطِنة”، تُنشر تقاريرها بانتظام، وتخضع لرقابة مبدأ “المصلحة العامة قبل الصورة العامة”.
تلك التجارب تؤكد أن الشفافية حين تتحول إلى ثقافة مؤسساتية، لا تحمي الدولة من الإشاعة فحسب، بل تحمي المجتمع من الشك.
تلك التجارب تؤكد أن الشفافية حين تتحول إلى ثقافة مؤسساتية، لا تحمي الدولة من الإشاعة فحسب، بل تحمي المجتمع من الشك.
لقد أظهرت احتجاجات جيل Z الأخيرة أن غياب المعلومة الدقيقة يخلق فراغًا واسعًا تُملؤه التأويلات والانفعالات. فالشباب لم يخرج فقط بسبب صعوبة الواقع، بل أيضًا بسبب ضبابية الخطاب وغياب من يشرح له بصدقٍ ووضوحٍ ماذا يجري في بلده. ولو أدّت وحدات التواصل دورها كما أُريد لها منذ البداية، لما وجدت الإشاعة طريقها بهذه السهولة إلى الشارع.
إن إصلاح منظومة التواصل المؤسساتي اليوم يبدأ من استعادة وظيفتها الأصلية ،أن تكون جسرًا لا جدارًا، وأن تبني المعرفة لا الصورة.
فالمعلومة الرسمية ليست ترفًا إداريًا، بل شرطًا للثقة والاستقرار. والحق في المعلومة، كما كرّسه دستور 2011، ليس مجرد نص قانوني، بل رؤيةٌ لعلاقة جديدة بين الدولة والمجتمع، قوامها الصدق والوضوح والاحترام المتبادل.
فقوة الدول لا تقاس بما تُخفيه، بل بما تجرؤ على قوله.
فالمعلومة الرسمية ليست ترفًا إداريًا، بل شرطًا للثقة والاستقرار. والحق في المعلومة، كما كرّسه دستور 2011، ليس مجرد نص قانوني، بل رؤيةٌ لعلاقة جديدة بين الدولة والمجتمع، قوامها الصدق والوضوح والاحترام المتبادل.
فقوة الدول لا تقاس بما تُخفيه، بل بما تجرؤ على قوله.