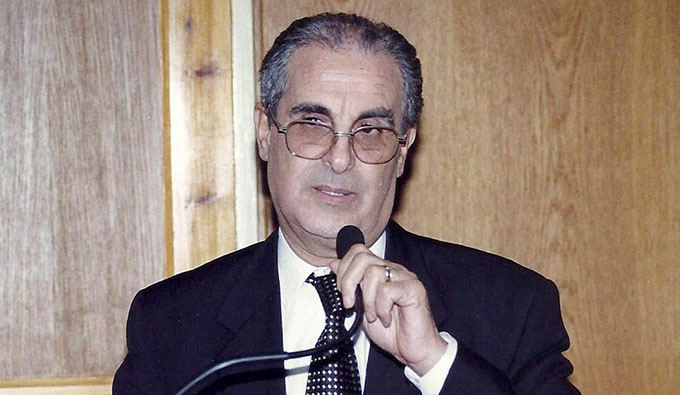دخول القرن الحادي والعشرين لم يُعدّل فقط موازين السياسة والاقتصاد، بل أعاد طرح سؤال جوهري في المغرب: من يُؤطّر الروح؟
في بلدٍ يُفاخر بثوابته الدينية الثلاثة — المذهب المالكي، العقيدة الأشعرية، والتصوف السني — يبدو أن التصوف، رغم حضوره في الخطاب الرسمي، يعيش غيابًا مؤسسيًا على أرض الواقع.
ففي الوقت الذي تُرفع فيه شعارات الإحسان والتزكية تحت مظلة إمارة المؤمنين، تتكفّل الزوايا التقليدية والمبادرات الفردية، وأحيانًا الحزبية، بملء الفراغ الروحي والتربوي الذي تركته المؤسسات الرسمية.
ففي الوقت الذي تُرفع فيه شعارات الإحسان والتزكية تحت مظلة إمارة المؤمنين، تتكفّل الزوايا التقليدية والمبادرات الفردية، وأحيانًا الحزبية، بملء الفراغ الروحي والتربوي الذي تركته المؤسسات الرسمية.
الإحسان: جوهر الدين ومقصد إمارة المؤمنين
في الحديث النبوي الجامع الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جاء جبريل عليه السلام يُعلّم المسلمين دينهم، سأل النبي (ص) عن الإحسان، فقال:
“أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.”
بهذا التعريف النبوي، يتجلّى الإحسان كمقام روحي عميق، يُعلّي من حضور القلب في العبادة، ويُربّي النفس على المراقبة، ويُهذّب السلوك في السر والعلن.
“أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.”
بهذا التعريف النبوي، يتجلّى الإحسان كمقام روحي عميق، يُعلّي من حضور القلب في العبادة، ويُربّي النفس على المراقبة، ويُهذّب السلوك في السر والعلن.
لكن الإحسان لا يقتصر على البُعد التعبّدي، بل يمتد إلى الإحسان في المعاملة، في العمل، وفي خدمة الناس. وهو بذلك يُشكّل مقصدًا مركزيًا في مشروع إمارة المؤمنين، الذي لا ينبغي أن يُختزل في الضبط الفقهي أو التنظيم الإداري، بل يُفترض أن يُفعّل الإحسان في بعديه:
• الإحسان إلى الله عبر التربية الروحية والتزكية
• الإحسان إلى الناس عبر العدالة، والرحمة، والرعاية الاجتماعية
• الإحسان إلى الناس عبر العدالة، والرحمة، والرعاية الاجتماعية
التصوف في الخطاب الرسمي
منذ سنوات، تبنّت الدولة المغربية التصوف كخيار استراتيجي لمواجهة التطرف الديني، وتعزيز الأمن الروحي. وقد عبّر الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة عن أهمية التصوف في نشر قيم التسامح والاعتدال، خصوصًا في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تُستخدم الزوايا المغربية كأدوات دبلوماسية ناعمة.
ورغم هذا التبني، فإن التصوف ظل في مستوى الخطاب، ولم يُترجم إلى ممارسة مؤسسية تُجسّد التصوف كمنظومة تربوية وروحية.
وزارة الأوقاف تُشرف على بعض الزوايا الكبرى، وتُصدر الظهائر الشريفة لتعيين شيوخ الطرق، وتدعم ملتقيات علمية وروحية، لكن هذا الإشراف يبقى جزئيًا وغير فعّال في بناء مشروع روحي متكامل تحت مظلة إمارة المؤمنين.
وزارة الأوقاف تُشرف على بعض الزوايا الكبرى، وتُصدر الظهائر الشريفة لتعيين شيوخ الطرق، وتدعم ملتقيات علمية وروحية، لكن هذا الإشراف يبقى جزئيًا وغير فعّال في بناء مشروع روحي متكامل تحت مظلة إمارة المؤمنين.
التصوف على الأرض: غياب الدولة وحضور الزوايا
في الواقع، التصوف يُمارَس من خلال الزوايا التقليدية: البودشيشية، القادرية، الدرقاوية، وغيرها. هذه الزوايا تحتفظ باستقلالية نسبية، وتُمارس طقوسها، وتُكوِّن مريديها، وتُحيي المناسبات الدينية دون أن يظهر دور مباشر لإمارة المؤمنين في التوجيه أو التأطير الروحي.
هذا الغياب يُثير تساؤلات حول مدى جدية الدولة في تحويل التصوف من خطاب إلى ممارسة، وهل يُمكن أن يُوظَّف فعليًا في بناء وعي ديني جماعي، لا مجرد توازن سياسي أو دبلوماسي.
مدى جدية الدولة ونجاعتها
رغم إدراج التصوف ضمن الثوابت الدينية، فإن جدية الدولة في تفعيله ميدانيًا تبقى محل تساؤل. فالمبادرات الرسمية غالبًا ما تكون موسمية أو احتفالية، وتفتقر إلى الاستمرارية والعمق التربوي.
أما من حيث النجاعة، فإن التصوف لم يُدمج في السياسات التعليمية أو الاجتماعية، ولم يُفعّل في المساجد أو المعاهد الدينية كمشروع تربوي حي.
وهنا يظهر التناقض بين الخطاب الذي يُعلي من قيمة التصوف، وبين الواقع الذي يُفرغه من محتواه العملي، ويتركه رهين الزوايا أو المبادرات الفردية.
أما من حيث النجاعة، فإن التصوف لم يُدمج في السياسات التعليمية أو الاجتماعية، ولم يُفعّل في المساجد أو المعاهد الدينية كمشروع تربوي حي.
وهنا يظهر التناقض بين الخطاب الذي يُعلي من قيمة التصوف، وبين الواقع الذي يُفرغه من محتواه العملي، ويتركه رهين الزوايا أو المبادرات الفردية.
فراغ مؤسساتي تملؤه المبادرات النسائية
في ظل هذا الفراغ، برزت مبادرات نسائية نشيطة في عدد من المساجد والمراكز الاجتماعية، تُعنى بتحفيظ القرآن، وتعليم الدين، ومحو الأمية، وتعزيز الوعي اللغوي والديني لدى النساء.
ورغم أن هذه الأنشطة تُقدَّم في إطار اجتماعي وتربوي، إلا أن بعضها ينطلق من خلفيات تنظيمية ذات امتداد سياسي، ويُساهم في بناء شبكات تأثير محلية تُعيد تشكيل المشهد الديني من القاعدة، وفق تصورات لا تخلو من توجهات أيديولوجية.
ورغم أن هذه الأنشطة تُقدَّم في إطار اجتماعي وتربوي، إلا أن بعضها ينطلق من خلفيات تنظيمية ذات امتداد سياسي، ويُساهم في بناء شبكات تأثير محلية تُعيد تشكيل المشهد الديني من القاعدة، وفق تصورات لا تخلو من توجهات أيديولوجية.
هذا الحضور النسائي المكثف، وإن كان يسدّ فراغًا تركته المؤسسات الرسمية، إلا أنه يُثير تساؤلات حول طبيعة التوجيه الذي تتلقاه هذه المبادرات، ومدى استقلاليتها عن المشاريع الحزبية التي تُوظّف الدين كأداة تعبئة ناعمة.
نحو تصوف أميري مؤسسي
لعل أحد المقترحات الجريئة هو إيجاد مقدمين روحيين في المساجد، يُجسّدون التصوف السني المالكي، ويُعيدون التوازن بين الفقه والتزكية، ويُمارسون الإحسان في بعديه الروحي والاجتماعي، تحت مظلة إمارة المؤمنين.
هؤلاء المقدمون يمكن أن يُجسّدوا التصوف الأميري كمشروع تربوي حي، يربط بين الروحانية والمواطنة، ويُعيد للتصوف مكانته كمصدر للإصلاح الأخلاقي والاجتماعي، لا مجرد تراث رمزي أو خطاب دبلوماسي.
هؤلاء المقدمون يمكن أن يُجسّدوا التصوف الأميري كمشروع تربوي حي، يربط بين الروحانية والمواطنة، ويُعيد للتصوف مكانته كمصدر للإصلاح الأخلاقي والاجتماعي، لا مجرد تراث رمزي أو خطاب دبلوماسي.