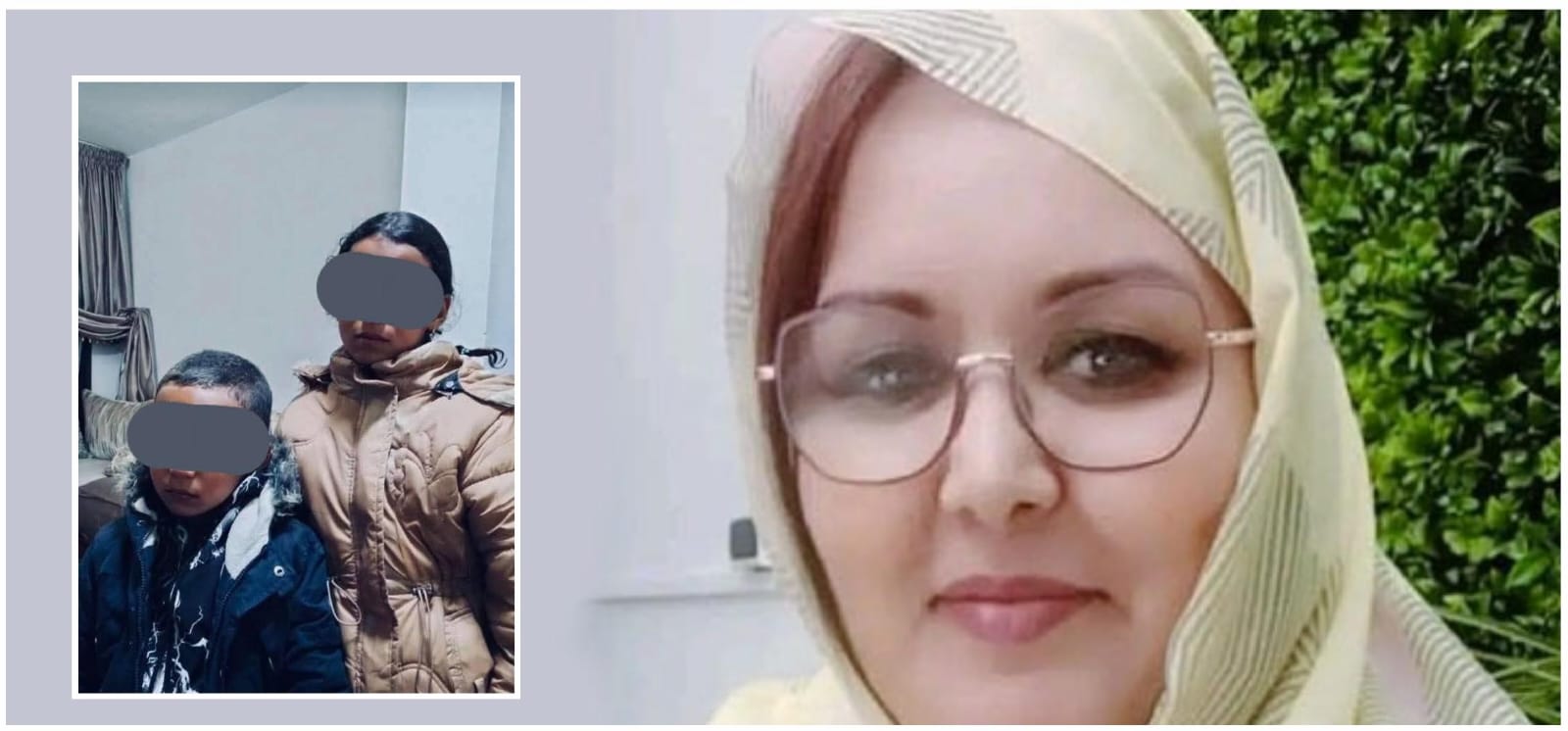طالب الاحتجاج الشبابي بإصلاح «التعليم» و«الصحة» وتوفير فرص الشغل، كما طالب بالكفاءة والعدالة والكرامة؛ وهي المطالب التي تمس، في العمق، جوهر العلاقة بين الدولة والمواطن الذي ظل، عبر أجيال، يطالب بإصلاحات تمس معيشه اليومي وتخرجه من الاستعصاء الذي يطال عدة مجالات حيوية لا يمكن قياس صدق الخطاب الحكومي أو الحزبي إلا بمدى تحققها على نحو ملموس في المستشفيات والمدارس وأسواق الشغل.
وتكمن المفارقة هنا في انتهاج الحكومة للغة الأرقام والمشاريع والميزانيات للدفاع عن برامجها، مقابل جيل يطالب بلغة القيم والمعنى والعدالة في توزيع الفرص، فضلا عن أحزاب معارضة تحاول إعادة رسم تموقعها في الخريطة السياسية من خلال نقد السياسات العمومية وإحياء ثقة المجتمع في السياسة ذاتها، وإعلان نفسها بديلا منقذا من الضلال.
لقد اتضح أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية تتقاطع في رؤية واحدة تلتقي عند ما يمكن تسميته «الإصلاح من فوق»، أي إصلاح تديره الحكومة عبر سياسة عمومية. بيد أن الحكومة- وهذا ما انتقده الملك في خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية (10 أكتوبر 2025) - منحت الأولوية للمشاريع الكبرى على حساب سياسات اجتماعية فعالة قادرة على تقليص الفوارق وضمان العدالة المجالية، مثل إصلاح التعليم والصحة اللذين يعتبران اختبارا حقيقيا لقيمة المواطنة وصدق الحكومة في تحقيق وعودها.
في المقابل، تطرح أحزاب المعارضة «الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية، الاشتراكي الموحد، فيدرالية اليسار الديمقراطي..» رؤى بديلة وإن كانت تفتقر إلى أدوات التنفيذ. فالاتحاد الاشتراكي، على سبيل المثال، يرى أن الإصلاح ينبغي أن يقوم على إعادة الاعتبار للمرفق العمومي وضمان العدالة المجالية، محذرا من خطر الخوصصة الزاحفة «تفويت المستشفيات العمومية» والدعم العمومي المفوت إلى المصحات الخاصة، مما قد يحول الصحة والتعليم إلى امتياز طبقي. بينما تبنى «البيجيدي» خطابا نقديا يركز على ضرورة ربط الإصلاح بالقيم الأخلاقية للحكامة الجيدة، وبتحقيق العدالة في الولوج إلى الخدمات. فيما أكد «التقدم والاشتراكية» ضرورة الإسراع بإطلاق «قفزة إصلاحية نوعية» لتحقيق العدالة الاجتماعية التي لن تمر إلا عبر إصلاح الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، لضمان ولوج فعلي وعادل لكافة المواطنين، كما اتهم الحكومة الحالية بعدم التفاعل مع ملاحظاته ومقترحاته طوال أربع سنوات، منتقدا تبنيها لـخطاب «الاستعلاء وإنكار الواقع». أما حزبا «فيدرالية اليسار الديمقراطي» و «الاشتراكي الموحد»، فيطرحان مقاربة جذرية تقوم على إعادة تعريف وظيفة الدولة نفسها: من دولة ضامنة للحد الأدنى إلى دولة راعية، من منطق السوق إلى منطق الحق. بينما يركز «الاتحاد الدستوري» و«الحركة الشعبية»، بصيغ خجولة ومتفاوتة، على أهمية تحفيز الاستثمار في القطاعين عبر الشراكة مع القطاع الخاص ولكن في إطار مراقبة صارمة وشفافية في التدبير.
والظاهر أن الأحزاب السياسية، رغم اختلافها، تدور حول محور واحد هو البحث عن توازن بين «الكلفة» و«الحق»، أي بين الواقعية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. لكن الشباب المحتج، الذي يشاهد على شاشته الصغيرة تجارب أنظمة تعليمية وصحية متقدمة في بلدان قريبة، لا يعترف بهذه التوازنات القديمة. فهو يريد تعليما عادلا يتيح له حرية الإبداع والانفتاح، وصحة تضمن كرامته دون أن يضطر لطلب «الواسطة» أو دفع الرشوة للسماسرة و«الشناقة». يريد سلطات تخاطبه باللغة التي يفهمها «لغة الواقع الملموس»، لا بلغة الخطب والجداول والأرقام ومعدلات النمو. ومن هنا يتولد نوع جديد من الاحتجاج الهادئ، احتجاج ثقافي وقيمي وأخلاقي يعبر من خلاله الشباب عن «الوطن الذي نريد».
ومهما يكن، فإن الإصلاح المؤسسي الذي تقترحه الأحزاب، أغلبية ومعارضة، ينبغي أن يلتقي مع الإصلاح الذي ينشده المغاربة، جيلا بعد جيل، مما سيفضي إلى فتح أفق جديد لبناء ثقة مفقودة تتعدى الحسابات الانتخابية الضيقة نحو توافق وطني حول التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين للسيادة المجتمعية. هذا هو الضمير الجديد الذي ينبغي أن يحكم الأحزاب السياسية أمام وعي شبابي حاد يرى أن الكرامة لا تجزّأ، وأن الحق في التعليم الجيد والعلاج هو ما يمنح للمواطن المغربي، هنا والآن، معنى الانتماء.
لقد سئم المغاربة من فشل الحكومات المتعاقبة كلها في إصلاح قطاعي التعليم والصحة. كما سئم المغاربة من ازدواجية الخطاب الحزبي بين الحملات الانتخابية والواقع، ومن تناقض الشعارات التي تتحدث عن «الكفاءة» و«النزاهة» و«المصداقية»، وبات المغاربة يدركون أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق بالتصريحات بل بالنتائج القابلة للقياس. لذلك فإن كل تأخر في إصلاح التعليم والصحة يتحول في نظرهم إلى مؤشّر على فشل السياسة نفسها، إذ ما معنى أن يمتلك المواطن بطاقة للتأمين الصحي بينما لا يجد طبيبا أو سريرا في مستشفى قريب خاصة في المناطق النائية؟ وما معنى أن لا يجد التلميذ الوسائل الضامنة لتعليم جيد؟ وما معنى أن يضطر الآباء والأولياء إلى اللجوء إلى التعليم الخاص لضمان الحد الأدنى من «جودة التمدرس»؟ وما معنى التفاوتات القاتلة في مجال التعليم الخاص؟ وما معنى إفراغ المدرسة العمومية من مضامينها وتركها للتشرميل والاكتظاظ؟
إن إصلاح التعليم والصحة في المغرب لا يمكن أن ينجح إلا إذا بني على ثلاثة أعمدة متكاملة: الإرادة السياسية الحقيقية، الكفاءة الإدارية، والمشاركة المجتمعية، بما فيها إشراك الفاعلين المباشرين والخبراء المتمكنين من المعطيات والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، بدل عرض هذا الإصلاح في شكل مؤشرات وأوراش رقمية.. وكفى لله المؤمنين شر القتال، والحال أن «تحسين وضعية الأطر التربوية»، و«تحسين الخدمات الصحية القروية»، و«إصلاح منظومة التوجيه التربوي» وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، ظلت كلها أوراش متعثرة أو محدودة الأثر، بل رهينة لمجموعة من الاختبارات والتجارب التي لا يمكن معرفة نتائجها.
لا زال المغاربة يواجهون هشاشة البنيات الاستشفائية «مستشفيات جهوية متهالكة، مراكز قروية بدون تجهيزات أساسية، ومؤسسات استشفائية كبرى لا تواكب الضغط السكاني ولا التوزيع العادل للمرض»، وما زالوا يقفون يوميا على سياسة دوائية تنهض على التلاعب والاحتكار، ذلك أن أسعار الأدوية تظل مرتفعة مقارنة بمستوى الدخل، ونظام التوزيع يخضع لهيمنة لوبيات قوية من شركات الاستيراد والتوزيع، في غياب سياسة وطنية فعالة لتشجيع الصناعة المحلية، كما مازالوا يفتقرون لأدوات العلاج الأساسية والتجهيزات الحيوية: «السكانير، أجهزة الأشعة، وحدات الإنعاش، المختبرات، وحتى سيارات الإسعاف المجهزة.. إلخ»، وما زالوا يعانون من غياب مسار علاجي واضح وموحد، وما زالوا يعانون من غياب البعد الأخلاقي المفقود في الخدمة الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية التي تتعامل إداراتها مع المرض باعتباره زبونا أو بقرة قابلة للحلب.
يتضح جليا أن التنظيمات الحزبية، أغلبية ومعارضة، يمينا ويسارا، ما تزال تقف على مسافة واضحة من المطالب الحقيقية للمغاربة، خاصة في مجالي التعليم والصحة اللذين يمثلان عصب الكرامة الاجتماعية وميزان العدالة في أي مشروع تنموي. فالملاحظ أن الخطاب الحزبي ظل أسيرا للغة عامة لا تلامس التفاصيل اليومية لمعاناة المواطنين، بينما تستمر المستشفيات في مواجهة خصاص مهول في الموارد البشرية والتجهيزات، والمدارس العمومية في الانحدار نحو مزيد من التدهور، وكأن الزمن السياسي يسير في اتجاه آخر مغاير لتطلعات المواطنين، مما يدل على أن أغلب الأحزاب المغربية فقدت حرارة التواصل المباشر مع الناس، وكفت عن القيام بأدوارها في الوساطة لتصحيح السياسات العمومية، والضغط على الحكومة لتجويد قراراتها، وبات عملها لا يبارح الموسم الانتخابي العابر، وكأن الأحزاب خلقت فقط للحاق بالمقاعد الوزارية وترك الحبل على الغارب للإقصاء الاجتماعي ليقول كلمته في مستشفياتنا ومدارسنا.
تفاصيل أوفى تجدونها في العدد الجديد من أسبوعية "الوطن الآن"