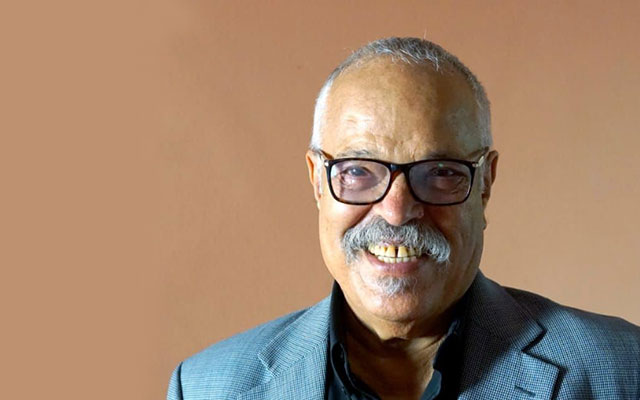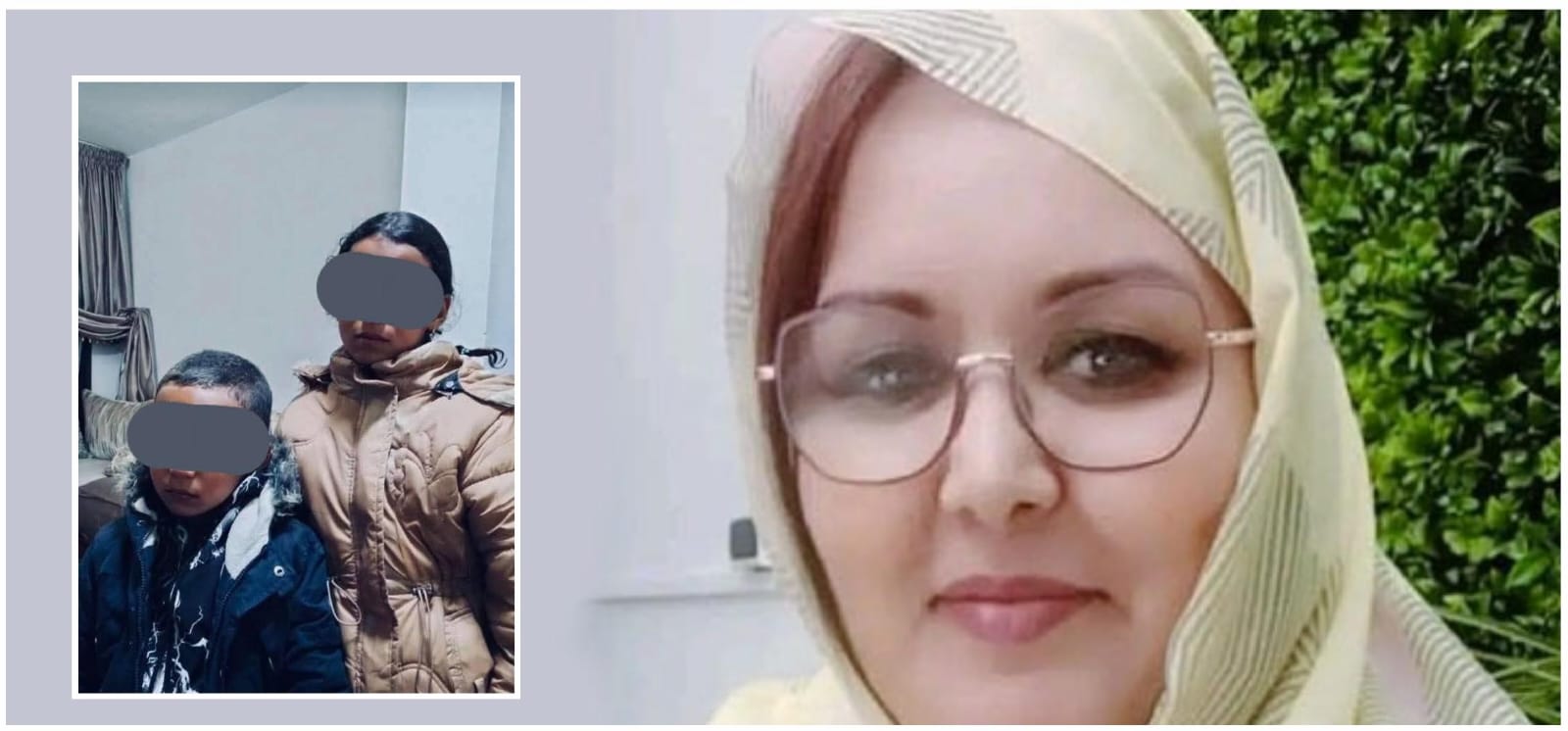في القرن الحادي والعشرين وفي وضح النهار، وعلى مرأىً من العالم المتحضر، تُفرض مجاعةٌ على قطاع غزة. ليست مجاعةً بسبب الجفاف، ولا بسبب فشل المحاصيل أو زلازل الطبيعة، بل مجاعةٌ مصنعة، مصممةٌ بعناية، تُدار من خلف شاشات المراقبة ونقاط التفتيش العسكرية، مجاعةٌ تُدار بالقرار لا بالقدر.
منذ أكتوبر 2023 حين اشتعلت الحرب على غزة، سارعت إسرائيل إلى إعلان الحصار الكامل على القطاع، لا كهرباء، لا وقود، لا ماء، لا طعام، ثم سرعان ما تحولت تلك الإجراءات من وسيلة ضغطٍ إلى استراتيجيةٍ مستدامة، ومع مرور الشهور، لم تكن القنابل وحدها تفتك بسكان غزة، بل الجوع، الجوع الذي لا يظهر في صور الأقمار الصناعية ولا تُوثقه كاميرات البنتاغون، لكنه أشد فتكاً من أي سلاح تقليدي.
اليوم، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، يعيش أكثر من نصف مليون إنسان في غزة ضمن المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي "كارثة" وهي مرحلةٌ لا يُستخدم فيها لفظ "الجوع" كمجازٍ سياسي، بل كوصفٍ علميٍ لمجاعة تتفشى فعلاً، أطفالٌ يموتون بسبب سوء التغذية، وآباءٌ يعودون من طوابير المساعدات بلا شيء، وأمهاتٌ يغلين الماء عله يُقنع الصغار أن هناك شيئاً يُطهى على النار.
الغريب ـ أو بالأحرى المفجع ـ أن كل هذا ليس خفياً، المنظمات الأممية توثق والهيئات الحقوقية تصرخ، ومحكمة العدل الدولية تطالب إسرائيل باتخاذ تدابير "فوريةٍ وفعالة" لتجنب المجاعة، لكن لا شيء يتغير، المساعدات ـ إذا وصلت ـ تُفتش لساعات، وتقيد بالكميات والمواقع، وتُطلق عليها النار أحياناً، وكأن رغيف الخبز تحول إلى هدفٍ عسكري.
يقول العالم المتحضر أنه يُدين استخدام التجويع كسلاح حرب، لكنه يتوقف عند الإدانة، ولا يتقدم خطوةً نحو المنع أو الإيقاف، فهل أصبحت المجاعة سياسةً مقبولةً إذا ارتُكبت بصمتٍ وبالجرعات البطيئة او بالاحرى إذا كانت من طرف "اسرائيل"؟
الأسئلة كثيرةٌ والإجابات شحيحة، تماماً كشحنات الطحين في شمال غزة، كيف نُسمي قتل الإنسان بمنع الطعام عنه؟ أهي جريمة حرب؟ إبادةٌ بطيئة؟ أم مجرد "عمليةٍ أمنيةٍ معقدة" كما تسميها بعض الحكومات الغربية؟ وهل يحق لمدينةٍ أن تختنق حتى الموت بينما يجلس مجلس الأمن في انتظار "توافق الدول الخمس"؟.
غزة اليوم لا تطالب بالمعجزات، ولا تطالب بأكثر من حقها بالحياة، فكل ما تريده هو أن يُسمح لأطفالها بأن يأكلوا، أن لا يموتوا وهم يبحثون عن وجبة، أن لا يتحول الخبز إلى رمزٍ للموت البطيء، في غزة لم يعد السؤال: هل هناك مجاعة؟، بل: كم عدد من سيموت قبل أن يتحرك العالم؟.. وهل تأخرنا عن اللحظة التي لم يعد فيها للجوع دواء؟
منذ أكتوبر 2023 حين اشتعلت الحرب على غزة، سارعت إسرائيل إلى إعلان الحصار الكامل على القطاع، لا كهرباء، لا وقود، لا ماء، لا طعام، ثم سرعان ما تحولت تلك الإجراءات من وسيلة ضغطٍ إلى استراتيجيةٍ مستدامة، ومع مرور الشهور، لم تكن القنابل وحدها تفتك بسكان غزة، بل الجوع، الجوع الذي لا يظهر في صور الأقمار الصناعية ولا تُوثقه كاميرات البنتاغون، لكنه أشد فتكاً من أي سلاح تقليدي.
اليوم، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، يعيش أكثر من نصف مليون إنسان في غزة ضمن المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي "كارثة" وهي مرحلةٌ لا يُستخدم فيها لفظ "الجوع" كمجازٍ سياسي، بل كوصفٍ علميٍ لمجاعة تتفشى فعلاً، أطفالٌ يموتون بسبب سوء التغذية، وآباءٌ يعودون من طوابير المساعدات بلا شيء، وأمهاتٌ يغلين الماء عله يُقنع الصغار أن هناك شيئاً يُطهى على النار.
الغريب ـ أو بالأحرى المفجع ـ أن كل هذا ليس خفياً، المنظمات الأممية توثق والهيئات الحقوقية تصرخ، ومحكمة العدل الدولية تطالب إسرائيل باتخاذ تدابير "فوريةٍ وفعالة" لتجنب المجاعة، لكن لا شيء يتغير، المساعدات ـ إذا وصلت ـ تُفتش لساعات، وتقيد بالكميات والمواقع، وتُطلق عليها النار أحياناً، وكأن رغيف الخبز تحول إلى هدفٍ عسكري.
يقول العالم المتحضر أنه يُدين استخدام التجويع كسلاح حرب، لكنه يتوقف عند الإدانة، ولا يتقدم خطوةً نحو المنع أو الإيقاف، فهل أصبحت المجاعة سياسةً مقبولةً إذا ارتُكبت بصمتٍ وبالجرعات البطيئة او بالاحرى إذا كانت من طرف "اسرائيل"؟
الأسئلة كثيرةٌ والإجابات شحيحة، تماماً كشحنات الطحين في شمال غزة، كيف نُسمي قتل الإنسان بمنع الطعام عنه؟ أهي جريمة حرب؟ إبادةٌ بطيئة؟ أم مجرد "عمليةٍ أمنيةٍ معقدة" كما تسميها بعض الحكومات الغربية؟ وهل يحق لمدينةٍ أن تختنق حتى الموت بينما يجلس مجلس الأمن في انتظار "توافق الدول الخمس"؟.
غزة اليوم لا تطالب بالمعجزات، ولا تطالب بأكثر من حقها بالحياة، فكل ما تريده هو أن يُسمح لأطفالها بأن يأكلوا، أن لا يموتوا وهم يبحثون عن وجبة، أن لا يتحول الخبز إلى رمزٍ للموت البطيء، في غزة لم يعد السؤال: هل هناك مجاعة؟، بل: كم عدد من سيموت قبل أن يتحرك العالم؟.. وهل تأخرنا عن اللحظة التي لم يعد فيها للجوع دواء؟