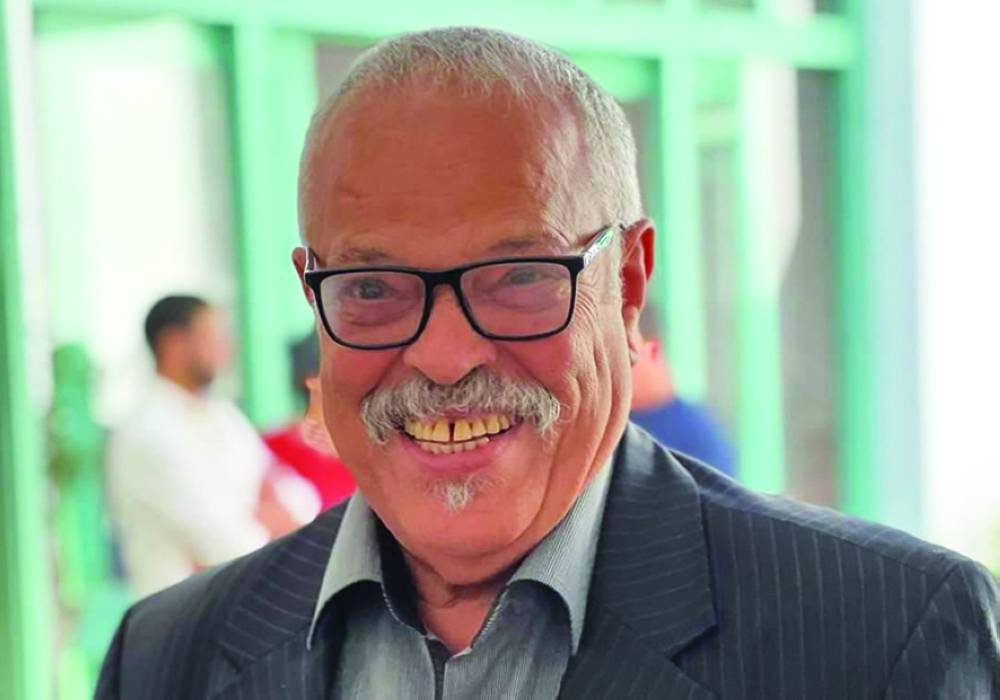في ركن من أركان المطبخ أو الساحة، تقف الشطابة، أو كما يسميها البعض "مكنسة العزف"، ساكنة، لكنها تخبئ في أعوادها الجافة قصصا كثيرة. ليست مجرد أداة لمسح الأرض، بل كائن يتنفس من تلافيف سعف النخيل أو القش، ويحرك ذاكرة الحواس، وملمس اليد، وصوت التنظيف الذي يشبه عزفا يوميا على أرض الحياة.
تصنع الشطّابة من مواد طبيعية محضة: سعف النخيل، القش الجاف، الدوم، أو ما شابهها من نباتات تجمع وتلف بخيوط قوية، ثم تشد من الرأس كضفيرة الأرض. تباع في الأسواق الشعبية، خصوصا على يد تجار قادمين من القرى، يحملون معهم منتجات يدوية من البيئة نفسها، حيث الشطابة قطعة من الأرض صارت أداة.
تستخدم لتنظيف الساحات والأرصفة والممرات، وحتى غرف الطين. كما تستعمل لنزع الشوك من ثمار التِّين الشُّوكي (الكرموس الهندي). وكانت جزءا من العدة اليومية: تعلق وستعار من الجيران، وتغمس في الماء، وتضرب بها الزوايا حتى يهرب الغبار. وفي البيوت الشعبية، لم يكن تنظيف أركان البيت يوم الجمعة يكتمل دونها، بل كانت تبدأ بها طقوس الاستعداد لصلاة الظهر.
من "شَطَّابة الدُّوم"، إلى "المصيليحة" و"المصلاح" في بعض البوادي، إلى "تليت" في سوس، و"ثاشطابث" في ميدلت، و "تاصفت" في عمق الأطلس. تعددت الأسماء، لكن الألياف واحدة، واليد التي تمسك بها واحدة، والوظيفة واحدة: طرد الفوضى.
في الأمثال: "شطابة جديدة كتمسح مزين، والقديمة كتعرف الزوايا".... و "الله يعطيك شطابة" كدعاء ساخر أو طرد رمزي. وفي الدعاء الشعبي: "الله يبعدك عليا ونتهنا منك بحال الشطابة".
في الأعراس أو الولائم، كان استعمالها يرمز لتنظيم الفضاء قبل دخول البركة. وفي بعض القرى، كانت تستعمل لتعليم الأطفال النظام، بالحضور المستمر والانضباط..
أن تمسك بالشطابة، هو أن تسترجع الحواس. رائحة القش، ملمس الألياف الخشنة، صوتها وهي تحتك بالأرض. كل حركة بها تثير تجربة واعية: كأنك تكنس الزمن، لا التراب فقط. وفي لحظة واحدة، قد تعيدك إلى بيت جدتك، إلى صباح بارد في بيت طيني، أو إلى ساحة مسجد قروي يتم تنظيفه قبل الصلاة. إنها ببساطة: بساطة في الشكل، عمق في الاستعمال، وجدلية بين الأرض واليد.
اليوم، حلت مكانها المكانس الكهربائية، والآلات الأنيقة. لكنها ما تزال تباع وستعمل وتستدعى في لغة الناس، وفي طقوس التنظيف التقليدي، بل وتوظف في الزينة والحنين.
الشطابة لم تكن أداة فقط. كانت إيقاعا نسمعه على أرض البيت كل صباح. قطعة من التراب تعود لتنظف التراب. كانت الحياة تختصر في حركتها: بين دفعة اليد وسكون الغبار... كان هناك نظام كامل يعاد ترتيبه....
تصنع الشطّابة من مواد طبيعية محضة: سعف النخيل، القش الجاف، الدوم، أو ما شابهها من نباتات تجمع وتلف بخيوط قوية، ثم تشد من الرأس كضفيرة الأرض. تباع في الأسواق الشعبية، خصوصا على يد تجار قادمين من القرى، يحملون معهم منتجات يدوية من البيئة نفسها، حيث الشطابة قطعة من الأرض صارت أداة.
تستخدم لتنظيف الساحات والأرصفة والممرات، وحتى غرف الطين. كما تستعمل لنزع الشوك من ثمار التِّين الشُّوكي (الكرموس الهندي). وكانت جزءا من العدة اليومية: تعلق وستعار من الجيران، وتغمس في الماء، وتضرب بها الزوايا حتى يهرب الغبار. وفي البيوت الشعبية، لم يكن تنظيف أركان البيت يوم الجمعة يكتمل دونها، بل كانت تبدأ بها طقوس الاستعداد لصلاة الظهر.
من "شَطَّابة الدُّوم"، إلى "المصيليحة" و"المصلاح" في بعض البوادي، إلى "تليت" في سوس، و"ثاشطابث" في ميدلت، و "تاصفت" في عمق الأطلس. تعددت الأسماء، لكن الألياف واحدة، واليد التي تمسك بها واحدة، والوظيفة واحدة: طرد الفوضى.
في الأمثال: "شطابة جديدة كتمسح مزين، والقديمة كتعرف الزوايا".... و "الله يعطيك شطابة" كدعاء ساخر أو طرد رمزي. وفي الدعاء الشعبي: "الله يبعدك عليا ونتهنا منك بحال الشطابة".
في الأعراس أو الولائم، كان استعمالها يرمز لتنظيم الفضاء قبل دخول البركة. وفي بعض القرى، كانت تستعمل لتعليم الأطفال النظام، بالحضور المستمر والانضباط..
أن تمسك بالشطابة، هو أن تسترجع الحواس. رائحة القش، ملمس الألياف الخشنة، صوتها وهي تحتك بالأرض. كل حركة بها تثير تجربة واعية: كأنك تكنس الزمن، لا التراب فقط. وفي لحظة واحدة، قد تعيدك إلى بيت جدتك، إلى صباح بارد في بيت طيني، أو إلى ساحة مسجد قروي يتم تنظيفه قبل الصلاة. إنها ببساطة: بساطة في الشكل، عمق في الاستعمال، وجدلية بين الأرض واليد.
اليوم، حلت مكانها المكانس الكهربائية، والآلات الأنيقة. لكنها ما تزال تباع وستعمل وتستدعى في لغة الناس، وفي طقوس التنظيف التقليدي، بل وتوظف في الزينة والحنين.
الشطابة لم تكن أداة فقط. كانت إيقاعا نسمعه على أرض البيت كل صباح. قطعة من التراب تعود لتنظف التراب. كانت الحياة تختصر في حركتها: بين دفعة اليد وسكون الغبار... كان هناك نظام كامل يعاد ترتيبه....