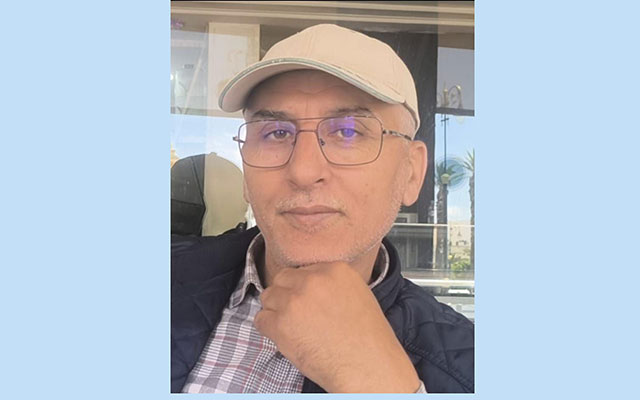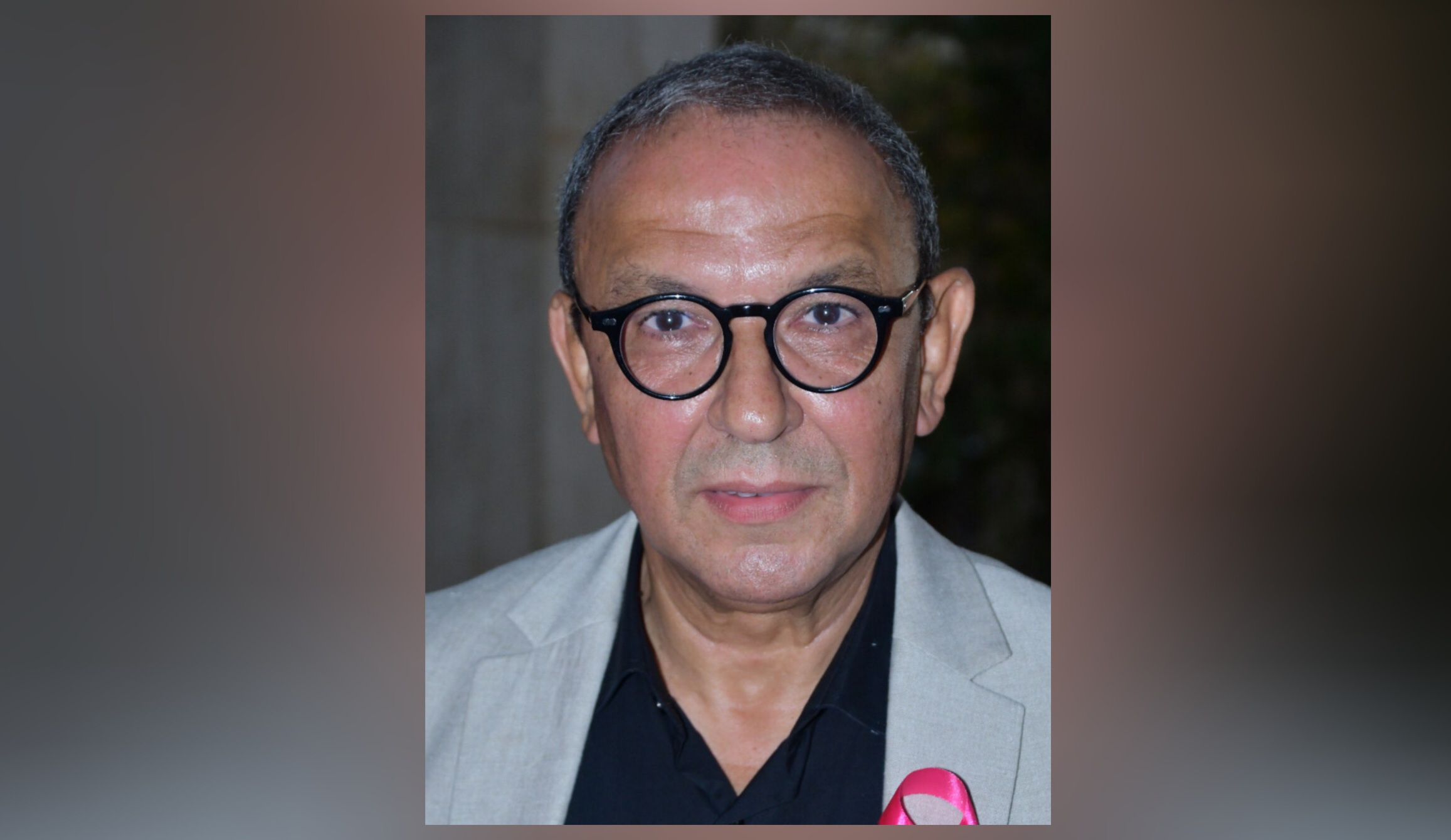الاحتجاج تمرين ديمقراطي مشروع، ووسيلة حضارية للتعبير عن المطالب، يكفلها الدستور وتؤطرها المواثيق والعهود الدولية. إنه ليس تهديدا للاستقرار، بل آلية لتقوية مؤسسات الدولة وتعزيز شرعيتها حين يقابل بالإنصات الجاد والحوار المسؤول. غير أن بعض المسؤولين لا يزالون يتعاملون مع الاحتجاج بمنطق "الصمت والاستخفاف"، بدل ثقافة الإصغاء والتفاعل، مما يزيد من حدة التوتر ويضعف الثقة في المؤسسات.
في المجتمعات الحديثة، لم يعد الاحتجاج مجرد رد فعل عفوي، بل تعبير ناضج عن وعي متزايد بالحقوق. وما يرافقه من تنظيم وتعبئة سلمية، يعكس ترسّخ ثقافة المشاركة والمساءلة. الاحتجاج السلمي لا يجب أن ينظر إليه كإزعاج، بل كمؤشر على حيوية المجتمع، وعلى وجود مطالب مشروعة تنتظر إجابات واضحة.
ضمن هذا الإطار، تلعب المؤسسات الوسيطة، من نقابات وهيئات المجتمع المدني وهيئات منتخبة، دورا حاسما في تأطير الحركات الاحتجاجية، وامتصاص الغضب الاجتماعي، ونقله من الشارع إلى طاولة الحوار. ضعف هذه الأدوار أو تهميشها يفضي إلى فقدان التوازن داخل المجتمع، ويترك فراغا يغذي التوترات والانفعالات.
نجاح المؤسسات اليوم لا يقاس فقط بقدرتها على إصدار القرارات، بل بمدى جاهزيتها للاستماع للمواطنين والتجاوب مع تطلعاتهم. فكلما تم احتواء مطالب المواطنين في بدايتها، كلما أتيحت فرصة أوسع للحل وتفادي التصعيد.
في المقابل، حين يقابل الاحتجاج بالصمت أو التوجس، بدل التفاعل والتفاوض، يصبح ذلك تغذية غير مباشرة للاحتقان. وتتحول قضايا بسيطة قابلة للحل إلى ملفات معقدة، تتطلب تدخلات أمنية، في حين كان يمكن تسويتها بأدوات التدبير الإداري والحكامة الجيدة.
إن الاحتجاج لا يعبر فقط عن خلل في توزيع المشاريع أو الخدمات، بل يفضح أحيانا غياب العدالة المجالية، ويكشف عمق التفاوتات الاجتماعية والمجالية في التنمية. كما يعكس، في حالات الشغيلة والموظفين، غياب العدالة في الحقوق، واستمرار التمييز غير المبرر في مسارات الترقية والاعتراف بالكفاءة، مما يولد شعورا بالإحباط وفقدان الأمل في الإنصاف المؤسساتي.
لذلك، فإن تعزيز آليات الإنصات والحوار، وتفعيل دور المؤسسات الوسيطة، والعمل الجاد على ترسيخ العدالة المجالية والأجرية، وضمان تكافؤ الفرص في الترقية والمسار المهني، ليست فقط مطالب فئوية، بل شروط أساسية لاستقرار اجتماعي حقيقي، وديمقراطية فعالة تعترف بالمواطن كفاعل لا كمتلقّ صامت.