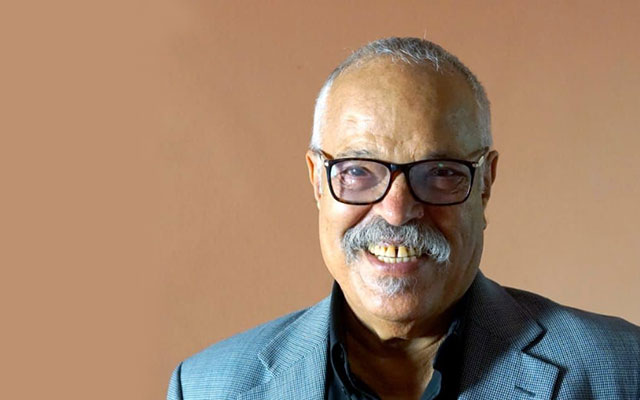المنشطات في مجتمعاتنا المعاصرة
"لم يعد الإنسان الحديث بحاجة إلى كهنة ليخدروه، لقد أصبح هو نفسه تاجره الشخصي، ومشجعه الذاتي، ومدمن منشطاته الخاصة. صالة الرياضة، معرض الفنون، حتى صندوق الاقتراع – جميعها تحولت إلى صيدليات لتوزيع منشطات وجودية" (بيتر سلوتردايك).
"عندما يتحول الإبداع إلى سباق محموم، يصبح الفنان أو المفكر مثل العداء الذي يتعاطى المنشطات، يخدع نفسه قبل أن يخدع الجمهور." (ميشال أونفري).
ظاهرة تناول المنشطات لتجاوز الإمكانات الخاصة والتفوق على الذات في استفحال متزايد. غير أن الإجراءات التي تتخذ عادة في حق متعاطينها، باستبعادهم وإقصائهم المبكر، لا تدل على إدراك حقيقي لدلالة الظاهرة، إذ يُكتفى بالنظر إليها على أنها زيغ وغش لا يورطان إلا مقترفه. إلا أن هذا التفسير الأخلاقي ربما يحول بيننا وبين إدراك مغزاها الشمولي العميق في مجتمعات الفرجة التي نحياها.
ظاهرة شاملة
ذلك أن هذه الظاهرة لا تقتصر فحسب على بعض المتبارين، ولا على المجال الرياضي وحده. فإذا عرفناها بأنها الاستنجاد بعوامل خارجية كي يتجاوز المرء إمكاناته الذاتية ويتفوق عليها بأقل مجهود، فإننا نلمسها اليوم في جميع المجالات ابتداء من الغش في الامتحانات المدرسية، حتى التزوير في الانتخابات السياسية، مرورا بتجميل الأجساد والسلع، والسرقات الأدبية، والانتهازية الثقافية. "الدوبينغ" Doping الذي يعني حرفيا تناول المنشطات غير القانونية، "عقلية" أكثر منها مجرد ممارسة في مجال بعينه. إنه يعكس هوس المجتمع بالأداء الفائق والتفوق بأي ثمن، والرغبة التي لا تحد في "أن ننتصر": ننتصر على الآخرين وعلى أنفسنا وعلى الأرقام.
لا تقتصر الظاهرة إذن على الرياضة وحدها، وإنما تطاول التربية والثقافة والفن والاقتصاد والسياسة، لكنها قد تأخذ أشكالا أكثر خفاء ورمزية، وتغلف أحيانا بشرعية اجتماعية، أو تتقنع وراء ضرورة مهنية. ففي السياسة قد تتخذ شكل خطابات كاريزمية مدعومة بفرق كتاب محترفين أو بعض الفنانين. وفي هذا الصدد لاحظنا غير مرة استنجاد بعض الرؤساء الفرنسيين في حملاتهم الانتخابية بالمغنين المشهورين.
تطاول الظاهرة حتى الميدان الثقافي حيث قد يستعين الكاتب بمن ندعوهم "كتاب الظل"، وحيث يعمل الكاتب نفسه على دفع النقاد إلى الكتابة عنه والتعريف بمنتوجه. وهكذا فإن الجوائز في هذا المجال، وكذا، التغطية الإعلامية، وحتى العلاقات داخل دوائر النخبة، كلها تؤدي دور "المنشطات" التي ترفع شأن مبدع دون آخر، ليس بناء على الجودة دائما، بل وفق معايير خارجية. أما في المجال الفني، فيتخذ "الدوبينغ" شكل تعديل رقمي للصور (فلاتر، فوتوشوب) كـ"منشط بصري"، أو إدخال عمليات التجميل المفرطة استجابة لمعايير جمالية بعيدة كل البعد عن الواقع. إضافة إلى ذلك، ما تعمل عليه وسائل الاتصال من خلق الأوهام بأن "الجميع يتفوقون عليك"، مما يولد رعب التخلف عن الركب الذي يزرع في نفسية الطفل روحا تنافسية مبالغا فيها، فيقتنع، منذ طفولته، أنه عندما يحتل المركز الثاني فإنه يكون "أول الخاسرين".
في السياسة والثقافة
خلاصة القول إن تناول المنشطات لا يقتصر على مجال الرياضة وحده، فهو يطاول السياسة متمثلا في النفوذ والإعلام والتلاعب بالسرديات، وهي أدوات تمنح السياسي تفوقا غير عادل دون أن تكون مجرّمة، كما يطاول الثقافة والفنون حيث يتجسد في الجوائز، والتغطية الإعلامية، والدعم المؤسساتي، مما يجعل بعض الأسماء تتصدر المشهد حتى لو لم يكن إبداعها هو الأرقى، بل إنه يسري في الحياة اليومية حيث تسود المبالغة في بناء صورة ذاتية قوية عبر وسائل التواصل.
إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يغض الطرف عن هذه الأشكال من "الدوبينغ" مقارنة بما يطاول التنشيط الرياضي؟ لعل الفارق الأساس بين هذه المجالات من جهة، ومجال الرياضة من جهة أخرى، هو أن الرياضي يعاقب لأنه يستخدم مواد "ملموسة"، قابلة للتجريب المخبري، وبالتالي للقياس وتحديد التفاوت بين القيمة-المعيار وبين نتيجة الفحوص، بينما المثقف أو السياسي يمكنه التلاعب بالظروف والمفاهيم ليحقق تفوقا غير عادل، من غير أن يحاسب. السياسة أو الفنون معاييرها ذاتية. واكتشاف المنشطات المادية (حقن، حبوب) أسهل من المنشطات الرمزية (كذب، تزييف). التنشيط هنا يكون عبر وسائل السلطة والنفوذ والإعلام والتلاعب بالرأي العام، وهي أدوات لا يمكن تصنيفها كـ"منشطات"، لكنها تؤثر بشكل مباشر على النجاح السياسي، هذا فضلا عن أن المجتمع يتقبل "الوهم" في الفن والسياسة كجزء من اللعبة.
لعل هذا ما جعل عالم اليوم في مسابقات أولمبية دائمة، الجميع في تبار مستمر ومنافسات لا نهاية لها. الكل يريد "أن ينتصر". التلميذ يعدو نحو النجاح و"الحصول على نقاط متفوقة"، والطالب يركض وراء الدبلومات، والفنان يتسابق نحو النجومية، والأديب يلهث وراء الجوائز، والمثقف يهرول نحو الاعتراف، والسياسي يجري وراء المناصب، في مجتمع غدت فيه كل الميادين مجال تسابق وركض نحو المصلحة.
عصر أداء الذات
أصبحنا نعيش في عصر "أداء الذات"، كما يقول الفيلسوف بيتر سلوتردايك، حيث يطلب منا جميعا أن نكون أسرع، وأبهى جمالا وأنجع إبهارا... حتى لو كان الثمن هو "تزوير ذواتنا". كأن الإنسان لم يعد يعيش حياته، بل يديرها كـ"مشروع مستمر"، دائم التعديل والتطوير، لكنه لا يصل أبدا إلى الاكتمال. لقد دخلنا في مرحلة "تفكيك الذات"، حيث لم يعد الإنسان يعرف حدوده الطبيعية ويعترف بها. الإنسان المعاصر يبدو وكأنه في سباق لا نهائي مع نفسه، وليس فقط مع الآخرين. إنه يسعى دائما إلى تحطيم أرقامه القياسية الشخصية، سواء في العمل، أو في الأداء البدني، أو في الإبداع.
لكن المشكلة أن هذا السباق ليس له خط نهاية، إنه جري من غير خط وصول، مما يضع الفرد تحت ضغط مستمر ويدفعه إلى البحث عن طرق خارجة عن الطبيعي للحفاظ على تفوقه. كأننا في مجتمع ماراثوني، حيث لا يسمح بالتوقف أو حتى بالتباطؤ، وإلا فالمتسابق يستبعد أو ينسى فـ"يخرج من السباق".
أمر طبيعي ومحمود أن يسعى المرء نحو تجاوز إمكاناته الذاتية والتفوق على نفسه، وإلا لما كان هناك تحطيم للأرقام القياسية، بل ولا حتى مجرد التقدم. إلا أن مجتمع الفرجة لا ينفك يغرس فينا أن إمكان التفوق على الذات قضية متيسرة سهلة المنال، وأنها لا تقتضي جهدا ذاتيا ومثابرة شخصية، بل ربما لا تتطلب نجاحا فعليا ما دامت الأمور جميعها بإمكانها، وبكل سهولة، أن تبدو غير ما هي عليه. الأمور جميعها قابلة للتلوين والتزيين حتى لا نقول التزييف. في هذه الحال يبدو أي بذل لمجهود حقيقي أمرا لا داعي له، بل هو ربما علامة على غفلة وتبلد.
ما يفتأ "مجتمع الفرجة" يعرض علينا نماذج النجاحات السريعة، والأرباح السهلة، والانتصارات من غير كبير جهد. وهو يصعقنا بين حين وآخر بالمبالغ المدوخة التي حصل عليها هذا الرياضي أو ذاك الفنان أو الكاتب، هذا فضلا عن حرصه الدائم على أن يظهر لنا النجوم في المجالات جميعها وكأننا لا نختلف عنهم في شيء، ليردم الهوة بيننا وبينهم، ويقنعنا أن كل المسافات قريبة، وأنه يكفينا المشاركة في السباق، ما دام يوفر لنا أسباب الانتصار، والتفوق السهل الدائم على الآخرين وعلى الذات.
ضد هذه السهولة المتيسرة، لا يبقى للإنسان إلا أن يحاول الانتصار على نفسه، ليس للحد من طموحها، وإنما لتجنب كل أشكال "الدوبينغ". فلعل أهم سباق هو ذاك الذي تجريه مع نفسك وليس مع آخرين، شريطة أن تكون مقتنعا أن التفوق الحقيقي ليس في الوصول في المرتبة الأولى، بل في عدم فقدان إنسانيتك أثناء الرحلة.
عن "مجلة المجلة".