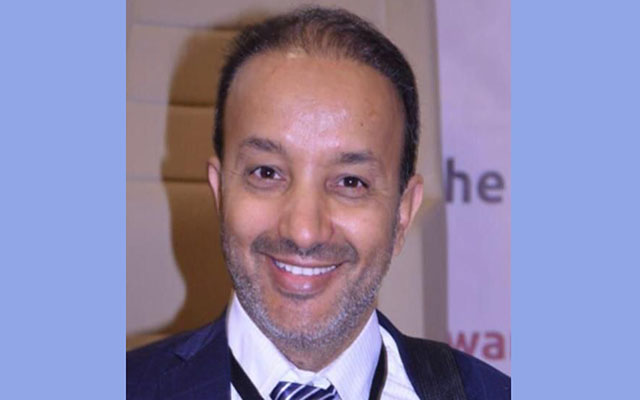لم تبق للانتخابات التشريعية سوى بضعة أشهر (2026)، ورغم قرب الموعد لا يظهر في الأفق أن المغرب معني بهذه المحطة لتوفير البنية السياسية الحاضنة لتدبير الشأن العام: فأحزاب المعارضة باهتة إن لم نقل أنها باردة بشكل يفوق برد سيبيريا، وأحزاب الأغلبية مفككة ومترهلة،وكل حزب "يقلز" للآخر من "تحت الجلابة"، والنقابات دب الوهن إلى مفاصلها وفقدت توهجها.
نعم، الانتخابات ليست هي البلسم الشافي لأعطاب المجتمعات، لكنها تبقى أحسن ما اخترعه العقل الكوني لحد الآن لتدبير التدافع السياسي داخل المجتمع لاختيار نخبة تتولى تدبير أمور الناس.
المؤسف أن نخبنا السياسية منشغلة بتأمين ريعها وتقاعدها بالبرلمان والحكومة، ومنشغلة بتسمين امتيازاتها، أكثر من الانشغال بالموعد المحتوم المرتقب عام 2026. إذ أيا كان لون الحزب السياسي الذي سيفوز في الانتخابات التشريعية القادمة، فإن المصير المجهول هو الذي ينتظر المغرب ما لم يتم الانتباه للحاجة إلى تمنيع الممارسة الحزبية، وتمكين المجتمع من كوابح تفرمل انزياح الشارع نحو قوى غير منظمة أو نحو قوى عدمية لا تؤمن أصلا بجدوى التدافع السياسي المدني.
من حق كل مواطن المطالبة بالافتحاص القبلي للملايير التي تقتطع من ضرائب الشعب لتمنح للأحزاب لتمارس دورها في التأطير وتمثيل الناخبين في المؤسسات الدستورية. فالمرء ليس ملزما بأن يكون عضوا في حزب حتى يكتسب الشرعية لمساءلة الحزب، بل كل مغربي له الحق في تتبع حياة الأحزاب ورصد إشراقاتها وإخفاقاتها، مادامت الأحزاب هي القناة الرئيسية التي يمر منها اختيار «صناع القرار» الحكومي والبرلماني وبالجماعات الترابية. لأن هذه الحكومة والبرلمان والجماعات تسن قوانين وتشريعات وتتخذ قرارات تمس الحياة اليومية والمعيشية للمواطن. وبالتالي من حق المواطن تتبع ومعرفة «العجينة» الحزبية التي ستلد رئيس الحكومة والوزراء والبرلمانيين في الاستحقاق المقبل.
فحين ندق ناقوس الخطر من تآكل أحزاب الأغلبية والمعارضة، فإننا ندق الناقوس خوفا من أن تأتينا حملة 2026، بنخب أفلس مما هو عليه الحال اليوم بالمؤسسات التمثيلية.
فكما يقول المثل الشعبي: «للي بغا الكراب في الصيف يتصاحب معاه في الليالي». وبالتالي فإن أردنا ربح رهان أحزاب قوية (أيا كانت مرجعياتها السياسية) في عام 2026 لإحداث قطيعة مع "الشناقة" ومع "سنوات الرصاص الحزبي"، فعلينا خلق رجة قوية اليوم وليس غدا.