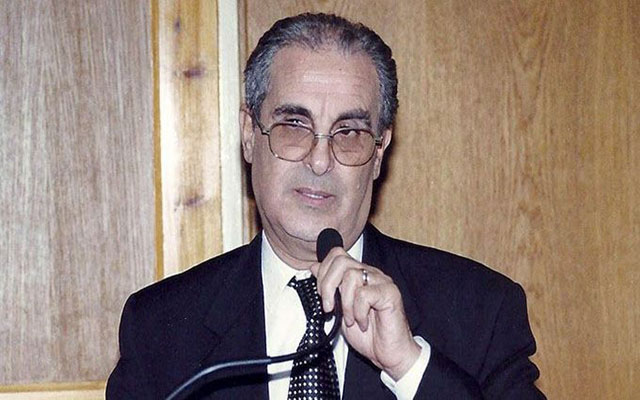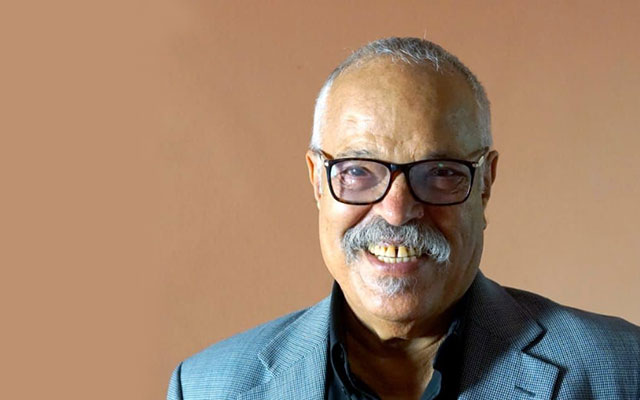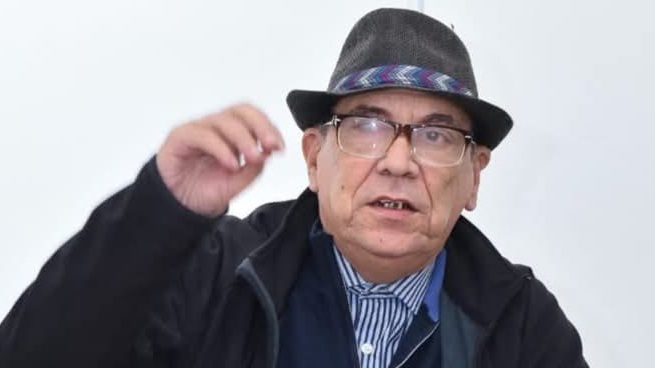أولا وقبل كل شيءٍ، أريد أن أعتذرَ للقارئ على إطالة هذه المقالة. وفي الحقيقة، إنني تعمَّدتُ هذه الإطالة كي أبيِّن للقارئ أنني اتَّبعتُ منهجيةَ تحليل تصاعدي أو تدريجي ليدركَ هذا القارئ، بتسلسلٍ منطقي، ما أريد أن أوصِلَه له. وفي هذا السياق، اعتبرتُ القرآن مجموعةَ آياتٍ متداخلة، أي أن هذه الآيات يفسِّر بعضُها البعضَ الآخرَ. وهذا يعني أن القرآن الكريم خطابٌ موجَّهٌ للبشرية جمعاء، أي أنه كل متكامل لا يجب الأخذ ببعضه وترك البعض الآخر. وكل ما ورد في هذه المقالة يدور حول ما أراد اللهُ، سبحانه وتعالى، أن يُبلِّغَه لنا، نحن البشر، من خلال الآية الكريمة رقم 38 من سورة المائدة : "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ".
اللهَ، سبحانه وتعالى، الذي، لما نتدبَّر ونحلِّل كثيرا من آيات القرآن الكريم، نستنتِج أنه، عزَّ وجلَّ، يريد الخيرَ لعباده. وهذا الخير نستشفُّه من خلال آياتٍ كثيرةٍ من القرآن الكريم. من بين هذه الآيات، أذكر على سبيل المثال :
1."وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا" (الإسراء، 70).
فبماذا كرَّم الله، سبحانه وتعالى، بني آدم؟ كرَّمهم بنِعمتَي العقل والنطق، أي جعل منهم ناساً واعين بوجودهم، في الأرض لإعمارِها pour son peuplement وبوجود الأشياء المحيطة بهم. و واعون، كذلك، بأقوالهم وأفعالهم وتصرُّفاتهم، ولهم القدرة على التَّعبير عن أفكارِهم بالقول والفعل.
1."وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا" (الإسراء، 70).
فبماذا كرَّم الله، سبحانه وتعالى، بني آدم؟ كرَّمهم بنِعمتَي العقل والنطق، أي جعل منهم ناساً واعين بوجودهم، في الأرض لإعمارِها pour son peuplement وبوجود الأشياء المحيطة بهم. و واعون، كذلك، بأقوالهم وأفعالهم وتصرُّفاتهم، ولهم القدرة على التَّعبير عن أفكارِهم بالقول والفعل.
وعندما نتحدث عن الأرض، فالمقصود هو الأرض بأكملها، برّاً، بحراً وجوّاً. والأرض لا يمكن فصلُها عن الغلاف الجوي الذي يحيط بها. والأرض هي المكان الذي أنشأَ فيه، سبحانه وتعالى، الحياةَ بالمعنى البيولوجي. لماذا؟ لأن الحياة، بالمعنى البيولوجي، الحيوانية والنباتية، غير ممكنة خارجَ هذه العناصر الثلاثة، أي البر والبحر والجو.
وماذا تعني "وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ"؟ تعني أن اللهَ، سبحانه وتعالى، مكَّن بني آدم من التَّنقُّل في جميع مناطق الأرض، برّاً، بحْراً وجوّاً. في الماضي، كان التَّنقُّل يعتمد، فقط، على ركوب الدواب برّاً، وركوب السُّفن بحراً. أما في العصر الحاضر، وبالضبط، في القرنين التاسع عشر والعشرين، لما تطوَّر العقلُ البشري، تعدَّدت وتنوَّعت وسائل التنقل براً، بحراً وجواً. وتعدُّدُ وتنوُّعُ وسائل التنقُل هما جزءٌ مما حقَّقه العقلُ البشري لإعمار الأرض.
وماذا تعني "وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ"؟ تعني أن اللهَ، سبحانه وتعالى، وضع رهنَ إشارة بني آدمَ كلَّ ما لهم فيه خيرٌ. فلماذا لم يقل، عزَّ وجلَّ، "رزقناهم من الخبيثات"، علما أن الخبيثات موجودة في الأرض؟ لم يقلها لأنه، سبحانه وتعالى، أولا، يريد الخير لعبادِه. ثانيا، العقل البشري له القدرة على التَّمييز بين الطيب والخبيث. وكل ما هو طيب أحلَّه الله لعباده. وكل ما هو طيب، يمكن أن يكون مادياً أو معنوياً. والأشياء المادية والمعنوية ضروريةٌ لإعمار الأرض.
وماذا تعني "وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"؟ تعني أن اللهَ، سبحانه وتعالى، أولا، فضَّل بني آدم على جميع مخلوقأته الحية، بالعقل والنُّطق، بينما المخلوقات الحية الحيوانية الأخرى تحيا، بيولوجياً، بالغريزة وتعيش، في الطبيعة، بالغريزة. بل فضلهم على الملائكة. ثم لماذا بدأ، سبحانه وتعالى، هذا الجزء من الآية رقم 70 من سورة الإسراء ب"وَفَضَّلْنَاهُمْ" وختمه ب"تَفْضِيلًا"؟
لأن التفضيلَ، في هذه الحالة، ليس كأي تفضيل. بل إنه تفضيلٌ من نوع خاص يتمثَّل في اختيار بني آدم ليسكنوا الأرضَ ويُعمِّرونها بما تنتِجه عقولُهم من معرفة. وإعمار الأرض يتمثَّل ليس فقط في البنيان والزراعة. بل يتمثَّل، كذلك، في صُنع واكتشاف واختراع كل ما من شأنه أن يساعدَ الناس على العيش الكريم، وكل ما يساعِدهم على التَّساكن والتَّعايش داخلَ المجتمعات. وكل ما هو ضروري لإعمار الأرض، يجب أن يتلاءمَ أو أن يتوافقَ مع "وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ".
السؤال الذي يفرض نفسَه علينا هنا، هو : "فهل يُعقل أن يأمرَ اللهُ، سبحانه وتعالى، بقطع يد السارق والسارقة لناسٍ كرَّمهم وفضَّلهم على جميع المخلوقات الحيَّة، وحتى على الملائكة، كما سنرى فيما بعد، في الآيةالموالية"؟
2."فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ" (الحجر، 29).
في هذه الآية الكريمة، يُخبرنا، سبحانه وتعالى، بالأفعال الإلهية التي قام بها، عزَّ وجلَّ، لتكريم بني آدم، وهي التَّسوية (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ) والنَّفخ (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي) والتَّفضيل (فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ).
السؤال الذي يفرض نفسَه علينا هنا، هو : "فهل يُعقل أن يأمرَ اللهُ، سبحانه وتعالى، بقطع يد السارق والسارقة لناسٍ كرَّمهم وفضَّلهم على جميع المخلوقات الحيَّة، وحتى على الملائكة، كما سنرى فيما بعد، في الآيةالموالية"؟
2."فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ" (الحجر، 29).
في هذه الآية الكريمة، يُخبرنا، سبحانه وتعالى، بالأفعال الإلهية التي قام بها، عزَّ وجلَّ، لتكريم بني آدم، وهي التَّسوية (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ) والنَّفخ (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي) والتَّفضيل (فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ).
"فَإِذَا سَوَّيْتُهُ" تعني وهبتُ له، أي لآدم ولذرِّيتِه، أحسن صورة بالمقارنة مع الكائنات الحية الأخرى، وخصوصا، الحيوانات. بالفعل، صورة الإنسان لا مثيلَ لها في عالم الأحياء، عقلاً وجسماً. وهو الوحيد الذي له عقلٌ esprit و وعيٌ conscience، وذكاء intelligence وإرادة volonté وذاكرة mémoire… وهو الوحيد الذي يمشي دائما على رجلين.
"وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي" تعني أن جزأً من الروح الإلهية انتقل من الذات الإلهية (مجازاً)، سبحانه وتعالى، إلى الذات الأدمية. وعندما يتم انتقالُ هذا الجزء من الروح الإلهية إلى الذات الأدمية، فهذا معناه، كذلك، أن جزأً من بعض الصفات الإلهية، وأقول جزأً من بعض الصفات وليس الصفات كلها وبأكملها، هي الأخرى تنتقل إلى الذات البشرية. مثلاً، "الخالِق" هو اسمٌ من أسماء الله الحُسنى أو صفةٌ من الصفات الإلهية. فانتقال هذه الصفة من الصفات الإلهية إلى الإنسان تجعله قادراً على الخلق والصُّنع والابتكار والاختراع والاستحداث… لكن الله قادرٌ على خلق الأشياء من عدم، مصداقا لقولِه، سبحانه وتعالى : "بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ" (البقرة، 117). بينما الإنسان يخلق الأشياء، دائما انطلاقاً من الموجودات المتوفِّرة لديه، والتي له بها سابق معرفة.
"فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ" تعني أن اللهَ، سبحانه وتعالى، بعدما سوَّى آدمَ ونفخ فيه من روحه، أمر الملائكة بالسجود له سجود تشريف وتكريمٍ وليس سجود عبادة. وهذا دليلٌ على أن اللهَ، سبحانه وتعالى، فضَّل بني آدم، ليس فقط على الكائنات الحية الأخرى، ولكن، كذلك، على الملائكة.
السؤال الذي يفرض نفسَه علينا هنا، هو : "فهل يُعقل أن الله، سبحانه وتعالى، الذي خلق الإنسان وسوَّاه في أحسن صورة ونفخ فيه جزأً من روحه وأمر الملائكةَ أن يسجدوا له، تشريفأً له، أن يتناقضَ، عزَّ وجلَّ، مع نفسِه فيأمر بتشويه صورة الإنسان بقطع أيدي السارق والسارقة"؟
وهو الذي يقول في الآية رقم 7 من سورة السجدة : "الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ". وفعل "أحسن" يعني لغويا، في هذه الآية، أتقن الصُّنعَ، أي برع في جودته، وبعبارة أخرى، أَجادَ صُنعَه.
والآيات التي تبيِّن بأنه، عزَّ وجلَّ، يريد الخير لعباده كثيرة، أذكر من بينها ما يلي :
-"إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا" ،(الشرح، 6)، أي مهما تعقَّدت الأمور وصعُبَت، فالفرج (اليُسر) يأتي من الله. وهو ما يُعبَّرُ عنه شعبباً ب"ملِّي اللهْ كَيْسدْ باب، كيفتح بيبان".
-"إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا" (النساء، 48)، أي أن اللهَ، سبحانه وتعالى، يغفر الذنوب جميعا إلا الشِّرك.
-"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" (الأتبياء، 107)، أي أن الله، سبحانه وتعالى، لما اختار محمداً (ص)، كآخر الرسل والأنبياء، أراده أن يكون ناقلاً لرحمته لجميع الناس.
-"وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ" (البقرة، 207)، أي أن الله، سبحانه وتعالى، يشمل جميع عباده برحمته الواسعة.
-"قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" (الزمر، 53).
-"وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (الأنعام، 54).
كل هذه الآيات الستة، السابقة الذكر، تبيِّن بأن اللهَ يريد الخير لعباده، من خلال تيسير الأمور الدنيوية والمغفرة والرحمة والرأفة…
والآيات التي تبيِّن بأنه، عزَّ وجلَّ، يريد الخير لعباده كثيرة، أذكر من بينها ما يلي :
-"إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا" ،(الشرح، 6)، أي مهما تعقَّدت الأمور وصعُبَت، فالفرج (اليُسر) يأتي من الله. وهو ما يُعبَّرُ عنه شعبباً ب"ملِّي اللهْ كَيْسدْ باب، كيفتح بيبان".
-"إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا" (النساء، 48)، أي أن اللهَ، سبحانه وتعالى، يغفر الذنوب جميعا إلا الشِّرك.
-"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" (الأتبياء، 107)، أي أن الله، سبحانه وتعالى، لما اختار محمداً (ص)، كآخر الرسل والأنبياء، أراده أن يكون ناقلاً لرحمته لجميع الناس.
-"وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ" (البقرة، 207)، أي أن الله، سبحانه وتعالى، يشمل جميع عباده برحمته الواسعة.
-"قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" (الزمر، 53).
-"وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (الأنعام، 54).
كل هذه الآيات الستة، السابقة الذكر، تبيِّن بأن اللهَ يريد الخير لعباده، من خلال تيسير الأمور الدنيوية والمغفرة والرحمة والرأفة…
وعلاقةً بعنوان هذه المقالة، يقول، سبحانه وتعالى، في الآية رقم 38 من سورة المائدة : "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ".
السؤال الذي لا بدَّ من طرحه على أنفسنا، والذي له علاقة بالتَّوضيحات التي أسلفتُها وله، كذلك، علاقة بالإية السابقة الذكر (رقم 38 من سورة المائدة)، هو : هل يُعقل أن يأمرَ اللهُ، سبحانه وتعالى، بقطع أيدي السارق والسارقة، وهو يريد الخيرَ لعباده؟
فهل هذا يعني أن اللهََ ظالمٌ للعباد، وحاشا أن يكونَ ظالِما لهم، أي يريد الخير للعباد، وفي نفس الوقت، يظلمهم بتشويه صورتهم التي أرادها لهم؟ وهو الذي يقول، في قرآنه الكريم، وبالضبط، في الآية رقم 108 من سورة آل عمران : "تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ". "لِّلْعَالَمِينَ"، أي لجميع الناس.
فهل هذا يعني أنه، عزَّ وجلَّ، يريد إلحاقَ الضررَ بالعباد بينما تدبُّر آيات قرآنه الكريم يوحي بأنه، عزَّ وجلَّ، يريد الخيرَ لعباده؟
فهل هذا يعني أنه، عزَّ وجلَّ، يريد إلحاقَ الضررَ بالعباد بينما تدبُّر آيات قرآنه الكريم يوحي بأنه، عزَّ وجلَّ، يريد الخيرَ لعباده؟
فهل هذا يعني أن كلامَ الله فيه تناقض؟ وحاشا أن يكونَ فيه تناقض، أي تخالُفٌ وتعارضٌ، وهو الذي يقول في الآية رقم 82 من سورة النساء : "أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا".
إذن، أين يوجد الخلل؟ الخلل يوجد في عدم إدراك ما أراد اللهُ، سبحانه وتعالى، أن يُوصِلَه لنا من خلال الآية رقم 38 من سورة المائدة. وعدم الإدراك هذا راجع إلى عدة أسباب، أذكر من بينها ما يلي :
1.علماء وفقهاء الدين، القدامى، الذين فسَّروا هذه الآية، وتبعهم، بغير تبصُّر، الذين جاءوا من بعدهم والمُعاصرون، لم يفرِّقوا بين الإنسان الذي كرَّمه الله، عزَّ وجلَّ، ونفخ فيه جزأً من روحه، وبين الإنسان السارق أو السارقة. والسارق والسارقة، هما معاً إنسان وشملهم التَّكريم والنفخ.
2.لما فسَّرَ علماء وفقهاء الدين، القدامى، هذه الآية، لم يستحضروا باقي آيات القرآن الكريم، التي، كثيرٌ منها، يُبيِّن بوضوح أن اللهَ، سبحانه وتعالى، يريد الخيرَ لعباده. والسارق والسارقة مصنفان من ضمن العباد. لو قارن علماء وفقهاء الدين هذه الآية مع باقي الآيات التي تبيِّن بأن اللهَ، سبحانه وتعالى، يريد الخير لعباده، لكان لهم رأيٌ آخر. بل إنهم فسَّروا هذه الآية بما كانت تفرضه عليهم خلفياتُهم الفكرية، الاجتماعية والثقافية التي، بموجبها، كان الناس يقطعون يد السارق والسارقة قبل مجيء الإسلام.
3.لما فسَّرَ علماء وفقهاء الدين، القدامى، هذه الآية، لم يتخلَّصوا من خلفياتهم الفكرية التي تعتبر السرقةَ رذيلة اجتماعية، وهذا صحيح، لكنهم لم يستحضروا ما قاله، سبحانه وتعالى، في آياتٍ كثيرةٍ، بأنه غفور رحيم، أي يغفر جميع الذنوب والمعاصي إلا الشرك.
4.كل كلمة في القرآن الكريم لها مدلول خاص بها طبقا لِما قاله، سبحانه وتعالى، في الآية رقم 1 من سورة هود : "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الر ۚكِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ" (هود، 1). والآيات عبارة عن مجموعة أسماء وأفعال وحروف. كل اسم وكل فعل وكل حرف موضوع في المكان الذي يناسبه ليتمكَّن القارئ من استنتاج ما أراد الله، سبحانه وتعالى، إيصالَه لنا نحن البشر.
إذن، أين يوجد الخلل؟ الخلل يوجد في عدم إدراك ما أراد اللهُ، سبحانه وتعالى، أن يُوصِلَه لنا من خلال الآية رقم 38 من سورة المائدة. وعدم الإدراك هذا راجع إلى عدة أسباب، أذكر من بينها ما يلي :
1.علماء وفقهاء الدين، القدامى، الذين فسَّروا هذه الآية، وتبعهم، بغير تبصُّر، الذين جاءوا من بعدهم والمُعاصرون، لم يفرِّقوا بين الإنسان الذي كرَّمه الله، عزَّ وجلَّ، ونفخ فيه جزأً من روحه، وبين الإنسان السارق أو السارقة. والسارق والسارقة، هما معاً إنسان وشملهم التَّكريم والنفخ.
2.لما فسَّرَ علماء وفقهاء الدين، القدامى، هذه الآية، لم يستحضروا باقي آيات القرآن الكريم، التي، كثيرٌ منها، يُبيِّن بوضوح أن اللهَ، سبحانه وتعالى، يريد الخيرَ لعباده. والسارق والسارقة مصنفان من ضمن العباد. لو قارن علماء وفقهاء الدين هذه الآية مع باقي الآيات التي تبيِّن بأن اللهَ، سبحانه وتعالى، يريد الخير لعباده، لكان لهم رأيٌ آخر. بل إنهم فسَّروا هذه الآية بما كانت تفرضه عليهم خلفياتُهم الفكرية، الاجتماعية والثقافية التي، بموجبها، كان الناس يقطعون يد السارق والسارقة قبل مجيء الإسلام.
3.لما فسَّرَ علماء وفقهاء الدين، القدامى، هذه الآية، لم يتخلَّصوا من خلفياتهم الفكرية التي تعتبر السرقةَ رذيلة اجتماعية، وهذا صحيح، لكنهم لم يستحضروا ما قاله، سبحانه وتعالى، في آياتٍ كثيرةٍ، بأنه غفور رحيم، أي يغفر جميع الذنوب والمعاصي إلا الشرك.
4.كل كلمة في القرآن الكريم لها مدلول خاص بها طبقا لِما قاله، سبحانه وتعالى، في الآية رقم 1 من سورة هود : "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الر ۚكِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ" (هود، 1). والآيات عبارة عن مجموعة أسماء وأفعال وحروف. كل اسم وكل فعل وكل حرف موضوع في المكان الذي يناسبه ليتمكَّن القارئ من استنتاج ما أراد الله، سبحانه وتعالى، إيصالَه لنا نحن البشر.
ولهذا، ففعل "فَاقْطَعُوا" فَهِمَه علماء وفقهاء الدين، القدامى، بمعنى البَتر، أي ما كان سائدا في المجتمعات العربية قبل مجيء الإسلام. والبَتْرُ هو فصل عضوٍ من الأعضاء عن الجسم. بينما، عندما نبحث معنى فعل "قطع" في قاموس "المعاني"، نجد أن هذا الفعل له معاني كثيرة، من بينها فصلُ عضو من الأعضاء عن الجسم. لكن، من بين المعاني الأخرى، نجد أن أحد المعاني مقترن ب"المنع". ففي نفس المُعجم، نجد أمثلةً تدل على هذا "المنع"، من بينها، أذكرُ ما يلي : "قطَع الطَّريق : منع المرورَ فيه-قطَع الطَّريقَ عليه : منعه من تنفيذ ما يريد تنفيذه-قطَع رزقَه/قطَع عيشَه : منع عنه أسباب العيش، طرده من الوظيفة-قطَع عليه حبلَ تفكيره : منعه من متابعة تفكيره، حال دون تسلسل أفكاره، شوّش عليه-قطَع عليه خطّ الرَّجعة: سدّ عليه المسالك، منعه من فرصة التَّراجع-قطَع رَحِمَه : هجرها، عقّها، منع كُلَّ اتّصال بها…"
إذن فعل قطع يمكن أن يدلَّ على البتر كما يمكن أن يدل على المنع، أي وضع حدٍّ لشيءٍ كي لا يحدث مرةً أخرى. فأي المعنيين سنختار؟ هل الأول أم الثانيّ؟ متدبِّر القرآن الكريم الذي يستشفُّ من تدبُّره أن اللهَ، سبحانه وتعالى، يريد الخيرَ لعباده، سيختار المعنى الثاني، أي وضع حدٍّ لشيء كي لا يتكرَّر مرةً أخرى.
والتَّحليل لا يقف عند هذا الحد! كيف ذلك؟ الله، سبحانه وتعالى، لم يستعمل، في الآية رقم 38 من سورة المائدة، كلمةَ "يد". بل استعمل كلمةَ "أَيْدِيَهُمَا" ولم يستعمل كلمةَ "يديهما". فما هو معنى كلمةِ "أيدي" في القرآن الكريم؟
أولا، اليد، في القرآن الكريم، تمتد من الكتف إلى أطراف أصابيع الكف. والدليل على ذلك، ما ورد في الآية رقم 6 من سورة المائدة : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ…". في هذه الآية، يقول، سبحانه وتعالى : "فَاغْسِلُوا… وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. والمرافق توجد في منتصف اليد.
والتَّحليل لا يقف عند هذا الحد! كيف ذلك؟ الله، سبحانه وتعالى، لم يستعمل، في الآية رقم 38 من سورة المائدة، كلمةَ "يد". بل استعمل كلمةَ "أَيْدِيَهُمَا" ولم يستعمل كلمةَ "يديهما". فما هو معنى كلمةِ "أيدي" في القرآن الكريم؟
أولا، اليد، في القرآن الكريم، تمتد من الكتف إلى أطراف أصابيع الكف. والدليل على ذلك، ما ورد في الآية رقم 6 من سورة المائدة : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ…". في هذه الآية، يقول، سبحانه وتعالى : "فَاغْسِلُوا… وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. والمرافق توجد في منتصف اليد.
علماء وفقهاء الدين، القدامى، خلطوا بين اليد والكف. لماذاّ؟ لأن القدامى أمروا بقطع الكف وليس اليد بأكملها. واليد، علميا، هي امتداد للدماغ الذي هو مركز التَّفكير. بمعنى أن الدماغ يفكر واليد تنفِّذ. واليدُ تقوم بالأفعالَ التي هي تجسيدٌ للأفكار على أرض الواقع. بمعنى أن اليدَ، عندما يتعلَّق الأمرُ بالأفعال، هي التي تنفذها، صوابا كانت أم خطأً. فماذا يقول القرآن الكريم في هذا الشأن؟
يقول، سبحانه وتعالى، في الآية رقم 41 من سورة الروم : "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ". "...بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ…" تعني "بما ترتَّب عن أفعال الناس من سوء تفكير وتدبير وأعمال سيِّئة".
كما يقول، سبحانه وتعالى، في الآية رقم 195 من سورة البقرة : "وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ". في هذه الآية الكريمة، "...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ…"، تعني "لا تقودكم أفعالُكم إلى ما لكم فيه هلاك".
إذن، إذا اعتبرنا أن فعلَ "قطع" هو منع الشيء كي لا يحدثَ مرةً أخرى، واعتبرنا أن "أَيْدِيَهُمَا" مقترنة بالأفعال، "…فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا…" تعني وضعَ حدٍّ للسرقة كي لا تتكرَّر مرَّاتٍ أخرى.
وما يؤكِّد ذلك أن الله، سبحانه وتعالى، يقول، في نفس الآية رقم 38 من سورة المائدة : "نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ". والنكال، لغويا، هو العقاب أو النازلة. والنكال لغويا مشتق من فعل "نكَلَ". ولما نُلقي نظرةً على معنى فعل "نَكَلَ" في معجم "المعاني"، نجد المثال التالي : "نَكَلَ أو نَكَّلَ بخَصمِه : أصابه بنازلةٍ تكون عبرةً لغيره.
ولهذا، ف"نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ" تعني أنه، سبحانه وتعالى، يحذِّر الناسَ من تكرار السرقة كيفما كانت وفي أية ظروف حدثت. لأنها من سوء الأخلاق وتضرب عرضَ الحائط مبدأ احترام الحق في الملكية الخاصة. كما تُزعزع حق التَّساكن والتعايش داخلَ المجتمعات البشرية، علماً أن هذين التَّساكن والتعايش هما الضامنان لاستقرار المجتمعات وأمنها وتنظيمها.
وفي الختام، "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، هي آية من آيات القرآن الكريم، المقصود منها، هو النَّهيُ عن السرقة لأنها، كما سبق الذكر، عاملٌ من عوامل اختلال التَّساكن والتعايش داخلَِ المجتمعات.