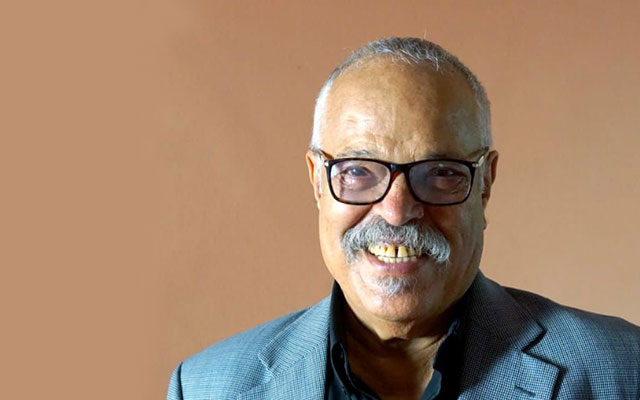تأتي الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مدريد في لحظة دقيقة تشهد فيها منطقة المغرب العربي إعادة تشكل دبلوماسي. فالخطوة تحمل رمزية واضحة بعد سنوات من التوتر بين البلدين، وتفتح في الوقت ذاته فصلاً جديداً في مثلّث العلاقات المعقّد بين إسبانيا والجزائر والمغرب، حيث يظلّ ملف الصحراء الغربية المحدِّدَ الرئيسي لمسار التفاعلات.
خلال الأعوام الماضية، صعّدت الجزائر من تحركاتها الدبلوماسية لمواجهة تنامي الدعم الدولي لخطة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب. وقد اعتُبرت خطوة إسبانيا عام 2022 — حين وصفت هذه الخطة بأنها الأكثر “جدية ومصداقية وواقعية” — تحوّلاً تاريخياً أحدث صدمة في الجزائر، وأدّى إلى سلسلة ردود من بينها سحب السفير، وتقييد التبادلات التجارية، وتجميد التواصل السياسي.
أما اليوم، فتأتي زيارة تبون في سياق مختلف نسبياً. فقد خففت الجزائر من بعض قيودها التجارية، وأعادت فتح قنوات الحوار مع مدريد، في محاولة لإحياء العلاقات الثنائية وإبراز أنها لا تزال فاعلاً أساسياً في معادلة الاستقرار السياسي والطاقي في غرب المتوسط.
ورغم الخلافات السياسية، واصلت الجزائر تزويد إسبانيا بالغاز عبر أنبوب "ميدغاز"، لكنها ما تزال ترفض إعادة فتح أنبوب المغرب–أوروبا (GME) المغلق منذ 2021، وهو ما يصبّ في غير صالح الرباط. هذا المزيج من الحزم السياسي والبراغماتية الطاقية يمثل الورقة الأهم لدى الجزائر، التي تدرك حاجة أوروبا الملحّة إلى مصادر آمنة للطاقة، وقد تستغل ذلك للحصول على مكاسب غير مباشرة، سواء على مستوى العقود أو الاستثمارات أو النفوذ في الأجندة الأورومتوسطية.
في المقابل، عززت مدريد في السنوات الأخيرة شراكتها مع الرباط: تعاون في ملف الهجرة، تنسيق أمني ومكافحة الإرهاب، مصالح اقتصادية متنامية، وسياسة منسجمة إلى حد كبير مع الموقف المغربي من قضية الصحراء. وباتت هذه العلاقة بالنسبة لإسبانيا ركيزة يصعب التفريط فيها.
لهذا تدخل الجزائر إلى مدريد بتوقعات محدودة، فاحتمال أن تغيّر إسبانيا موقفها من الصحراء يبدو ضعيفاً، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع تحمل تدهور إضافي في علاقاتها مع الجزائر، خاصة في ظل هشاشة أسواق الطاقة واتساع اهتمام أوروبا بجنوب المتوسط.
هل يمكن لإسبانيا أن تلعب دور الجسر؟ وهل تتجه الجزائر نحو تعديل مقاربتها؟
ورغم أن ذلك غير مرجح على المدى القريب، إلا أن الجزائر قد تبحث عن مقاربة أكثر واقعية تركز على المكاسب الملموسة كالتعاون الطاقي والصناعي، وتعزيز حضورها الإقليمي، وتخفيف الاستنزاف السياسي في صراعها الطويل مع المغرب.
وفي هذا السياق، قد تلعب إسبانيا دور "الجسر الوظيفي" — لا الوسيط المباشر — لتهيئة مناخ أقل توتراً في المنطقة. إلا أن هذا الدور يظل مشروطاً بمرونة جزائرية وبقدرة مدريد على الحفاظ على توازن دقيق دون إثارة قلق الرباط التي تشعر اليوم بتفوق دبلوماسي نسبي.
هل يمكن تصور سيناريو إيجابي؟
الاحتمال قائم وإن بحذر. في أفضل الحالات، يمكن لهذه الزيارة أن تؤسس لتهدئة حقيقية بين مدريد والجزائر، وضمان استقرار طويل الأمد لإمدادات الطاقة نحو أوروبا، وتخفيف التوتر الجزائري–المغربي على الأقل اقتصادياً، وفتح الباب أمام مقاربة أكثر واقعية لمستقبل المنطقة.
لكن هذا السيناريو تصطدم به تساؤلات جوهرية:
هل ستقبل الجزائر بتعديل موقفها في قضية تراها مصيرية؟
وإلى أي حد يمكن لإسبانيا أن توازن التزاماتها مع المغرب دون إحياء الشكوك الجزائرية؟
وهل يمكن للمغرب العربي أن يحقق حدّاً أدنى من التعاون وسط منافسة بنيوية بين ضفتيه؟
زيارة تبون لن تقدم إجابات نهائية، لكنها تشكل خطوة سياسية محمّلة بالرمزية في منطقة تتحرك دبلوماسيتها بحسابات دقيقة وذاكرة طويلة. التحدي الأكبر هو أن تتحول هذه الخطوة من مجرد صورة إلى بداية هدنة تهدفُ ربح الوقت وتسمح ببناء استقرار ممكن، ولو بصعوبة.
ومع ذلك، يبقى العامل الحاسم الذي يجب الإقرار به في المشهد الإقليمي اليوم، هو أن المغرب أصبح الحلقة الأقوى في المعادلة، والأكثر استقراراً في الإقليم، والشريك الموثوق لدى أوروبا والولايات المتحدة، ما يجعل حضوره محورياً في صياغة وترتيب أي مشهد مستقبلي للمنطقة.
خلال الأعوام الماضية، صعّدت الجزائر من تحركاتها الدبلوماسية لمواجهة تنامي الدعم الدولي لخطة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب. وقد اعتُبرت خطوة إسبانيا عام 2022 — حين وصفت هذه الخطة بأنها الأكثر “جدية ومصداقية وواقعية” — تحوّلاً تاريخياً أحدث صدمة في الجزائر، وأدّى إلى سلسلة ردود من بينها سحب السفير، وتقييد التبادلات التجارية، وتجميد التواصل السياسي.
أما اليوم، فتأتي زيارة تبون في سياق مختلف نسبياً. فقد خففت الجزائر من بعض قيودها التجارية، وأعادت فتح قنوات الحوار مع مدريد، في محاولة لإحياء العلاقات الثنائية وإبراز أنها لا تزال فاعلاً أساسياً في معادلة الاستقرار السياسي والطاقي في غرب المتوسط.
ورغم الخلافات السياسية، واصلت الجزائر تزويد إسبانيا بالغاز عبر أنبوب "ميدغاز"، لكنها ما تزال ترفض إعادة فتح أنبوب المغرب–أوروبا (GME) المغلق منذ 2021، وهو ما يصبّ في غير صالح الرباط. هذا المزيج من الحزم السياسي والبراغماتية الطاقية يمثل الورقة الأهم لدى الجزائر، التي تدرك حاجة أوروبا الملحّة إلى مصادر آمنة للطاقة، وقد تستغل ذلك للحصول على مكاسب غير مباشرة، سواء على مستوى العقود أو الاستثمارات أو النفوذ في الأجندة الأورومتوسطية.
في المقابل، عززت مدريد في السنوات الأخيرة شراكتها مع الرباط: تعاون في ملف الهجرة، تنسيق أمني ومكافحة الإرهاب، مصالح اقتصادية متنامية، وسياسة منسجمة إلى حد كبير مع الموقف المغربي من قضية الصحراء. وباتت هذه العلاقة بالنسبة لإسبانيا ركيزة يصعب التفريط فيها.
لهذا تدخل الجزائر إلى مدريد بتوقعات محدودة، فاحتمال أن تغيّر إسبانيا موقفها من الصحراء يبدو ضعيفاً، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع تحمل تدهور إضافي في علاقاتها مع الجزائر، خاصة في ظل هشاشة أسواق الطاقة واتساع اهتمام أوروبا بجنوب المتوسط.
هل يمكن لإسبانيا أن تلعب دور الجسر؟ وهل تتجه الجزائر نحو تعديل مقاربتها؟
ورغم أن ذلك غير مرجح على المدى القريب، إلا أن الجزائر قد تبحث عن مقاربة أكثر واقعية تركز على المكاسب الملموسة كالتعاون الطاقي والصناعي، وتعزيز حضورها الإقليمي، وتخفيف الاستنزاف السياسي في صراعها الطويل مع المغرب.
وفي هذا السياق، قد تلعب إسبانيا دور "الجسر الوظيفي" — لا الوسيط المباشر — لتهيئة مناخ أقل توتراً في المنطقة. إلا أن هذا الدور يظل مشروطاً بمرونة جزائرية وبقدرة مدريد على الحفاظ على توازن دقيق دون إثارة قلق الرباط التي تشعر اليوم بتفوق دبلوماسي نسبي.
هل يمكن تصور سيناريو إيجابي؟
الاحتمال قائم وإن بحذر. في أفضل الحالات، يمكن لهذه الزيارة أن تؤسس لتهدئة حقيقية بين مدريد والجزائر، وضمان استقرار طويل الأمد لإمدادات الطاقة نحو أوروبا، وتخفيف التوتر الجزائري–المغربي على الأقل اقتصادياً، وفتح الباب أمام مقاربة أكثر واقعية لمستقبل المنطقة.
لكن هذا السيناريو تصطدم به تساؤلات جوهرية:
هل ستقبل الجزائر بتعديل موقفها في قضية تراها مصيرية؟
وإلى أي حد يمكن لإسبانيا أن توازن التزاماتها مع المغرب دون إحياء الشكوك الجزائرية؟
وهل يمكن للمغرب العربي أن يحقق حدّاً أدنى من التعاون وسط منافسة بنيوية بين ضفتيه؟
زيارة تبون لن تقدم إجابات نهائية، لكنها تشكل خطوة سياسية محمّلة بالرمزية في منطقة تتحرك دبلوماسيتها بحسابات دقيقة وذاكرة طويلة. التحدي الأكبر هو أن تتحول هذه الخطوة من مجرد صورة إلى بداية هدنة تهدفُ ربح الوقت وتسمح ببناء استقرار ممكن، ولو بصعوبة.
ومع ذلك، يبقى العامل الحاسم الذي يجب الإقرار به في المشهد الإقليمي اليوم، هو أن المغرب أصبح الحلقة الأقوى في المعادلة، والأكثر استقراراً في الإقليم، والشريك الموثوق لدى أوروبا والولايات المتحدة، ما يجعل حضوره محورياً في صياغة وترتيب أي مشهد مستقبلي للمنطقة.