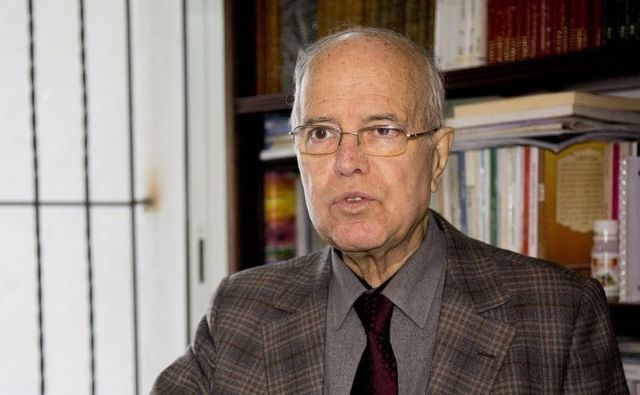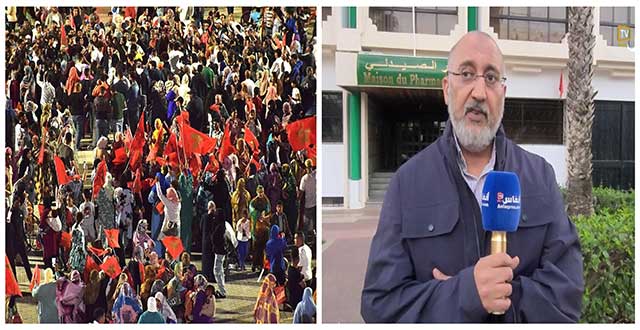في عوالم السرد العجائبي وكوميديا الخداع، قلّما تجتمع نصوص من حضارات وأزمنة مختلفة على اهتمامٍ مشتركٍ بمتاهات الهوية، ونزوات الحب، ودوّامات التنكّر. فحكاية "قمر الزمان وبدر البدور" من ألف ليلة وليلة تدخل في حوارٍ مدهش مع مسرحيتين من عيون المسرح الإليزابيثي: حلم ليلة صيف وليلة الملوك لوليام شكسبير. وعلى الرغم من البُعد بين السياقات الثقافية واللغوية والدينية -فالحكاية العربية منغمسة في الخيال الإسلامي الكلاسيكي، بينما المسرحيتان تنبعان من روح عهد النهضة -فإن النصوص الثلاثة تشترك في ولعٍ بعوالمَ مقلوبة، وهوياتٍ سائلة، وحبٍّ متنكّر.
من خلال عدسة التنكّر والسحر السردي والسّعي العاطفي، تتساءل هذه الأعمال عن الحدود بين المظهر والحقيقة، وبين النظام الاجتماعي والفوضى الخصبة. وكما بيّن ميخائيل باختين، فإن الأدب الكوميدي والكرنفالي يخلق «عالمًا معكوسًا» تُعلّق فيه التراتبيات وتُعاد صياغة الهويات -فضاء مؤقت، لكنه ضروريٌّ لتجديد المجتمع. ومن جهتها، تدعونا جوديث بتلر إلى النظر إلى الجندر لا كجوهرٍ ثابت، بل كـ«أداء» متكرر، ما يلقي ضوءًا جديدًا على تنكّر بدر البدور أو فيولا. وأخيرًا، يشدّد نورثروب فراي على البنية الدورية للكوميديا: فوضى → لبس → اعتراف → احتفال اتحادي. وهي بنيةٌ تتردد أصداؤها في أثينا كما في البصرة. وعلى الرغم من المسافة الجغرافية والزمانية بينهما، فإن هذه القصص تشترك في آليات سردية أساسية، لاسيما استخدام التنكر وتدخل القوى الخارقة للطبيعة.
تقترح هذه الدراسة قراءةً مقارنةً لهذه النصوص الثلاثة بهدف تسليط الضوء على تلاقياتها، دون تغريب خصوصياتها الجمالية والأيديولوجية. لا يسعى هذا البحث إلى فرض صلة نسبٍ مباشرة، ولكن إلى استكشاف «رنينٍ عابر للتاريخ» حول الكوميديا باعتبارها فضاءً للتحوّل والانقلاب والكشف.
التنكّر والقناع - بين الضرورة والتمثيل
لماذا نتنكّر؟
التنكّر ليس مجرّد حيلة درامية؛ هو استجابة وجودية للعالم. فإذا كان الإنسان، كما قال شكسبير، «ممثلًا على خشبة الدنيا»، فإن القناع ليس خيانةً للذات، بل وسيلة للوجود في عالمٍ لا يسمح لنا بالظهور كما نحن.
لكن - وهنا يكمن الفرق الجوهري -
- في التراث السردي العربي، يرتدي القناع ليصل إلى حقيقته.
- في المسرح الإليزابيثي، يكتشف أنه لا حقيقة خلف القناع.
هذا التقابل يشكّل فحوى تحليلنا.
بدر البدور - التنكّر كفعل مقاومة أخلاقية
بعد اختفاء زوجها قمر الزمان، تجد بدر البدور نفسها وحيدة في بلاطٍ ذكوري. لا يمكنها أن تسافر، تبحث، تأمر، أو تحكم كأنثى — فالفضاء العام مغلق أمام جسدها. تختار التنكّر كاستراتيجية نجاة، لا كلهو. تختار الهوية المزدوجة: بين ظاهر وباطن، إن لم تتنكّر، يضيع الحبّ، وينهار العدل. تصبح وزيرةً، قاضيةً، بل وملِكةً. لكن في داخلها، تظل بدر البدور — حبّها لقمر الزمان لا يتغيّر، ولا ينكسر. القناع هنا غطاءٌ مؤقت للجوهر الثابت، لا تفكيكٌ له.
في عالم يُسكت المرأة، يصبح التنكّر فعل كلامٍ بصمت. بدور لا تطلب الإذن؛ تختلس الفعل من بين أصابع النظام.
هذا يذكّرنا بتحليل ميشال فوكو: السلطة لا تُقاوَم من خارجها، بل من داخل ثناياها — عبر التملّص، الحيلة، التقمّص. بدور لا تنكر أنوثتها، تستخدم الذكورة كأداة لإنقاذ حبّها الأنثوي.
فيولا / سيزاريو - التنكّر كأزمة وجودية
فيولا لا تختار التنكّر بدافع الاستراتيجية، وإنما لضرورة وجودية، بعد غرق السفينة وفقدان أخيها.
قولها الشهير: «ماذا سأفعل؟ لا أستطيع أن أكون فيولا هنا!» يكشف انهيار الهوية، لا مجرد تحوّل. لا "تتظاهر" بأنها رجل، ولكن تؤدي الذكورة عبر اللغة، الحركة، العلاقة بالسلطة. هنا، التنكّر هو استجواب للطبيعة نفسها.
هل الحبّ يرى الجسد… أم يرى الروح خلف الكلمات؟ ويصبح المثلث العاطفي فضيحة للرغبة:
أورسينو يحب أوليڤيا، أوليڤيا تحب سيزاريو، سيزاريو (فيولا) تحب أورسينو.
لا أحد يحب "الشخص الحقيقي"، بل الصورة التي يعكسها الآخر. التنكّر يكشف أن للرغبة بنية إسقاطية.
فيولا لا تخدع الآخرين؛ هي فقط تكشف سذاجة إيمانهم بالهوية الثابتة.
بُوتُّم - التنكّر كهزلٍ كوني
هنا يصير التنكّر عقوبة ونعمة في آن واحد. بُوتُّم لا يختار التحوّل إلى حمار؛ بل يُفرض عليه كعقابٍ سحري. ومع ذلك، يصير محبوبًا من ملكة الجن!
التحوّل يصبح كشفاً عن طبيعة الجسد، هنا الجسد المشوه كما عند باختين. الرأس الحماري، الصوت الخشن، الحضور الجسدي المفرط… كلها صفات لـ"الجسد الكرنفالي". جسد مفتوح، غير مكتمل، مرتبط بالأكل، النوم، الجنس. بينما النبلاء يتحدثون عن الحبّ ببلاغة، فإن بُوتُّم يختبر الحبّ جسديًّا — حتى في هيئة حمار! في حماقته، هو أصدق شخصية في المسرحية. لأنه لا يدّعي شيئًا؛ لا يحبّ "باسم القانون" أو "باسم الفضيلة"، وإنما باسم الرغبة البسيطة.
الضحك عليه إشادة بالحقيقة المخفية وليس سخرية: كل إنسانٍ حمارٌ في لحظةٍ ما من حبه.
القناع يعمل كمرآة مزدوجة
التنكّر في هذه النصوص اختبارٌ للحقيقة فهو لا يخون أحدا.
- في ألف ليلة وليلة، القناع طريقٌ إلى الذات.
- عند شكسبير، القناع هو الذات نفسها.
في الحالتين، يُطرح السؤال الأزلي:
هل نحن من نرتدي الأقنعة… أم الأقنعة هي التي ترتدينا؟
وربما أن الجواب يكمن في لحظة خلع القناع ، لأن الكشف، أكثر من التنكّر، هو ما يصنع المأساة… أو المصالحة.
السحر ليس ترفًا، هو نظامُ عالم
السحر والعجائبي لا يوظف كزينةً خيالية في هذه النصوص، إنما منطق وجودي يُنظّم العلاقة بين الإنسان، الكون، والحقيقة. لكن هذا المنطق يختلف جذريًّا بين التراث السردي العربي والإطار المسرحي الإليزابيثي:
- في ألف ليلة وليلة، السحر جزء من الواقع - لا يُستغرب، ولا يُفسّر؛ هو ببساطة كيف يكون العالم.
- عند شكسبير، السحر استثناء مؤقت - فضاءٌ درامي يُعلّق قوانين الواقع ليكشف عن حقائق نفسية أو اجتماعية.
هذا الاختلاف في منطق السرد يولّد وظائف رمزية متباينة: السحر في الليالي يُحقّق العدالة، بينما السحر عند شكسبير يُربك الحقيقة.
السحر في قمر الزمان وبدر البدور: منطق القدر والعدالة
الجِنّ، الطيور الناطقة، الخواتم السحرية، والقصور الطائرة لا تنتمي للـ«خيال»، لأنها أدوات ضمن نظام كوني منسجم. لا يُطرح السؤال «هل هذا ممكن؟»، لأن العالم نفسه لا يفرق بين الطبيعي والخارق.
هذا ما يسمّيه لوسيان ليفي-بريل بـ«التفكير المشارك » : كل شيء مترابط بعلاقات سرّية. للسحر وظيفة سردية: فهو يسرع القدر. يُحقّق ما هو مكتوب دون أن يُغيّر مسار القصة:
الجني داند ينقذ قمر الزمان ليس عن طيبوبة، ولكن لأن القدر لا يسمح لها بالموت. الطيور تحمل الرسائل لأن الحبّ يستحق أن يُوصل. حتى الشر (مثل سحر الملك شهرمان) يخدم التوازن الأخلاقي: العقاب يسبق المكافأة.
السحر يجسّد يد العناية الإلهية التي لا تُرى لكنها تدبّر. لا فوضى، لا عبث: كل حدث سحري مُوجّه نحو لقاءٍ عادل. هنا يتبين أن العجائبي لا يهرب من الواقع، وإنما يؤكد على معناه الأخلاقي.
السحر عند شكسبير: منطق الوهم والكشف النفسي
أ. في حلم ليلة صيف: السحر كفوضى خلاّقة
- السحر خارجي (زهرة الحب، تعويذات بَكْ)، لكنه يعكس الفوضى الداخلية للشخصيات.
- لا يوجد «عدل سحري»: التعويذة تصيب الأبرياء (هيلينا) وتضحك على الغوغاء (بُوتُّم).
- الوظيفة السردية: خلق اللبس الذي يُفضي إلى الاعتراف.
- الوظيفة الرمزية: نقد العقلانية — فالعقل لا يحكم الحبّ، بل الرغبة اللاواعية.
كما يقول ديسيوس: "أوه، كيف تكون عقول العشاق مخالفة للعقل!"
السحر هنا مرآة لللاعقل الذي يسكن القلب البشري.
ب. في ليلة الملوك: السحر كغيابٍ للسحر
لا جِنّ، لا تعويذات — لكن التنكّر، سوء الفهم، واللغة تلعب دور السحر.
فيولا تقول: "الزمن يخلط كلّ شيء!" — الزمن نفسه يصبح قوة سحرية.
هذا الخلط له وظيفة سردية: يجعل تحول الهوية ممكنا، ووظيفة رمزية لأنه يسمح بنفكيك الهوية وإعادة تركيبها.
السحر هنا داخلي، لغوي، نفسي — وهو أقرب إلى التحليل النفسي منه إلى الخرافة.
السحر كمرآة للرؤية الكونية
في الثقافة العربية-الإسلامية:
السحر في الليالي لا يُهدّد النظام، بل يُثبته.
الكون عند مُنظَّم، عادل، ومفهوم — حتى في أعجب تجلياته.
الجِنّ تطيع الأوامر، والطيور تحمل رسائل الحبّ، لأن الكون كله في خدمة المعنى.
في الثقافة الإليزابيثية:
السحر عند شكسبير يُزعزع اليقين. الكون ليس عادلًا، بل مسرح للالتباس — والحبّ، الهوية، حتى الحقيقة، كلها قابلة للتلاعب.
كما يقول فست في ليلة الملوك: "الحياة مسرح، وكل الرجال والنساء مجرد ممثلين."
سحران، عالمان
السحر في ألف ليلة وليلة يقول: «الكون معك إذا كنتَ وفيًّا».
السحر عند شكسبير يقول: «لا تثق بما تراه، فالواقع لعبة أقنعة».
الأول يُطمئن: الفوضى مؤقتة، والعدالة آتية. الثاني يُحذّر: الحقيقة وهم، والحبّ تمثيل.
لكن، كلاهما يستخدم العجائبي ليس كهروب من الحياة، بل كـعدسة لفهمها —
إما عبر الإيمان بالنظام الكوني، أو عبر التشكيك في ثبات الهوية.
وهكذا، يصبح السحر في كلا التقليدين مرآةً للإنسان:
في الشرق، يرى فيه يد القدر، وفي الغرب، يرى فيه وجه ذاته المتغيّر.
الحبّ كابتلاءٍ ولعبة: الحبّ بين الامتحان والتمثيل
في التراث السردي الإنساني، يظهر الحبّ إما كـامتحان روحي يُختبر فيه الإيمان والوفاء، أو كـلعبة اجتماعية تُمارَس عبر الأقنعة والكلمات.
- في الثقافة العربية-الإسلامية الكلاسيكية، غالبًا ما يُصوَّر الحبّ (حتى في سياقه الدنيوي) كـابتلاءٍ إلهي أو امتحان أخلاقي: الصبر، الوفاء، والتضحية هي فضائله.
- أما في المسرح الإليزابيثي، فيُقدَّم الحبّ كـلعبة لغوية ودرامية، حيث الرغبة متقلّبة، والهوية قابلة للتمثيل، والقلب ساحة للاضطراب لا للثبات.
هذه الثنائية — الحبّ كابتلاءٍ مقابل الحبّ كلعبة — تشكّل محور المقارنة بين عالم ألف ليلة وليلة وعالم شكسبير.
1. الحبّ الملحمي والوفاء في الحكاية العربية
حبّ قمر الزمان وبدر البدور زاهد، يتطهّر بالفرقة والصبر. يندرج في منطق الاعتراف الأخلاقي، لا الرغبة الآنية. الزوجان في النهاية يجسّدان الانسجام الكوني، وليس فقط الإشباعٍ العاطفي.
الحبّ كامتحان إلهي وروحي
لا يلتقي قمر الزمان وبدر البدور إلا لِيُفرّقا فورًا. ما يلي ليس مغامرة، بل سلسلة ابتلاءات منتظمة:
-
- قمر الزمان يُسجن، يُغوى، يُجرّب بالإغراء.
- بدر البدور تبحث عنه عبر الممالك، تتخفّى، تحكم، وتتحمّل الوحدة.
كل ابتلاء يهدف إلى تنقية الحبّ من الشوائب: الغدر، الخيانة، النسيان.
هنا، الحبّ ليس شعورًا فرديًّا، بل عهد كونيً يجب الحفاظ عليه رغم الزمن والفصل.
الزمن في الحكاية خطّيّ ومقدّس: كل يوم يمرّ هو اختبارٌ جديد للإيمان بالآخر.
لا مكان للصدفة أو الخطأ: حتى السحر (مثل تدخل الجنيات) يعمل ضمن مشيئة قدريّة تُعيد العشيقين إلى بعضهما.
اللقاء الأخير لا يأتي عبر الصدفة، بل بعد إثبات الجدارة. الاعتراف بصوت الحبيب، برائحته، بخاتمه… هو انتصار للذاكرة على الزمن. الحبّ هنا عملٌ تعبدي: الصبرُ عبادة، والوفاءُ عدل، واللقاءُ جزاء.
- الحبّ المتقلّب والساخر عند شكسبير-الحبّ كلعبة في مسرحيتي شكسبير
في حلم ليلة صيف: الحبّ كفوضى لا عقلانية، الحبّ ليس اختيارًا، بل خطأ سحريً
العشاق يغيّرون محبوبهم في لحظة — ليس لأنهم خائنون، بل لأن الرغبة نفسها سخيفة.
شكسبير يسخر من فكرة "الحبّ الحقيقي": فالحبّ عند البشر مثل حلمٍ يُنسى عند الصحوة.
الحبّ هنا لعبة الطبيعة، لا فضيلة إنسانية.
· ب. في ليلة الملوك: الحبّ كتمثيل هوياتي
فيولا تقول: "أنا غارقة في الحبّ، لكن لا أحد يعلم!" — لأنها تلعب دور رجل.
أوليڤيا تحب «سيزاريو»، أي تحب شخصًا غير موجود.
أورسينو يحب صورة أوليڤيا، لا أوليڤيا ذاتها.
الحبّ ليس اكتشاف الآخر، بل بناء وهمٍ ذاتي عبر مرآة الآخر.
الحبّ عند شكسبير يُبنى بالكلمات، لا بالأفعال:
-
- خطابات أورسينو الشعرية.
- حوارات فيولا المليئة بالازدواجيات الدلالية.
- أغاني فست التي تذكّر بأن الحبّ زائل.
الحبّ لعبة لغوية: من يجيد الكلام، يفوز بالقلب — ولو كان كاذبًا.
في حلم ليلة صيف، الحبّ غير مستقرّ، قابلٌ للتلاعب، بل سخيف تقريبًا — ما يجعله سخريةً من تقاليد الغزل.
في ليلة الملوك، يولد الحبّ من اللبس، لكنه يستقرّ في الاعتراف النهائي.
نحو تصنيفٍ لأنماط الحبّ الكوميدي
-
- الحبّ الشكسبيري نرجسي (فرويد): يحبّ المرء ما يعكس صورةً عن ذاته
- حبّ الليالي محاكي: الرغبة في الآخر كوسيطٍ للرغبة في الذات
- لكن في الحالتين، يجب أن يسقط الوهم ليظهر الحبّ الحقيقي — ما يتوافق مع مفهوم فرويد عن رفع الكبت
التركيب: قد تختلف الثقافات في أخلاقيات الحبّ، لكنها تلتقي في مطلب الحقيقة: لا يزهر الحبّ إلا حين يسقط القناع. إذا كانت مسرحية " حلم ليلة صيف" تحتفل بفوضى الخيال وتحرّر الرغبة من قيود العقل والقانون، فإن" ليلة الملوك" تستكشف الهشاشة الوجودية للهوية في عالمٍ يُبنى على المظاهر. الأولى تضحك على الحبّ، والثانية تتأمل في وجعه. ومع ذلك، تشترك المسرحيتان في إيمانٍ عميق بقدرة الفن والضحك على شفاء الانقسامات الإنسانية — ولو مؤقتًا.
الحبّ في ألف ليلة وليلة هو صبرٌ على الغياب؛ الحبّ عند شكسبير هو تمثيلٌ في حضور الغياب. الأول يُعلّمنا أن الحبّ يُبنى بالوفاء، والثاني يُذكّرنا أن الحبّ يُخترع بالكلمة.
لكن كلا منهما، في العمق، يعترف بأن القلب لا يسكن إلا حيث يُرفع الوهم —سواءً كان وهم السحر، أو وهم التنكّر، أو وهم الصورة المثالية.
ولعلّ هذا هو السرّ المشترك بين البصرة وأثينا وإيليريا: أن الحبّ، في جوهره، طلبُ حقيقةٍ في عالمٍ من الأقنعة.
تنتهي مسرحية "الليالي" بالعرش المشترك، رمزًا لاستعادة التوازن الكوني. تختتم مسرحية "شكسبير" بالزفاف الجماعي، رمزًا للمصالحة الاجتماعية المؤقتة. → يحتفل الشرق بالعدالة الأبدية. → يحتفل الغرب بالسلام المؤقت. المقارنة أصبحت تبدو مشروعة: فهي تُبرز اختلافًا بين الحضارات في طريقة تصور الإنسانية: في المخيلة الإسلامية في العصور الأولى، يُختبر الفرد لإثبات جدارته، والسرد مرآة أخلاقية. في العهد الإليزابيثي، يُستغل الفرد، ويُخدع، ويُعاد تشكيله، والمسرح مرآة مرحة. ومع ذلك، في قلب الأعمال الثلاثة، يُطرح السؤال نفسه: "كيف يُمكننا أن نُحب عندما يُجبرنا العالم على الاختباء؟" تُجيب مسرحية "الليالي": "بالبقاء على طبيعتنا، حتى تحت القناع." يجيب شكسبير: "بإدراك أن القناع هو الذات". لم تعد هذه المقارنة مجرد تمرين أكاديمي، بل أصبحت تأملاً في كيفية تصوير الثقافات للروح البشرية.
تكشف المقارنة أن السرديات الإنسانية، رغم اختلاف الحضارات والأزمنة، تتقاسم بُنىً عميقة: التنكّر كمرحلة انتقالية، والسحر ككاشفٍ للرغبات المخفية، والحبّ كقوةٍ فوضويةٍ وتجدّديةٍ في آنٍ واحد.
فالتنكّر، هو حيلة سردية تكشف اعتباطية الفئات الاجتماعية. أما السحر، فيعمل وفق منطقين: عند شكسبير، هو نفسي وكرنفالي (باختين، فرويد)، بينما في ألف ليلة وليلة، هو كوني وأخلاقي، منسجمٌ مع نظامٍ إلهي. وأخيرًا، الحبّ — سواءً كان ملحميًّا أو كوميديًّا — لا ينتصر إلا حين يُرفع الوهم ليحلّ محلّه الاعتراف.
وهكذا، فإن هذه الأعمال، رغم اختلاف مظاهرها، تشترك في شعريةٍ واحدة للانقلاب المؤقت: فهي تذكّرنا أننا غالبًا ما نرى العالم «مستقيمًا» فقط حين نمرّ بعالمٍ «معكوس» — عالمٍ تسكنه جنيات أو عفاريت أو شبان متنكّرون. وهي تدعو هذه إلى تأمّلٍ في الوظيفة الكونية للكوميديا: أن تمنح، عبر الضحك أو العجب أو الحيلة، مخرجًا لضياع القلب والهوية — وبهذا، تظلّ إنسانيةً إلى أبعد حدّ.