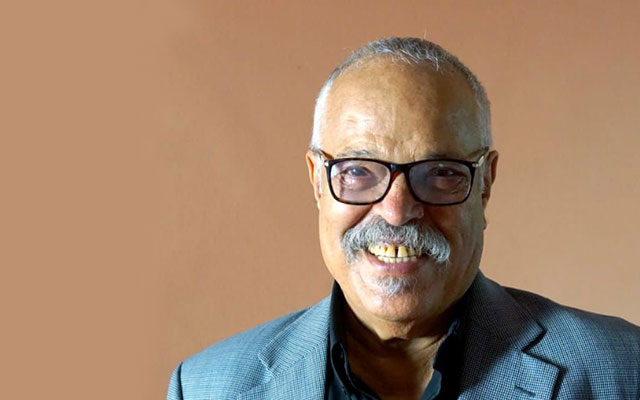غالبا ما تفتقد كلمات أساسية معانيها وغاياتها من فرط استعمالها المكرور إلى درجة الاستخفاف بها. ومنها كلمة المسؤولية. عِلما أن المسؤول، لغةً، هو الشخص الذي يُسأل عما يتخذه من قرارات، وعليه أن يجيب عمَّا هو مسؤول عنه من مهام وإجراءات، وتقييم نتائجها ومردودها، والوقوف عند حجم تأثيرها في المجال الذي هو مُكلف بإدارته وتسييره. مساءلة المسؤول تهدف إلى الوقوف على مدى ما ساهمت فيه قراراته، الفردية أو التشاركية، من خلق قيمٍ مضافة فعلية يمكن البناء عليها، حقا، خارج ما يرصده الإعلام المحسوب وما يولده من انتشاء عابِر. المسؤولية وعيٌ وفهم، واحترام القوانين، والتزام بالبرامج وتفاعل مؤسسي داخلي ومنجز مادي تراكمي ملموس، تقاس بمدى الوفاء بمقتضيات التأطير القانوني والمؤسسي الذي ينظم مجالات مسؤوليات المسؤول، من منطلق الالتزام بمنطوق تصدير الدستور الذي أكَّد على: "توطيد مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة".
لعل الحراك المجتمعي والسياسي الوطني الجاري يستدعي، مرة أخرى، الحديث عن المسؤولية، وعن الاستعمال العمومي للحوار وللنقد، واستحضار الآراء المختلفة حول النخبة وتدخلات الصحفيين والمفكرين والمبدعين والفاعلين الاجتماعيين والشباب في المجال العام؛ والتساؤل عن قدرتهم على الجهر بأفكارهم وتحليلاتهم، ومواقفهم، وعلى الفعل والمشاركة في قضايا المجتمع وصنع الأحداث.
وإذا كان البعض يلهث وراء التموقعات والشهرة فإن إنتاج المثقف، سواء كان شاعرًا أو روائيًا، أو رسامًا، أو سينمائيًا، أو موسيقيًا، أو مُنظرًا، أو صحفيًا، أو فاعلا مدنيًا هو، في جميع الأحوال، الأداة الأنجع التي بها يصوغ أسئلة المجتمع والزمن والوجود، ويشارك بها في المجال العام، ومن خلالها يسهم في مسارات الثقافة والسياسة والمجتمع. وعلى الرغم من أننا نشهد منسوبًا جارفًا من الانفعال، وتضخمًا للمشاعر، وسطوة للثرثرة على حساب الثقافة والحس النقدي، فإننا ما زلنا نفاجأ بقدرة فاعلين ومبدعين وكتابا وفنانين وشباب على معاندة هذا الضجيج، والاستمرار في الكتابة والتموقع في وسائط التواصل والحضور.
ليست حرية التعبير أو المشاركة في المناقشة العمومية مطلبًا سياسيًا فقط، وإنما هي مبدأ تأسيسي للمجتمع العصري، وضرورة للبناء الديمقراطي. وعلى الرغم من أن المغرب جعل من "الاختيار الديمقراطي" ثابتا من الثوابت الجامعة" للأمة في الدستور، فإن العقد الأخير تميز، كما يلاحظ الجميع، بتراجع بائِن للإعلام العمومي عن عرض القضايا الوطنية والمجتمعية ومناقشتها من منظور تعددي يتيح إبراز تيارات الفكر والرأي التي تعتمل في ثنايا المجتمع والسياسة والثقافة. نجد بعض البرامج التي توهم بمنح الكلمة للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، حكومة ومعارضة، لتبرير احترام مقتضيات التعددية كما تفترضها دفاتر التحملات التي تؤطرها "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"؛ وقد تفتح المجال، بمناسبات محسوبة، لبعض المثقفين أو الباحثين؛ لكن هذه البرامج لا تستجيب لما يتعين على الإعلام الوفاء به لتقديم خدمة عمومية تعددية تتيح مساحات المناقشة الحرة، بالابتعاد عن منطق الدعاية وحسابات الرقابة، مع الحرص التحريري على تنويع أنماط التحليل، من أجل كشف مظاهر التقصير واللامساواة والتفاوت التي يقر بها أصحاب القرار السياسي، فضلا عن الدفاع عن الانتقال الحر للمعلومات وترويجها بكل حرية لتنوير المشاهد والجمهور.
وإذا كانت المناقشة العمومية، كما هو معروف، اختيار سياسي وانخراط جماعي يسمحان بمشاركة الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والثقافيين في عمليات بلورة السياسات العمومية، بواسطة آليات الترافع والديمقراطية التشاركية في أفق اتخاذ القرارات الملائمة التي تخدم المصلحة العامة، فإن تأمين هذه المشاركة تستلزم محددين اثنين: ولوج المعلومة، وتعبئة ما يلزم من معطيات موضوعية وحُجج للإقناع؛ بحيث إن مبدأ البرهنة يصبح، في العديد من الحالات، أنجع من منطق الأغلبية والأقلية، شريطة مراعاة الآراء المختلفة واحترام المساواة في أخذ الكلمة والتبادل.
ولقد شهد المغرب فصولا من المناقشة العمومية منذ بداية هذه الألفية، من أبرزها التعبئة العلمية والسياسية الوطنية لتقييم السياسات العمومية منذ استقلال المغرب إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي، نتجت عنها بحوث ومداولات ومناقشات النخبة الوطنية، من مختلف الاتجاهات، وتمخض عنها ما نعت ب"تقرير الخمسينية" الذي وضع شروط نهضة تُحقق "المغرب الممكن". كما أن الورش التاريخي الذي فتح لإعادة قراءة التاريخ الراهن للمغرب مع "هيأة الإنصاف والمصالحة" شكل، بدوره لحظة كثيفة من لحظات المناقشة العمومية حول قضايا تتعلق بالحرية، والعدالة، وحقوق الإنسان، والهوية الوطنية، والوحدة والتعدد، وغيرها من القضايا المحورية التي انخرط فيها مثقفون، ومناضلون، وإعلاميون، وسياسيون، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من مختلف الحساسيات والأعمار والجهات.
ولكي لا أدخل كثيرا في تفاصيل لحظات المشاركة الجماعية في المناقشات العمومية، أكتفي بالتذكير بما جرى في خضم أحداث 20 فبراير وما نتج عنها من دعوة إلى تعديل الدستور، والمناقشات الواسعة التي واكبت عمليات الاستماع للأحزاب، والنقابات، والجمعيات، والنخب، وغيرها من الوثائق والمقترحات والبرامج التواصلية التي نظمت حول شروط بناء مرجعيات معيارية لمغرب ديمقراطي. نفس الاختيار التنظيمي حصل، أيضا، في سياق تحضير "النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية" الذي أشرف على تدبير التفكير الجماعي حوله "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، وما حصل مع مشروع "الجهوية الموسعة"، وبحث "الثروة الإجمالية للمغرب"، ومجهودات التقييم والتقارير التي هيأت لصياغة "الرؤية الاستراتيجية 2030-2015" لإصلاح التعليم التي أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والبحث العلمي، إلى الاستشارة الواسعة التي دارت حول "النموذج التنموي الجديد".
لكن، كيف تعمل الصياغة النهائية على تقدير ما يتمخض عن هذه المناقشات المفتوحة؟ وهل تعكس مُخرجاتها عن التوجهات الكبرى التي يعبر عنها المفكرون والفاعلون السياسيون والاجتماعيون لِما يجب أن تكون عليه السياسات العمومية؟ وإلى أي حد يترجم أصحاب القرار ما يتفق عليه الفاعلون في شكل برامج وسياسات تحرص على تحقيق العدالة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الصارخة في المغرب؟ ثم ما هي الأسباب التي حالت دون الارتقاء بالنقاش العمومي إلى مستوى جعله اختيارا إعلاميا وسياسيا وثقافيا للمساءلة والمحاسبة الدائمة؟
من جهة أخرى، قد يتساءل متسائل: هل نملك في المغرب ما يلزم من النضج الوجداني لتقبُّل النقد والمحاسبة؟ وهل توفرت الشروط الفكرية للاستعمال العمومي الدائم للحرية؟
يبدو أن هذين السؤالين يفترضان استدعاء فكرة الحرية التي بقيت عندنا رهينة اعتبارات إيديولوجية ومناسبات ظرفية. يرى عبد الله العروي، في هذا السياق، "أن الحرية إذا كانت شعارا، مفهوما أو تجربة، فيتيعن التمييز بين التجربة وطريقة التعبير عنها". إذ كثيرا ما تم اختزال الحرية في مجرد شعار، كما أن مفهومها لم يكن واضحا ولا متجذرا في الأذهان أو مُحَقَّقا في الواقع، والأنكى أن يكون مترجما في سلوكات. والسبب؟ هنا يلتقي العديد من مفكرينا، ومنهم عبد الله العروي، في إرجاع السبب إلى غياب الاستيعاب المعرفي والتاريخي لمفهوم الحرية؛ بل وأضيف أن الأمر لا يقتصر على ما يتعرض له مصطلح الحرية من تسيُّب ومن تراشق غامض، وإنما يمس أهم مرتكزات دولة تتطلع إلى أن تكون حديثة يعود إلى استخفاف عدد يزداد تناميا من المسؤولين بمسؤولياتهم القانونية، والمؤسسية، والأخلاقية. وهو ما يستلزم تفعيلا جديا لآليات التقييم والمحاسبة على صرف المال العام والنتائج الموعود بها.