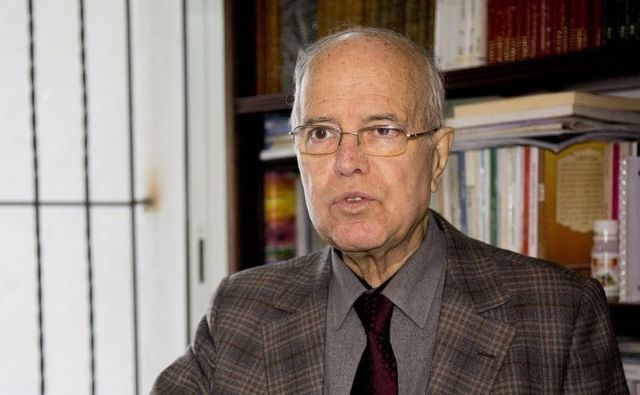لم تكن الطفولة على شاطئ الطنطان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي مجرد فسحة على رمال البحر، بل كانت مرحلة تكوين حقيقية، ومختبرا مبكرا للقيم التي ستظل راسخة في ذاكرة أجيال كاملة. لم تكن مجرد لهو عابر، ولا فسحة محدودة بين البحر والرمال؛ كانت زمنا قائما بذاته، ترسم معالمه مع كل فجر جديد.
في الصباح، ومع خيوط الضوء الأولى، كان الأطفال يهرولون جماعات صوب المرسى. خطواتهم الصغيرة كانت تعكس حماسة جيل لم يعرف غير البساطة، لكنه عاشها كأنها حياة كاملة.
هناك، عند “البركوات” أو “الباريخات”، كان البحارة يستقبلونهم بوجوه لفحتها الشمس، يمدون لهم صناديق السمك الطازج. فيعود هؤلاء الصغار إلى الخيام كفرسان عادوا من غزوة مظفرة، لا يقتسمونها فيما بينهم فقط، بل يوزعونها على الخيام المجاورة. كان مشهد القسمة درسا مبكرا في الكرم الجماعي والتكافل الاجتماعي، حيث ما يمنحه البحر يصبح للجميع.
لكن الملحمة لم تتوقف عند حدود البحر. هناك "النطفية"، على مسافة ليست باليسيرة، كان ينتظرهم طقس آخر: "رحلة الماء" يخرجون جماعات، الشمس قد بدأت تلفح جلودهم، والرمال تلسع أقدامهم الحافية. يحمل بعضهم "بيدوات" صغيرة من البلاستيك، بينما يتعاون آخرون على رفع "بيطاكة" ضخمة قد تصل سعتها إلى ثلاثين لترا. الأذرع الصغيرة ترتجف من ثقلها، لكن الحكايات والطرائف التي يتبادلونها على الطريق تجعل المسافة أقصر، وتجعل المشقة أخف.
وما إن يعودوا بالماء، حتى يوزع جزء منه على خيام أخرى، ولو لم تجمعهم بها صلة دم. كان الماء في مخيم شاطئ الطنطـــــــــان أكثر من سائل يطفئ الظمأ؛ كان رمزا للتضامن، وإعلانا أن لا أحد يترك وحيدا أمام قسوة الطبيعة في تأكيد على أن العطش عدو جماعي، لا يُترك أحد ليواجهه بمفرده.
وحين تبدأ الشمس بالانحدار، يتحول المشهد فوق "الغرد" إلى مسرح جماعي. الجميع يجلس صفا واحدا: الرجال والنساء، الصغار والكبار. كانوا يحتسون الشاي بنكهة البحر، ويرتشفون "أزريگ"، فيما تنحدر الشمس نحو الأفق لتذوب في البحر كقطعة ذهب سائلة. عند تلك اللحظة، كان الصمت يسود، كأن الجميع أمام صلاة كونية، حيث الجمال يتفوق على الكلام، والبحر يفرض هيبته على العيون والقلوب معا.
ومع حلول الليل، تعود الحياة إلى الخيام. على ضوء الشموع، تتوزع المهام: من يشعل النار، من يُعد الطعام، ومن يتولى الشاي. أما الأطفال فينسجون من اللحظة فرحا جديدا: لعبة “الأحكام”، حيث يضحك الجميع من غرابة العقوبات، التي يواجه فيها الخاسر عقوبات طريفة—شرب ماء البحر، أو رميه بين الأمواج. لم تكن هذه الأحكام عقابا، بل طقسا جماعيا يؤكد أن الضحكة المشتركة هي العملة الأثمن في زمن القسوة.
في زوايا أخرى من المخيم، تُقام السهرات. أصوات الغناء، إيقاعات “الگدرة”، ورنين “الگيتار” تتداخل لتصنع سيمفونية محلية، تغني عن صخب المدن، وتعيد صياغة الليل بلغة الفرح. لم يكن الغناء مجرد طرب، بل كان وسيلة للتنفيس عن قسوة العيش، وطريقة جماعية لتأكيد أن الحياة، رغم شدتها، ما زالت تستحق الاحتفاء.
لكن خلف هذه البهجة، ظل الغياب حاضرا. الآباء، جلهم كانوا عساكر يرابطون في تخوم الصحراء، لا يعودون إلا مرة واحدة في السنة. غيابهم لم يكن فراغا فقط، بل كان عبئا إضافيا على الأمهات اللواتي أصبحن أما وأبا في آن واحدة. ومع ذلك، كن في الوقت نفسه مربيات وقائدات، يُدبرن شؤون البيت، ويحافظن على تماسك الأسرة. أما المجتمع فقد شكل بدوره "عائلة كبرى" تحتضن الجميع، حيث الجار يقوم مقام الأخ، والكبير يحظى بمقام الأب، والصغير يُعامل كابن للجميع. هكذا لم تكن التربية شأنا فرديا، بل مسؤولية جماعية تُبنى على العرف والحياء والاحترام.
ومن هذا التناقض وُلد جيل متماسك: جيل تعلم أن يجعل من القليل ثروة، ومن التضامن درعا في مواجهة الحاجة. جيل عرف أن البحر ليس مجرد شاطئ، بل مدرسة ومورد حياة، وأن الخيمة ليست مجرد مأوى، بل وطن صغير.
من هنا، تَشكل جيل صلب، جيل عاش بساطة الموارد لكن بثراء القيم. جيل صنع من البحر مدرسة، ومن الخيمة جامعة، ومن الشاطئ أكاديمية للحياة. لقد صاغت تلك الحقبة ملامح شخصية ابن الطنطان: صبورا أمام قسوة الطبيعة، كريما في مواجهة الحاجة، وفيا لذاكرته، مؤمنا أن الفرح الجماعي أعظم من المكاسب الفردية.
في الختام، يظل الدعاء مرفوعا لأولئك الآباء المرابطين في ثغور الوطن. غابوا بأجسادهم، لكن ذكراهم باقية كرايات خفاقة في وجدان أبنائهم، ورمزا للفداء والصبر. سلام عليهم في مرقدهم، ورحمة واسعة تظللهم، وجزاء يليق بما قدموا من وفاء وتضحية.
هكذا كان شاطئ الطنطان، وهكذا بقي في الذاكرة: ليس مجرد فضاء طبيعي، بل صفحة من التاريخ الحي، وملحمة من الحياة البسيطة التي صنعت أجيالا لا تشترى قيمها بثمن.