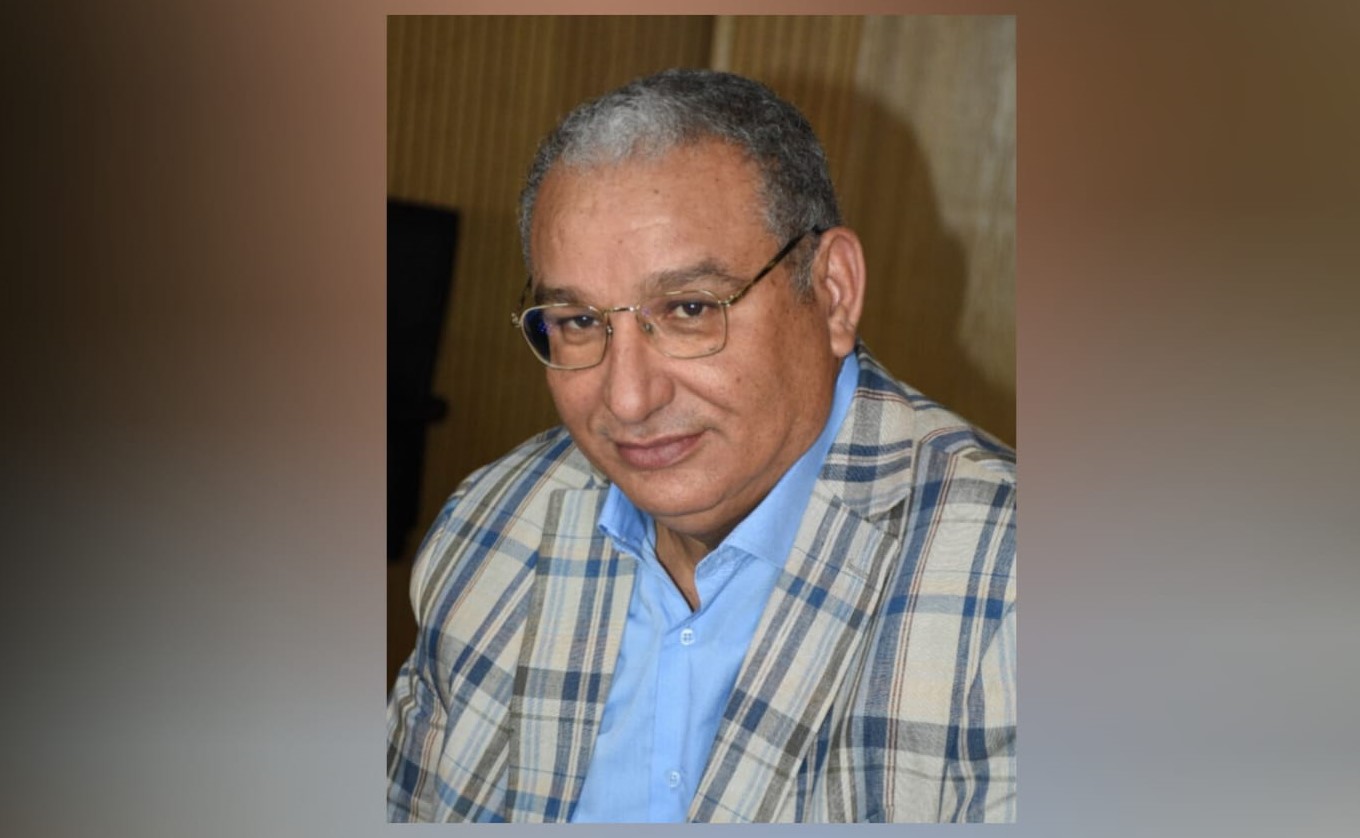صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم الحق في الإضراب، بعدما صادق عليه قبل ذلك مجلس النواب الذي سيحال إليه من جديد في إطار قراءة ثانية بعد أن قامت الغرفة الثانية بإدخال مجموعة من التعديلات على بعض مواده، وربما سيحال فيما بعد على المحكمة الدستورية من أجل تدقيق مقتضياته وتمحيص مدى انسجامها مع الوثيقة الدستورية ومختلف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، ولو أن أهم اتفاقية تخص هذا الحق وهي الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية حول حرية التجمع وحماية الحق في التنظيم النقابي الصادرة سنة 1948 لم تصادق عليها المملكة إلى حدود الآن رغم أهميتها الكبيرة على مستوى تطوير العمل النقابي وضمان الحق في الإضراب كأحد أهم الحقوق التي يجب حمايتها واحترامها من طرف الدول والحكومات.
وإذا كانت المسودات والمشاريع السابقة التي حاولت تفعيل مقتضيات الفصل 29 من الدستور من خلال بلورة القانون التنظيمي، الذي يحدد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب كانت موضوع جدل دائم مرتبط باتهام النقابات للدولة بغياب الإرادة السياسية اللازمة من أجل تنزيله وفق ما فرضه النص الدستوري منذ أول دستور للبلاد سنة 1962 إلى آخر تعديل له الذي صدر سنة 2011 . وإذا كان هذا الجدل قد انتهى مبدئيا بدفع هذا القانون نحو مسطرة المصادقة التشريعية، فإن مقتضياته باعتبارها أحكام من المفروض أن تحقق التوازن بين الحق في الإضراب وبين الحق في استمرار العمل او التوازن ما بين الدولة الباطرونا وبين الاجراء والموظفين والمهنيين، ما تزال تثير العديد من النقاشات والجدالات السياسية والحقوقية والقانونية التي أكدت في اغلبها على أن مقتضيات هذا القانون جاءت لتفرغ المبدأ الدستوري من محتواه.
وإذا كانت النقابات العمالية قد عبرت عن موقفها من هذا القانون التنظيمي واعتبرت على أنه قانون رجعي يقيد الحق في الاضراب ويصعب من شروط تطبيقه على أرض الواقع، إلى درجة أن هذه النقابات دعت إلى إضراب عام وشامل على المستوى الوطني احتجاجا على ما تضمنه هذا القانون من مقتضيات مكبلة ومقيدة لهذا الحق الكوني والدستوري. فإن النقابات المهنية ظلت ساكتة ولم تعبر عن موقف صريح وواضح من هذا المشروع قانون رغم انه لا يهم فقط الموظفين والأجراء فقط ولكنه يخص فئات أخرى من بينها المهنيين . ولعل من أبرز المهن التي يشملها هذا المشروع قانون بمقتضياته هي مهنة المحاماة التي للأسف لم تعبر مؤسساتها المهنية سواء على مستوى الهيئات السبعة عشر او على مستوى جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن موقف واضح وصريح منه رغم أنه قانون سيؤثر بشكل عميق على حصانة واستقلالية مهنة المحاماة والمنتسبين اليها بصفة مباشرة وغير مباشرة، لا سيما أن فعل الاضراب بمختلف تسمياته "التوقف الجماعي، التوقف الجزئي،المقاطعة" هي آلية أو آليات استعملت بكثرة في الأربع سنوات الأخيرة من طرف الجسم المهني للمحاماة من أجل مواجهة حملة الاستهداف التي كانت تقوم بها الحكومة اتجاه مهنة الدفاع على المستوى التشريعي والتدبيري، ويكفي أن نذكر بثلاث محطات أساسية قام من خلالها المحامين بالإضراب عن العمل لحوالي أسبوعين من الزمن بشكل أثر على قطاع العدالة ومختلف القطاعات المرتبطة بها. فقد كانت البداية مع الإضراب في مواجهة التدابير الاحترازية التي قررت بمقتضى المذكرة الثلاثية الموقعة من طرف وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة حول منع مختلف المرتفقين ومن بينهم المحامين من ولوج المحاكم إلا بشرط الادلاء بجواز التلقيح، والمحطة الثانية كانت إضرابا في مواجهة المقتضيات الضريبية المتعسفة في حق المحامين التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، والمحطة الأخيرة هي التي كانت أقوى وأنجع وجعلت الحكومة ترضخ الى فضيلة الحوار وتبدأ مع ممثلي مهنة المحاماة جلسات حوارية لازالت مطبوعة بالسرية ولا نعلم مدى استجابتها الى تضحيات وطموحات المحاميات والمحامين الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل حماية حصانة واستقلالية مهنتهم النبيلة.
ولذلك نستغرب مرور مشروع القانون التنظيمي هذا مرور الكرام دون أن تكون لنا كمحامين مذكرة ترافعية تحدد فيها بدقة مطالبنا التي كان يمكن أن تستهدف توسيع مجال الضمانات وتقليص مجال القيود أثناء قيام المحامين بالإضراب كآلية احتجاجية عادلة ومشروعة من اجل النضال لتحقيق المكتسبات وسحب كل القيود الموضوعية والإجرائية التي من شأنها تكبيل المؤسسات المهنية في الدعوة إلى التوقف عن العمل. كما أن هذا التجاهل الذي مورس من قبل ممثلي المحامين إزاء هذا المشروع قانون يجعلنا نؤكد على أننا لم نتعلم من الدروس السابقة التي مفادها وخلاصتها أننا لا نواكب مسودات ومشاريع القوانين التي لها علاقة بمهنة المحاماة من أجل التدخل في الوقت المناسب بقصد الترافع لفائدة المهنة وإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان . ولنا في تجربة قانون غسل الأموال الذي فرض على المحامين ان يصبحوا وشاة ومخبرين صغار لفائدة الجهاز الأمني والقضائي في تعارض مع نبل وقداسة رسالتهم المهنية وفي ضرب صارخ لأحد اهم المبادئ التي تقوم عليها رسالة الدفاع وهي الحفاظ على السر المهني ، وأيضا في تجربة قانون المالية لسنة 2023 الذي فرض احكام ضريبية لا تراعي ظروف وطبيعة مهنة المحاماة وممتهينبها ، ما يجعلنا نؤكد اننا بعيدين كل البعد عن المواكبة التشريعية للمسودات والمشاريع التي يكون لها تأثير على مهنة الدفاع، وان ترافعنا ينصب فقط على قوانين بعينها هي قانون المهنة والقوانين المسطرية سواء قانون المسطرة المدنية او قانون المسطرة الجنائية ، وكأن باقي القوانين الأخرى لا تعنينا ولا تهمنا ، والحال أنها تشكل خطورة بالغة على أسس ومبادئ مهنة المحاماة وعلى حاضرها ومستقبلها .
وبغض النظر عن الملاحظات والتحفظات المثارة أعلاه فإنه يمكن التأكيد على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب يتضمن مجموعة من المقتضيات المرتبطة بالمهنيين عامة ومهنة المحاماة على وجه الخصوص التي كان حريا المطالبة بتدقيقها او تعديلها للتلائم مع طبيعة المحاماة ودورها الحقوقي والمجتمعي. وهكذا فإن من بين المقتضيات التي تتثير نقاشا قانونيا وحقوقيا نجد المادة الثالثة التي حددت الجهة الداعية إلى الاضراب وعرفتها بكونها الجهة التي تتولى الدعوة إلى الاضراب والتفاوض بمناسبته او السعي إلى تسوية القضايا الخلافية واتخاذ قرار تنفيذ الاضراب او توقيفه مؤقتا أو إنهائه او إلغائه أو السهر على سريانه وتأطيره وتشمل من ضمن ما تشمل "..منظمة نقابية تمثل المهنيين في وضعية قانونية سليمة … " ، وهذه المادة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمادة 11 من القانون التنظيمي التي تنص على أن الدعوة إلى الإضراب بالنسبة للمهنيين تتم من قبل منظمة نقابية تمثلهم بحسب الحالة . وهنا يطرح تساؤل مهم بخصوص مهنة المحاماة حول من يمثل هذه المهنة؟ ومن له الحق في الدعوة إلى الإضراب؟ والحال ان القانون لا يحدد سوى معيار عام يتعلق " بمنظمة نقابية تمثلهم " ؟ مع العلم على أن هناك العديد من المنظمات النقابيّة داخل الجسم المهني فهناك الهيئات المنظمة بقانون المهنة رقم 28.08 وهناك جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنظمة بظهير 1958 المتعلق بالحريات العامة ، وهناك نقابة المحامين بالمغرب التي تخضع للقانون المنظم للنقابات ، وهناك مؤسسات جمعوية مهنية خاضعة هي الأخرى لظهير 1958 من قبيل اتحادات وجمعيات المحامين الشباب وفيدرالية المحامين الشباب بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب إضافة إلى جمعيات أخرى ترى نفسها تمثل تيار مهني معين . فهل التمثيلية تقع حصرا على الهيئات السبعة عشر لأنها هي التي لها الصفة القانونية في تمثيل المحامين ؟ ام ان جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الممثلة باعتبارها الاطار التنسيقي على المستوى الوطني وهي التي كانت تدعو إلى التوقفات والإضرابات على المستوى الوطني ؟ ام ان باقي الاطار النقابيّة والجمعوية المهنية التي سبق لها هي الأخرى الدعوة الى وقفات دفاعا عن المهنة وعن المنتسبين اليها لها أيضا الصفة للدعوة إلى الاضراب؟
قد تكون الإجابة بسيطة ومباشرة والقول أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب هي المختصة للدعوة إلى الاضراب في قطاع المحاماة مادامت هي من دعت إلى ذلك في المرات السابقة وحققت نجاحا غير مسبوقا في اطار الاضراب الأخير الذي ما تزال تعيش الساحة المهنية على وقعه باعتباره شكال انتصاراً كبيرا عمل على فرض الأمر الواقع على الدولة والحكومة وساهم في تغيير نظرتهم وتعاملهم مع مهنة المحاماة . ولكن الإشكال المطروح هو ان الانسجام الموجود حاليا بين جميع المكونات المهنية في انتظار " مخرجات الحوارات السرية " لا يكون دائما على هذا المنوال من السلم والتفاهم . ولعل تجارب الولايات السابقة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب وأيضا بداية هذه الولاية الحالية تؤكد على ان المكونات المؤسساتية المهنية لا تقف مكتوفة الأيادي في حالة تقاعس الجمعية عن القيام باتخاذ مواقف قوية وحاسمة في كل ما يتعلق بالشأن المهني ، بل انه في الكثير من الأحيان تم تحدي الجمعية من طرف هذه الإطارات التي تعتبرها لا تمثل المحامين لانعدام صفتها القانونية وايضاً لانها مجرد جمعية مثلها مثل باقي الجمعيات المؤسسة طبقا لظهير 1958 . ولذلك فانه من الممكن ان يكون هناك إشكال حقيقي حول التمثيلية المشار اليها في المادة الثالثة والحادية عشر من مشروع القانون التنظيمي المنظم للحق في الاضراب ، لأن كل الإطارات والتعبيرات المهنية تمثل المحامين وهو الشرط الوحيد الذي اشترطه هذا المشروع قانون من أجل دعوة اطار مهني معين إلى خوض إضراب وفق الشروط المحددة في هذا القانون التنظيمي . وهذا الأمر قد يخلق في المستقبل خلاقا وانقساما داخل صفوف المحاميات والمحامين في حالة اختلاف وتعدد الرؤى والأهداف والمصالح بين كل هذه المكونات المؤسساتية المهنية ، وهو ما قد يؤدي الى اضعاف وحدة الصف الذي لطالما افتخر بترسخها داخل الجسم المهني سائر المنتسبين الى مهنة النبلاء .
ومن بين الإشكاليات الأخرى التي تثار في اطار مقتضيات هذا القانون التنظيمي هو اقتصار المشرع في المادة 12 من هذا المشروع قانون على إمكانية ان تتكون لجنة الاضراب في المؤسسات والمقاولات في القطاع الخاص، ولم تشمل المهنيين وباقي الفئات التي يطبق عليها القانون . ولجنة الاضراب تؤسّس بمحضر يوقعه 25 في المائة من الأجراء المكونين للمقاولة وتتكون اللجنة من عدد لا يتعدى الستة هي التي تكون مختصة بالدعوة إلى الإضراب . ورغم ان هذا المادة أحالت على نص تنظيمي من اجل تحديد كيفية تطبيق هذه مقتضيات هذه المادة ، إلا المبدأ الوارد في هذه المادة التي يجعل هذه اللجنة مقتصرة على مقاولات القطاع الخاص من شأنه تقليص مجال الاضراب ، إذا أنه في الكثير من الأحيان يكون هناك خلاف كبير بين المنتمين إلى قطاع معين والمؤسسات النقابيّة التي تمثلهم ، وبالتالي سيكون تعميم هذا المبدأ مهما وحاسما في توسيع وضمان الحق في الاضراب في باقي القطاعات وايضاً في قطاع المحامين .
كما تثير المادة 13 من مشروع القانون التنظيمي إشكالية تتعلق بآجال الدعوة إلى الاضراب وقد حددته بالنسبة للجميع بمن فيهم المهنيين في أجل 45 يوما قابل للتمديد 15 يوما وذلك فيما يتعلق بالملف المطلبي الذي عرفته المادة الثالثة من مشروع القانون التنظيمي على أنه كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية او اقتصادية او اجتماعية او مهنية ذات الصلة بظروف العمل او بممارسة المهنة ويمكن ان يضاف اليها قضايا خلافية ، وتحتسب الاجال بهذا الخصوص من تاريخ التوصل بالملف المطلبي ويجب خلالها القيام بمفاوضات قصد البحث عن حلول متفق عليها . أما بالنسبة للمسائل الخلافية التي عرفتها المادة الثالثة أيضا على أنها كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل في القطاع العام او القطاع الخاص أو بسبب ممارسة مهنة او بسبب الإخلال بالالتزامات التعاقدية بين الأطراف ، والاجل المحدد لها هو 30 يوما يبتدئ من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية ويجب القيام خلالها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها . والتحفظ الوارد على هذه المادة هو نفس التحفظ الذي أبدته النقابات العمالية وايضاً تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذين أكدوا على ضرورة تقليص هذه الآجالات حتى لا ينتهي ويندثر الغرض او الهدف من خوض الاضراب ، لا سيما حينما يكون الملف المطلبي واضح او القضية الخلافية لا تتطلب مجهودات وامكانيات مادية وإنما مجرد إرادة سياسية لتفعيل حق وضمان حرية . وربما تتأكد هذه الحقيقة بشكل اكبر على مستوى مهنة المحاماة لأن ملفاتنا المطلبية وقضايانا الخلافية مع وزارة العدل ومع الحكومة في غالب الأحيان تكون حول أمور ذات طبيعة تشريعية وتنظيمية وتدبيرية وليست مادية ، ولا تحتاج في نهاية المطاف الى كل هذه المدد المحددة في المادة 13 من القانون التنظيمي المنظم للحق في الاضراب .
وتتضمن المادة 14 من مشروع القانون التنظيمي مقتضى يمس باستقلالية مهنة المحاماة انطلاقا من تعدد الجهات الرقابية على الاضراب الذي يمكن ان يقوم به المحامين بدعوة من اجهزتهم التمثيلية ، فهذه المادة تنص على أنه يجب على الجهة الداعية إلى الاضراب قبل الشروع الفعلي في تنفيذ الاضراب ، تبليغ قرار الاضراب باي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وأيضا إلى السلطة الحكومية المشرفة على المهنة إذا تعلق الأمر باضراب يمارسه المهنيون . وهكذا على سبيل المثال إذا أراد المحامين خوض إضراب دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم وذودا عن استقلالية مهنتهم وحصانتها ان يبلغوا إضرابهم ليس فقط الى وزارة العدل التي تشرف على قطاع العدالة ولكن أيضا الى وزارة الداخلية المكلفة بالجانب الأمني داخل المملكة ، وبالتالي يظهر على ان الرقابة والوصاية أضحت مزدوجة على مهنة الدفاع من خلال جهتين حكومتين هما العدل والداخلية ، والحال اننا كمحامين كنا نرفض حتى الوصاية التي تمارسها وزارة العدل على اعتبار ان مهنة المحاماة يجب ان تتمتع باستقلال ذاتي عن طريق خضوع المنتسبين اليها فقط لنقبائهم ومؤسساتهم المهنية ، فاذا بهذا المشروع قانون التنظيمي أضاف وصاية وزارة الداخلية كجهة امنية إلى الرقابة والوصاية التي تمارسها وزارة العدل كجهة تشريع وتدبير . وهذا الأمر فيه الكثير من الانتقاص من استقلالية مهنة المحاماة التي لا يمكن ان تقوم لها قائمة إذا فقدت استقلالها في تدبيرها لقضايا العدالة والوطن بمنتهى الاستقلالية عن أي جهك أخرى كيفما كانت.
اما المادة 21 من هذا مشروع القانون فانها أيضا تثير تحفظات في مضمونها، ذلك انها اعتبرت ان المهن القانونية والقضائية ومن بينها مهنة المحاماة تعد من المرافق الحيوية وفرضت عليها توفير الحد الأدنى من الخدمة ، وقد عرف القانون هذه الأخيرة على انها ضرورة توفير قدر كاف من الخدمات الأساسية المقدمة من طرف المرافق الحيوية والتي تروم الحفاظ على حياة الأفراد وامنهم وصحتهم وعلى سلامتهم وعلى النظام العام وان نص تنظيمي سيحدد مقدار هذا الحد الأدنى بعد استشارة المنظمات المهنية . وهذه المادة من دون شك ستخلق إشكالات كبيرة انطلاقا من التجارب السابقة التي عاشها المحامين في إضراباتهم وأشكالهم النضالية السابقة ، ذلك أن الكثير من الهيئات حاولت أثناء هذه الإضرابات توفير الحد الأدنى من الخدمة عن طريق تعيين مداومين من اجل تدبير الملفات المرتبطة بالأجالات والحالات الاستعجالية، وأثبتت التجربة على ان توفير هذا الحد الأدنى من الخدمة لم يجعل هذا التوقف او المقاطعة او الاضراب يحقق أهدافه المخطط له ، بينما كانت الخطوة النضالية الأخيرة التي دعت من خلالها جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى التوقف الشامل واللامحدود والمستمر من دون تقديم أي حد ادنى من الخدمة فعالة وناجعة في تحقيق الضغط على الحكومة ووزارة العدل من اجل الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديمها لوعود بالاستجابة لكثير من المطالب الذي ناضل من اجلها الجسم المهني . من أجل ذلك فإن فرض توفير الحد الأدنى من الخدمة اثناء خوض الإضرابات سيعمل على ضمان استمرارية المرفق العام بشكل يجعل عامل الضغط الذي يعتبر اهم اهداف خوض الإضرابات متهافت ويجعل القطاع الحكومي المعني في وضع مريح يحول دون استجابته للحوار او لتحقيق المطالب الواردة في الملفات المطلبية او في القضايا الخلافية . وبالتالي فخضوع مهنة المحاماة لهذا القانون التنظيمي سيجعلها مجبرة على توفير الحد من الخدمة في مجال عملها، وهذا ما سيجعل وزارة العدل والحكومة في حل من أي ضغط حقيقي يجبرها على الاستجابة لمطالب المحامين ومذكراتهم الترافعية ، وهذا المعطى سيشكل تبخيسا للقوة النضالية التي كانت لدى المحامين حينما لم يكونوا خاضعين لهذا القانون.
كما أن تدخل قاضي المستعجلات في العديد من بنود ومواد هذا القانون من اجل الرقابة على الحق في الاضراب وتحديد الحق الأدنى من الخدمة والتدخل في مختلف تفاصيل الاضراب سيضر باستقلالية المحاماة في خوض معاركها النضالية عن طريق الية الاضراب ، وبالتالي فان الرقابة لم تبقى فقط مزدوجة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية بل سيصبح القضاء أيضا متدخل كجهاز وصي ورقابي على المحاماة ومؤسساتها والمنتسبين اليها في حقهم المشروع والمطلق في النضال والإضراب من أجل تحصين مكتسباتهم والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم . وهكذا ستصبح هناك ثلاث جهات رقابية على ممارسة المحامين لهذا الحق وهي وزارة العدل ووزارة الداخلية والسلطة القضائية، وهو أمر يبقى غير مقبول وغير مبرر ويتعارض مع طبيعة مهنة المحاماة التي تقوم على أساس الحرية في الترافع والدفاع احقاقا للحق ومناهضة للظلم.
وأخيرا وليس آخرا ، يمكن ان نتحدث عن العقوبات المقررة على المخالفين لأحكام هذا المشروع قانون التنظيمي المنظمة في الباب الثالث والأخير منه المتعلقة بالجزاءات . فاذا كانت العقوبات المقررة في هذا المشروع قانون كلها متعلقة بالجزاءات المالية عن طريق تطبيق الغرامات ، لان هذا المشروع قانون جاء خلوا من العقوبات السالبة للحرية وهذا توجه مستحسن في اطار ما أصبحت تفرضه السياسات العقابية الجديدة التي تستند على مبادئ مدرسة الدفاع الاجتماعي ، إلا أن هذا التوجه مع ذلك يتبين على أنه غير صحيح لا سيما ان الأفعال المرتبطة بالإضرابات غالبا يمكن تكييفها تكييفا ينطبق على العقوبات الواردة في القانون الجنائي ، وبالتالي فليس هناك أي ضمانة لعدم المتابعة والإدانة وفق مقتضيات القانون الجنائي ولا سيما مقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مئة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”. . خاصة امام عدم وجود نص صريح وواضح يمنع سلطات المتابعة والإدانة من الاستعانة بالمقتضيات الزجرية الواردة في القانون الجنائي من اجل متابعة الجهات الداعية إلى الاضراب والمشاركين فيه وإدانتهم بعقوبات سالبة للحرية . ولن نذهب بعيدا لنستدل على هذا الأمر من خلال قانون الصحافة والنشر الذي صدر سنة 2016 وجاء خاليا أيضا من أي عقوبات سالبة للحرية واقتصر فقط على العقوبات المالية والغرامات ، ولكن بتتبع قضايا الصحافيين منذ صدور هذا القانون سنجد على ان اغلب الصحافيين المتابعين والمدانين توبعوا وادينوا بعقوبات سالبة للحرية باستناد سلطات المتابعة والإدانة على مقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة الذي لا يتضمن أي عقوبة حبسية . ويمكن توقع نفس السيناريو والمصير للأشخاص الذين يمكن متابعتهم بخرق قواعد الاضراب او المشاركة في إضراب غير مشروع وفق احكام القانون التنظيمي المنظم للحق في الاضراب ، ذلك ان يمكن اللجوء إلى مقتضيات القانون الجنائي وإقرار عقوبات سالبة للحرية في مواجهتهم لانه ليس هناك أي نص يمنع النيابة العامة وقضاء الحكم من المتابعة والإدانة من الاستعانة بمقتضيات القانون الجنائي من أجل ادانة المضربين بعقوبات سالبة للحرية . وهنا ما دمنا نتحدث عن المحاماة والمحاميات والمحامين فانه يمكن التأكيد على انهم يمكن ان يتابعوا ويدانوا ليس فقط بالعقوبات المالية الواردة في هذه القانون التنظيمي ولكن أيضا بالعقربات السالبة للحرية الواردة في القانون الجنائي ، وهذا أقصى مساس بحريتهم واستقلاليتهم وحصانتهم التي تعتبر أسمى المبادئ التي تشكل أساس قوتهم ورمزيتهم .
لكن من وجهة نظري الشخصية ، وبغض النظر عن الملاحظات والتحفظات التي أثرناها أعلاه بخصوص المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي المنظم للإضراب والتي من شأنها أن تقوض من الجانب الرمزي والنضالي لمهنة المحاماة وتمس بشكل مباشر وغير مباشر بحصانتها واستقلاليتها ، فإن اهم مطلب كان ينبغي ان ينصب عليه ترافع المؤسسات المهنية المحاماة ولا سيما جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تمثل الجسم المهني امام الحكومة وباقي المؤسسات المتدخلة في مجال التشريع والعدالة هو ان يتم رفض ادماج مهنة المحاماة لتصبح احد المهن التي يسري عليها هذا القانون على اعتبار ان طبيعتها وتاريخها ورمزيتها ودورها الحقوقي يأبى ان يتم تقييدها بمختلف هذه القيود الموضوعية والإجرائية التي ستحول دون قيامها بدورها الترافعي في المجال الحقوقي والسياسي بكل حرية ومن دون قيود قبلية او بعدية . وقد كانت المشاريع السابقة التي تم إقبارها ولم تستكمل مسارها التشريعي تسير في هذا الاتجاه اذ كانت تنص فقط على فئة الأجراء او العمال والموظفين ونقاباتهم التمثيلية ، ولم تكن تتوسع لتستهدف فئات أخرى كالمهنيين ولا سيما المهن القانونية والقضائية التي تعتبر مهنة المحاماة جزء لا يتجزأ من مكوناتها . وهذا التوجه الصحيح والسليم الذي كان على مؤسساتنا المهنية الدفع في اتجاهه .
ختاما ينبغي القول أنه مع كامل الأسف فلم يعد هناك مجال كبير يسمح للمؤسسات المهنية للمحاماة بالترافع حول مقتضيات هذا المشروع قانون التنظيمي سواء بتعديل بعض بنوده او بالمطالبة بعدم سريانه على المهنة والمنتسبين اليها وإخراجهم من نطاق تطبيقه ، لانه تمت المصادقة على هذا القانون في الغرفة الثانية للبرلمان بعدما تمت المصادقة عليه في الغرفة الأولى وسيرجع لمجلس النواب من أجل قراءة ثانية . لكن أمام عدم تحمل العديد من المتدخلين لدورهم ومسؤوليتهم التاريخية سواء كانوا نوابا أو مستشارين غاب اغلبهم اثناء النقاش الذي عرفه هذا القانون والتصويت عليه ، أو المنظمات النقابيّة العمالية التي لم تعبر عن موقفها الرافض من هذا المشروع قانون باعتباره قانونا رجعيا يكبل أحد أهم الحقوق التي ينص عليها الدستور ، ولم تتحرك وتدعو إلى الاضراب احتجاجا على مقتضيات هذا القانون إلا بعد مصادقة مجلس المستشارين على هذا المشروع قانون ، أو المنظمات النقابيّة المهنية وخاصة جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تجاهلت هذا القانون ولم تبدي أي رأي او تحفظ عليه رغم تأثيره المباشر على استقلالية وحصانة مهنة المحاماة وتقييده لآلياتها الترافعية والنضالية التي استندت اليها بشكل كبير في معاركها المهنية مع الحكومة وقطاعاتها . فإنه يبقى مع ذلك يبقى الأمل والمجال مفتوحا امام القضاء الدستوري من أجل تصحيح ما يمكن تصحيحه في هذا المشروع قانون التنظيمي الذي تضمن العديد من التراجعات التي تمس بالحق في الاضراب كأحد أهم الحقوق والحريات التي يجب ضمانها واحترامها وحمايتها من طرف الدولة.
وإذا كانت المسودات والمشاريع السابقة التي حاولت تفعيل مقتضيات الفصل 29 من الدستور من خلال بلورة القانون التنظيمي، الذي يحدد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب كانت موضوع جدل دائم مرتبط باتهام النقابات للدولة بغياب الإرادة السياسية اللازمة من أجل تنزيله وفق ما فرضه النص الدستوري منذ أول دستور للبلاد سنة 1962 إلى آخر تعديل له الذي صدر سنة 2011 . وإذا كان هذا الجدل قد انتهى مبدئيا بدفع هذا القانون نحو مسطرة المصادقة التشريعية، فإن مقتضياته باعتبارها أحكام من المفروض أن تحقق التوازن بين الحق في الإضراب وبين الحق في استمرار العمل او التوازن ما بين الدولة الباطرونا وبين الاجراء والموظفين والمهنيين، ما تزال تثير العديد من النقاشات والجدالات السياسية والحقوقية والقانونية التي أكدت في اغلبها على أن مقتضيات هذا القانون جاءت لتفرغ المبدأ الدستوري من محتواه.
وإذا كانت النقابات العمالية قد عبرت عن موقفها من هذا القانون التنظيمي واعتبرت على أنه قانون رجعي يقيد الحق في الاضراب ويصعب من شروط تطبيقه على أرض الواقع، إلى درجة أن هذه النقابات دعت إلى إضراب عام وشامل على المستوى الوطني احتجاجا على ما تضمنه هذا القانون من مقتضيات مكبلة ومقيدة لهذا الحق الكوني والدستوري. فإن النقابات المهنية ظلت ساكتة ولم تعبر عن موقف صريح وواضح من هذا المشروع قانون رغم انه لا يهم فقط الموظفين والأجراء فقط ولكنه يخص فئات أخرى من بينها المهنيين . ولعل من أبرز المهن التي يشملها هذا المشروع قانون بمقتضياته هي مهنة المحاماة التي للأسف لم تعبر مؤسساتها المهنية سواء على مستوى الهيئات السبعة عشر او على مستوى جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن موقف واضح وصريح منه رغم أنه قانون سيؤثر بشكل عميق على حصانة واستقلالية مهنة المحاماة والمنتسبين اليها بصفة مباشرة وغير مباشرة، لا سيما أن فعل الاضراب بمختلف تسمياته "التوقف الجماعي، التوقف الجزئي،المقاطعة" هي آلية أو آليات استعملت بكثرة في الأربع سنوات الأخيرة من طرف الجسم المهني للمحاماة من أجل مواجهة حملة الاستهداف التي كانت تقوم بها الحكومة اتجاه مهنة الدفاع على المستوى التشريعي والتدبيري، ويكفي أن نذكر بثلاث محطات أساسية قام من خلالها المحامين بالإضراب عن العمل لحوالي أسبوعين من الزمن بشكل أثر على قطاع العدالة ومختلف القطاعات المرتبطة بها. فقد كانت البداية مع الإضراب في مواجهة التدابير الاحترازية التي قررت بمقتضى المذكرة الثلاثية الموقعة من طرف وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة حول منع مختلف المرتفقين ومن بينهم المحامين من ولوج المحاكم إلا بشرط الادلاء بجواز التلقيح، والمحطة الثانية كانت إضرابا في مواجهة المقتضيات الضريبية المتعسفة في حق المحامين التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، والمحطة الأخيرة هي التي كانت أقوى وأنجع وجعلت الحكومة ترضخ الى فضيلة الحوار وتبدأ مع ممثلي مهنة المحاماة جلسات حوارية لازالت مطبوعة بالسرية ولا نعلم مدى استجابتها الى تضحيات وطموحات المحاميات والمحامين الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل حماية حصانة واستقلالية مهنتهم النبيلة.
ولذلك نستغرب مرور مشروع القانون التنظيمي هذا مرور الكرام دون أن تكون لنا كمحامين مذكرة ترافعية تحدد فيها بدقة مطالبنا التي كان يمكن أن تستهدف توسيع مجال الضمانات وتقليص مجال القيود أثناء قيام المحامين بالإضراب كآلية احتجاجية عادلة ومشروعة من اجل النضال لتحقيق المكتسبات وسحب كل القيود الموضوعية والإجرائية التي من شأنها تكبيل المؤسسات المهنية في الدعوة إلى التوقف عن العمل. كما أن هذا التجاهل الذي مورس من قبل ممثلي المحامين إزاء هذا المشروع قانون يجعلنا نؤكد على أننا لم نتعلم من الدروس السابقة التي مفادها وخلاصتها أننا لا نواكب مسودات ومشاريع القوانين التي لها علاقة بمهنة المحاماة من أجل التدخل في الوقت المناسب بقصد الترافع لفائدة المهنة وإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان . ولنا في تجربة قانون غسل الأموال الذي فرض على المحامين ان يصبحوا وشاة ومخبرين صغار لفائدة الجهاز الأمني والقضائي في تعارض مع نبل وقداسة رسالتهم المهنية وفي ضرب صارخ لأحد اهم المبادئ التي تقوم عليها رسالة الدفاع وهي الحفاظ على السر المهني ، وأيضا في تجربة قانون المالية لسنة 2023 الذي فرض احكام ضريبية لا تراعي ظروف وطبيعة مهنة المحاماة وممتهينبها ، ما يجعلنا نؤكد اننا بعيدين كل البعد عن المواكبة التشريعية للمسودات والمشاريع التي يكون لها تأثير على مهنة الدفاع، وان ترافعنا ينصب فقط على قوانين بعينها هي قانون المهنة والقوانين المسطرية سواء قانون المسطرة المدنية او قانون المسطرة الجنائية ، وكأن باقي القوانين الأخرى لا تعنينا ولا تهمنا ، والحال أنها تشكل خطورة بالغة على أسس ومبادئ مهنة المحاماة وعلى حاضرها ومستقبلها .
وبغض النظر عن الملاحظات والتحفظات المثارة أعلاه فإنه يمكن التأكيد على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب يتضمن مجموعة من المقتضيات المرتبطة بالمهنيين عامة ومهنة المحاماة على وجه الخصوص التي كان حريا المطالبة بتدقيقها او تعديلها للتلائم مع طبيعة المحاماة ودورها الحقوقي والمجتمعي. وهكذا فإن من بين المقتضيات التي تتثير نقاشا قانونيا وحقوقيا نجد المادة الثالثة التي حددت الجهة الداعية إلى الاضراب وعرفتها بكونها الجهة التي تتولى الدعوة إلى الاضراب والتفاوض بمناسبته او السعي إلى تسوية القضايا الخلافية واتخاذ قرار تنفيذ الاضراب او توقيفه مؤقتا أو إنهائه او إلغائه أو السهر على سريانه وتأطيره وتشمل من ضمن ما تشمل "..منظمة نقابية تمثل المهنيين في وضعية قانونية سليمة … " ، وهذه المادة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمادة 11 من القانون التنظيمي التي تنص على أن الدعوة إلى الإضراب بالنسبة للمهنيين تتم من قبل منظمة نقابية تمثلهم بحسب الحالة . وهنا يطرح تساؤل مهم بخصوص مهنة المحاماة حول من يمثل هذه المهنة؟ ومن له الحق في الدعوة إلى الإضراب؟ والحال ان القانون لا يحدد سوى معيار عام يتعلق " بمنظمة نقابية تمثلهم " ؟ مع العلم على أن هناك العديد من المنظمات النقابيّة داخل الجسم المهني فهناك الهيئات المنظمة بقانون المهنة رقم 28.08 وهناك جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنظمة بظهير 1958 المتعلق بالحريات العامة ، وهناك نقابة المحامين بالمغرب التي تخضع للقانون المنظم للنقابات ، وهناك مؤسسات جمعوية مهنية خاضعة هي الأخرى لظهير 1958 من قبيل اتحادات وجمعيات المحامين الشباب وفيدرالية المحامين الشباب بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب إضافة إلى جمعيات أخرى ترى نفسها تمثل تيار مهني معين . فهل التمثيلية تقع حصرا على الهيئات السبعة عشر لأنها هي التي لها الصفة القانونية في تمثيل المحامين ؟ ام ان جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الممثلة باعتبارها الاطار التنسيقي على المستوى الوطني وهي التي كانت تدعو إلى التوقفات والإضرابات على المستوى الوطني ؟ ام ان باقي الاطار النقابيّة والجمعوية المهنية التي سبق لها هي الأخرى الدعوة الى وقفات دفاعا عن المهنة وعن المنتسبين اليها لها أيضا الصفة للدعوة إلى الاضراب؟
قد تكون الإجابة بسيطة ومباشرة والقول أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب هي المختصة للدعوة إلى الاضراب في قطاع المحاماة مادامت هي من دعت إلى ذلك في المرات السابقة وحققت نجاحا غير مسبوقا في اطار الاضراب الأخير الذي ما تزال تعيش الساحة المهنية على وقعه باعتباره شكال انتصاراً كبيرا عمل على فرض الأمر الواقع على الدولة والحكومة وساهم في تغيير نظرتهم وتعاملهم مع مهنة المحاماة . ولكن الإشكال المطروح هو ان الانسجام الموجود حاليا بين جميع المكونات المهنية في انتظار " مخرجات الحوارات السرية " لا يكون دائما على هذا المنوال من السلم والتفاهم . ولعل تجارب الولايات السابقة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب وأيضا بداية هذه الولاية الحالية تؤكد على ان المكونات المؤسساتية المهنية لا تقف مكتوفة الأيادي في حالة تقاعس الجمعية عن القيام باتخاذ مواقف قوية وحاسمة في كل ما يتعلق بالشأن المهني ، بل انه في الكثير من الأحيان تم تحدي الجمعية من طرف هذه الإطارات التي تعتبرها لا تمثل المحامين لانعدام صفتها القانونية وايضاً لانها مجرد جمعية مثلها مثل باقي الجمعيات المؤسسة طبقا لظهير 1958 . ولذلك فانه من الممكن ان يكون هناك إشكال حقيقي حول التمثيلية المشار اليها في المادة الثالثة والحادية عشر من مشروع القانون التنظيمي المنظم للحق في الاضراب ، لأن كل الإطارات والتعبيرات المهنية تمثل المحامين وهو الشرط الوحيد الذي اشترطه هذا المشروع قانون من أجل دعوة اطار مهني معين إلى خوض إضراب وفق الشروط المحددة في هذا القانون التنظيمي . وهذا الأمر قد يخلق في المستقبل خلاقا وانقساما داخل صفوف المحاميات والمحامين في حالة اختلاف وتعدد الرؤى والأهداف والمصالح بين كل هذه المكونات المؤسساتية المهنية ، وهو ما قد يؤدي الى اضعاف وحدة الصف الذي لطالما افتخر بترسخها داخل الجسم المهني سائر المنتسبين الى مهنة النبلاء .
ومن بين الإشكاليات الأخرى التي تثار في اطار مقتضيات هذا القانون التنظيمي هو اقتصار المشرع في المادة 12 من هذا المشروع قانون على إمكانية ان تتكون لجنة الاضراب في المؤسسات والمقاولات في القطاع الخاص، ولم تشمل المهنيين وباقي الفئات التي يطبق عليها القانون . ولجنة الاضراب تؤسّس بمحضر يوقعه 25 في المائة من الأجراء المكونين للمقاولة وتتكون اللجنة من عدد لا يتعدى الستة هي التي تكون مختصة بالدعوة إلى الإضراب . ورغم ان هذا المادة أحالت على نص تنظيمي من اجل تحديد كيفية تطبيق هذه مقتضيات هذه المادة ، إلا المبدأ الوارد في هذه المادة التي يجعل هذه اللجنة مقتصرة على مقاولات القطاع الخاص من شأنه تقليص مجال الاضراب ، إذا أنه في الكثير من الأحيان يكون هناك خلاف كبير بين المنتمين إلى قطاع معين والمؤسسات النقابيّة التي تمثلهم ، وبالتالي سيكون تعميم هذا المبدأ مهما وحاسما في توسيع وضمان الحق في الاضراب في باقي القطاعات وايضاً في قطاع المحامين .
كما تثير المادة 13 من مشروع القانون التنظيمي إشكالية تتعلق بآجال الدعوة إلى الاضراب وقد حددته بالنسبة للجميع بمن فيهم المهنيين في أجل 45 يوما قابل للتمديد 15 يوما وذلك فيما يتعلق بالملف المطلبي الذي عرفته المادة الثالثة من مشروع القانون التنظيمي على أنه كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية او اقتصادية او اجتماعية او مهنية ذات الصلة بظروف العمل او بممارسة المهنة ويمكن ان يضاف اليها قضايا خلافية ، وتحتسب الاجال بهذا الخصوص من تاريخ التوصل بالملف المطلبي ويجب خلالها القيام بمفاوضات قصد البحث عن حلول متفق عليها . أما بالنسبة للمسائل الخلافية التي عرفتها المادة الثالثة أيضا على أنها كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل في القطاع العام او القطاع الخاص أو بسبب ممارسة مهنة او بسبب الإخلال بالالتزامات التعاقدية بين الأطراف ، والاجل المحدد لها هو 30 يوما يبتدئ من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية ويجب القيام خلالها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها . والتحفظ الوارد على هذه المادة هو نفس التحفظ الذي أبدته النقابات العمالية وايضاً تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذين أكدوا على ضرورة تقليص هذه الآجالات حتى لا ينتهي ويندثر الغرض او الهدف من خوض الاضراب ، لا سيما حينما يكون الملف المطلبي واضح او القضية الخلافية لا تتطلب مجهودات وامكانيات مادية وإنما مجرد إرادة سياسية لتفعيل حق وضمان حرية . وربما تتأكد هذه الحقيقة بشكل اكبر على مستوى مهنة المحاماة لأن ملفاتنا المطلبية وقضايانا الخلافية مع وزارة العدل ومع الحكومة في غالب الأحيان تكون حول أمور ذات طبيعة تشريعية وتنظيمية وتدبيرية وليست مادية ، ولا تحتاج في نهاية المطاف الى كل هذه المدد المحددة في المادة 13 من القانون التنظيمي المنظم للحق في الاضراب .
وتتضمن المادة 14 من مشروع القانون التنظيمي مقتضى يمس باستقلالية مهنة المحاماة انطلاقا من تعدد الجهات الرقابية على الاضراب الذي يمكن ان يقوم به المحامين بدعوة من اجهزتهم التمثيلية ، فهذه المادة تنص على أنه يجب على الجهة الداعية إلى الاضراب قبل الشروع الفعلي في تنفيذ الاضراب ، تبليغ قرار الاضراب باي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وأيضا إلى السلطة الحكومية المشرفة على المهنة إذا تعلق الأمر باضراب يمارسه المهنيون . وهكذا على سبيل المثال إذا أراد المحامين خوض إضراب دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم وذودا عن استقلالية مهنتهم وحصانتها ان يبلغوا إضرابهم ليس فقط الى وزارة العدل التي تشرف على قطاع العدالة ولكن أيضا الى وزارة الداخلية المكلفة بالجانب الأمني داخل المملكة ، وبالتالي يظهر على ان الرقابة والوصاية أضحت مزدوجة على مهنة الدفاع من خلال جهتين حكومتين هما العدل والداخلية ، والحال اننا كمحامين كنا نرفض حتى الوصاية التي تمارسها وزارة العدل على اعتبار ان مهنة المحاماة يجب ان تتمتع باستقلال ذاتي عن طريق خضوع المنتسبين اليها فقط لنقبائهم ومؤسساتهم المهنية ، فاذا بهذا المشروع قانون التنظيمي أضاف وصاية وزارة الداخلية كجهة امنية إلى الرقابة والوصاية التي تمارسها وزارة العدل كجهة تشريع وتدبير . وهذا الأمر فيه الكثير من الانتقاص من استقلالية مهنة المحاماة التي لا يمكن ان تقوم لها قائمة إذا فقدت استقلالها في تدبيرها لقضايا العدالة والوطن بمنتهى الاستقلالية عن أي جهك أخرى كيفما كانت.
اما المادة 21 من هذا مشروع القانون فانها أيضا تثير تحفظات في مضمونها، ذلك انها اعتبرت ان المهن القانونية والقضائية ومن بينها مهنة المحاماة تعد من المرافق الحيوية وفرضت عليها توفير الحد الأدنى من الخدمة ، وقد عرف القانون هذه الأخيرة على انها ضرورة توفير قدر كاف من الخدمات الأساسية المقدمة من طرف المرافق الحيوية والتي تروم الحفاظ على حياة الأفراد وامنهم وصحتهم وعلى سلامتهم وعلى النظام العام وان نص تنظيمي سيحدد مقدار هذا الحد الأدنى بعد استشارة المنظمات المهنية . وهذه المادة من دون شك ستخلق إشكالات كبيرة انطلاقا من التجارب السابقة التي عاشها المحامين في إضراباتهم وأشكالهم النضالية السابقة ، ذلك أن الكثير من الهيئات حاولت أثناء هذه الإضرابات توفير الحد الأدنى من الخدمة عن طريق تعيين مداومين من اجل تدبير الملفات المرتبطة بالأجالات والحالات الاستعجالية، وأثبتت التجربة على ان توفير هذا الحد الأدنى من الخدمة لم يجعل هذا التوقف او المقاطعة او الاضراب يحقق أهدافه المخطط له ، بينما كانت الخطوة النضالية الأخيرة التي دعت من خلالها جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى التوقف الشامل واللامحدود والمستمر من دون تقديم أي حد ادنى من الخدمة فعالة وناجعة في تحقيق الضغط على الحكومة ووزارة العدل من اجل الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديمها لوعود بالاستجابة لكثير من المطالب الذي ناضل من اجلها الجسم المهني . من أجل ذلك فإن فرض توفير الحد الأدنى من الخدمة اثناء خوض الإضرابات سيعمل على ضمان استمرارية المرفق العام بشكل يجعل عامل الضغط الذي يعتبر اهم اهداف خوض الإضرابات متهافت ويجعل القطاع الحكومي المعني في وضع مريح يحول دون استجابته للحوار او لتحقيق المطالب الواردة في الملفات المطلبية او في القضايا الخلافية . وبالتالي فخضوع مهنة المحاماة لهذا القانون التنظيمي سيجعلها مجبرة على توفير الحد من الخدمة في مجال عملها، وهذا ما سيجعل وزارة العدل والحكومة في حل من أي ضغط حقيقي يجبرها على الاستجابة لمطالب المحامين ومذكراتهم الترافعية ، وهذا المعطى سيشكل تبخيسا للقوة النضالية التي كانت لدى المحامين حينما لم يكونوا خاضعين لهذا القانون.
كما أن تدخل قاضي المستعجلات في العديد من بنود ومواد هذا القانون من اجل الرقابة على الحق في الاضراب وتحديد الحق الأدنى من الخدمة والتدخل في مختلف تفاصيل الاضراب سيضر باستقلالية المحاماة في خوض معاركها النضالية عن طريق الية الاضراب ، وبالتالي فان الرقابة لم تبقى فقط مزدوجة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية بل سيصبح القضاء أيضا متدخل كجهاز وصي ورقابي على المحاماة ومؤسساتها والمنتسبين اليها في حقهم المشروع والمطلق في النضال والإضراب من أجل تحصين مكتسباتهم والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم . وهكذا ستصبح هناك ثلاث جهات رقابية على ممارسة المحامين لهذا الحق وهي وزارة العدل ووزارة الداخلية والسلطة القضائية، وهو أمر يبقى غير مقبول وغير مبرر ويتعارض مع طبيعة مهنة المحاماة التي تقوم على أساس الحرية في الترافع والدفاع احقاقا للحق ومناهضة للظلم.
وأخيرا وليس آخرا ، يمكن ان نتحدث عن العقوبات المقررة على المخالفين لأحكام هذا المشروع قانون التنظيمي المنظمة في الباب الثالث والأخير منه المتعلقة بالجزاءات . فاذا كانت العقوبات المقررة في هذا المشروع قانون كلها متعلقة بالجزاءات المالية عن طريق تطبيق الغرامات ، لان هذا المشروع قانون جاء خلوا من العقوبات السالبة للحرية وهذا توجه مستحسن في اطار ما أصبحت تفرضه السياسات العقابية الجديدة التي تستند على مبادئ مدرسة الدفاع الاجتماعي ، إلا أن هذا التوجه مع ذلك يتبين على أنه غير صحيح لا سيما ان الأفعال المرتبطة بالإضرابات غالبا يمكن تكييفها تكييفا ينطبق على العقوبات الواردة في القانون الجنائي ، وبالتالي فليس هناك أي ضمانة لعدم المتابعة والإدانة وفق مقتضيات القانون الجنائي ولا سيما مقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مئة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”. . خاصة امام عدم وجود نص صريح وواضح يمنع سلطات المتابعة والإدانة من الاستعانة بالمقتضيات الزجرية الواردة في القانون الجنائي من اجل متابعة الجهات الداعية إلى الاضراب والمشاركين فيه وإدانتهم بعقوبات سالبة للحرية . ولن نذهب بعيدا لنستدل على هذا الأمر من خلال قانون الصحافة والنشر الذي صدر سنة 2016 وجاء خاليا أيضا من أي عقوبات سالبة للحرية واقتصر فقط على العقوبات المالية والغرامات ، ولكن بتتبع قضايا الصحافيين منذ صدور هذا القانون سنجد على ان اغلب الصحافيين المتابعين والمدانين توبعوا وادينوا بعقوبات سالبة للحرية باستناد سلطات المتابعة والإدانة على مقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة الذي لا يتضمن أي عقوبة حبسية . ويمكن توقع نفس السيناريو والمصير للأشخاص الذين يمكن متابعتهم بخرق قواعد الاضراب او المشاركة في إضراب غير مشروع وفق احكام القانون التنظيمي المنظم للحق في الاضراب ، ذلك ان يمكن اللجوء إلى مقتضيات القانون الجنائي وإقرار عقوبات سالبة للحرية في مواجهتهم لانه ليس هناك أي نص يمنع النيابة العامة وقضاء الحكم من المتابعة والإدانة من الاستعانة بمقتضيات القانون الجنائي من أجل ادانة المضربين بعقوبات سالبة للحرية . وهنا ما دمنا نتحدث عن المحاماة والمحاميات والمحامين فانه يمكن التأكيد على انهم يمكن ان يتابعوا ويدانوا ليس فقط بالعقوبات المالية الواردة في هذه القانون التنظيمي ولكن أيضا بالعقربات السالبة للحرية الواردة في القانون الجنائي ، وهذا أقصى مساس بحريتهم واستقلاليتهم وحصانتهم التي تعتبر أسمى المبادئ التي تشكل أساس قوتهم ورمزيتهم .
لكن من وجهة نظري الشخصية ، وبغض النظر عن الملاحظات والتحفظات التي أثرناها أعلاه بخصوص المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي المنظم للإضراب والتي من شأنها أن تقوض من الجانب الرمزي والنضالي لمهنة المحاماة وتمس بشكل مباشر وغير مباشر بحصانتها واستقلاليتها ، فإن اهم مطلب كان ينبغي ان ينصب عليه ترافع المؤسسات المهنية المحاماة ولا سيما جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تمثل الجسم المهني امام الحكومة وباقي المؤسسات المتدخلة في مجال التشريع والعدالة هو ان يتم رفض ادماج مهنة المحاماة لتصبح احد المهن التي يسري عليها هذا القانون على اعتبار ان طبيعتها وتاريخها ورمزيتها ودورها الحقوقي يأبى ان يتم تقييدها بمختلف هذه القيود الموضوعية والإجرائية التي ستحول دون قيامها بدورها الترافعي في المجال الحقوقي والسياسي بكل حرية ومن دون قيود قبلية او بعدية . وقد كانت المشاريع السابقة التي تم إقبارها ولم تستكمل مسارها التشريعي تسير في هذا الاتجاه اذ كانت تنص فقط على فئة الأجراء او العمال والموظفين ونقاباتهم التمثيلية ، ولم تكن تتوسع لتستهدف فئات أخرى كالمهنيين ولا سيما المهن القانونية والقضائية التي تعتبر مهنة المحاماة جزء لا يتجزأ من مكوناتها . وهذا التوجه الصحيح والسليم الذي كان على مؤسساتنا المهنية الدفع في اتجاهه .
ختاما ينبغي القول أنه مع كامل الأسف فلم يعد هناك مجال كبير يسمح للمؤسسات المهنية للمحاماة بالترافع حول مقتضيات هذا المشروع قانون التنظيمي سواء بتعديل بعض بنوده او بالمطالبة بعدم سريانه على المهنة والمنتسبين اليها وإخراجهم من نطاق تطبيقه ، لانه تمت المصادقة على هذا القانون في الغرفة الثانية للبرلمان بعدما تمت المصادقة عليه في الغرفة الأولى وسيرجع لمجلس النواب من أجل قراءة ثانية . لكن أمام عدم تحمل العديد من المتدخلين لدورهم ومسؤوليتهم التاريخية سواء كانوا نوابا أو مستشارين غاب اغلبهم اثناء النقاش الذي عرفه هذا القانون والتصويت عليه ، أو المنظمات النقابيّة العمالية التي لم تعبر عن موقفها الرافض من هذا المشروع قانون باعتباره قانونا رجعيا يكبل أحد أهم الحقوق التي ينص عليها الدستور ، ولم تتحرك وتدعو إلى الاضراب احتجاجا على مقتضيات هذا القانون إلا بعد مصادقة مجلس المستشارين على هذا المشروع قانون ، أو المنظمات النقابيّة المهنية وخاصة جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تجاهلت هذا القانون ولم تبدي أي رأي او تحفظ عليه رغم تأثيره المباشر على استقلالية وحصانة مهنة المحاماة وتقييده لآلياتها الترافعية والنضالية التي استندت اليها بشكل كبير في معاركها المهنية مع الحكومة وقطاعاتها . فإنه يبقى مع ذلك يبقى الأمل والمجال مفتوحا امام القضاء الدستوري من أجل تصحيح ما يمكن تصحيحه في هذا المشروع قانون التنظيمي الذي تضمن العديد من التراجعات التي تمس بالحق في الاضراب كأحد أهم الحقوق والحريات التي يجب ضمانها واحترامها وحمايتها من طرف الدولة.
الدكتور خالد الادريسي
محامي بهيئة المحامين بالرباط
محامي بهيئة المحامين بالرباط