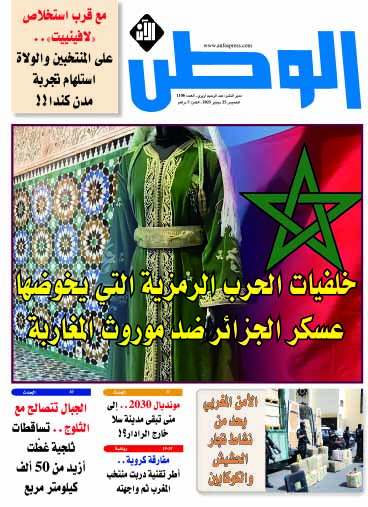مِزْهَراً كان يسْخَرُ من جُرحِ
[1] نَعْيٌ:
* يوم 25 دجنبر ليلاً، رنَّ الهاتف، لاح اسم الصّديق عبد المالك أبو تراب، حيّاني بصوت مجروح، وأردف:
هو ـ عزاؤنا واحد في صديقنا الشاعر،
أنا ـ وأخيرا هَزَمَ الموتُ الجسَدَ المقاومَ بعدما عجَزً عن هَزْمِ القصيدة.
هو ـ سأبعث إليك برقم ابنه الدكتور غسان الذي ينتهي بـ 4224، إذا رغبت في تعزية الأسرة المكلومة...
أنا ـ رحم الله السّي محمد عنيبة الحمري شاعرا أبيّاً، كبيرَ القلب، لم تُغرِهِ شُهْرةٌ، ولم تُرهبْهُ سلطةٌ، فظلّ مخلصاً لنقائه إخلاصَهُ لشعره.
[2]كيف عرفتُ عنيبة قبل أن ألتقي بشخصه الكريم؟ حدث ذلك ذات أصيل شتويّ سنة 1969 وأنا أستمع للمذيع المتألق أحمد الرّيفي في برنامج ثقافي كانت تبثه إذاعة فاس الجهوية، وهو يقدّم مجموعة "الحبّ مهزلة القرون" مقارناً بينها وبين بعض نصوص نزار قباني. كان عنيبة آنذاك طالبا في سنته الأخيرة بقلعة ظهر المهراز، بينما كنتُ أنا تلميذا في قسم الباكلوريا قبل سنة تماما من الانتساب لنفس الكلية. شغلني اسم الشاعر وما قيل عن ديوانه، وإن كنا لم نلتق إلا في أوّل مؤتمر حضرتُه لاتحاد كتاب المغرب، ثم توالت اللقاءات في مهرجانات ومناسبات كثيرة في مدن مختلفة.
[3] إحصائيا، أظنّ أنّ إصدار الشّاعر لثمانية دواوين شعرية في حوالي ستين سنة من الإبداع مؤشّرٌ يوضّحُ أنه كان ينشُرُ ديوانا واحدا كل سبع سنوات ونصف، وهو معدل يبيّنُ أنه لم يكن شاعرا مقلاً بالقياس إلى تواتر إصدارات شعراء جيله، لكنه في نفس الآن لا يدلّ على إسهال، مما يؤكد جدّيته، وتعامله بصرامة مع النصوص التي كان ينشرها، إذ لا يسمح بما يصدر عفو الخاطر إلا بعد إخضاعه للغربلة والتنقيح والتحكيك، لبلوغ مرحلة الرضا عن قيمته الفنية، قبل إرضاء متلقٍّ افتراضي لا يتساهل في رسم أفق انتظاره وتفاصيل ملامحه، ويريده أن يجتهد في التّحليق لإدراك استعاراته البللورية، مخيّباً بذلك انتظار متلقّين آخرين ينتظرون نصّاً مُستنسَخاً على مقاسِهم، سواء أكان تقليديا ذا تضاريس عارية منبسطة، أو نصّاً حداثياً خطيرَ المنعرجات، عويصَ التضاريس.
[4] إنّ تأمّل إصدارات الفقيد ليؤكّد أنّ تجربته تطوّرتْ في ثلاث مراحل:
أولاها مرحلة البدايات التي عرفتْ اهتماما ملحوظا بمواضيع عاطفية تنصتُ لنبضاتِ القلبِ حتّى وهي تعارضُ شعرَ المرأة أحيانا، وقد اختتمها باعترافه للمرأة التي عذبته وألهمته منذ نعومة أظفاره بكون (حديث الحبّ أضحى بعض مهزلة) من مهازله.
كانت هذه المعارضة الغزلية وعداً صادقاً بالانتقال إلى مرحلة ثانية تتميز بواقعيةٍ لا تخلو من لمساتٍ رومانسية، بدأت بـ "مرثية للمصلوبين" وامتدت إلى "داء الأحبة"، وذلك انعكاساً لما كان يكتوي به الشّاعر ومحيطه من لهيب سنوات الرّصاص من جهة، ونتيجةً أيضا للإنصات لتوجيهات تلقّيه وعدم ترحيبه بما يكتبه الشاعر من شعر عاطفي، ولومه على نزوعه الذّاتيّ.
وحسبي أن هذا النقد الذي لم ينسه عنيبة كان فاتحة خير هدتْهُ إلى تغيير أساليبه ورؤيته منتقلا إلى مرحلة ثالثة دشنها بمجموعة "سمّ هذا البياض". وهو بياضٌ منفتحٌ على بلاغةِ الإيجاز، وتكثيفِ اللغة الشعرية، والبحثِ الدّؤوب عن وسائطَ شعرية جديدة لتطوير الإيقاعِ، والتقاطِ صورٍ غنيةٍ بالدّلالات، ونحتِ رموزٍ صوفيةٍ تنعطفُ بالقصيدة إلى ما يشبه الشذرة. هذا التحوّل هو الذي استطاع أن يكشف لديهِ عن حداثةٍ تشيّدُ جسراً لعبورِ الأجيال، وشموخِ شاعرٍ دائبِ الحركةِ لا يستلذّ الاستكانة في مواقع البدايات الدافئة في أواخر ستينيات القرن الماضي، وهذا ديدنُ كلّ عظيم كما يصفُهُ "كتاب الطّاو":
فما صار البحرُ مَصَبَّ أنهارٍ شتّى
إلا بما احتشدَ لديهِ من دفْقِ الجريان (كتاب الطاو، ص 130)
[5] ورغبة في الاقتراب أكثر من تجربة عنيبة، فإنني أقترح أربع شرفاتٍ عالية لتيسير رؤيتها وهي: الميتاشعر، وثيمة الموت، والموقف من التجريب، والاستشراف:
5 ـ 1 ـ من الملاحظ أن الشّاعر اهتم في نصوصه الأخيرة بإنتاج خطاب حول الشعر باللغة الشعرية ذاتها لم تعرفْهُ مجاميعُهُ السابقة بنفس الكثافة، إذ لم يعد التفكير في الشعر خطابا يقتصر على المقالة النقدية أو الدراسة الأدبية فقط، بل تجاوز حدوده المرسومة عادة لخطاب تقريري يعالج قضايا مختلفة بلغة نثرية، إلى الاتساع في النص الشعري نفسه. وهذا الخطاب إن كان يحرّم الاقتراب من الوظيفة المرجعية تفاديا لإفساد أناقة الشّعر وروائه، فإنّه غالباً ما يرتمي في أحضان الوظيفة النّدائية التي تُشركُ متلقّي الشّعر في تأمّل نظري يخصّ الشّاعر، حتى وهو غيرُ مستعدٍّ للنّبش في المسألة الشعرية، أو التجوّل في مسالك نظرية الأدب. يقول في أحد نصوصه مثلا:
أنتَ من قد أساءَ
اختيارَ المدادِ
وجنسَ الورَقْ
إذ تدعونا الحكمةُ الميتاشعرية على لسان الشاعر، إلى الكفّ عن لوْم الغبار الذي يعكّر صفاء النصّ، ويساهم في إفقاره ومحوه شعريا، أو تقريع الرّيح على ما اقترفته في حق كلماته وأوراقه، والالتفات إلى الفاعل الحقيقي المسؤول عن العبث بالقصيدة الذي يستحق اللوم وحده، ألا وهو الشاعر.
5 ـ 2 ـ من جانب آخر، لم يهتمّ عنيبة بثيمات الحب والواقع وتأمل الوجود وتأمل الكتابة فقط، بل اهتم أيضا بثيمة الموت. وكيف لا يهتم شعريا بهذا الموضوع مع أنه كان من أهمّ الخلجان التي سبح فيها دون أن يوفّيه نقاده حقّ قدره؟ فقد سلّط الضوء على مصائر الشعراء وحيواتهم الغريبة، في كتابه "إعدام الشعراء" الذي يجسّدُ ما عانوه من قهر الحكام وذوي النفوذ، ويؤكد مرة أخرى أن هذه العلاقة أشبه ما تكون بعلاقة الأنبياء بالحكّام. والثاني كتابه "حينما يخطئ الموت طريقه" الذي يختلف عن الأوّل اختلاف الخطأ القدري الحتمي عن قهر الطغيان، لكنّه يشترك معه في دلالة الفقدان. وفي الحالتين معا يتأكد أن الموت المفكر فيه سرديا في سير الشعراء بأسلوب نثري، هو نفسه الموت المفكر فيه جماليا على جناحي شعر مسربلٍ بلبوسٍ شفّافٍ تطرّزُهُ الرّموز والاستعارات.
5 ـ 3 ـ لم يكتب عنيبة، حسب علمي، قصيدة النثر، ومع ذلك لم يتخذ موقفا متطرفا منها، بل كان موقفه منها هو موقفه من أي تيّار تجريبي ينصح من يُقدم على اقتحامه بالمعرفة التي ينبغي أن يتأسّس عليها كلُّ تجريب أو تجديد أو تحديث. إيماناً منهُ بأنّ كلّ هدْم يحتاج إلى دراية بما يُراد هدمه أو بناؤه، ذلك أن (الذي يريد تفجيرَ عمارة يجب عليه الإلمام ببنيتها وهندستها، إذ لا يتم الهدم من فراغ)، وكما يحتاجُ الهدمُ إلى معرفة فالبناء يحتاج أيضا إلى معرفة. وبنفس الوعي والتروي عبّر عنيبة عن نية تطوير تجربته في أكثر من مناسبة، قائلا: إنه "كلّما كتبتُ نصا اعتبرته تسويدا لنص مقبل، وأشعر بأنني لم أكتب النص المأمول بعد". وهذا يدلّ بوضوح على أنه لم يكن يقنع بما يتحقق له رغم قيمته الفنية التي لا تخفى، بل كان يطمح باستمرار إلى كتابة الأبهى والأجمل. وحسبي أنّ هذا التّهيّب إن هو إلا تواضع شاعرٍ يموّهُ الإقدام والشّجاعة بالحيطة والأناة إسوةً بداهية الحرْب الذي يتغنّى بحكمته الطاوية:
لا طاقةَ لي بالهجوم،
فإنما أنا متعيّنٌ بالموقفِ الدّفاعيّ،
وإنّهُ أهونُ عليّ أنْ أنسحِبَ ذراعاً
من أن أتقدّم شبراً واحدا (كتاب الطاو، ص 135)
5 ـ 4 ـ هل كان الشاعر يُرهصُ بالمستقبل، ويستشرفُ النّهايات، بعد أن أدرك أنّ كلّ المحاولات لا تسعفْهُ على تمديد الإقامة في عالم كاذب منافق؟ لقد آمن فقيدُنا بأنّ الحضورَ بالفعلِ لا يحقّقه وجودُ حيّزِ الجسَدِ الصّوريّ في فضاء العالم وحده، وما أكثرَ الأجسادَ التي تملأ الفضاءَ دونَ أنْ تحضرَ حضورا حافلا بالثراء الرّمزي والامتلاء النّورانيّ، من هنا كان إشعاعُ القصيدة وتلألُؤُها حضوراً غامراً يعوّضُ ما يُفتقدُ مادّياً. أولم ينصحْ عنيبة في نصّ له يتأمّلُ صيرورة الزمان، بضرورة توفير لحظة فرح بنبرة خيامية أبيقورية تُغني عن القرون العجفاء، وعدم الاهتمام بالعمرِ وتخومِ أمدائه؟ ألم يكنِ الشّاعرُ طوال حياته مِزْهراً يعرفُ كيف يسخَرُ من جرحه بمعانقة النّغم للكلمة؟
إنّ الزمان لا يُحدِث فراغاً في ذاته ولا فراغا في الروح، وإنما الفراغُ بالفعل هو ما يحدُثُ لمادة الجسَدِ الذي يتوجّبُ ملؤه بالكتابة، وكأنّي بالشاعر يسلّمُ ضمنيا بأنّ ما يدوّنه من كلمات يخلّدُ بهجةً قصوى يعتبرها أغنى كنز وأخلدَ عُمُرٍ، أعني أوفى وجودٍ يملأ الفراغ ويخلّصُهُ من زمانٍ فلكيٍّ محدودٍ لكي يسبحَ في المطلق. وهكذا تكون رؤيا الشاعر الرائي التي لا تخطئ وهي تقلِبُ الموازين وتحوّل الأشياءَ في خيميائها؟
[6] الصّورة المنقوشة في ذاكرتي للشاعر محمد عنيبة الحمري ظلت تجلّلُها ألوانٌ وأطيافٌ توحي بأنه شاعر خلوق متعفّف، يعتز بنفسه، ويعتبر كرامته مقدسا فوق كل اعتبار، ينأى بها عما يخدش نصاعتها. لذلك ظل بعيدا عن القطيع، في مأمن من الغرق في مستنقع القبيلة، أو المشاركة في عنف الميليشيات المفترسة، سواء أكانت سياسية أو ثقافية. غير أن ثمن خيارٍ مثل هذا الخيار الصّعب ثمنٌ باهظ طالما حزّ في نفسه، وتجلّتْ معاناته في شعره وفي دردشته مع الأصفياء، ومع ذلك لم تحملْهُ آثارُ الأذى على تغيير موقفه مهادنةً للنّقيض الذي يبغضُهُ، وهذا يتّضح في تبرّمه من النقد السّائد الذي يطبعُهُ طابعُ المجاملة والمداهنة والمصالح المتبادلة، مما يتسبّبُ في التّهميش والإقصاء لمن يتسامى مُسْتقِلاً برأيه مثل شاعرنا الذي لم يعرفِ النّفاقُ إلى قلبه طريقاً، ولم يكنْ مستعدّا (لا للتوسّل، ولا للتسوّل) كما عبّر في حواره مع الشاعر عبد اللطيف الوراري.
[7] لقطات دالة:
7 ـ 1 ـ لقطة مُتواترة في كل لقاء:
كلّما اشتدّ النقاشُ حول موضوع الثقافة المغربية، تدخّلَ عنيبة بعد صمتٍ حكيم:
ـ نهاية الكلام: لهم غزالةٌ مقهورة في السيرك، ولنا غزالةٌ طليقةٌ في الغاب، وعلى الأرض السلام.
7 ـ 2 ـ لقطة قديمة من إيموزار:
ذات سَمَرٍ دافئ في ليلة قارسة من ليالي إيموزار الشّتوية، بمناسبة مهرجان شعريّ رائع سنة 2008، قال لي عنيبة في حديقةٍ معلّقةٍ تكللها أشجار الأرز، تحت سماءٍ أطلسيةٍ تزركشها النجوم:
ـ كبرنا يا علال... ردَدْتُ مبتسماً للشّوق للإبحار:
ـ عزاؤنا يا السّي محمّد أننا لا نزالُ نحبُّ الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا...
بحرارة قرعْنا الجمرة بالجمرة نكايةً بالثّلج، قبل أن يردّ مازحاً وهو يُربّتُ على كتِفِ بوجمعة مستفزّاً:
ـ الحمدُ لله على نعمةِ الشّعر أيّها الصّعلوك... والشّعر ما سطرَهُ سَدَنَةُ الخزانات العامرة في السّبعينيات، لا ما لَها بهِ فتيانُ الفايسبوك، أليس كذلك يا بوجمعة؟ لم يتمالكْ أشفري نفسَهُ. ضمّنا إليهِ معا، وهو يقهقِهُ:
ـ حديث ومغزل... لنَجْنِ عناقيدَ البهجةِ في محبّة ديونيزوس.
7 ـ 3 ـ لقطة أقدم من مكناس:
ثمة لحظات هاربة من ميعة الشباب تستعيدُ بعضاً من إشراقات مكناس ذاتَ مهرجان سنة 1976. وإن أنسَ لا أنسَ ونحن ننتظر الغذاء في بيت مضيفنا المرحوم الصفندلة، كيف استجمع السّي محمد رزانته وحدّق فيّ جادا وهو يتساءلُ:
ــ هل اتّصلَ بكَ طالبٌ مكناسيٌّ يهيئ بحث السنة الرّابعة حول ديوان "الحلم في نهاية الحداد"؟
أدركتُ مقلبَ دعابته، فما كان منّي إلا أن أفاجئه ضاحكاً وأنا أردُّ التحيةَ بما يناسبُها، وقد تذكّرتُ ديوانه "الشوق للإبحار" الذي بعث لي منه بعشرين نسخة قصدَ توزيعها في قصر السوق:
ــ لا شكّ أنّ صديقه البيضاويّ الذي يُعد الدكتوراه حول ديوانك الأخير هو الذي أخبرَكَ بالأمر أيها العزيز... لم يتمالكْ نفسَهُ فانفجر مقهقها قهقهته الأثيرة وهو يعانقني. ومنذئذ أصبحت هذه الدّعابة لازمة تتكرّر كلما التقينا...
الشهادة قدمت ضمن فعاليات التأبين الذي نظمه المركز المغربي للثقافة والإبداع ـ فرع مكناس ـ يوم السبت 08 أكتوبر 2025 بالمعهد الموسيقي/مكناس.
لاو تسي: كتاب الطاو، ترجمة محسن فرجاني، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة 2017
[1] نَعْيٌ:
* يوم 25 دجنبر ليلاً، رنَّ الهاتف، لاح اسم الصّديق عبد المالك أبو تراب، حيّاني بصوت مجروح، وأردف:
هو ـ عزاؤنا واحد في صديقنا الشاعر،
أنا ـ وأخيرا هَزَمَ الموتُ الجسَدَ المقاومَ بعدما عجَزً عن هَزْمِ القصيدة.
هو ـ سأبعث إليك برقم ابنه الدكتور غسان الذي ينتهي بـ 4224، إذا رغبت في تعزية الأسرة المكلومة...
أنا ـ رحم الله السّي محمد عنيبة الحمري شاعرا أبيّاً، كبيرَ القلب، لم تُغرِهِ شُهْرةٌ، ولم تُرهبْهُ سلطةٌ، فظلّ مخلصاً لنقائه إخلاصَهُ لشعره.
[2]كيف عرفتُ عنيبة قبل أن ألتقي بشخصه الكريم؟ حدث ذلك ذات أصيل شتويّ سنة 1969 وأنا أستمع للمذيع المتألق أحمد الرّيفي في برنامج ثقافي كانت تبثه إذاعة فاس الجهوية، وهو يقدّم مجموعة "الحبّ مهزلة القرون" مقارناً بينها وبين بعض نصوص نزار قباني. كان عنيبة آنذاك طالبا في سنته الأخيرة بقلعة ظهر المهراز، بينما كنتُ أنا تلميذا في قسم الباكلوريا قبل سنة تماما من الانتساب لنفس الكلية. شغلني اسم الشاعر وما قيل عن ديوانه، وإن كنا لم نلتق إلا في أوّل مؤتمر حضرتُه لاتحاد كتاب المغرب، ثم توالت اللقاءات في مهرجانات ومناسبات كثيرة في مدن مختلفة.
[3] إحصائيا، أظنّ أنّ إصدار الشّاعر لثمانية دواوين شعرية في حوالي ستين سنة من الإبداع مؤشّرٌ يوضّحُ أنه كان ينشُرُ ديوانا واحدا كل سبع سنوات ونصف، وهو معدل يبيّنُ أنه لم يكن شاعرا مقلاً بالقياس إلى تواتر إصدارات شعراء جيله، لكنه في نفس الآن لا يدلّ على إسهال، مما يؤكد جدّيته، وتعامله بصرامة مع النصوص التي كان ينشرها، إذ لا يسمح بما يصدر عفو الخاطر إلا بعد إخضاعه للغربلة والتنقيح والتحكيك، لبلوغ مرحلة الرضا عن قيمته الفنية، قبل إرضاء متلقٍّ افتراضي لا يتساهل في رسم أفق انتظاره وتفاصيل ملامحه، ويريده أن يجتهد في التّحليق لإدراك استعاراته البللورية، مخيّباً بذلك انتظار متلقّين آخرين ينتظرون نصّاً مُستنسَخاً على مقاسِهم، سواء أكان تقليديا ذا تضاريس عارية منبسطة، أو نصّاً حداثياً خطيرَ المنعرجات، عويصَ التضاريس.
[4] إنّ تأمّل إصدارات الفقيد ليؤكّد أنّ تجربته تطوّرتْ في ثلاث مراحل:
أولاها مرحلة البدايات التي عرفتْ اهتماما ملحوظا بمواضيع عاطفية تنصتُ لنبضاتِ القلبِ حتّى وهي تعارضُ شعرَ المرأة أحيانا، وقد اختتمها باعترافه للمرأة التي عذبته وألهمته منذ نعومة أظفاره بكون (حديث الحبّ أضحى بعض مهزلة) من مهازله.
كانت هذه المعارضة الغزلية وعداً صادقاً بالانتقال إلى مرحلة ثانية تتميز بواقعيةٍ لا تخلو من لمساتٍ رومانسية، بدأت بـ "مرثية للمصلوبين" وامتدت إلى "داء الأحبة"، وذلك انعكاساً لما كان يكتوي به الشّاعر ومحيطه من لهيب سنوات الرّصاص من جهة، ونتيجةً أيضا للإنصات لتوجيهات تلقّيه وعدم ترحيبه بما يكتبه الشاعر من شعر عاطفي، ولومه على نزوعه الذّاتيّ.
وحسبي أن هذا النقد الذي لم ينسه عنيبة كان فاتحة خير هدتْهُ إلى تغيير أساليبه ورؤيته منتقلا إلى مرحلة ثالثة دشنها بمجموعة "سمّ هذا البياض". وهو بياضٌ منفتحٌ على بلاغةِ الإيجاز، وتكثيفِ اللغة الشعرية، والبحثِ الدّؤوب عن وسائطَ شعرية جديدة لتطوير الإيقاعِ، والتقاطِ صورٍ غنيةٍ بالدّلالات، ونحتِ رموزٍ صوفيةٍ تنعطفُ بالقصيدة إلى ما يشبه الشذرة. هذا التحوّل هو الذي استطاع أن يكشف لديهِ عن حداثةٍ تشيّدُ جسراً لعبورِ الأجيال، وشموخِ شاعرٍ دائبِ الحركةِ لا يستلذّ الاستكانة في مواقع البدايات الدافئة في أواخر ستينيات القرن الماضي، وهذا ديدنُ كلّ عظيم كما يصفُهُ "كتاب الطّاو":
فما صار البحرُ مَصَبَّ أنهارٍ شتّى
إلا بما احتشدَ لديهِ من دفْقِ الجريان (كتاب الطاو، ص 130)
[5] ورغبة في الاقتراب أكثر من تجربة عنيبة، فإنني أقترح أربع شرفاتٍ عالية لتيسير رؤيتها وهي: الميتاشعر، وثيمة الموت، والموقف من التجريب، والاستشراف:
5 ـ 1 ـ من الملاحظ أن الشّاعر اهتم في نصوصه الأخيرة بإنتاج خطاب حول الشعر باللغة الشعرية ذاتها لم تعرفْهُ مجاميعُهُ السابقة بنفس الكثافة، إذ لم يعد التفكير في الشعر خطابا يقتصر على المقالة النقدية أو الدراسة الأدبية فقط، بل تجاوز حدوده المرسومة عادة لخطاب تقريري يعالج قضايا مختلفة بلغة نثرية، إلى الاتساع في النص الشعري نفسه. وهذا الخطاب إن كان يحرّم الاقتراب من الوظيفة المرجعية تفاديا لإفساد أناقة الشّعر وروائه، فإنّه غالباً ما يرتمي في أحضان الوظيفة النّدائية التي تُشركُ متلقّي الشّعر في تأمّل نظري يخصّ الشّاعر، حتى وهو غيرُ مستعدٍّ للنّبش في المسألة الشعرية، أو التجوّل في مسالك نظرية الأدب. يقول في أحد نصوصه مثلا:
أنتَ من قد أساءَ
اختيارَ المدادِ
وجنسَ الورَقْ
إذ تدعونا الحكمةُ الميتاشعرية على لسان الشاعر، إلى الكفّ عن لوْم الغبار الذي يعكّر صفاء النصّ، ويساهم في إفقاره ومحوه شعريا، أو تقريع الرّيح على ما اقترفته في حق كلماته وأوراقه، والالتفات إلى الفاعل الحقيقي المسؤول عن العبث بالقصيدة الذي يستحق اللوم وحده، ألا وهو الشاعر.
5 ـ 2 ـ من جانب آخر، لم يهتمّ عنيبة بثيمات الحب والواقع وتأمل الوجود وتأمل الكتابة فقط، بل اهتم أيضا بثيمة الموت. وكيف لا يهتم شعريا بهذا الموضوع مع أنه كان من أهمّ الخلجان التي سبح فيها دون أن يوفّيه نقاده حقّ قدره؟ فقد سلّط الضوء على مصائر الشعراء وحيواتهم الغريبة، في كتابه "إعدام الشعراء" الذي يجسّدُ ما عانوه من قهر الحكام وذوي النفوذ، ويؤكد مرة أخرى أن هذه العلاقة أشبه ما تكون بعلاقة الأنبياء بالحكّام. والثاني كتابه "حينما يخطئ الموت طريقه" الذي يختلف عن الأوّل اختلاف الخطأ القدري الحتمي عن قهر الطغيان، لكنّه يشترك معه في دلالة الفقدان. وفي الحالتين معا يتأكد أن الموت المفكر فيه سرديا في سير الشعراء بأسلوب نثري، هو نفسه الموت المفكر فيه جماليا على جناحي شعر مسربلٍ بلبوسٍ شفّافٍ تطرّزُهُ الرّموز والاستعارات.
5 ـ 3 ـ لم يكتب عنيبة، حسب علمي، قصيدة النثر، ومع ذلك لم يتخذ موقفا متطرفا منها، بل كان موقفه منها هو موقفه من أي تيّار تجريبي ينصح من يُقدم على اقتحامه بالمعرفة التي ينبغي أن يتأسّس عليها كلُّ تجريب أو تجديد أو تحديث. إيماناً منهُ بأنّ كلّ هدْم يحتاج إلى دراية بما يُراد هدمه أو بناؤه، ذلك أن (الذي يريد تفجيرَ عمارة يجب عليه الإلمام ببنيتها وهندستها، إذ لا يتم الهدم من فراغ)، وكما يحتاجُ الهدمُ إلى معرفة فالبناء يحتاج أيضا إلى معرفة. وبنفس الوعي والتروي عبّر عنيبة عن نية تطوير تجربته في أكثر من مناسبة، قائلا: إنه "كلّما كتبتُ نصا اعتبرته تسويدا لنص مقبل، وأشعر بأنني لم أكتب النص المأمول بعد". وهذا يدلّ بوضوح على أنه لم يكن يقنع بما يتحقق له رغم قيمته الفنية التي لا تخفى، بل كان يطمح باستمرار إلى كتابة الأبهى والأجمل. وحسبي أنّ هذا التّهيّب إن هو إلا تواضع شاعرٍ يموّهُ الإقدام والشّجاعة بالحيطة والأناة إسوةً بداهية الحرْب الذي يتغنّى بحكمته الطاوية:
لا طاقةَ لي بالهجوم،
فإنما أنا متعيّنٌ بالموقفِ الدّفاعيّ،
وإنّهُ أهونُ عليّ أنْ أنسحِبَ ذراعاً
من أن أتقدّم شبراً واحدا (كتاب الطاو، ص 135)
5 ـ 4 ـ هل كان الشاعر يُرهصُ بالمستقبل، ويستشرفُ النّهايات، بعد أن أدرك أنّ كلّ المحاولات لا تسعفْهُ على تمديد الإقامة في عالم كاذب منافق؟ لقد آمن فقيدُنا بأنّ الحضورَ بالفعلِ لا يحقّقه وجودُ حيّزِ الجسَدِ الصّوريّ في فضاء العالم وحده، وما أكثرَ الأجسادَ التي تملأ الفضاءَ دونَ أنْ تحضرَ حضورا حافلا بالثراء الرّمزي والامتلاء النّورانيّ، من هنا كان إشعاعُ القصيدة وتلألُؤُها حضوراً غامراً يعوّضُ ما يُفتقدُ مادّياً. أولم ينصحْ عنيبة في نصّ له يتأمّلُ صيرورة الزمان، بضرورة توفير لحظة فرح بنبرة خيامية أبيقورية تُغني عن القرون العجفاء، وعدم الاهتمام بالعمرِ وتخومِ أمدائه؟ ألم يكنِ الشّاعرُ طوال حياته مِزْهراً يعرفُ كيف يسخَرُ من جرحه بمعانقة النّغم للكلمة؟
إنّ الزمان لا يُحدِث فراغاً في ذاته ولا فراغا في الروح، وإنما الفراغُ بالفعل هو ما يحدُثُ لمادة الجسَدِ الذي يتوجّبُ ملؤه بالكتابة، وكأنّي بالشاعر يسلّمُ ضمنيا بأنّ ما يدوّنه من كلمات يخلّدُ بهجةً قصوى يعتبرها أغنى كنز وأخلدَ عُمُرٍ، أعني أوفى وجودٍ يملأ الفراغ ويخلّصُهُ من زمانٍ فلكيٍّ محدودٍ لكي يسبحَ في المطلق. وهكذا تكون رؤيا الشاعر الرائي التي لا تخطئ وهي تقلِبُ الموازين وتحوّل الأشياءَ في خيميائها؟
[6] الصّورة المنقوشة في ذاكرتي للشاعر محمد عنيبة الحمري ظلت تجلّلُها ألوانٌ وأطيافٌ توحي بأنه شاعر خلوق متعفّف، يعتز بنفسه، ويعتبر كرامته مقدسا فوق كل اعتبار، ينأى بها عما يخدش نصاعتها. لذلك ظل بعيدا عن القطيع، في مأمن من الغرق في مستنقع القبيلة، أو المشاركة في عنف الميليشيات المفترسة، سواء أكانت سياسية أو ثقافية. غير أن ثمن خيارٍ مثل هذا الخيار الصّعب ثمنٌ باهظ طالما حزّ في نفسه، وتجلّتْ معاناته في شعره وفي دردشته مع الأصفياء، ومع ذلك لم تحملْهُ آثارُ الأذى على تغيير موقفه مهادنةً للنّقيض الذي يبغضُهُ، وهذا يتّضح في تبرّمه من النقد السّائد الذي يطبعُهُ طابعُ المجاملة والمداهنة والمصالح المتبادلة، مما يتسبّبُ في التّهميش والإقصاء لمن يتسامى مُسْتقِلاً برأيه مثل شاعرنا الذي لم يعرفِ النّفاقُ إلى قلبه طريقاً، ولم يكنْ مستعدّا (لا للتوسّل، ولا للتسوّل) كما عبّر في حواره مع الشاعر عبد اللطيف الوراري.
[7] لقطات دالة:
7 ـ 1 ـ لقطة مُتواترة في كل لقاء:
كلّما اشتدّ النقاشُ حول موضوع الثقافة المغربية، تدخّلَ عنيبة بعد صمتٍ حكيم:
ـ نهاية الكلام: لهم غزالةٌ مقهورة في السيرك، ولنا غزالةٌ طليقةٌ في الغاب، وعلى الأرض السلام.
7 ـ 2 ـ لقطة قديمة من إيموزار:
ذات سَمَرٍ دافئ في ليلة قارسة من ليالي إيموزار الشّتوية، بمناسبة مهرجان شعريّ رائع سنة 2008، قال لي عنيبة في حديقةٍ معلّقةٍ تكللها أشجار الأرز، تحت سماءٍ أطلسيةٍ تزركشها النجوم:
ـ كبرنا يا علال... ردَدْتُ مبتسماً للشّوق للإبحار:
ـ عزاؤنا يا السّي محمّد أننا لا نزالُ نحبُّ الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا...
بحرارة قرعْنا الجمرة بالجمرة نكايةً بالثّلج، قبل أن يردّ مازحاً وهو يُربّتُ على كتِفِ بوجمعة مستفزّاً:
ـ الحمدُ لله على نعمةِ الشّعر أيّها الصّعلوك... والشّعر ما سطرَهُ سَدَنَةُ الخزانات العامرة في السّبعينيات، لا ما لَها بهِ فتيانُ الفايسبوك، أليس كذلك يا بوجمعة؟ لم يتمالكْ أشفري نفسَهُ. ضمّنا إليهِ معا، وهو يقهقِهُ:
ـ حديث ومغزل... لنَجْنِ عناقيدَ البهجةِ في محبّة ديونيزوس.
7 ـ 3 ـ لقطة أقدم من مكناس:
ثمة لحظات هاربة من ميعة الشباب تستعيدُ بعضاً من إشراقات مكناس ذاتَ مهرجان سنة 1976. وإن أنسَ لا أنسَ ونحن ننتظر الغذاء في بيت مضيفنا المرحوم الصفندلة، كيف استجمع السّي محمد رزانته وحدّق فيّ جادا وهو يتساءلُ:
ــ هل اتّصلَ بكَ طالبٌ مكناسيٌّ يهيئ بحث السنة الرّابعة حول ديوان "الحلم في نهاية الحداد"؟
أدركتُ مقلبَ دعابته، فما كان منّي إلا أن أفاجئه ضاحكاً وأنا أردُّ التحيةَ بما يناسبُها، وقد تذكّرتُ ديوانه "الشوق للإبحار" الذي بعث لي منه بعشرين نسخة قصدَ توزيعها في قصر السوق:
ــ لا شكّ أنّ صديقه البيضاويّ الذي يُعد الدكتوراه حول ديوانك الأخير هو الذي أخبرَكَ بالأمر أيها العزيز... لم يتمالكْ نفسَهُ فانفجر مقهقها قهقهته الأثيرة وهو يعانقني. ومنذئذ أصبحت هذه الدّعابة لازمة تتكرّر كلما التقينا...
الشهادة قدمت ضمن فعاليات التأبين الذي نظمه المركز المغربي للثقافة والإبداع ـ فرع مكناس ـ يوم السبت 08 أكتوبر 2025 بالمعهد الموسيقي/مكناس.
لاو تسي: كتاب الطاو، ترجمة محسن فرجاني، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة 2017
الأديب الدكتور علال الحجام .