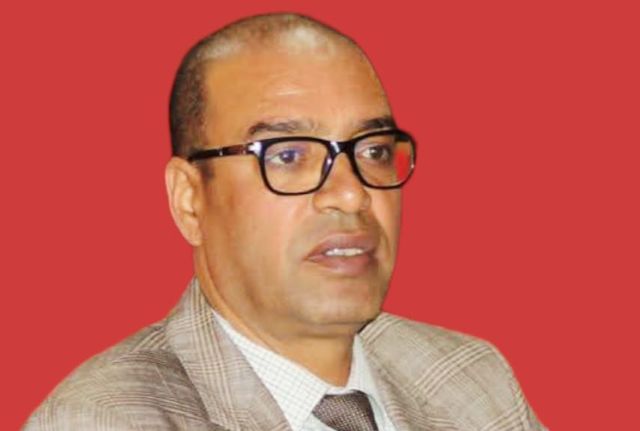مقدمة:
تم إقرار التأمين الإجباري على السيارات في المغرب (والذي يُعرف قانوناً بـ "التأمين الإجباري لتغطية المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك") بموجب: الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.69.100 الصادر بتاريخ 8 شعبان 1389 (الموافق 20 أكتوبر 1969).الذي ألزم مالكي العربات بضرورة التوفر على تأمين لتغطية الأضرار التي قد يسببونها للغير (المسؤولية المدنية).
لاحقاً، تم نسخ مقتضيات ظهير 1969 ودمجها ضمن القانون رقم 17.99 المتعلق بـ "مدونة التأمينات"، الذي صدر في 3 أكتوبر 2002، وهو الذي ينظم قطاع التأمين بشكل شامل حالياً.
سياق إقرار ظهير 2 أكتوبر 1984:
كانت المحاكم المغربية، في دعاوى المسؤولية عن الاضرار الناتجة عن حوادث السير تطبق القاعد العامة لقانون الالتزامات والعقود وخصوص الفصول 77 و78 و88 منه. وكانت المحاكم تعتمد في تقدير التعويضات على الخبرة الطبية وعلى السلطة التقديرية الواسعة لقضاة الموضوع.
بدأ الحديث عن وضع إطار قانوني للحد من التعويضات الجزافية منذ سنة 1978، وتقدمت شركات التامين بعدة مذكرات ومشاريع في هذا الاتجاه. وعقدت وزارة العدل ندوات وطنية في بداية الثمانينات في الموضوع.
يُعتبر قانون 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير (المعروف بظهير 1984) نقطة تحول كبرى في النظام القانوني المغربي. لم يكن إصداره وليد صدفة، بل جاء كاستجابة لظروف اقتصادية وقانونية ضاغطة، كان هدفها الأساسي هو إنقاذ قطاع التأمين من الانهيار.
الظروف الاقتصادية (السبب الرئيسي):
الدافع الأكثر إلحاحاً لإصدار هذا القانون كان الأزمة المالية الحادة التي كان يمر بها قطاع التأمين في المغرب في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.
خطر الإفلاس:قبل عام 1984، كان تحديد التعويضات عن حوادث السير يخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية (الفصل 77 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود). هذا الأمر كان يترك للسلطة التقديرية للقضاة تحديد مبالغ التعويض، والتي كانت في كثير من الأحيان مرتفعة جداً وغير متوقعة.
إثقال كاهل الشركات:أدت هذه التعويضات المرتفعة إلى إثقال كاهل شركات التأمين بشكل كبير، حيث فاقت قيمة التعويضات المدفوعة قدرتها المالية.
انهيار شركات:تشير المصادر إلى أن هذا الوضع الاقتصادي الحرج أدى بالفعل إلى إفلاس ما لا يقل عن خمس شركات تأمين في تلك الفترة. أصبح القطاع بأكمله مهدداً بالانهيار، وهو ما يمثل خطراً اقتصادياً كبيراً للدولة.
الظروف القانونية والسياسية (الحل)
أمام هذا الوضع الاقتصادي المتأزم، كان التدخل السياسي والقانوني ضرورياً لضمان استمرارية قطاع التأمين.
التدخل لإنقاذ القطاع :كان القرار السياسي هو حماية قطاع التأمين باعتباره ركيزة اقتصادية. تم عقد ندوات ومناقشات في أوائل الثمانينيات لبحث سبل الخروج من الأزمة، والتي أفضت إلى ضرورة وضع إطار قانوني جديد.
الانتقال من "التعويض القضائي" إلى "التعويض القانوني":كان الهدف القانوني هو "توحيد" و "تقنين" (Standardization) التعويضات. بدلاً من ترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي، جاء ظهير 1984 بجداول ومعايير حسابية دقيقة ومحددة سلفاً.
خلق توازن جديد:حاول القانون خلق "توازن" (وإن كان محل انتقاد اليوم) بين طرفين:
ضحايا الحوادث:بضمان حصولهم على تعويض بشكل شبه تلقائي وسريع نسبياً دون الدخول في إجراءات إثبات الخطأ المعقدة (إذ أقر القانون بالمسؤولية المفترضة).
شركات التأمين:بوضع سقف للتعويضات وجعلها متوقعة (Predictable)، مما يسمح لها بضبط ميزانياتها وتجنب الإفلاس.
لذلك يمكن تلخيص الظروف التي أدت إلى إصدار قانون 1984 بأنه كان "خطة إنقاذ" اقتصادية لقطاع التأمين، تم تنفيذها عبر أداة قانونية صارمة. فضل المشرّع آنذاك الاستقرار المالي لشركات التأمين على حساب منح تعويضات كاملة وعادلة (بالمفهوم القضائي) للضحايا، وهو السبب الذي يجعل هذا القانون اليوم، بعد أكثر من 40 عاماً، محل مطالبة واسعة بضرورة إصلاحه جذرياً لكونه أصبح "مُجحفاً" بحق الضحايا نظراً لربطه بجداول تعويضات أصبحت متجاوزة.
سياق طرح مشروع القانون الحالي:
إذا كان قانون 1984: كان تدخلاً "مالياً وتقنياً" ضرورياً لإنقاذ شركات التأمين من الإفلاس وضمان استقرار القطاع. فان تعديله هو مطلب "اجتماعي وحقوقي" ضروري لإنصاف الضحايا من قانون أصبح مجحفاً، ولتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومباشرة بعد إقرار هذا القانون وصدوره، بدأت المطالبات بتغييره، وعقدت عدة ندوات في هذا الاتجاه منذ المناظرة الوطنية التي عقدتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال نونبر 1986 بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، والتي عرضت ثلاثة مشاريع تعديل للقانون المذكور على ضوء تجربة تنفيذه، الي الندوة الدولية التي عقدتها هيئة المحامين بالدار البيضاء خلال شهير نونبر 2019، حول نفس الموضوع.
كما ان تأخر تنفيذ الاحكام الصادرة في الموضوع كان دائما موضوع عدة دوريات ومناقشات واحتجاجات.
طرح مشروع التعديل الحالي جاء ليصحح الوضع بعد تغير الظروف التي أدت لإقرار ظهير 1984.
1. الظرف الاقتصادي
في 1984 (ظرف الإنشاء):
الأزمة: كان قطاع التأمين على حافة الانهيار بسبب التعويضات المرتفعة وغير المتوقعة التي كانت تحكم بها المحاكم (وفقاً للسلطة التقديرية للقضاة).
الهدف:حماية شركات التأمين. كان الهدف هو وضع سقف للتعويضات وجعلها متوقعة (عبر جداول حسابية) لضمان الاستقرار المالي للقطاع وإنقاذه من الإفلاس.
حالياً (ظرف التعديل):
الاستقرار: قطاع التأمين اليوم يُعتبر قطاعاً مستقراً ومربحاً للغاية.
الأزمة (المعاكسة): الأزمة اليوم هي أزمة ضحايا لا يحصلون على تعويض عادل. الجداول الحسابية لعام 1984 أصبحت هزيلة جداً (زهيدة) ولا تتناسب إطلاقاً مع غلاء المعيشة والتكاليف الطبية الحقيقية وفقدان الدخل في 2025.
الهدف:حماية الضحايا. الهدف هو تحيين (تحديث) مبالغ التعويض لتعكس الواقع الاقتصادي الحالي وضمان تعويض "جابر للضرر".
2. الظرف القانوني والحقوقي
في 1984 (ظرف الإنشاء):
الفراغ القانوني: كان الاعتماد على القواعد العامة للمسؤولية المدنية (قانون الالتزامات والعقود) يسبب تبايناً كبيراً في الأحكام.
الهدف:التوحيد والتقنين. كان الهدف هو إيجاد آلية قانونية سريعة وموحدة (Standardization) لتصفية الملفات، حتى لو كان ذلك على حساب التعويض العادل.
حالياً (ظرف التعديل):
التطور الدستوري: السياق القانوني تغير جذرياً بوجود دستور 2011. أصبح قانون 1984 في نظر الكثيرين غير دستوري لأنه يمس بالحق في السلامة الجسدية والحق في التعويض العادل والكرامة الإنسانية (بسبب التعويضات الزهيدة).
الهدف:العدالة والإنصاف. الهدف لم يعد السرعة أو التوحيد فقط، بل تحقيق العدالة الاجتماعية وملاءمة القانون مع المبادئ الدستورية العليا.
3. الظرف الاجتماعي
في 1984 (ظرف الإنشاء):
التركيز: كان التركيز تقنياً ومالياً. البُعد الاجتماعي كان ثانوياً، والهم الأكبر هو استمرار عمل نظام التأمين.
حالياً (ظرف التعديل):
الضغط الاجتماعي: يوجد اليوم ضغط مجتمعي وحقوقي وقضائي (من محامين وقضاة وجمعيات) كبير. أصبح يُنظر للقانون على أنه "مجحف" و "لا إنساني"، لأنه يتجاهل أضراراً حقيقية (مثل الضرر النفسي، ضرر التمتع بالحياة) أو يعوضها بمبالغ رمزية.
الهدف:جبر الضرر الشامل. الهدف هو الاعتراف بجميع الأضرار التي تلحق بالضحية (المادية والمعنوية والنفسية) وتعويضها بشكل منصف.
هكذا اذن وبعد مرور أكثر من أربعين عاماً على صدور ظهير 1984، قدمت الحكومة المغربية مشروع القانون رقم 70.24 الذي يهدف إلى إصلاح شامل لمنظومة تعويض ضحايا حوادث السير.
جاء هذا المشروع في سياق ارتفاع حوادث السير بالمغرب، حيث سجلت سنة 2024 حوالي 655,360 حادثة، منها 143,293 حادثة جسمانية خلفت 4,024 وفاة، مع تعويضات بلغت 7.9 مليار درهم.
يأتي هذا الإصلاح استجابة لضرورات دستورية واقتصادية واجتماعية ملحة، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الضحايا وضمان استدامة قطاع التأمين. يستند المشروع إلى تقييم شامل للظهير القديم بمشاركة لجنة تقنية متخصصة ومختلف الفاعلين المعنيين من قضاة وهيئات تأمين وقطاعات حكومية.
الجوانب الإيجابية في مشروع القانون 70.24
أولاً: الرفع الجوهري لقيمة التعويضات
يشكل رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات أبرز مستجدات المشروع، حيث سيرتفع من 9,270 درهماً (المعتمد منذ 1998) إلى 14,270 درهماً، بزيادة قدرها 54% على خمس مراحل متتالية. هذه الزيادة من شأنها أن ترفع متوسط التعويضات بنسبة قد تصل إلى ٪33.7.
على سبيل المثال، ضحية في سن 24 سنة بنسبة عجز بدني قدره 20%، كان يحصل في ظل النظام الحالي على تعويض قدره 41,030 درهماً، سيرتفع تعويضه بعد الإصلاح إلى حوالي 61,001 درهم، أي بزيادة تقارب 49٪.
ثانياً: توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات
يقترح المشروع توسيع نطاق المستفيدين ليشمل فئات كانت مهمشة سابقاً.
الأبناء المكفولين والآباء الكافلين: انسجاماً مع مقتضيات مدونة الأسرة المغربية
الزوج العاجز عن الإنفاق: حماية للأزواج في وضعيات اجتماعية خاصة
الطلبة والمتدربون: في مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي
خريجو مؤسسات التكوين والتعليم العالي: الذين لم يحصلوا بعد على عمل
هذا التوسيع يعكس تطور المفهوم الاجتماعي للأسرة والعلاقات الأسرية في المجتمع المغربي.
ثالثاً: إقرار مبدأ حرية الإثبات
من المستجدات الجوهرية إقرار مبدأ حرية الإثبات فيما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضرر. هذا المبدأ يمكّن الفئات العاملة في القطاع غير المهيكل من إثبات دخلها الفعلي، بما في ذلك:
النساء العاملات في القطاع غير المنظم
الحرفيون وأصحاب المهن الحرة
العمال الموسميون
العمال اليوميون
هذا التوجه يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن تعويضاً عادلاً يعكس الواقع الاقتصادي للمتضررين.
رابعاً: إضافة مصروفات جديدة قابلة للاسترجاع
يقترح المشروع إضافة أصناف جديدة من المصاريف والنفقات القابلة للاسترجاع:
إصلاح أو استبدال الأجهزة التعويضية: التي أصبحت غير صالحة بسبب الحادث (كالنظارات، الأطراف الصناعية، الكراسي المتحركة)
تكاليف التحاليل الطبية: المرتبطة مباشرة بالإصابة
إلغاء السقف الأقصى: الذي كان محدداً سابقاً في 50% من قيمة بعض المصاريف.
خامساً: استثناء بعض التعويضات من تشطير المسؤولية
ينص المشروع على استثناء مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض المعنوي عن الوفاة من قاعدة تشطير المسؤولية عن الحادث. هذا يعني أن هذه التعويضات ستُدفع كاملة حتى لو كان المتوفى يتحمل جزءاً من المسؤولية عن الحادث، وهو توجه إنساني يراعي كرامة المتوفى وحقوق ذويه.
سادساً: مراجعة دورية للحدود
يستبدل المشروع النظام القديم المرتبط بالوظيفة العمومية بنظام ديناميكي مرن لتحديث الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد، مع إلزامية مراجعتها كل خمس سنوات. هذه الآلية تضمن استمرارية ملاءمة التعويضات مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية دون الحاجة إلى انتظار إصلاحات تشريعية جديدة.
سابعاً: توحيد وتنظيم آجال التقادم
يوحد المشروع مدة التقادم لطلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر لتصبح خمس سنوات بدلاً من سنتين، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه وبدء سريانه. هذا التمديد يمنح الضحايا وقتاً كافياً لممارسة حقوقهم، خاصة في الحالات المعقدة التي تتطلب وقتاً لتحديد مدى الضرر.
الجوانب السلبية والإشكاليات
أولاً: التنفيذ التدريجي قد يؤخر الاستفادة الكاملة
رغم أن الزيادة في الحد الأدنى للأجر تبلغ 54%، إلا أن تطبيقها على خمس مراحل متتالية يعني أن الضحايا لن يستفيدوا من التعويضات الكاملة إلا بعد عدة سنوات. هذا التأخير قد لا يواكب التضخم والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، مما يُضعف القيمة الحقيقية للتعويضات عند اكتمال التطبيق.
ثانياً: غياب نظام تعويضي محدد وموحد (Baremo)
على عكس النظام الإسباني الذي يعتمد على جداول تعويضية دقيقة ومفصلة (Baremo) محددة بموجب القانون 35/2015، والنظام الفرنسي الذي يوفر إطاراً واضحاً لتقييم الأضرار، لا يتضمن المشروع المغربي نظاماً تعويضياً محدداً وموحدا.
في إسبانيا، يحدد الـBaremo معدلات تعويضية يومية تتراوح بين 31.61 يورو للأيام العادية و105.35 يورو للأيام الشديدة، مع نظام نقاط دقيق لتقييم العجز الدائم. هذا الوضوح يقلل من النزاعات ويسرع إجراءات التعويض، بينما يبقى النظام المغربي معتمداً على التقدير القضائي المستند على الخبرات القضائية المأمور بها مما قد يؤدي إلى اختلافات كبيرة في التعويضات عن إصابات متماثلة بين محاكم المملكة.
ثالثاً: عدم تحديد سقف واضح للتعويض عن الأضرار المعنوية
بينما يحدد المشروع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات المادية، إلا أنه لا يتضمن معايير واضحة ودقيقة لتحديد التعويض عن الألم المعنوي والمعاناة النفسية. هذا الغموض يترك مجالاً واسعاً للتفاوت في الأحكام القضائية ويخلق حالة من عدم اليقين القانوني.
في المقابل، يوفر النظام الإسباني جداول محددة للتعويض عن الأضرار المعنوية والجمالية والجنسية، بينما يحدد النظام الألماني شروطاً واضحة للتعويض عن الأضرار غير المادية.
رابعاً: عدم وجود آلية واضحة للتسوية السريعة
على عكس القانون الفرنسي Loi Badinter الذي يلزم شركات التأمين بتقديم عرض تعويض خلال 8 أشهر من الحادث (أو 5 أشهر من تاريخ استقرار الحالة الصحية)،
ورغم إقرار المشروع الزامية سلوك مسطرة الصلح، فلا يتضمن المشروع المغربي آجالاً إلزامية محددة لتقديم عروض التعويض..
كما أن النظام الإسباني يوفر إمكانية تقديم تعويضات مؤقتة للضحايا الذين يعانون من إصابات خطيرة، وهو ما لا نجد له مقابلاً واضحاً في المشروع المغربي..
خامساً: عدم تنظيم واضح لحالات الحوادث المتعددة الأطراف
بينما تنظم الأنظمة المقارنة بشكل واضح حالات الحوادث التي تتورط فيها عدة مركبات، لا يقدم المشروع المغربي تفصيلاً كافياً حول كيفية توزيع المسؤولية والتعويضات في هذه الحالات المعقدة..
سادساً: غياب آلية حماية خاصة للفئات الهشة
بينما يوفر القانون الفرنسي Loi Badinter حماية خاصة للفئات "الممتازة" (victimes super privilégiées) بما في ذلك الأطفال دون 16 سنة والمسنين فوق 70 سنة والمعاقين بنسبة تفوق 80%، الذين يستفيدون من تعويض كامل بغض النظر عن مسؤوليتهم في الحادث، لا يتضمن المشروع المغربي نظاماً مماثلاً للحماية الخاصة..
سابعاً: عدم وضوح آليات التنفيذ والمراقبة
لا يحدد المشروع بشكل واضح الآليات التنفيذية للإصلاح، ولا دور الهيئات الرقابية في مراقبة تطبيق القانون وضمان احترام شركات التأمين لالتزاماتها. كما لا يتضمن عقوبات واضحة للشركات التي تتأخر في دفع التعويضات أو ترفض تقديم عروض عادلة.
جوانب النقص في التشريع
أولاً: عدم معالجة قضية التأمين على الدراجات الكهربائية والنارية الخفيفة
مع تزايد استخدام وسائل التنقل الحديثة مثل الدراجات الكهربائية (trottinettes électriques) والدراجات النارية الخفيفة، لا يوضح المشروع بشكل كافٍ نظام التأمين الإلزامي والتعويضات المتعلقة بحوادث هذه الوسائل. هذه الفجوة التشريعية قد تخلق نزاعات قانونية مستقبلية حول نطاق تطبيق القانون.
ثانياً: غياب تنظيم واضح لحالات العجز المتفاقم
رغم أن المشروع ينص على إمكانية مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر، إلا أنه لا يوفر إطاراً تفصيلياً واضحاً لهذه العملية، بما في ذلك.
معايير تحديد التفاقم
الجهة المختصة بتقييم التفاقم
آجال تقديم طلبات المراجعة
إجراءات المراجعة القضائية أو الودية
ثالثاً: عدم معالجة قضية صندوق مال ضمان حوادث السير
رغم وجود صندوق خاص لتعويض ضحايا الحوادث التي تتسبب فيها مركبات غير مؤمنة أو مجهولة، الا ان هذه الالية لا زالت تعاني من اضطراب في سيرها وخصوصا من تأخير كبير في تدخلها واستفادة المحكوم لهم من التعويضات المستحقة.
رابعاً: غياب آليات بديلة لحل النزاعات
رغم إشارة المشروع إلى تشجيع التسوية الودية (الصلح)، إلا أنه لا يقدم إطاراً مؤسسياً واضحاً لآليات بديلة لحل النزاعات خصوصا بالشكل الذي يضمن المساواة ما بين الطرف القوي المسلح بمصالح قانونية وطبية قوية، وبين الضحية الذي يقف منزوع السلاح عاجزا امامه.
ان تجربة تطبيق قانون التعويض عن حوادث الشغل، الذي اقر هو الاخر الية الصلح، تبين ان هذا الالية تشتغل فقط لصالح شركات التامين،
كان يجب على وزارة العدل والوزارة الوصية على قطاع التأمينات، إعداد دراسة علمية لتأثير تطبيق مسطرة الصلح على حقوق الضحايا وتعويضاتهم.
كما ان هذه الالية يجب ان تتم بإلزامية نظام للمساعدة القانونية والقضائية للضحايا ضمانا للمساواة بين الأطراف. وتتميم المسطرة بلجان تحكيم متخصصة، مع إقرار آليات الشكوى أمام الهيئات الرقابية.
خامساً: عدم وضوح نظام التعويض المسبق
لا يتضمن المشروع آلية للتعويض المسبق أو المؤقت للضحايا الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة ومكلفة قبل البت النهائي في قيمة التعويض. هذا النقص قد يضع الضحايا وأسرهم في وضعيات مالية صعبة، خاصة في الحالات الخطيرة التي تتطلب علاجات مكلفة.
سادساً: عدم معالجة قضية الأضرار البيئية والنفسية طويلة المدى
لا يتناول المشروع بشكل مفصل التعويض عن الأضرار النفسية والعقلية طويلة المدى، مثل اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD) أو الاكتئاب المزمن الناتج عن الحادث. كما لا يعالج قضية التعويض عن فقدان جودة الحياة بشكل شامل.
سابعا: معالجة إشكالية الدخل المعتمد:
تتجه المحاكم نحو اعتماد الدخل الصافي كأساس لاحتساب تعويض الضحايا. رغم ان هذا الدخل لا يشكل الدخل الحقيقي للضحية، والذي يخضع لاقتطاعات هي جزء من دخل الضحية.
كما ان اعتما الدخل الإجمالي لسنة قبل الحادثة غير متوافق مع الطبيعة التعويضية. ذلك ان الشخص الذي فقد دخله الذي يحصل عليه وقت وقوع الحادثة يستحق التعويض عن هذا الدخل، لان الضرر هو اصابته من جراء الحادثة بما سيفقده جزء او أجزاء من دخله.
ثامنا: معالجة بعض الحالات العملية:
مثل :
التعويض عن وفاة الجنين،
التعويض عن وفاة الطفل الذي لم يصبح قادرا عن الكسب بعد، لكنه يشكل امل اسرته وعائلته التي انفقت مصاريف على تنشئته وتربيته،
التعويض عن الاستعانة بشخص والذي ستختلف تكاليفه حسب المستوى الاجتماعي للضحية.
تاسعا: الاستفادة من الأنظمة المقارنة:
مثل النظام الفرنسي (Loi Badinter)
يُعد القانون الفرنسي رقم 85-677 الصادر في 5 يوليو 1985 (Loi Badinter) من أكثر الأنظمة حماية لضحايا حوادث السير. يقوم على مبدأ التعويض التلقائي دون حاجة لإثبات الخطأ للضحايا غير السائقين (المشاة، الركاب، راكبي الدراجات).
النظام الإسباني (Baremo)
يعتمد النظام الإسباني على القانون 35/2015 الصادر في 22 سبتمبر 2015، الذي أدخل نظام تعويضي مفصل ومُلزم (Baremo). يستند إلى مبدأ المسؤولية الموضوعية، حيث لا يُشترط إثبات الخطأ أو الإهمال.
المعدلات التعويضية اليومية (2025):
أيام عادية: 31.61 يورو.
أيام متوسطة الشدة: 54.78 يورو.
أيام شديدة: 79.02 يورو.
أيام شديدة جداً: 105.35 يورو.
نظام النقاط للعجز الدائم:
كل نسبة عجز لها عدد محدد من النقاط
قيمة النقطة تختلف حسب عمر الضحية
تعويضات إضافية للأضرار الجمالية والجنسية وفقدان جودة الحياة.
النظام الأمريكي
يختلف النظام الأمريكي من ولاية لأخرى، حيث تتبع 12 ولاية نظام "عدم الخطأ" (No-Fault) بينما تتبع 38 ولاية نظام "الضرر"
نظام No-Fault:
يتطلب تأمين الحماية من الإصابات الشخصية( (PIP
كل سائق يُعوَّض من تأمينه الخاص بغض النظر عن المسؤولية
تتراوح حدود التغطية من 2,500 دولار (تكساس) إلى 50,000 دولار (نيويورك)
في فلوريدا: 10,000 دولار (أو 2,500 دولار بدون حالة طبية طارئة)
القيود على رفع الدعاوى إلا في الحالات الخطيرة
نظام Tort:
تأمين السائق المخطئ يغطي التعويضات
حق مفتوح في رفع الدعاوى
تعويضات قد تصل إلى ملايين الدولارات في بعض الحالات
توصيات للتحسين:
أولاً: اعتماد نظام Baremoمغربي
يُوصى بوضع جداول تعويضية واضحة ومُلزمة على غرار النظام الإسباني، تحدد:
معدلات يومية للإصابات المؤقتة حسب شدتها
نظام نقاط للعجز الدائم مع قيم واضحة
معايير محددة للتعويض عن الأضرار المعنوية والجمالية
تحديث سنوي للمعدلات حسب مؤشر التضخم
ثانياً: تحديد آجال إلزامية للتعويض
على غرار النظام الفرنسي، يجب إلزام شركات التأمين بـ::
تقديم عرض تعويض أولي خلال 3 أشهر من الحادث
تقديم عرض نهائي خلال 5 أشهر من استقرار الحالة الصحية
فرض غرامات مالية على التأخير
ثالثاً: إصلاح نظام التعويض من خلال صندوق ضمان حوادث السير
رابعاً: اعتماد حماية خاصة للفئات الهشة
يجب النص على حماية خاصة للأطفال والمسنين والمعاقين، تشمل:
تعويض كامل بغض النظر عن المسؤولية الجزئية
آليات مبسطة للحصول على التعويض
أولوية في المعالجة القضائية والإدارية
خامساً: تطوير آليات بديلة لحل النزاعات
يُوصى بإنشاء:
نظام إلزامي للمساعدة القانونية والقضائية للضحايا.
لجان وساطة إلزامية قبل اللجوء للقضاء
هيئات تحكيم متخصصة في نزاعات التأمين
آليات شكوى فعالة أمام الهيئات الرقابية
سادساً: وضع نظام للتعويض المسبق
يجب إنشاء آلية للتعويض المؤقت تغطي:
المصاريف الطبية العاجلة
تكاليف إعادة التأهيل الأولية
الدعم المالي المؤقت للأسر في حالات الوفاة
سابعاً: تعزيز الرقابة والشفافية
يجب تقوية دور الهيئات الرقابية من خلال:
إلزام شركات التأمين بنشر إحصائيات دورية
إنشاء قاعدة بيانات وطنية للحوادث والتعويضات
فرض عقوبات صارمة على المخالفات
الخلاصة
يمثل مشروع القانون 70.24 خطوة إيجابية نحو تحديث منظومة تعويض ضحايا حوادث السير بالمغرب بعد أربعة عقود من تطبيق ظهير 1984. الرفع الجوهري للتعويضات بنسبة 54%، وتوسيع دائرة المستفيدين، وإقرار مبدأ حرية الإثبات، كلها مستجدات تعزز العدالة الاجتماعية وتحمي حقوق الضحايا.
ومع ذلك، يعاني المشروع من نقائص جوهرية مقارنة بالأنظمة الدولية المتقدمة، أبرزها غياب نظام تعويضي محدد وموحد (Baremo)، وعدم تحديد آجال إلزامية للتعويض، وغياب حماية خاصة للفئات الهشة. كما يفتقر إلى آليات واضحة للتسوية السريعة والتعويض المسبق، وإلى صندوق وطني لتغطية الحالات الخاصة.
لتحقيق إصلاح شامل وفعال، يجب استلهام أفضل الممارسات الدولية، خاصة من الأنظمة الفرنسية والإسبانية والألمانية، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية المغربية. الهدف النهائي هو ضمان تعويض عادل وسريع وشفاف لكل ضحايا حوادث السير، مع الحفاظ على استدامة قطاع التأمين وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القانونية.
إن الإصلاح الحقيقي لا يكتمل بتحسين النصوص القانونية فقط، بل يتطلب أيضاً تطوير البنية التحتية، وتعزيز الوعي المروري، وتحسين آليات الرقابة والتطبيق، وتدريب القضاة والخبراء على الأساليب الحديثة لتقييم الأضرار وحساب التعويضات. كما يتطلب إشراك جميع الفاعلين من ضحايا وجمعيات مجتمع مدني وشركات تأمين وخبراء في عملية التطوير المستمر للمنظومة.