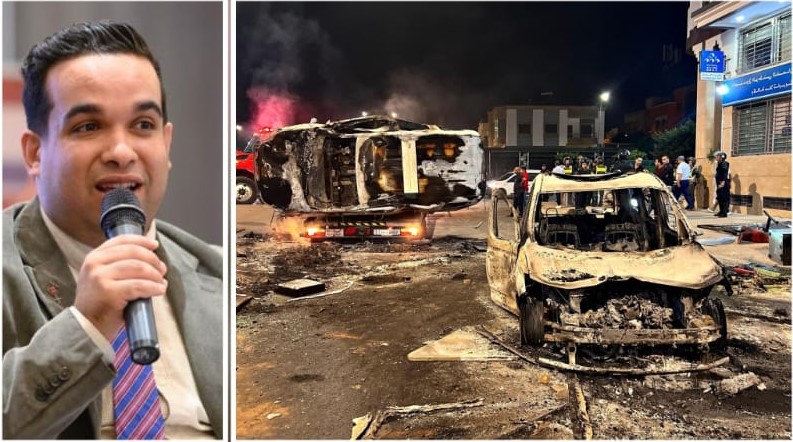في سياق النقاش الدائر في أوساط حزب الأصالة المعاصرة حول المشروع الديمقراطي الحداثي، خاصة مع صعود عبد اللطيف وهبي لقيادة حزب " البام"، توصلت "أنفاس بريس" بمساهمة أحمد العمراوي، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة:
اتسمت سنة 2007 بالعديد من الأحداث والوقائع والمؤشرات التي أجمعت على استدعاء ذروة يقظة الدولة على أعلى المستويات والمؤسسات. التحديات كانت عديدة وجلها من العيار الثقيل وهامش الخطأ في قراءة ما كان يعتمل كان شبيها بذلك المتاح في غرفة عمليات تحتضن جراحة معقدة ودقيقة.
أبرز معالم الوضع الصعب الذي كانت تمر منه البلاد تمظهرت، من وجهة نظري، على ثلاثة مستويات. الجانب الأول مرتبط بإكراهات الحالة الاقتصادية رغم انخراط الدولة في مشروع تنموي واعد واهتمامها العملي بالمعايير الدولية للتنمية البشرية والحصيلة الموفقة، إلى حد ما، لحكومة إدريس جطو.
ومع ذلك بقي الناتج الداخلي الخام بعيدا عن أن يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة، ناهيكم عن معدلات النمو التي لا تتيح تحقيق إرادة ولوج نادي الدول الصاعدة وحجم الإنفاق العمومي الذي لا يتناسب وانتظارات الطبقة الوسطى والفئات الهشة على صعيد معضلات التعليم والصحة والشغل وتحسين الأجور والخدمات الاجتماعية.
الأمر الثاني متعلق بتعاظم الفعل الاحتجاجي الذي بلغ أرقاما مقلقة وأخذ أشكالا غير مسبوقة، وبدا أنه يعكس حالة استياء عام من عدم تناسب ما تحقق على امتداد قرابة عشرة أعوام من الجهود على مستوى التنمية والانتقال الديمقراطي وحقوق الناس، عدم تناسبه مع سقف انتظارات المغاربة التي بدت أنها بدون سقف بعد 30 يوليوز 1999.
أما المعطى الثالث الذي كان بمثابة عريضة جماعية غير مكتوبة من الناس إلى المؤسسات، فهو عدم اكتراث 80 بالمائة من الكتلة الناخبة بالانتخابات البرلمانية لـ 7 شتنبر 2007 وما سيترب عنها من مؤسسات دستورية، إضافة إلى رقم أكثر إثارة للقلق هو رقم غير المسجلين. كل هذا رغم حملات التحسيس والماركوتينغ السياسي ودعوات المواطنين المضنية للتسجيل في اللوائح والمشاركة المكثفة لربح انخراط أوسع الفئات في مسار استكمال البناء المؤسساتي وتجويد الترسانة القانونية وأداء الجهاز التنفيذي وصلاحيات البرلمان في التشريع والمراقبة، ليكون الجميع في الموعد مع حسم انتقال البلاد نحو الديمقراطية في أجواء من التعبئة الشعبية.
أكيد، أن الدولة اهتمت بترتيب أمور تعيين الوزير الأول، خاصة وأن عباس الفاسي كان واضحا في استجدائه بتشكيل حكومة ما بعد رمزية عبد الرحمان اليوسفي وكفاءة إدريس جطو. إلا أن الأساسي في الأمر أن عقلها الاستراتيجي كان منشغلا بحتمية تقديم عرض سياسي جديد يسترعي اهتمام المغاربة بعد أن سئموا خطابي المشروعية الوطنية والتضحيات، وبعد أن فقد الخطابان معا أي قنوات ذات مصداقية مع الشارع ولم يحافظا على المسافات المطلوبة بين الأحزاب وإدارة مناطق من الحكم والشأن العام. لقد بدا واضحا أن القوى السياسية والاجتماعية التقليدية قد فقدت القدرة على التأطير، بل وعلى الكلام، مما أفضى إلى رتابة سياسية غير مسبوقة أضحت تهديدا استراتيجيا لمشروع الانتقال الديمقراطي، خاصة أن الفراغات الشاسعة التي خلفها ترهل الأحزاب والنقابات كانت تكتسح عبر الحركات الدعوية لإسلام سياسي يتقن فنون التقية مع صناع القرار ويتفوق في خوصصة المشترك الديني لنفسه، لاستمالة المغاربة بخطاب يتفوه بالدين أمام الملإ، ويحسب لاختراق مفاصل الدولة أمام المريدين.
أمام هكذا وضع كان لزاما على الدولة أن تجس نبض ما كان يسمى بالقوى الحية. المعاينة أبانت أن هذه القوى غير مؤهلة لإعادة الإمساك بزمام المبادرات إما بسبب عجز بنيوي أو لاستمرار العدمية في أوساط كان بإمكانها القبول بتسوية أهدرت برعونة لتجد الدولة نفسها مضطرة لتحمل مسؤولياتها كاملة في معالجة الأمر، حتى إن اتهمت بإحالات على ما جرى سنة 1963 وبمحاولة محاكاة نظام بنعلي في تونس. الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق، الحقيقة تكمن في كون الخيارات لم تكن كثيرة والوقت كان يلعب ضد انتقالنا السلس نحو الديمقراطية والتصرف كان واجبا وطنيا عظيما وملحا.
في تلك المرحلة كانت النخب التي تقاسمت تصور الفقيد إدريس بنزكري لتعقيدات مراحل الانتقال ولضرورة عقد التسويات الكبرى وصرف النظر عن منطق الصدام والانخراط في سيرورة ومسار بناء الثقة والتعاقد بين المؤسسة الملكية والفاعلين السياسيين، كانت تلك النخب التي سبق وأن استوعبت معنى نعم السياسية التي أشهرها عبد الرحمان اليوسفي أمام دستور 1996 وساهمت في إرساء تجربة العدالة الانتقالية بين 2002 و2004 واحتكت بخطوط التماس مع الدوائر، وأدركت أن الملك يقود بحزم وقناعة استراتيجية نقل البلاد إلى الأفضل على كافة الجبهات. كانت تلك النخب قد تقاطعت مع قلق الدولة من أرقام خريف 2007 وأفضى هذا التقاطع إلى نزول رجل قريب من الملك إلى معترك الصراع السياسي المباشر على الأرض، ليس من باب إرادة في التحكم كما يزعم الخطاب السياسوي المهووس بتسجيل الأهداف من حالات الشرود، لكن من قبيل تقدير ثاقب للموقف وتحمل رجالات الدولة لمسؤولياتهم في الشدائد.
لقد كان واضحا أن الاتهامات ستنهال وقراءات النوايا ستقصف بالمدفعية الثقيلة والتأويلات السطحية ستتصدر العناوين. لكن لا أحد في حينه تساءل لماذا يقدم رجل مشهود له بالذكاء والخبرة والكفاءة على قرار المساهمة في تأسيس حركة لكل الديمقراطيين وحزب الأصالة والمعاصرة أمام أنظار الرأي العام الوطني والدولي؟
الجواب في غاية البساطة: عندما يكون أمامك خياران إما ترك البلاد ومصير الناس مبنيا للمجهول ومفتوحا على أسوء الاحتمالات، وإما تحمل الافتراءات على الشخص وعلى قناعة الدولة بالخيار الديمقراطي لتيسير مواجهة أسباب هجر المغاربة للسياسة والمؤسسات ومخاطر استشراء الإسلام السياسي في مفاصل الدولة، عندما نكون أمام هكذا خياران فقط، فليس صعبا أن يجد الديمقراطيون الحقيقيون الجواب الملائم.
سيكتشف المؤرخون والباحثون من زوايا النظر الموضوعية يوما ما العمق النظري والإبداع السياسي والشجاعة الفكرية لما أنتجته حركة لكل الديمقراطيين، وهي تقارب بلقنة المشهد الحزبي والعزوف الانتخابي وأساطير المشروعيات واحتياجات البلاد والمواطنين، وسينصف ذلك الفريق من الأطر والمناضلين الذين تمكنوا من صياغة خطاب عابر لانشغالات كل الفئات تحت عنوان الدولة الاجتماعية والمصالح العليا للوطن والناس، وسيتذكر المغاربة تضحيات الرعيل الأول للأصالة والمعاصرة، ومعه الأجيال التي تلت وهم يقاومون مخططات السطو على المؤسسات باسم الدين في محاولات إعادة إنتاج تجارب لفظها التاريخ بالدم في أوروبا، وما زالت تتراوح بين الحاكم الأوحد في تركيا والتقية في تونس وإفساح المجال للعسكر في مصر وتعميم البؤس في فض النزاعات الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط. ولمن يرددون اللازمة السخيفة أن الأصالة والمعاصرة اعتمد على الأعيان، فليتذكروا الانتخابات الجزئية لشتنبر 2008 وسنوات الاعتقال التي أمضاها جل قياديه في السجون زمن سوء الفهم الكبير وليقرأوا جيدا قبل وبعد ذلك كله، المعنى السوسيو-ثقافي للأعيان في تاريخنا ونسيجنا المجتمعي.
ولئن كانت مقارعة الإسلام السياسي أحد أبرز مرتكزات الحركة والحزب، فإن التعاطي المنتج للحلول اتجاه المعضلات الكبرى للبلاد والانتظارات المشروعة للمغاربة على كافة المستويات وفق رؤية تنهل من الجرأة في نقد موروثنا السياسي بكل احترام لكن دون أي تحفظ ومن التقرير الخمسيني الذي أنجزه خبراء في كافة حقول المعرفة العلمية بالواقع ومن خلاصات هيئة الإنصاف والمصالحة التي قرأت ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الناس قبل أن تعمل على طيه وعلى ألا يتكرر. إن التعاطي الخلاق مع قضايا البلاد والمواطنين ومصالحة الناس مع السياسة والمؤسسات ومع الوطن كان يتصدر سلم الأولويات، وكان في حاجة طبعا إلى نسج تحالفاتنا مع المحيط الفكري والسياسي للمشروع الديمقراطي الحداثي دون سواه. لقد آمنا، دون تردد وبشكل نهائي، بالسند القيمي للممارسة السياسة وتخلصنا من النزوعات السياسوية الخرقاء التي تقبل التحالف، بدعوى مقتضيات تشكيل الأغلبيات والحقائب وفن الممكن، مع من لا قواسم مشتركة معهم في تصورنا للدولة و المجتمع والحريات، و ترجمت هذه القناعة أحد تجليات فهم جديد للسياسة لطالما كان مبعث تميز لنا، حتى وإن كان ثمنه أن تبقى القوة الثانية في البرلمان في المعارضة إلى الأبد.
على أي حال، ما نود أن يبقى راسخا في الأذهان هو أن من واجهناهم منذ البداية، والذين أسعفهم كل ما جرى بعد 17 دجنبر 2010 على امتداد جغرافيا الوطن العربي ولوحوا بـ 20 فبراير، ليصادروا كل ما استطاعوا من حريات من مسودة دستور يوليوز 2011 وركبوا الشعبوية ومنحوا الوعود دون خجل ليتصدروا المشهد النيابي في 25 نونبر 2011 ويقودوا الحكومة، ومعها العديد من الجماعات الترابية والمجالس الجهوية على مدى ولايتين، ما نود أن يبقى راسخا في الأذهان هو أنهم نكثوا الوعود التي منحوها للمغاربة وباتو أنجب من برنامج التقويم الهيكلي إزاء صندوق النقد الدولي. أين معدل نمو يصل 7 بالمئة؟ وأين زيادة الدخل الفردي بـ 40 بالمئة؟ وأين صندوق المقاصة ومكتسبات التقاعد؟ وأين التقليص من الضريبة على الدخل؟ وأين تلك الأرقام التي وعدوا بها في مجال الشغل؟ وأين إصلاح التعليم والمنظومة الصحية والجبائية؟ وأين الصلاحيات التنظيمية لرئيس الحكومة؟ وأين كان تصريف الأعمال عندما حصلت فاجعة محسن فكري بالحسيمة؟ وأين كانت الحكومة عندما مات عمال السندريات بجرادة؟ وأين قد نجد أي أثر للحكومة على صعيد قضية وحدتنا الترابية؟ هذه أشجار أسئلة تخفي غابة العجز والتخبط والعشوائية التي تركنا شأننا العام فيها.
على المغاربة أن يعاقبوا من يتنكرون للوعود خاصة عندما تمنح من منصات في الساحات العمومية ملفوفة بالقسم وبالدين.
لقد خذل حزب العدالة والتنمية حليفا كاد أن يجازف بكل ماضيه وبحاضره وبمستقبله من أجل التعاقد حول برنامج، خذلوا حزب التقدم والاشتراكية الذي ظن الجميع أنهم عقدوا معه قرانا كاثوليكيا لا مجال فيه للطلاق.
كل أوراق الاعتماد التي تثبت أن الإسلام السياسي غير جدير بثقة الناخبين وبتحالف الفرقاء السياسيين وبأشياء أخرى، قدمها حزب العدالة والتنمية في واضحة النهار، وبعد ذلك يأتينا المؤتمر الرابع للأصالة والمعاصرة بمن يشكك في جوهر منطلقات وأسباب نزول حركة لكل الديمقراطيين وحزب الأصالة والمعاصرة، ويضرب عرض الحائط بـ 12 سنة من صمودنا وصمود الديمقراطيين المغاربة في وجه توجه قد يعيدنا سنوات ضوئية إلى الوراء في السياسة والاجتماع والاقتصاد والحريات والقيم، جاء من يشكك ويسخر ويتملص ويتخلص من كل هذا، فقط لأنه ارتأى أن ذلك سبيله للظفر بالأمانة العامة لحزب كان صارما في مسألة التحالف مع الإسلام السياسي ليصبح الآن مخرجا لعودتهم لرئاسة الحكومة ومواقع أخرى في 2021. كان حريا بعبد اللطيف وهبي وهو يستخدم كل الأسلحة المحظورة من أجل التموقع على رأس الحزب، كان حريا به، على الأقل، ألا يقارن بين إمارة المؤمنين برمزيتها ووقعها على الشأن الديني للمغاربة وبحرصها على أمنهم الروحي وتثمين قيم الإسلام السمحاء التي أوجدت للمغرب مكانا في الحوار والتسامح بين الحضارات والمعتقدات والأديان، وبين الإسلام السياسي الذي يصبو إلى السلطة عبر العبث بالدين والتكفير وامتطاء الدعوة والعمل الإحساني لتمرير مشروعهم السياسي عندما يتسع هامش المناورة، وعبر العبث بالدين والتقية والرياء عندما يضيق ذلك الهامش لأي سبب من الأسباب.
فعلا، إن التاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل مأساة أو ملهاة. فهل سيذهب المشروع الديمقراطي الحداثي وكل ما أنجز منذ يناير 2008 سدى وأدراج الريح؟
تلك هي المسألة المتروكة لضمير كل الديمقراطيين.