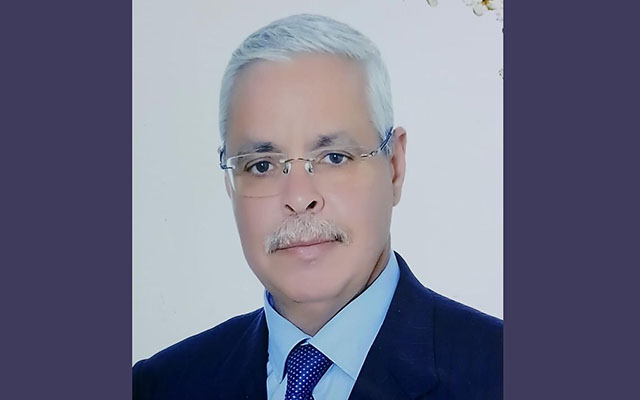يكفي أن يتابع الزائر حالة المغرب لأقل من 24 ساعة لكي يقتنع أن الطريقة الوحيدة التي أصبح الوصول بها إلى السياسة ممكنا في البلاد هي الخبر - الترفيهي، أو ما اصطلح على تسميته تحت سماوات أخرى infotainment وهو المصطلح التركيبي بين الخبر وبين التسلية الذي يعود ميلاده إلى الفترة التي حكم فيها بوش أمريكا في الثمانينيات، عندما كانت القفشات والأخبار المضحكة والانزلاقات اللغوية لرئيس أمريكا تشكل المادة السياسية الأولى لدى الإعلاميين لقياس الوعي بالمسؤولية أو القدرة على الحكم.
اليوم يكفينا أن نتابع زعماء الأغلبية، (بفعل هيمنتهم على الإعلام والفضاء التشريعي والعمومي) ومن ورائهم أخبارهم وزيجاتهم أو مأكولاتهم لكي نتأكد أن المصطلح أصبح جزءا من السياسة حتى قبل أن يصبح جزءا من الإعلام السمعي البصري كما في فرنسا ودول الغرب مثلا.
وفي هذا تفوق السياسيون في الحكومة في أن يدشنوا عهد الخبر التسلية كطريقة وحيدة في السياسة عوض التحليل والمتابعة والبرامج والمواقف وما إلى ذلك.
لعالم الميديولوجيا أن يحلق في الأعالي، ويقول إن في هذه المعالجة يختفي الخبر المعقول لفائدة الفرجة، وتكون الفرجة هي مقدمة موت السياسة.. لكن المتابع لا يمكن أن يغفل أن هناك مواسم، بدأنا نستأنس بها، هي مواسم "الصولد" أوالتخفيضات تحل مع المواسم الانتخابية مصحوبة بتدني سقف المسؤولية السياسية. وميزتها الأساسية وضع الحياة العامة في خدمة الاستهلاك الفوري للسخرية التي تعوض الشأن العام.
ومن ميزتها الابتذال اليومي، مع النجاح في تقديمه على شكل كوميديا إخبارية إعلامية تجعل مستهلكها يشعر بالسعادة بأنه يستطيع الحصول عليها بثمن بسيط وفور وقوعها!
لهذا نفهم انزعاج الفنانين من الفكاهة عند بنكيران وعند من يسايره في ذلك بدون مقابل ولا ضريبة ولا أحكام الجمهور!...
ليس حادثة الشوباني وبنخلدون هي أجلى هذه التوجهات الجديدة في تكريس سياسة الفرجة أو تخفيض من الحدث السياسي إلى درجة الابتذال، بل قد يكون موضوعا جديا أو خطيرا تعالجه الحكومة ببساطة تثير التسليه والخوف معا!
فهل يمكن أن نتصور إجراء انتخابات تحت نيران داعش، كما كان الرفيق لينين يبحث عن تأسيس الحزب الثوري تحت نيران الأعداء؟
لا يوجد أي شعب سيحتار في الجواب، وهو يرى بأم صناديق الاقتراع أن الداعشي يخرج عن صمته وعن طوره كلما خرج شعب ما يبحث، في التاريخ، عن تمرين للديمقراطية. وقد شاهدنا أن الدول التي سهرت شعوبها كثيرا في الشارع بحثا عن الديمقراطية، كما في دول الربيع العربي، مثلها مثل الشعوب التي تقيم جيمناز ديمقراطي كنيجيريا بالقرب من مقابر الداعشيين من بوكو حرام كلها تسير على صراط حاد بين الإرهاب وبين صناديق الاقتراع .
فكلما كان الإرهاب حاضرا نخاف على قلب الديمقراطية من جلطة دموية تقتله وتوقف نبضه.
لكن في بلادنا السعيدة، لا يكلف وزير في الحكومة نفسه عناء التفكير في الصراع الذي يدور الآن بين الديمقراطية والإرهاب، بالرغم من أن كل واحد ينفي الآخر في تبادل مطلق لا يمكن أن يجمع بين الاثنين.
فالإرهاب يهدد الديمقراطية، وليس الانتخابات فقط.
ولهذا يبدو من المفارق كثيرا أن يتساهل نبيل بنعبد الله، الذي يعتبر سليل مدرسة تقدمية على اطلاع واسع بما يقوله غرامشي في بناء الانتقالات الديمقراطية مع الإرهاب، ويعتبر أن الحديث عنه محاولة تبريرية لرفع الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
أولا لابد من التأكيد بأن الربط الجدلي بين الديمقراطية ومحاربة الإرهاب مر على أجساد مناضلين جديين اختاروا إستراتيجية النضال الديمقراطي للخروج من الابتذال الذي وضعت النخبة الحاكمة فيه البلاد عبر تجريبية سياسية فجة تملأ الفراغ بما هو أفرغ منه!.
فعمر بنجلون، قتل وهو يعد للمسلسل الديمقراطي، وهو يجتهد في الجمع بين دفاتر غرامشي ، المستشهد في سجون الفاشية وبين التحليل الملموس للواقع الملموس وطبيعة الدولة في المغرب وبين معنى التاريخ وصناعته من خلال التجريب المر.
ليس صدفة أن قتله جاء بعد مساهمته الكبرى في توطين إستراتيجية النضال الديمقراطي الذي تبنته التيارات كلها من بعد،..
لهذا يبدو لنا أن الارتباط بين التفكير في الإرهاب وبين الديمقراطية هو ارتباط نفي متبادل..
ثانيا لعل من أهم ما ربحه المغرب في العهد الجديد هو انتظامية العملية الاقتراعية، بناء على قناعة تهم الاطمئنان على انتظامية أداء الدولة ومؤسساتها. وقد جرب الإرهاب ضربة 16 ماي 2003، وتوقع الكثيرون أن الضربة التي كانت في مقدمة الصيف ستعطل الخريف الانتخابي، أي شتنبر 2003 وما قد يتبعه من تطورات تعيد شبح الارتباك والعشوائية والمزاج في تحديد مواعيد الدولة الكبرى. ولم يحدث ذلك، وما زال المغاربة يذكرون أن الملك، رئيس الدولة، ألقى خطابا كان حاسما فيه بأن الرد يكون هو الاقتراع وليس غير الاقتراع، لأنه شكل الديمقراطية.
وعندما يتصرف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وكأن الإرهاب حالة طقس معزولة، محكومة بمقاييس الأمطار والوحل في الطريق المؤدية إلى القري! وأنه ليس امتحانا عسيرا ورهيبا للدولة وأمنها ونخبتها، وأنه مجرد نقطة نظام في نقاش حزبي انتخابي.. علينا أن نتساءل أين يقف الموقف وأين يبدأ التبخيس؟! أين يبدأ الموقف وأين يبدأ الترفيه؟
قد نعذر الشعب إذا هو لم يعد يقتنع بإستراتيجيات التواصل، لأنها تفتقد إلى خطاب واضح وقوي، وإلى مواقف تسنده وتدل عليه؟
إذا سلمنا جدلا بوجودها، فأين الموقف القوي والخطاب، وأين الأفعال التي تقدم في المناسبات السياسية للتواصل، بالنسبة لمن يملك قرار الوصول إلى أفعال وليس الذي عليه دستوريا أن يصحح اعوجاجها؟
فهل نحن أمام هكذا وضع في بلادنا؟
هناك خطاب بدون أفعال، سواء في محاولة التسييس الجماعي ككل نقاش أو في محاربة الفساد أو في تشخيص وضعية التفاؤل الاجتماعي التي تروج لها الحكومة.
لنتفق أن مرد ذلك هو أن السياسيين في الحكومة اليوم يفقدون معنى الأمد الطويل! وعوض أن تفرض السياسة مسارها في إنضاج شروط العمل تخضع بفعل الهرولة المتواصلة لزعماء الحكومة إلى اللحظية والخبر - الالتماعة إلخ..
يضاف إلى ذلك، فشل الحكومة أو صعوبة تحقيقها لتوافقات وتسويات سياسية كبرى أو اجتماعية دنيا حول الإصلاحات التي تدعيها.. لذلك يكون الحل هو في الجمع بين نصف الجد ونصف الهزل!