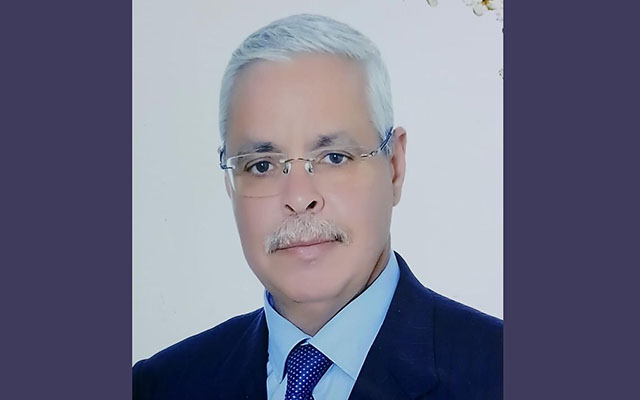من وحي الحملة الوطنية للتفاعل النقدي مع المنظومة الجنائية، لاحت فكرة في الأفق، مهمة وجيدة، وهي، كيف لنا أن نطور الحماية الجنائية للعقود، باعتبار أن الدستور والالتزامات الصادرة عن طرفي التعاقد ينبغي أن تكون مشمولة بحماية جناية، أي أن السياسات العمومية والإجراءات الصادرة عن الدولة والحكومة والمؤسسات ينبغي أن يجرم كل إخلال بها.. وبالتالي لا ينبغي فقط مجاراة الخطاب السياسي والإعلام في ما هم يجروننا إليه من إدانة «سياسية/ انتخابية/ إعلامية»، بمثابة تنفيس استهلاكي، يتم به امتصاص النقم، كما هو حاصل مثلا في مطاردات الساحرات في العلاقة مع تضخم ملفات الفساد وسوء التدبير. والحال أن المختص هو القضاء الذي له القانون يضبط به إيقاع الحقوق مقابل الالتزامات، إلى درجة تم تجاهل أنه لن يتم القضاء على الفساد دون تجريم للاستبداد، حيث لم تعد تكفي المحاسبة الإعلامية و«ديماغوجيا» العقاب الانتخابي وثقافة «الفضح الإعلامي» المستهلكة كاللمجة السريعة لدى «الدواجن الانتخابية».. فكيف يعقل أن نغض الطرف عن تحقير المواطنين بالتدليس والوعود الكاذبة وهو جنحة كالقذف في الأعراض والنبش في الحيوات الخاصة للمواطنين، ونصر أيما إصرار على أنه يفترض في الناخب، وهو كالصحفي القاذف، كل النوايا الحسنة مادام الأمر يدخل ضمن «حرفته» المشمولة بحماية الحق في النشير، عفوا النشر وشراء الذمم، من جهة، وعلى سبيل المثال، ومن جهة ثانية، ودائما ليس على سبيل الحصر، لقد حان الوقت لتجريم كل انتهاك للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بمقتضى تعريف صريح ودقيق، في وقت لم يعد ينفع معه السكوت عن الفقر، واعتباره مجرد مظهر من مظاهر التخلف.. إنه تفقير مؤسس على إرادة مبيتة لقتل الكرامة، والتي بدونها لا وجود للإنسان. فما جدوى مقتضيات لا تلزم الدولة بتحقيق نتيجة، وحتى «بدل» العناية الواردة في الفصل 31 من الدستور غير مشمولة بأي جزاء ولو مدني وبالأحرى جنائي..
من هنا علينا تجريم الإقصاء الاجتماعي، ليس فقط لمناهضة واستئصال التطرف والإرهاب، ولكن أساسا لضمان الحق في الحياة ولتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن باسم الولاء للأمة.