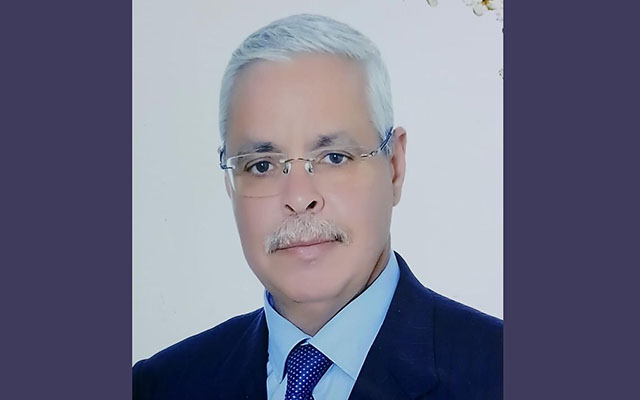كعادتي كل يوم، استيقظتُ باكرا في الخامسة صباحا، لأنًّ ضرورات العمل جعلتْ ساعتي البيولوجية مبرمجةً على هذا التوقيت، حتى في يوم العطلة.. تذكرت أن اليوم السبت 21 مارس هو "اليوم العالمي للشعر".. يقال والله أعلم؟
ليس لي في الحقيقة برنامج خاص واستثنائي لما تقتضيه المناسبة، التي ليست شرطا لأحد ما دامت تتعلق بهذا الغريب المتغرب على أرض الغربة والغرابة: أي الشعر. كل ما في الأمر أنني سأنتظر استيقاظ الأسرة بعد ثلاث ساعات على الأقل كي أتناول فطوري، وأنطلق نحو قريتي، حيث لا يحتاج الشعر ليوم عالمي كي يحتفي بعزلته المضاعفة، ففي القرية على الأقل ثمة ربيع حقيقي ملموس لم تسرقه بعد عصابات الظلام لتحوله ببداوتها الهمجية إلى خريف مثخن بالجراح وجثث القتلى بعدد من عواصم ومدائن العالم العربي، وفي القرية كذلك ما يليق بالشعر من صمت وهدوء وتلقائية، بعيدا عن مظاهر التصنع والضجيج المخترقة للعديد من التظاهرات التي تحتضنها مدن بالمناسبة، وفي القرية أيضا ما يكفي من ألوان الربيع كي يطلق الشعر عصافيره دون خوف من فلول هذه المدنية الكاذبة، المنافقة والطاحنة..
أن يحظى الشعر ب "يوم عالمي"، لا يعني بتاتا أنه سيحظى مثل أيامٍ عالميةٍ أخرى لأشياء أخرى بالكثير من الاهتمام والرعاية والاحتفال.. ففي بلادنا السعيدة، لم تُعِرْ أيةُ وسيلةٍ إعلامية سمعية بصرية اهتماما استثنائيا بالشعر و"يومه العالمي" المزعوم، بل منها من لم يشر إليه حتى من باب الإخبار البارد... وبالكاد وجَدَتْ جريدةٌ يوميةٌ ما يكفي من أخبار حوله لتسويد بياضِ صفحةٍ واحدةٍ من ملحقها الثقافي، أما الأسبوعيات فقد تغاضت تماما عن الموضوع... إحداها تخصص في كل عدد صفحتين كاملتين للسينما وطز في الشعر والقصة والكتاب...
أحد رؤساء التحرير لا يتعب من تذكير ملايين قرائه بأن الشعر قد انتهى منذ زمان، وأنه لا يستحق أكثر من جنازة رمزية، وليذهبِ شعراءُ اليوم إلى الجحيم، والمفارقة أن هذا الحداثي العظيم ينسى أنّهُ فقط يُلَوِّكُ مقولةً بالية ورجعيةً لا يتعب صديقي القروي الأمي من ترديدها كلما تعقدتْ عليه الأمور بلهجة دارجة: "ما خلَّاوْا الْوَالَا للتْوَالَا ما يْقُولُوا".. ولو ترجمنا هذه المقولة إلى العربية الفصحى، لكان على مِثْلِ هذا الحداثي الصنديد أن يستقيل من حداثته وعمله معًا مادام الأولون لم يتركوا له شيئا ليقوله أو يدبجه في جريدته..
أما التظاهرات التي تنظم بالمناسبة فإن أغلبها يقتلُ الشّعرَ عوض أن يحتفي به، ويُنَفِّرُ الجمهورَ منه عوض أن يُحَبِّبُهُ إليه، كما لو أن هناك اتفاقا ضمنيا لنصب مقاصلَ للشعر تحت ذريعة الاحتفاء به بمناسبة "يوم سلخه العالمي" هذا، والنتيجة أنك تجد في الغالب برنامجا يُكَدِّسُ الشواعر والشعراء في جلسة واحدة، يكاد كل واحد يمحي متعة ما ألقاه الذي قبله، فيخرج في النهاية المتلقي النادر خاوي الوفاض، وفي الكثير من الأحيان ما يتشبث بعضهُم بالمنصة تَشبُّثَ الديكتاتور بكرسيه، ينهال بأريحية مدحا في المنظمين والمدعمين والجمهور القليل جدا وحتى العابرين بجانب القاعة، قبل أن ينتقل إلى مقدمة طللية يتحدث فيها عن تجربته العصماء ونصوصه التي نشرت والتي لم تنشر، ليبدأ في تلاوتها الواحد تلو الآخر بطريقة رديئة، دون أن يفكر أن عددا من فصيلته ينتظر دوره في طابور طويل لقراءة ما كتبه أكان شعرا أو ادعاء.. وتكتمل عملية سلخ الشعر وتعذيب الشعراء عندما يستغل بعض الأشخاص صفتهم التنظيمية ليعلنوا فجأة أنهم أصبحوا مع توالي دورات مهرجانهم شعراء فطاحلة ونقاد مبرزين، لإجبار ضيوفهم على الإنصات لتُرَّهاتِهم، هم الذين لم يسبق أن كتبوا سوى تقارير جافة عن أنشطتهم البعيدة عن المجال، قبل أن يركبوا موجة "اليوم العالمي لسلخ الشعر".
ورغم أن بعض الهيئات تعاني حقيقة من أجل تنظيم ملتقياتها بالمناسبة، رغم ضيق ذات اليد وبخل القطاعين العام والخاص، فتلجأ إلى استعارة أو تبادل عدد من الشعراء الأجانب، في إطار الالتفاف على ميزانيتها المتواضعة وأيضا لضمان طابع عربي أو دولي لتظاهراتها، إِلَّا أنَّ تسيُّبَ بعض المتطفلين على الشعر في يوم تعذيبه العالمي، ينتج مفارقات غريبة تسيء للشعر والشعراء والمناسبة معا، ففي إحدى دورات مهرجان شعري متواضع ينظم بمدينة صغيرة لا يكاد سكانها يسمعون أخباره، حدث أن تم تكريم شاعر عربي، تطوع لتوزيع نسخ من آخر مجاميعه الشعرية على الشعراء المدعوين، فما كان من المنظمين إلا أن طالبوهم بإرجاع تلك النسخ التي أهداهم إياها الشاعر العربي المحتفى به إلى الجمعية المنظمة، ومن أغرب ما حدث أنهم احتجزوا البطاقة الوطنية لأحد الشعراء وأخبروه أنهم لن يعيدوها إليه إلا عندما يعيد لهم نسخة الديوان، فهل الشعر نفيس وغالي إلى درجة تدفع جمعية لأساليب بوليسية من أجل إجبار شاعر في مهرجان شعري على التنازل عن ديوان شعر مهدى إليه، أم أن الشعر هنا مجرد صهوة لركوب الموضى من أجل تحقيق أهداف أخرى لا علاقة لها به؟
هنيئا أيها الشعر... لا عيد لك..