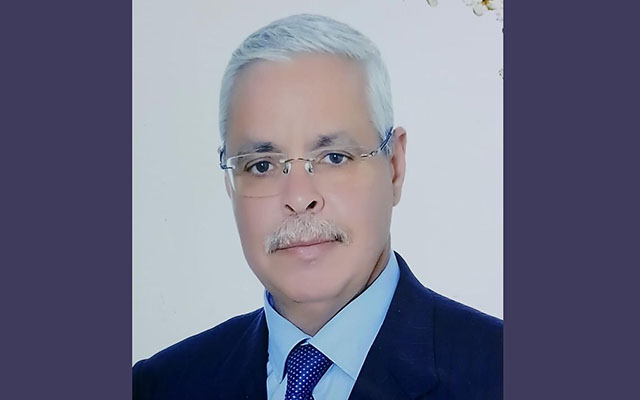في خطوة مفاجئة اقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عشية زيارته للمملكة العربية السعودية، مطلع شهر مارس 2015، تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة كفيلة، حسب رأيه، بتعزيز أمن الدول العربية واستقرارها، مشيرا إلى أن هذه القوة تمثل حلما قديما لم يكتب له أن يتجسد لحد الآن، ومشددا على أن طبيعة هذه القوة ستكون دفاعية محضة، وليس من مهامها التوسع أو الاعتداء على أحد.
وأضاف الرئيس المصري يقول إنه يعتقد بأن المملكة العربية السعودية أكثر الدول ترحيبا بتكوين هذه القوة لمواجهة الإرهاب، وأن كلا من العاهل الأردني وأمير دولة الكويت أعربا له عن الاستعداد للمشاركة في تشكيل القوة المقترحة، لاسيما بعد أن نقل عن ملك الأردن دعوته إلى التحرك لتنفيذ هذا المقترح الذي باتت، كما قال، الدول العربية في أمس الحاجة إليه. ولم يستبعد الرئيس المصري انضمام الإمارات العربية المتحدة لهذا الجهد الذي رحبت به هي الأخرى مبكرا.
وبما أن المؤسسات المصرية الرسمية (رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية) لم تقدم لحد الآن أي تصور عملي مفصل لهذا الاقتراح، فقد انبرت التقارير الإعلامية والصحفية متطوعة لشرحه وإعطاء مضمون له هو أقرب لأهواء الكتاب والمحللين منه إلى أي شيء آخر، على أساس كلام مجتر يؤكد على ضرورة وحيوية وجود هذه القوة لمواجهة الجماعات الإرهابية المتناسلة في المنطقة، وأهمها داعش، وما قد يتفرع عنها أو ينشأ بعدها من مجموعات متشددة أخرى بدون دراسة علمية ومنطقية للموضوع من مختلف جوانبه.
وفي الوقت الذي اختصر آخرون دور هذه القوات في حل المنازعات العربية بدلا من اللجوء المتواصل إلى القوات الدولية، الغربية بصفة خاصة، لم يخجل فريق ثالث من دخول حلبة المزايدة ليتحدث عن وجود نواة هذه القوة انطلاقا من التدريبات والمناورات العسكرية الموسمية، التي تجري بين القوات المسلحة في العديد من الدول العربية، وأبرزها في الآونة الأخيرة تلك التي تجري بين مصر والمملكة العربية السعودية، ثم مصر والإمارات العربية المتحدة.
ولم تشأ جامعة الدول العربية أن تفوت فرصة هذا الاقتراح. فقبل الاطلاع على فحواه وتفاصيله، وعلى ردود الفعل التي أثارها على الأقل عربيا، بادرت إلى الإعلان عن أنها ستدرج الاقتراح في جدول أعمال القمة العربية المزمع انعقادها في شرم الشيخ المصرية نهاية شهر مارس 2015، معتبرة إياه خطوة عملية هامة لتحقيق ما أسماه نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية حماية الأمن القومي العربي، بل وقامت بعرضه على الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية يومي 9 و10 مارس 2015..
وقد ذهب المسؤول العربي بعيدا لدرجة أنه أوجد للمقترح سندا قانونيا ومرجعية فكرية لخصها في كل من ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك بين الدول العربية المبرمة سنة 1950، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي، فضلا عن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى وجود قوات مماثلة لدى كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، من دون أن يشير إلى أن القوة الإفريقية غارقة في أوحال أزمة الصومال، التي هي أيضا أزمة عربية مستمرة منذ أزيد من 24 سنة تختلط فيها طموحات السلطة بأطماع الانفصال، وأن ما قيل عن قوة أخرى لمواجهة توسع جماعة بوكوحرام في نيجيريا وبعض أجزاء الكامرون ما يزال حبيس مشاورات الكواليس.
وبما أن المقترح المصري لم يتبلور بعد في خطوات عملية، ولا في إجراءات ميدانية، يغدو التساؤل مشروعا عن إمكانية رؤيته للنور، كما يغدو الإسهام في النقاش الدائر حوله مستساغا وربما مطلوبا، خاصة إذا انطلق من طبيعة المرجعية القانونية التي يراد إعطاؤها للموضوع، ومن التجارب الفعلية السابقة في الإطار العربي، ومن حقيقة العلاقات الثنائية والجماعية العربية ـ العربية كما هي على أرض الواقع، وليست كما في أوهام زيد أو أحلام عمرو.
إن مجرد التفكير في الاستناد على معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية لتبرير إنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة هو وأد للفكرة في مهدها، لأن هذه المعاهدة في حكم الملغاة من الناحية الواقعية، إذ لم تفعل على الإطلاق وأثبتت فشلها أو على الأقل قصور مقتضياتها في كل المحطات التي كان ينتظر منها أن تكون فعالة على الرغم من أنها محطات تنطبق عليها من الناحية القانونية الصرفة أحكام المادة 2 من المعاهدة التي تعتبر كل اعتداء على دولة متعاقدة أو اكثر أو على قواتها اعتداء عليها جميعا يستوجب اللجوء إلى حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي.
وبهذا المعنى كان ينتظر أن يتنادى العرب تلقائيا لتطبيق بنود المعاهدة في حالة العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956، وعلى احتلال إسرائيل لأراضي سورية ومصرية وأردنية بعد عدوان يونيو 1967، وعلى الاجتياح الإسرائيلي للبنان الذي وصل إلى العاصمة بيروت سنة 1982، ناهيك عن الغزو العراقي للكويت سنة 1990، والغزو الأمريكي للعراق سنة 2003، ولكن شيئا من ذلك لم يحصل إطلاقا. وفي كل هذه الحالات استنجد العرب بمجلس الأمن الدولي، الذي أشاروا في معاهدة الدفاع المشترك إلى ضرورة إخطاره بوقوع أي اعتداء وما اتخذ بصدده من تدابير وإجراءات (المادة 2 من المعاهدة).
لا شك إذن أن هذه الوقائع أثبتت عدم فعالية المعاهدة، إن لم نقل عدم جدواها من الأصل؛ الأمر الذي حذا بالعرب إلى أن ينسوا منذ زمن بعيد أن ملحق المعاهدة المذكورة ينص على تشكيل لجنة عسكرية دائمة لم تجتمع منذ أن انتهت حرب أكتوبر 1973، التي سجلت تضامنا عربيا لافتا تم في معظمه من خارج نطاق معاهدة الدفاع المشترك، وإنما في سياق انتعاشة العلاقات الثنائية بين بعض الدول آنذاك، وتنفيذا نسبيا لمقتضيات ميثاق التضامن العربي، الذي وافقت عليه القمة العربية الثالثة في الدار البيضاء سنة 1965.
والواقع أن مصيرا فاشلا كهذا كان منتظرا لهذه المعاهدة لأكثر من سبب:
- لم تكن المعاهدة وليدة تفكير هادئ وعميق بقدر ما كانت رد فعل للحرب العربية الإسرائيلية الأولى سنة 1948، التي كشفت ضعف القوات المسلحة العربية وهشاشتها وفساد أسلحتها، وانتهت إلى توسيع رقعة البقعة الأرضية الممنوحة للدولة اليهودية بموجب قرار التقسيم الأممي الصادر سنة 1947، وفرض هدنة على كافة الجبهات العربية.
- تزايدت مخاوف الدول العربية من بعضها البعض أكثر من مخاوفها من الأخطار الخارجية، وذلك نتيجة تباين المصالح والسياسات العربية، وانقسام العرب إبان الحرب الباردة بين محسوبين على المعسكر الغربي سموا رجعيين، وبين دائرين في فلك المعسكر الشرقي وصفوا أنفسهم بالتقدميين.
وقد تأججت تلك المخاوف من خلال العديد من الممارسات يمكن أن نذكر منها أطماع العراق المبكرة في الكويت التي ظهرت غداة إعلان استقلال هذه الأخيرة سنة 1961، وما اعتبرته السعودية تهديدا لحدودها مع اليمن بسبب تدخل الجيش المصري في الحرب الأهلية اليمنية سنة 1962، ودعم مصر أيضا للجزائر ضد المغرب في حرب الرمال سنة 1963.
- استحالة تحديد مفهوم مشترك لمقولة "الأمن القومي العربي" التي اختزلتها بعض الدول في التهديدات الإسرائيلية، ما صعب إيجاد تعريف مشترك لطبيعة الأخطار والتهديدات العسكرية والأمنية التي تفترض قيام عمل عربي مشترك.
ويروق للبعض في سياق الدعاية للمقترح الجديد الحديث عن قوات الردع العربية التي تشكلت سنة 1976 بأعداد وصلت إلى 30 ألف عسكري ساهمت سوريا فيها ب 25 ألف، وتوزع الباقي على كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والسودان واليمن الشمالي إضافة إلى لبنان، وذلك بغية العمل على وقف الحرب الأهلية اللبنانية، وأيضا عما يعتبره البعض نجاحا نسبيا لهذه القوات في وقف الاشتباك بين القوات اللبنانية والفصائل الفلسطينية المرابطة آنذاك في عدد من مناطق لبنان تنفيذا لاتفاقية القاهرة 1976، واتفاق شتورة المنبثق عنها سنة 1977.
وفي خضم التهليل الجاري لهذه الفكرة المقترحة، يتناسى هؤلاء أن الدولة اللبنانية نفسها رفضت التجديد لقوات الردع العربية سنة 1983، فانسحبت كل القوات العربية باستثناء القوات السورية التي كان عليها أن تنسحب في غضون سنتين بموجب اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، ولكنها لم تفعل وظلت سيدة القرار على الساحة اللبنانية إلى أن أجبرت على المغادرة قسرا بقرار مجلس الأمن الدولي 1559 سنة 2005 بعد الاتهامات السياسية التي وجهت لسوريا بتدبير اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
ورغم كل انتكاسات الماضي يعود الحديث من جديد وعلى أرفع المستويات عن تشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة لمحاربة هدف واحد هذه المرة تحت عنوان واسع وعريض هو الإرهاب، الذي فشلت الأمم المتحدة نفسها في وضع تعريف له جامع، مانع ومتفق عليه بين جميع الأعضاء. فأي إرهاب هذا الذي ستتم محاربته؟ وما هو شكل القوة العربية المشتركة هل هي دائمة أم مؤقتة؟ ما هو حجمها، وما هي مكوناتها وكيف سيتم التنسيق بين مدارسها التدريبية والتسليحية المختلفة؟ ولمن ستؤول قيادتها، وهل سيقبل الآخرون بتلك القيادة؟ وأين سترابط؟ ومن سيؤمن تمويلها وتموينها؟ وكيف يتخذ القرار في إطارها؟...إلخ.
هذه مجرد عينة من أسئلة عديدة مسترسلة تطرح في هذا السياق دون أن توجد أجوبة قطعية لها لحد الآن، وقد لا توجد في المدى المنظور أيضا. ولكن من المعلومات المتوفرة من أكثر من مصدر يمكن استخلاص إرهاصات لما يسعى البعض إلى طبخه في العتمة، وتوفير غطاء شرعية عربية له في القمة المقبلة.
تقول المعلومات إن هنالك شبه اتفاق بين عدد من الدول العربية على أن تكون نواة هذه القوة في البداية مجموعة من القوات الخاصة المحدودة العدد، وخلايا مخابراتية يتم زرعها إن لم تكن موجودة في مناطق النزاع الملتهبة حاليا مع داعش في كل من سوريا والعراق وليبيا، ومع القاعدة في اليمن، والسعي إلى التواجد في شمال مالي بتنسيق مع الجزائر والقوات الدولية المرابطة هناك، وخاصة القوات الفرنسية الأكثر نشاطا في المنطقة.
ومن المنتظر حسب المعلومات ذاتها أن تنطلق قريبا جدا مشاورات تشكيل مجلس دفاع مشترك جديد، سيعلن على أنه امتداد للمجلس الذي كان موجودا من قبل وأنهيت مهامه سنة 1981 بعد تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية، وذلك من أجل البدء بالخطوات العملية الأولى لتحديد أعداد القوات المطلوبة وطبيعتها والأهداف المرسومة لها، ونقاط انتشارها.
وبطبيعة الحال، فإن هذه المعلومات تستدعي مجموعة من الملاحظات، كما تثير العديد من التساؤلات التي تحتاج لتفسيرات، لاسيما وأن عددا محدودا من الدول العربية قد تحمس لخطوة كهذه. فالجزائر كانت سباقة عبر أقلام صحفية إلى إبداء رفضها من خلال اعتبار هذه القوة أداة لحماية المصالح الغربية، والتأكيد على أن الجيش الجزائري هو جيش الشعب وليس الحكام، وأن الدستور يمنعه من القيام بعمليات عسكرية عسكرية خارج التراب الجزائري (انظر عبد العالي رزاقي: قوة عسكرية عربية لحماية المصالح الغربية في جريدة الشروق الجزائرية ليوم 26/2/2015).
وفي ذات سياق الموقف الجزائري تجدر الإشارة إلى أن العراق عبر بمناسبة التحالف الدولي ضد داعش عن رفضه لأي قوات برية أجنبية على أراضيه، مكتفيا لحد الآن بقوات إيرانية متخفية فيما يسمى بقوات الحشد الشعبي، وبخبراء أمريكيين يرتكز وجودهم على الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين البلدين في أعقاب الانسحاب الأمريكي العسكري من الأراضي العراقية. فمن أين ستنطلق تلك القوات إذا أرادت مثلا محاربة داعش على الأرض؟ ليس أمامها سوى دخول الأراضي السورية عبر الحدود الأردنية، ما يعني إمكانية الاصطدام بالقوات السورية النظامية وحلفائها من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني والكتائب الشيعية العراقية. فهل بالإمكان تحمل التبعات السياسية لاصطدام كهذا مع ما قد يعنيه من خلق بؤر ميدانية جديدة لمناطق احتكاك أخرى مع إيران؟
وتبقى أكبر الملاحظات على ما يروج من معلومات هي:
- أولا استثناء شبه جزيرة سيناء من تواجد ونشاط القوة العربية المشتركة المزمع إنشاؤها، وذلك رغم التحدي الأمني الكبير الذي تعيشه مصر هناك، حيث تتمركز جماعة أنصار بيت المقدس، التي بايعت خليفة داعش. والسبب فيما يبدو يعود إلى القيود المفروضة على الانتشار العسكري المصري نفسه في سيناء بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، التي تؤمن مراقبة تنفيذها قوات دولية. ومن المؤكد أن إسرائيل رغم استفادتها الحتمية من أي حرب محتملة على الجماعات المتشددة والإرهابية المنتشرة في سيناء لن تسمح بوجود قوات عربية على مرمى من حدودها.
- أما الملاحظة الثانية فتتعلق بهدف التحرك الجديد وهو الإرهاب. فإذا اقتصر دور القوات العربية المشتركة كما يتسرب على محاربة داعش واستطرادا القاعدة، فإن ذلك ربما لن يكون كافيا لبعض الدول العربية الأخرى، التي تضع على لائحة التنظيمات الإرهابية جماعات مسلحة أخرى كما هو الشأن بالنسبة للبحرين مثلا إزاء حزب الله اللبناني، ومصر إزاء حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام، وكل من مصر والسعودية والإمارات إزاء جماعة الإخوان المسلمين. فكيف سيكون تصرف هذه القوات إذا طلب منها التدخل لمواجهة تلك التنظيمات؟ الأكيد أن مسعى كهذا ولو أنه افتراضي لحد الساعة، سيزيد من حدة الاستقطابات داخل النظام الإقليمي العربي أكثر فأكثر.
والواضح من خلال الحماسة التي أثارها هذا الاقتراح أن الجميع تناسى تجربة إعلان دمشق الذي تشكل في فورة تحرير الكويت سنة 1991، والذي تلاشى واندثر مع الوقت لعدم الرغبة في تفعيل شقه العسكري، خاصة من دول الخليج التي لم تتمكن بعد عشرات السنين من تطوير قوات درع الجزيرة وجعلها نواة صلبة لقوات خليجية مشتركة رغم كل عوامل التقارب القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تجلت محدودية تلك القوات في الاكتفاء بعناصر من السعودية والإمارات فقط للمساهمة في استقرار الأمن بالبحرين في أعقاب ما شهدته هذه الأخيرة من اضطرابات.
ولعل هذه المحدودية التي كانت متوقعة من البداية والناجمة أساسا عن حساسيات في العلاقات داخل هذا المنتدى المغلق هي التي حدت بالدول الخليجية منفردة إلى الاستعاضة في تأمين حمايتها بإبرام تحالفات واتفاقيات مع القوى الدولية الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تواجد عسكري دائم في قواعد باتت أشهر من نار على علم كقاعدة العديد في قطر، ومقر الأسطول الأمريكي الخامس في قاعدة الجفير بالبحرين.
ومع ذلك، فإنه لا يجوز، إذا كان السعي العربي جادا في دخول هذه التجربة، التغاضي عن تحليل مآل العديد من التجارب على الصعيد الدولي في محاربة الإرهاب وادعاء اجتثاثه بالقوة العسكرية وحدها. فقد أثبتت وقائع هذه التجارب وتطوراتها فشلا ذريعا يمكن رصده في:
- اضطرار القوات الأمريكية في منتصف التسعينات إلى الانسحاب من الصومال الذي ذهبت إليه بغطاء أممي كي تزرع الأمل فيه، وتنتشله من حرب أهلية ما تزال متواصلة لحد الآن.
- بعد أزيد من عشر سنوات من القتال في أفغانستان لاستئصال "ورم" طالبان وجدت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من الحلف الأطلسي أنفسهم مجبرين على المغادرة، والورم لا يزال حيا ونشطا، ومصمما على استعادة السلطة في كابول.
- نفس المصير لقيته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في العراق، حيث بدل القضاء على حليف للإرهاب كما ادعت على نظام صدام حسين، أوجدت بيئة مواتية لتفريخ جماعات إرهابية أخرى، وجاذبة لكل الناقمين على أمريكا وحلفائها في الغرب والمنطقة، الراغبين في خوض هذا النوع من المغامرة. أو ليست داعش امتداد لجماعة أبو مصعب الزرقاوي.
في ضوء هذه المعطيات حري بالذين يتصدرون المشهد الإعلامي في محاربة الإرهاب أن يتمعنوا في التاريخ قليلا، وأيضا فيما قاله رئيس الحكومة الفرنسية مؤخرا عن معلومات تشير إلى إمكانية أن يصل عدد المتطوعين الأوروبيين وحدهم في الجماعات الإرهابية بسوريا إلى حوالي عشرة آلاف شاب وشابة في متم سنة 2015، ليدركوا أن المواجهة العسكرية والأمنية مع الإرهاب غير كافية ما لم تعالج أسباب الارتماء في أحضانه، والدوافع التي تقود مناطق شاسعة وجماعات بشرية كبيرة إلى توفير بيئة حاضنة له.
لقد كاد الفقر أن يكون كفرا، فما بالك إذا اقترن الفقر بالتهميش والإقصاء وسوء توزيع الثروة وانعدام العدالة ، وشيوع الفساد والاستبداد والغي في إهدار الكرامة الإنسانية.