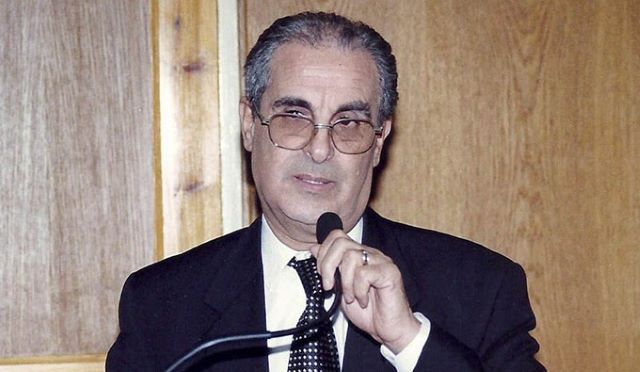إن إدراج طنجة ضمن شبكة المدن المبدعة في مجال الأدب، وفق تصنيف اليونسكو، هو تكريم لذاكرة مدينة لا تموت، ولعرق وحبر كتّابها العظماء. لكن هذا الإنجاز التاريخي تحوّل، بفضل خطابات العمدة المصوّرة، إلى مجرد وسام سياسي يُعلّق على جدار إهمال ثقافي مزمن. التصنيف، رغم أهميته الرمزية والدولية، لا يمكن أن يُقرأ كـ "منجز إداري" بمعزل عن الواقع اليومي للمبدعين والأدباء. فبينما يتبجح البعض بـ "مشروع مؤسساتي متكامل"، تظل المدينة الحقيقية للأدب خارج المشهد الإداري والسياسي تمامًا. وهذا الإعلان يفتح الباب ليس للاحتفال، بل للمساءلة الجادة: هل سنحوّل هذا الرمز إلى فعل، أم سنكتفي بتلميعه؟
البنيات الثقافية موجودة ولكن..
ليست طنجة فقيرة من حيث البنى الثقافية؛ فالمراكز والقاعات ودور الشباب والمسارح قائمة على أرض الواقع، ويمكن لأي متابع أن يلمس وجودها. من القاعات الجديدة سواء التابعة لوزارة الثقافة أو وزارة الشبيبة والرياضة أو إلى المراكز المحلية، وهي عديدة. إنها فضاءات يمكن أن تكون منطلقًا للإبداع لو تم تدبيرها بالشكل الصحيح. لكن ما يثير القلق هو أن وجود الحجر وحده لا يضمن إنتاج الثقافة، فالمعضلة الحقيقية تكمن في إفلاس السياسات الثقافية وإخفاق الإدارة في تفعيل هذه الموارد بشكل فعّال ومستدام.
ما زالت الإدارة، بأسلوبها التقليدي، أسيرة المحسوبية والزبونية، وتتحكم في الموارد الثقافية بطريقة تحولها إلى واجهات بصرية للاحتفالات الرسمية أو البرامج الموسمية التي تُرضي الإعلام وتثير الانبهار اللحظي، لكنها لا تسهم في بناء قاعدة إنتاج ثقافي حقيقي. الفضاءات التي يمكن أن تكون مختبرات للإبداع تصبح بذلك مجرد ديكور يُستغل في مناسبات معينة دون أن تُترك حرية الحركة للفاعلين الثقافيين المحليين. وهكذا، تظهر بوضوح أن الكفاءة والإنتاجية الثقافية الفعلية تُهمّش لصالح من يُوظّفون لإضفاء صورة مؤقتة للثقافة، بينما يظل الكتّاب والمبدعون الحقيقيون بعيدين عن الموارد والفرص التي يحتاجونها للإنتاج والتواصل مع جمهورهم.
إن غياب السياسات المستدامة لا يضر فقط بالمبدعين، بل يحد من قدرة المدينة على إنتاج جيل جديد من القرّاء والمثقفين، ويخلق فجوة بين تاريخ طنجة الأدبي الزاخر وإمكاناتها الحالية، مما يضع المدينة أمام معضلة حقيقية: كيف يمكن لطنجة أن تحافظ على مكانتها كعاصمة ثقافية إذا ظل الإبداع مجرد ديكور مؤقت؟
التمويل والثقافة: المفارقة المذهلة
من الظواهر اللافتة والمثيرة للقلق في المشهد الثقافي المحلي أن الميزانيات المخصصة للثقافة غالبًا ما تُوجّه إلى المهراجانات البراقة يستفيد منها النجوم من خارج المدينة، يتم إحضارهم لمهرجانات أو حفلات تكتفي بوجودهم لخلق صورة إعلامية مؤقتة تتلاشى بمجرد انتهاء الحدث. أما الأجور التي تُدفع لهؤلاء الفنانين، في ساعات قليلة، قد تكفي لطباعة أعمال كاملة للكتّاب المحليين أو لتمويل برامج ثقافية مستدامة تمتد على أشهر وسنوات، لكنها تُستهلك في لحظاتٍ عابرة لا تترك أثرًا طويل المدى. هذه الممارسة ليست مجرد قصور إداري، بل إلغاء فعلي للأدوار الإنتاجية للأدباء والمبدعين المحليين، الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين محدودية الموارد وغياب الاعتراف الرسمي، محولين إلى قطع ديكور في مشهد موسمي مؤقت، دون أن تتاح لهم الفرصة للإنتاج المستمر أو التفاعل الحقيقي مع جمهورهم. والحقيقة المرة أن الأدب والثقافة لا يُنتجان بالضجيج الإعلامي ولا بالصور البراقة، ولا بالاحتفالات التي تختزل الفن في حدث واحد. الإبداع يحتاج إلى الوقت والفضاء والدعم المستمر، وإلى منظومة تمكن الكاتب والمبدع من المتابعة والتجريب والاتصال المباشر بالقراء، بحيث تتحول الفكرة إلى نص، والفكر إلى إنتاج ملموس، والفنان إلى عنصر فاعل في بناء مجتمع ثقافي حيّ ومستدام.
وعندما يُحرم الكتّاب والمبدعون المحليون من هذا الدعم، لا يختفي فقط الإبداع، بل تتضرر المدينة بأكملها، لأن الثقافة الحية التي تُنتج محليًا هي التي تغذي الهويات، وتخلق الفضاء العام للنقاش، وتبني ذاكرة حية مرتبطة بالمكان، بينما الاحتفالات العابرة تصنع صورًا فارغة لا تغني المشهد ولا تثري تجربة الجمهور.
مقترح رؤية استراتيجية لإعادة التألق
لتحويل التصنيف الرمزي إلى فعل ملموس، يجب اعتماد برنامج ثقافي متكامل يغطي كل مستويات المشهد الثقافي. يبدأ ذلك بإرساء حوكمة ثقافية شفافة، عبر إنشاء مجلس ثقافي استشاري يضم كتّابًا وفنانين وممثلين عن المجتمع المدني دون إقصاء، ليشاركوا في وضع الاستراتيجيات وتقييم الأداء. كما ينبغي اعتماد ميثاق ثقافي محلي يحدد الأولويات وسبل التمويل وتوزيع الفرص، ونشر تقارير دورية عن تنفيذ المشاريع وأثرها، ليصبح المواطن والمتابع قادرين على معرفة أين ذهبت الموارد وما هي نتائجها.
يدعم هذا التوجه إنشاء صندوق دائم للإبداع والنشر المحلي، يغطي تكاليف الطباعة، والترجمة، والتنقيب في أرشيف طنجة الأدبي، وإطلاق بيت الأدب الطنجاوي كمؤسسة دائمة تحتضن الكتّاب والمبدعين، وتستضيف ورشات قراءة ولقاءات، وتوثق تاريخ الأدب المحلي. كما ينبغي تنظيم إقامات أدبية للكتّاب المحليين والأجانب لتشجيع التبادل الفكري وخلق إنتاج جديد مرتبط بالمدينة، وربط المدارس بهذه البرامج عبر ورشات أسبوعية لتعليم الأدب وفنون الكتابة للناشئة وربط الجيل الجديد بتاريخ طنجة الأدبي.
من جهة أخرى، يجب تحويل المراكز الثقافية إلى فضاءات مفتوحة للنقاش والإبداع، ليست محصورة في الاحتفالات أو الفعاليات الرسمية، وإنشاء منصة رقمية رسمية توثق كل الإنتاجات، وتنشر الأخبار والفعاليات، وتتيح فرص التواصل بين القراء والمبدعين، مع توسيع الفعاليات لتصل إلى الأحياء المهمشة، بما يضمن أن الثقافة ليست حكرًا على مراكز المدينة، بل حقًا للجميع.
ولا يكتمل هذا البرنامج إلا بإرساء العدالة الثقافية وتثمين التراث، عبر إطلاق مشاريع وثائقية لتوثيق أرشيف الأدب المحلي، وإقامة جوائز سنوية للأدب الطنجاوي في الشعر والقصة والمسرح، مع ضمان مشاركة حقيقية للجيل الصاعد، ودعم مشاريع بحثية حول تاريخ المدينة وهويتها الثقافية، وإصدار مطبوعات تعكس هذا الإرث.
من الرمزية إلى الفعل
تصنيف طنجة كمدينة مبدعة في الأدب يجب أن يكون منطلقًا وليس غاية. البداية تكون بإعادة الاعتبار للكتّاب والمبدعين، بإرساء حوكمة شفافة، وبإطلاق برامج مستدامة تدعم الإنتاج الثقافي المحلي. الثقافة ليست شعارًا يُرفع في المناسبات ولا جوائز تُمنح مؤقتًا، بل ممارسة يومية مستمرة تعيد للمدينة روحها وإشعاعها التاريخي.
طنجة، التي ألهمت أعظم الأدباء والفنانين عبر العصور، تستحق أن يكون الأدب حاضرًا فيها ليس فقط في التصنيفات الدولية أو الصور الإعلامية، بل في المكتبات، في القاعات، في الشوارع، وفي قلوب من يكتبون ويقرأون فيها كل يوم.