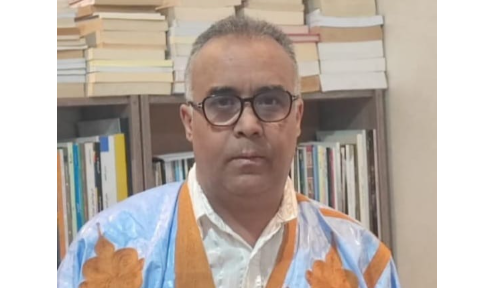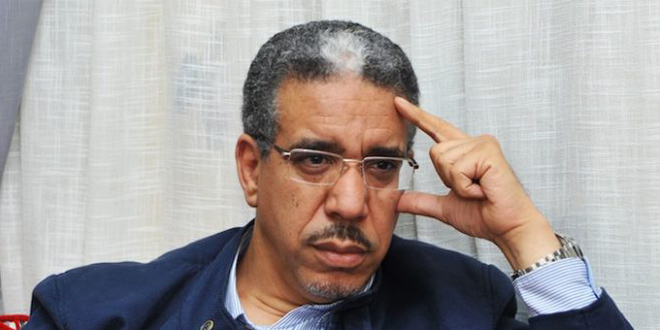تمهيد منهجي
تهدف هذه الدراسة إلى فهم التحولات الجذرية في أشكال الاحتجاج والتعبير السياسي التي يقودها جيل Z على الصعيد العالمي، مع التركيز على التجربة المغربية الحديثة. نعتمد في تحليلنا على المقاربة النظرية لكلاي شيركي حول "التنظيم بلا مؤسسات" كما طورها في كتابه الرائد "Here Comes Everybody" سنة 2008، مع الاستئناس بأعمال مانويل كاستيلز حول "شبكات الغضب والأمل" وديفيد هارفي حول أزمة الرأسمالية النيوليبرالية.
المحور الأول: التأسيس النظري لمفهوم "الثورة بلا قيادات"
في كتابه الذي صدر قبل عقد ونصف من الزمن، تنبأ كلاي شيركي بظهور أشكال جديدة من التنظيم الاجتماعي تتجاوز الهياكل الهرمية التقليدية، مدفوعة بثورة الاتصالات الرقمية. حدد شيركي ثلاثة تحولات جوهرية في طبيعة التنظيم الاجتماعي المعاصر.
أولا، انهيار الحواجز التقليدية للتنظيم، حيث لم تعد الحاجة قائمة لبنية مؤسسية معقدة أو رأسمال اجتماعي كبير لتجميع الأفراد حول قضية مشتركة. التكنولوجيا الرقمية خفضت تكلفة التنسيق والتنظيم إلى درجة تجعل من الممكن لأي مجموعة صغيرة أن تصل إلى جماهير واسعة وتحشدها للعمل المشترك.
ثانيا، بروز ما أطلق عليه "الذكاء الجماعي" كبديل عن القيادة الفردية الكاريزمية. في النموذج الجديد، تصبح القرارات نتاج تفاعل الجماهير وتراكم مساهماتهم الفردية، أكثر من كونها إملاءات نخبوية من أعلى إلى أسفل. هذا التحول يخلق ديناميكية جديدة تماما في اتخاذ القرار الجماعي.
ثالثا، السرعة الفائقة في التعبئة والاستجابة، حيث يصبح بالإمكان تنظيم حدث جماهيري في ساعات قليلة، مما يجعل الأنظمة التقليدية عاجزة عن مواكبة إيقاع التغيير. هذه السرعة تخلق عنصر المفاجأة الذي يصعب على السلطات التقليدية التعامل معه.
هذه التنبؤات النظرية التي بدت مجردة في 2008، تتجسد اليوم بوضوح مذهل في كل حراك شبابي نشهده، من احتجاجات هونغ كونغ إلى حراك الجزائر، ومن "السترات الصفراء" في فرنسا إلى الاحتجاجات الأخيرة في المغرب.
المحور الثاني: الجذور الاقتصادية للغضب الجيلي
لفهم الدوافع العميقة وراء احتجاجات جيل Z، لا بد من العودة إلى السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي تشكل فيه هذا الجيل. جيل Z هو في جوهره نتاج مباشر لأزمة النظام الرأسمالي النيوليبرالي التي انفجرت عام 2008 واستمرت تداعياتها حتى اليوم.
الأزمة المالية العالمية لعام 2008 لم تكن مجرد انهيار مؤقت في الأسواق، بل كشفت عن تناقضات بنيوية عميقة في النموذج الاقتصادي السائد. كما يوضح ديفيد هارفي في كتابه "لغز رأس المال" 2011، فإن السياسات النيوليبرالية التي هيمنت منذ الثمانينات خلقت تراكما هائلا للثروة في يد النخب، مقابل تفقير متزايد للطبقات الوسطى والشعبية.
بالنسبة لجيل Z، الذي ولد في عقد التسعينات أو بداية الألفية الثانية، فإن هذه الأزمة ليست حدثا طارئا بل الوضع "الطبيعي" الذي نشأ فيه. هذا الجيل لم يعش تجربة الازدهار الاقتصادي التي شهدتها الأجيال السابقة، بل نشأ في زمن التقشف والخصخصة وتراجع الخدمات العامة وهشاشة سوق العمل.
جوزيف ستيغليتز في كتابه "الناس والقوة والأرباح" 2019 يفسر كيف أن هذا النموذج الاقتصادي خلق "جيلا محروما" يجد نفسه أمام خيارات أسوأ من تلك المتاحة لآبائه، رغم ارتفاع مستوى التعليم والوعي. هذا التناقض بين الوعود والواقع غذى إحساسا عميقا بالظلم والإحباط تجاه النظام القائم.
في السياق المغربي، تتجلى هذه الأزمة في تراجع جودة التعليم العمومي، وانهيار منظومة الصحة، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب المتعلم، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. الوعود الإصلاحية التي رافقت دستور 2011 لم تترجم إلى تحسن ملموس في ظروف عيش هذا الجيل، مما خلق إحساسا عميقا بالخذلان السياسي.
المحور الثالث: دروس الربيع العربي وإجهاض الإصلاحات السياسية
عقد ونصف مر على اندلاع الربيع العربي، وحان الوقت لتقييم نقدي للتجربة ودروسها بالنسبة لجيل Z الحالي. التجارب العربية الأربع الكبرى تقدم لنا دروسا مهمة حول حدود الثورات التقليدية وإمكانيات الالتفاف عليها.
في المغرب، جاء دستور 2011 كاستجابة استباقية لموجة الربيع العربي، ووعد بإصلاحات جوهرية في منظومة الحكم. النص الدستوري تضمن مبادئ متقدمة حول الديمقراطية والحكامة والعدالة الاجتماعية، لكن التطبيق الفعلي كان أقل بكثير من هذه الطموحات. المجالس المنتخبة ظلت هامشية في اتخاذ القرارات المهمة، والفوارق الاجتماعية تفاقمت بدلا من أن تتراجع، والشباب وجد نفسه مهمشا في العملية السياسية رغم كونه القوة الرئيسية وراء حراك 20 فبراير.
التجربة الجزائرية تقدم نموذجا آخر للالتفاف على مطالب التغيير. حراك 2019 الذي أطاح بعبد العزيز بوتفليقة كان يحمل شعارات راديكالية حول "تغيير النظام وليس الوجوه". لكن النظام استطاع إعادة إنتاج نفسه بوجوه جديدة دون تغيير جوهري في آليات الحكم أو البنية الاقتصادية. النتيجة كانت إحباطا عميقا خاصة بين الشباب الذي قاد الحراك وضحى من أجله.
تونس، التي كانت تُعتبر النموذج "الناجح" للربيع العربي، شهدت انهيارا كاملا للتجربة الديمقراطية مع انقلاب قيس سعيد الدستوري في يوليو 2021. هذا الانهيار جاء بعد عقد من عدم الاستقرار السياسي والتدهور الاقتصادي، مما أفقد التونسيين الثقة في النموذج الديمقراطي ذاته.
مصر قدمت النموذج الأكثر قسوة في التراجع عن مكاسب الثورة. الثورة المضادة التي قادها عبد الفتاح السيسي لم تكتف بإعادة النظام السلطوي، بل جعلته أكثر قمعا وعسكرة من نظام حسني مبارك. القمع الوحشي الذي تعرض له الإخوان المسلمون امتد ليشمل كل أشكال المعارضة والاحتجاج السلمي.
هذه التجارب المريرة علمت جيل Z درسا مهما مفاده أن الثورات التقليدية القائمة على الحشد الجماهيري والقيادات الكاريزمية يمكن أن تُجهض أو يُلتف عليها بسهولة نسبية. الأنظمة تعلمت كيف تتعامل مع هذا النوع من التحديات عبر مزيج من القمع والاحتواء والمناورة السياسية. لكن الثورة الرقمية اللامركزية تطرح تحديات من نوع مختلف، أصعب في السيطرة عليها أو التنبؤ بتطوراتها.
المحور الرابع: تجارب مقارنة حديثة - فرنسا ونيبال نموذجا
لفهم السياق العالمي الذي تندرج فيه الاحتجاجات المغربية، من المهم تحليل تجربتين حديثتين تجسدان بوضوح خصائص "الثورة بلا قيادات" في سياقين مختلفين تماما.
التجربة الفرنسية في شتنبر 2025
شهدت فرنسا في شتنبر 2025 موجة احتجاجات استثنائية تحت شعار "Bloquons Tout" أي "لنوقف كل شيء". هذه الحركة دعت المواطنين لمقاطعة شاملة للعمل والتسوق والأنشطة الاقتصادية، مع "الاحتلال السلمي للمواقع الرمزية" في المدن الفرنسية الكبرى.
النتيجة كانت مذهلة من ناحية الحشد. يوم 10 سبتمبر خرج 200 ألف متظاهر حسب وزارة الداخلية، وصل العدد إلى 250 ألف حسب نقابة العمال الجنرالية. تم اعتقال 473 شخصا، ونُشر 80 ألف شرطي لمواجهة الاضطرابات. في 18 سبتمبر، شهدت البلاد تظاهرة أكبر شارك فيها بين 600 ألف و900 ألف شخص، حسب تقديرات مختلفة.
لكن ما ميز هذه الاحتجاجات لم يكن حجمها فقط، بل طبيعتها اللامركزية. لم تكن هناك قيادة واحدة أو برنامج سياسي محدد، بل تحالف عضوي بين غضب تقليدي للنقابات ضد إصلاحات العمل، وغضب جديد لجيل Z ضد أزمة المناخ والفوارق الاجتماعية. شعار "لنوقف كل شيء" كان تعبيرا عن رفض شامل للنظام الاقتصادي والسياسي القائم أكثر من كونه مطالبة بإصلاحات محددة.
هذا الطابع اللامركزي كان نقطة قوة ونقطة ضعف في آن واحد. من جهة، جعل من الصعب على السلطات قمع الحراك أو احتواءه عبر التفاوض مع قيادات محددة. من جهة أخرى، غياب قيادة واضحة جعل من الصعب ترجمة القوة الشعبية إلى مكاسب سياسية ملموسة. الحكومة الفرنسية استطاعت في النهاية تجاوز الأزمة دون تقديم تنازلات جوهرية، بانتظار تبدد الزخم الشعبي تلقائيا.
التجربة النيبالية: ثورة Discord
إذا كانت التجربة الفرنسية تُظهر حدود الحراك اللامركزي، فإن التجربة النيبالية في سبتمبر 2025 تقدم نموذجا مغايرا تماما يكاد يكون ثوريا في تاريخ الاحتجاجات العالمية.
بدأت الأحداث عندما قررت الحكومة النيبالية حظر 26 منصة تواصل اجتماعي، من فيسبوك ويوتيوب إلى واتساب وDiscord، بحجة عدم الامتثال لقواعد التسجيل الجديدة. هذا القرار أثار غضب جيل Z النيبالي الذي يعتمد كليا على هذه المنصات للتواصل والتعبير.
رد الفعل كان سريعا وذكيا. الشباب تحولوا إلى منصة Discord، وهي في الأصل تطبيق مخصص للألعاب الإلكترونية، لتنظيم أكبر انتفاضة في تاريخ نيبال الحديث. مجموعة "Hami Nepal" التي تديرها منظمة شبابية محلية، استطاعت جمع أكثر من 160 ألف عضو في وقت قياسي.
ما حدث في كاتماندو بين 8 و10 شتنبر كان استثنائيا بكل المقاييس. عشرات الآلاف من الشباب خرجوا للشوارع في احتجاجات ضد الفساد والسلطوية، في مواجهات دموية مع الشرطة أدت لسقوط 61 قتيلا وإحراق المحكمة العليا والبرلمان. الحراك أجبر رئيس الوزراء على الاستقالة وأدخل البلاد في فراغ سياسي كامل.
لكن الأهم والأكثر إثارة كان ما حدث مساء 10 سبتمبر على منصة Discord. بينما كانت الفوضى تهدد بابتلاع البلاد، نظم 7586 شابا نيباليا تصويتا رقميا لاختيار رئيس وزراء مؤقت عبر قناة "الشباب ضد الفساد". العملية تمت بشفافية كاملة ومشاركة واسعة، وأفرزت فوز سوشيلا كاركي، القاضية المتقاعدة البالغة من العمر 69 عاما، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ نيبال.
هذه التجربة أذهلت العالم وأثارت جدلا واسعا حول مشروعيتها الدستورية. الأحزاب التقليدية رفضت الاعتراف بنتائج "انتخابات غير دستورية" على منصة ألعاب، لكن الشارع النيبالي ساند التجربة واعتبرها نموذجا للديمقراطية المباشرة في عصر الرقمنة.
للمرة الأولى في التاريخ، تم اختيار رئيس حكومة عبر تصويت رقمي على منصة Discord. هذا الحدث يطرح أسئلة عميقة حول مستقبل الممارسة الديمقراطية وإمكانيات الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير آليات جديدة للمشاركة السياسية.
المحور الخامس: الحالة المغربية في السياق العالمي
في هذا السياق العالمي المتوهج، تندرج الاحتجاجات الشبابية المغربية الأخيرة كحلقة في سلسلة عالمية من حراك جيل Z اللامركزي. لكن الحالة المغربية تتميز بخصائص محلية تستحق التحليل المعمق.
أولا، الطابع العفوي والمفاجئ للحراك. كما في التجارب الفرنسية والنيبالية، جاءت الاحتجاجات المغربية دون مقدمات تنظيمية تقليدية. لا توجد أحزاب سياسية وراء هذا الحراك، ولا نقابات، ولا منظمات مجتمع مدني معروفة. الشباب المغربي استخدم الصفحات المغلقة على فيسبوك وتطبيقات التراسل الفوري مثل Discord وTelegram لتجميع الطاقة الاحتجاجية، مما جعل حتى الأجهزة الأمنية تتفاجأ بالزخم المحقق.
ثانيا، اللامركزية التنظيمية المذهلة. على عكس الاحتجاجات التقليدية في المغرب التي كانت تنطلق عادة من الرباط أو الدار البيضاء ثم تنتشر، شهدنا هذه المرة حراكا متزامنا في خمس مدن على الأقل دون تنسيق مركزي ظاهر. هذا يعكس منطق الشبكات اللامركزية الذي تحدث عنه شيركي، والذي يصعب السيطرة عليه أو التفاوض معه بالأساليب التقليدية.
ثالثا، الهوية الرقمية العابرة للحدود. الشباب المغربي المحتج يعرّف نفسه أولا كجزء من جيل Z العالمي، قبل أن يعرّف نفسه كمغربي من مدينة معينة أو منطقة محددة. هذا الانتماء العابر للحدود يفسر المطالب "الكونية" التي يرفعها، مثل الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية وجودة الحياة، وهي مطالب يرفعها أقرانه في باريس وكاتماندو وساو باولو ولندن.
رابعا، التفاعل البراغماتي مع السلطة. بخلاف النموذج النيبالي الذي أطاح بالحكومة، أو الفرنسي الذي واجه السلطة بحدة، يبدو الحراك المغربي أكثر براغماتية وأقل راديكالية في خطابه وممارساته. هذا قد يفتح مجالا للحوار والاستيعاب، لكنه قد يعكس أيضا قيودا بنيوية في البيئة السياسية المغربية تحد من إمكانيات التصعيد.
خامسا، استخدام نفس الأدوات الرقمية العالمية. المنصات المستخدمة في التنظيم والتعبئة هي ذاتها التي استخدمها الشباب في فرنسا ونيبال، مما يؤكد الطابع العالمي لهذه الظاهرة ووحدة الأساليب المعتمدة رغم اختلاف السياقات المحلية.
المحور السادس: تحديات وحدود جيل Z
رغم القوة التعبوية المذهلة التي يُظهرها جيل Z، إلا أن هذا الجيل يواجه تحديات جوهرية تحد من فعاليته السياسية طويلة المدى.
التحدي الأول هو عدم التجانس الداخلي. جيل Z ليس كتلة واحدة متماسكة، بل يضم فئات متنوعة ومتناقضة أحيانا. هناك النشطاء الرقميون الملتزمون سياسيا، وهناك الغالبية الصامتة من غير المهتمين بالسياسة، وهناك أيضا الفئات المحافظة التي قد تقف ضد التغيير الراديكالي. هذا التنوع يجعل من الصعب الحديث عن موقف موحد أو استراتيجية متماسكة.
التحدي الثاني هو غياب مشروع سياسي مؤسسي واضح. القوة الهدامة لجيل Z واضحة وفعالة، لكن القدرة على البناء والإنتاج السياسي لا تزال محدودة. الشباب يعرف بوضوح ما يرفضه، لكنه أقل وضوحا فيما يريده بدقة، وأقل خبرة في كيفية ترجمة المطالب إلى سياسات قابلة للتطبيق.
التحدي الثالث هو قابلية التلاعب والاختراق. الاعتماد الكلي على المنصات الرقمية يجعل هذا الحراك عرضة للتلاعب من قبل أطراف خارجية أو داخلية تتقن استخدام هذه الأدوات لتوجيه الرأي العام أو زرع الفتنة. الجيوش الإلكترونية والمزارع الرقمية أصبحت أدوات معتادة لدى الدول والشركات للتأثير على الحراك الشبابي.
التحدي الرابع هو استدامة الطاقة الاحتجاجية. الحماس العفوي قوي لكنه قصير المدى في الغالب. بدون بنية تنظيمية مستدامة، تميل هذه الحركات للتبدد سريعا عند مواجهة أول عقبة جدية أو عند تحقيق مكسب جزئي يُشعر المشاركين بالرضا المؤقت.
المحور السابع: استراتيجيات الدولة في المواجهة الرقمية
من الجانب الآخر، الدولة المغربية لم تبق مكتوفة الأيدي أمام هذا التطور، بل طورت استراتيجيات جديدة للتعامل مع التحدي الرقمي.
أولا، التشديد التشريعي. تم تعديل قوانين الجرائم الإلكترونية لتشمل أشكالا جديدة من "التحريض" و"المس بأمن الدولة" عبر المنصات الرقمية، مما يوسع هامش المناورة القانونية للسلطات في التعامل مع النشطاء الرقميين.
ثانيا، تطوير القدرات التقنية للمراقبة. الاستثمار في تقنيات متقدمة لمراقبة المنصات الرقمية وتتبع النشطاء، بما يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتوقع الحراك قبل حدوثه.
ثالثا، نشر الجيوش الإلكترونية. إنشاء وحدات متخصصة في التأثير على الرأي العام الرقمي عبر نشر محتوى مضاد أو تشويش على رسائل الحراك الاحتجاجي، بما يشمل استخدام حسابات وهمية وبوتات.
رابعا، الاحتواء الذكي. تطوير قنوات حوار رقمية مع الشباب، وإشراك بعض الوجوه الشبابية في مناصب حكومية، واستخدام لغة وأدوات تواصل تتماشى مع ثقافة جيل Z.
المحور الثامن: التوصيات الاستراتيجية
بناء على هذا التحليل المعمق، يمكن تقديم توصيات على مستويات مختلفة للتعامل الإيجابي مع ظاهرة حراك جيل Z.
على المستوى السياسي، يُنصح بإنشاء آليات مؤسسية جديدة للحوار والمشاركة تتجاوز القنوات التقليدية. هذا يتطلب تطوير منصات رقمية حكومية تتيح المشاركة المباشرة في صنع القرار، على غرار تجارب الديمقراطية التشاركية في دول مثل إستونيا وفنلندا.
على المستوى التعليمي، من الضروري إعادة النظر في المناهج والأساليب التعليمية لتتماشى مع عقلية جيل Z وتطوير قدراته على التفكير النقدي والمشاركة البناءة، بدلا من التلقين السلبي الذي يغذي الإحباط والتمرد.
على المستوى الاقتصادي، يتطلب الأمر سياسات جديدة تركز على خلق فرص عمل نوعية للشباب المتعلم، وتطوير الاقتصاد الرقمي الذي يتماشى مع مهارات وتطلعات هذا الجيل.
على المستوى الإعلامي، من المهم تطوير قنوات إعلامية تتحدث بلغة جيل Z وتفهم اهتماماته وطرق تفكيره، بدلا من الاعتماد على الخطاب الإعلامي التقليدي الذي لم يعد يصل إلى هذا الجيل.
خاتمة: نحو عقد اجتماعي رقمي جديد
ما نشهده اليوم في المغرب والعالم ليس مجرد موجة احتجاجات عابرة، بل إرهاصات تحول جذري في طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. جيل Z يطرح تحديا وجوديا على الأنظمة السياسية التقليدية، لأنه لا يقبل الخضوع للسلطة لمجرد أنها سلطة، بل يطالب بالمشاركة الفعلية والمستمرة في صنع القرارات التي تخص مستقبله.
هذا الجيل، الذي ولد في عصر الرقمنة، يرى أن الديمقراطية التمثيلية التقليدية قديمة وبطيئة وغير فعالة في مواجهة تحديات العصر. يريد ديمقراطية مشاركة أكثر مباشرة وشفافية، ديمقراطية تستفيد من إمكانيات التكنولوجيا للوصول إلى قرارات أسرع وأكثر عدالة.
التحدي الأساسي ليس كيفية إيقاف هذا التطور أو مقاومته، بل كيفية فهمه وتوجيهه نحو بناء نظام سياسي أكثر عدالة وفعالية. النفق المظلم الذي حذر منه التحليل الأولي لهذه الظاهرة ليس مصيرا حتميا، بل تحذير من مخاطر عدم التكيف الذكي مع التحولات الجيلية الجارية.
المستقبل للأنظمة السياسية التي تفهم أن الشرعية في القرن الحادي والعشرين لا تأتي من صناديق الاقتراع وحدها، بل من المشاركة الفعلية والمستمرة للمواطنين في صنع مستقبلهم. جيل Z يقدم لنا فرصة تاريخية لبناء ديمقراطية حقيقية تتجاوز حدود الديمقراطية الشكلية التقليدية. الأمر متروك للقيادات السياسية لاغتنام هذه الفرصة أم تفويتها، مع كل ما يترتب على ذلك من تبعات على الاستقرار والتنمية المستدامة.
المراجع والمصادر
المصادر النظرية الأساسية:
Shirky, Clay (2008). Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations. New York: Penguin Books.
Castells, Manuel (2012). Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity Press.
Harvey, David (2011). The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism. London: Profile Books.
Stiglitz, Joseph (2019). People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent. New York: W. W. Norton & Company.
Tufekci, Zeynep (2017). Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest. New Haven: Yale University Press.
المصادر المتخصصة في الحراك العربي:
Lynch, Marc (2012). The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East. New York: PublicAffairs.
Bayat, Asef (2017). Revolution without Revolutionaries: Making Sense of the Arab Spring. Stanford: Stanford University Press.
Zemni, Sami (2017). The Tunisian Revolution: Neoliberalism, Urban Contentious Politics and the Right to the City. London: Zed Books.
دراسات حول المجتمع المغربي المعاصر:
Willis, Michael J. (2014). Politics and Power in the Maghreb: Algeria, Tunisia and Morocco from Independence to the Arab Spring. London: Hurst Publishers.
Emperador Badimon, Montserrat (2013). "Does Unemployment Fuel Protest? Employment, Labor Mobilization, and the Arab Spring in North Africa." Mobilization: An International Quarterly 18(4): 399-418.
Bogaert, Koenraad (2018). Globalized Authoritarianism: Megaprojects, Slums, and Class Relations in Urban Morocco. Minneapolis: University of Minnesota Press.
مصادر حول التكنولوجيا والسياسة:
Morozov, Evgeny (2011). The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom. New York: PublicAffairs.
Howard, Philip N. and Muzammil M. Hussain (2013). Democracy's Fourth Wave?: Digital Media and the Arab Spring. Oxford: Oxford University Press.
Gerbaudo, Paolo (2012). Tweets and the Streets: Social Media and Contemporary Activism. London: Pluto Press.
دراسات جيل Z والشباب:
Seemiller, Corey and Meghan Grace (2016). Generation Z Goes to College. San Francisco: Jossey-Bass.
Twenge, Jean M. (2017). iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy. New York: Atria Books.
Parker, Kim and Ruth Igielnik (2020). "On the Cusp of Adulthood and Facing an Uncertain Future: What We Know About Gen Z So Far." Pew Research Center.
المصادر الصحفية والتقارير:
تقارير السفارة الأمريكية بباريس حول احتجاجات سبتمبر 2025 (مصنفة).
تقارير منظمة العفو الدولية حول أحداث نيبال سبتمبر 2025.
تقارير المعهد الملكي المغربي للدراسات الاستراتيجية حول حراك الشباب 2025.
تقارير البنك الدولي حول البطالة والتنمية في شمال أفريقيا 2020-2025.
مصادر رقمية ومنصات التواصل:
تحليل محتوى مجموعة "Hami Nepal" على Discord (سبتمبر 2025).
أرشيف منصة "Bloquons Tout" الفرنسية على Telegram.
تقارير مراكز مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي حول الحراك المغربي.
دراسات الاتجاهات الرقمية لجيل Z في المنطقة العربية (مركز الدراسات الاستراتيجية - أبو ظبي).
ملاحظات منهجية:
تم الاعتماد في هذا التحليل على المقاربة المقارنة متعددة الحالات، مع التركيز على الأبعاد السوسيولوجية والسياسية للظاهرة. كما تم استخدام تقنيات تحليل المحتوى الرقمي لفهم ديناميكيات التعبئة عبر المنصات المختلفة.
الدراسة اعتمدت على مصادر متنوعة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، مع الحرص على التحقق من المعلومات عبر مصادر متعددة. بعض المعطيات المتعلقة بالأحداث الحديثة قد تخضع للمراجعة مع توفر معلومات إضافية.
تم احترام قواعد الأخلاقيات البحثية في التعامل مع المحتوى الرقمي، مع تجنب الكشف عن هويات الأشخاص المشاركين في الحراك لضمان سلامتهم.
هوامش ختامية:
تشكل هذه الدراسة مساهمة أولية في فهم ظاهرة معقدة ومتطورة باستمرار. الحراك الشبابي الرقمي يتطور بسرعة أكبر من قدرة البحث الأكاديمي على ملاحقته، مما يستدعي مقاربات منهجية مبتكرة تجمع بين الرصد الآني والتحليل النظري العميق.
كما أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الظاهرة تتطلب تعاونا أكاديميا دوليا لفهم أبعادها المختلفة وتطوير استراتيجيات ملائمة للتعامل معها بشكل إيجابي وبناء.
أخيرا، من المهم التأكيد على أن هذا التحليل لا يهدف إلى إصدار أحكام قيمية على الحراك الشبابي أو على استجابات الأنظمة السياسية، بل إلى فهم الديناميكيات الجارية وتقديم رؤية علمية موضوعية تساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة من جميع الأطراف المعنية.


 (1).png)