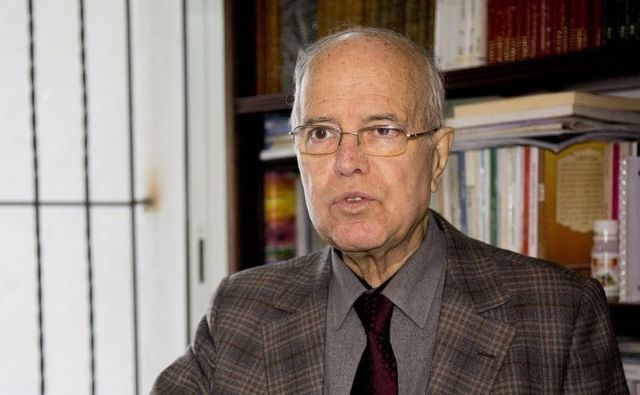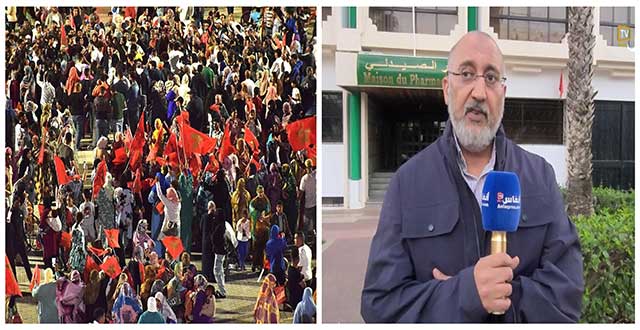في المشهد الحزبي المغربي، تبرز ظاهرة تستحق التأمل العميق: الرفاهية السياسية القاتلة التي تعيشها الأحزاب الكلاسيكية، يسارية كانت أم يمينية. هذه الرفاهية لا ترتبط بالمال أو النفوذ فقط، بل تتجلى في نوع من الاستقرار الرمزي الذي يجعلها تخاف من التجديد، وتتحاشى المغامرة الفكرية والتنظيمية، وكأن الزمن السياسي الذي نشأت فيه أبدي، لا يعرف القطيعة ولا التحول.
لكن في زمن الذكاء الاصطناعي، لم يعد الجمود السياسي مجرد خيار تنظيمي، بل أصبح مفارقة إبستمولوجية. فكما أن المعرفة العلمية لم تعد تُبنى على لحظات قطيعة مفاجئة، بل على تتابعات معرفية متراكبة، فإن الفكر السياسي أيضًا لم يعد يحتمل التكرار الآمن، بل يحتاج إلى نمط من القطائع المتتابعة يعيد تشكيل العلاقة بين الحزب والمجتمع، بين الخطاب والواقع، وبين التنظيم والزمن.
تشبه هذه الأحزاب الموظف الذي يضمن رزقه كل شهر، فيرفض المجازفة لتحسين وضعه، بينما التاجر، الذي يغامر بأفكار جديدة، يسعى إلى رفع مستواه رغم المخاطر. هذا التشبيه لم يعد مجرد استعارة اجتماعية، بل أصبح نموذجًا إبستمولوجيًا لفهم الفرق بين من يُدير الموجود ومن يُعيد تشكيله. الأحزاب التي تكتفي بإعادة إنتاج خطابها القديم، وتعيد تدوير نفس الوجوه، تُشبه مؤسسات تعيش على ذاكرة المجد، دون أن تسعى إلى صناعة مجد جديد.
لكن التحول الأخطر لا يكمن فقط في غياب القطيعة، بل في تحوّل السياسي إلى تكنوقراطي رمزي. لم يعد السياسي المغربي يُنتظر منه أن يُنتج المعنى أو يُقترح البدائل، بل بات يُدير الموجود، يُحافظ على التوازنات، ويُعيد تدوير الخطاب دون مساءلة شروطه. هذا التحول لا يُشبه التكنوقراطية في بعدها التقني، بل يُجسّد ما يمكن تسميته بـ”التكنوقراطية الرمزية”، حيث يُفرغ السياسي من دوره التأويلي، ويُختزل في وظيفة إدارية تُشبه إدارة الملفات أكثر مما تُشبه صناعة المستقبل.
في هذا السياق، يُصبح السياسي أقرب إلى نموذج معرفي انتهى زمنه، يُكرر ذاته دون أن يُدرك أن الزمن الإبستمولوجي قد تجاوزه. إنه يُشبه النموذج العلمي الذي يستمر في تفسير الظواهر بأدوات لم تعد صالحة، في حين أن الواقع يُطالب بنموذج جديد، يُعيد ترتيب العلاقة بين الفهم والممارسة، بين النظرية والتأثير.
وما يزيد هذا الجمود تعقيدًا هو استمرار التبعية الرمزية للنموذج الفرنسي، الذي كان لعقود مصدرًا للتنظيم الحزبي المغربي. غير أن فرنسا نفسها تعاني اليوم من أزمة معرفية وسياسية، وأحزابها التقليدية لم تعد قادرة على إنتاج خطاب يتماشى مع التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم. وهذا الاستيراد غير الواعي للنموذج الفرنسي يُكرّس التبعية الرمزية، ويُعيق إمكانات التأسيس المحلي. فهل من الحكمة أن نستمر في استلهام نموذج يعاني من العجز؟ وهل يمكن لأحزابنا أن تجد طريقًا خاصًا بها، ينبع من الواقع المغربي، ويستجيب لتحدياته، بدل أن تكرر نماذج لم تعد صالحة حتى في موطنها الأصلي؟
في الفكر العلمي، كما في الفكر السياسي، هناك ما يسمى بـ”الزمن الإبستمولوجي” — لحظة لا تُقاس بالوقت، بل بالتحول في شروط الفهم. إن رفض الأحزاب المغربية لهذه اللحظة هو رفض ضمني للاعتراف بأن الواقع تغير، وأن أدوات الفهم القديمة لم تعد صالحة لتفسيره أو التأثير فيه.
وإذا نظرنا إلى ما تنتجه هذه الأحزاب في مجلاتها، ومواقعها الإلكترونية، وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، نجد أن المحتوى غالبًا ما يكون ضعيفًا، تقليديًا، وغير متفاعل. لا يخاطب المواطن بلغة اليوم، ولا يطرح أسئلة المستقبل، ولا يواكب التحولات الرقمية. وهذا الفراغ في الإنتاج الفكري ليس سوى عرض من أعراض غياب القطيعة المعرفية، حيث يُعاد إنتاج الخطاب دون مساءلة شروطه، ويُدار التنظيم دون مساءلة وظيفته.
في المقابل، يبرز المؤثر الرقمي كفاعل جديد، لا لأنه أكثر شرعية، بل لأنه يُجسّد نمطًا جديدًا من الأداء السياسي، حيث يُبنى التأثير على التفاعل، ويُعاد تشكيل المعنى من خلال التجربة، لا من خلال النظرية. وهنا المفارقة: السياسي يُشبه التكنوقراط، والمؤثر يُشبه السياسي. الأول يُدير الماضي، والثاني يُغامر بالمستقبل. وبينهما، يقف المواطن حائرًا: هل يُصغي لمن يُجيد الإدارة، أم لمن يُجيد مخاطبة الزمن؟
ربما آن الأوان لأن تعيد الأحزاب النظر في مفهوم “الوفاء للتاريخ”، فالتاريخ لا يُصان بالتكرار، بل يُخلّد بالتجديد. والمستقبل لا يُصنع بالحنين، بل بالجرأة على القطيعة، لا بوصفها لحظة انفصال، بل بوصفها لحظة انزياح معرفي مستمر يُعيد مساءلة المفاهيم، ويُفتح إمكانات جديدة للفهم والتجاوز. فإما أن تُغامر الأحزاب بالخروج من رفاهيتها الرمزية، أو أن تترك المجال لفاعلين جدد يعيدون تشكيل المعنى السياسي من جذوره.
لكن في زمن الذكاء الاصطناعي، لم يعد الجمود السياسي مجرد خيار تنظيمي، بل أصبح مفارقة إبستمولوجية. فكما أن المعرفة العلمية لم تعد تُبنى على لحظات قطيعة مفاجئة، بل على تتابعات معرفية متراكبة، فإن الفكر السياسي أيضًا لم يعد يحتمل التكرار الآمن، بل يحتاج إلى نمط من القطائع المتتابعة يعيد تشكيل العلاقة بين الحزب والمجتمع، بين الخطاب والواقع، وبين التنظيم والزمن.
تشبه هذه الأحزاب الموظف الذي يضمن رزقه كل شهر، فيرفض المجازفة لتحسين وضعه، بينما التاجر، الذي يغامر بأفكار جديدة، يسعى إلى رفع مستواه رغم المخاطر. هذا التشبيه لم يعد مجرد استعارة اجتماعية، بل أصبح نموذجًا إبستمولوجيًا لفهم الفرق بين من يُدير الموجود ومن يُعيد تشكيله. الأحزاب التي تكتفي بإعادة إنتاج خطابها القديم، وتعيد تدوير نفس الوجوه، تُشبه مؤسسات تعيش على ذاكرة المجد، دون أن تسعى إلى صناعة مجد جديد.
لكن التحول الأخطر لا يكمن فقط في غياب القطيعة، بل في تحوّل السياسي إلى تكنوقراطي رمزي. لم يعد السياسي المغربي يُنتظر منه أن يُنتج المعنى أو يُقترح البدائل، بل بات يُدير الموجود، يُحافظ على التوازنات، ويُعيد تدوير الخطاب دون مساءلة شروطه. هذا التحول لا يُشبه التكنوقراطية في بعدها التقني، بل يُجسّد ما يمكن تسميته بـ”التكنوقراطية الرمزية”، حيث يُفرغ السياسي من دوره التأويلي، ويُختزل في وظيفة إدارية تُشبه إدارة الملفات أكثر مما تُشبه صناعة المستقبل.
في هذا السياق، يُصبح السياسي أقرب إلى نموذج معرفي انتهى زمنه، يُكرر ذاته دون أن يُدرك أن الزمن الإبستمولوجي قد تجاوزه. إنه يُشبه النموذج العلمي الذي يستمر في تفسير الظواهر بأدوات لم تعد صالحة، في حين أن الواقع يُطالب بنموذج جديد، يُعيد ترتيب العلاقة بين الفهم والممارسة، بين النظرية والتأثير.
وما يزيد هذا الجمود تعقيدًا هو استمرار التبعية الرمزية للنموذج الفرنسي، الذي كان لعقود مصدرًا للتنظيم الحزبي المغربي. غير أن فرنسا نفسها تعاني اليوم من أزمة معرفية وسياسية، وأحزابها التقليدية لم تعد قادرة على إنتاج خطاب يتماشى مع التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم. وهذا الاستيراد غير الواعي للنموذج الفرنسي يُكرّس التبعية الرمزية، ويُعيق إمكانات التأسيس المحلي. فهل من الحكمة أن نستمر في استلهام نموذج يعاني من العجز؟ وهل يمكن لأحزابنا أن تجد طريقًا خاصًا بها، ينبع من الواقع المغربي، ويستجيب لتحدياته، بدل أن تكرر نماذج لم تعد صالحة حتى في موطنها الأصلي؟
في الفكر العلمي، كما في الفكر السياسي، هناك ما يسمى بـ”الزمن الإبستمولوجي” — لحظة لا تُقاس بالوقت، بل بالتحول في شروط الفهم. إن رفض الأحزاب المغربية لهذه اللحظة هو رفض ضمني للاعتراف بأن الواقع تغير، وأن أدوات الفهم القديمة لم تعد صالحة لتفسيره أو التأثير فيه.
وإذا نظرنا إلى ما تنتجه هذه الأحزاب في مجلاتها، ومواقعها الإلكترونية، وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، نجد أن المحتوى غالبًا ما يكون ضعيفًا، تقليديًا، وغير متفاعل. لا يخاطب المواطن بلغة اليوم، ولا يطرح أسئلة المستقبل، ولا يواكب التحولات الرقمية. وهذا الفراغ في الإنتاج الفكري ليس سوى عرض من أعراض غياب القطيعة المعرفية، حيث يُعاد إنتاج الخطاب دون مساءلة شروطه، ويُدار التنظيم دون مساءلة وظيفته.
في المقابل، يبرز المؤثر الرقمي كفاعل جديد، لا لأنه أكثر شرعية، بل لأنه يُجسّد نمطًا جديدًا من الأداء السياسي، حيث يُبنى التأثير على التفاعل، ويُعاد تشكيل المعنى من خلال التجربة، لا من خلال النظرية. وهنا المفارقة: السياسي يُشبه التكنوقراط، والمؤثر يُشبه السياسي. الأول يُدير الماضي، والثاني يُغامر بالمستقبل. وبينهما، يقف المواطن حائرًا: هل يُصغي لمن يُجيد الإدارة، أم لمن يُجيد مخاطبة الزمن؟
ربما آن الأوان لأن تعيد الأحزاب النظر في مفهوم “الوفاء للتاريخ”، فالتاريخ لا يُصان بالتكرار، بل يُخلّد بالتجديد. والمستقبل لا يُصنع بالحنين، بل بالجرأة على القطيعة، لا بوصفها لحظة انفصال، بل بوصفها لحظة انزياح معرفي مستمر يُعيد مساءلة المفاهيم، ويُفتح إمكانات جديدة للفهم والتجاوز. فإما أن تُغامر الأحزاب بالخروج من رفاهيتها الرمزية، أو أن تترك المجال لفاعلين جدد يعيدون تشكيل المعنى السياسي من جذوره.