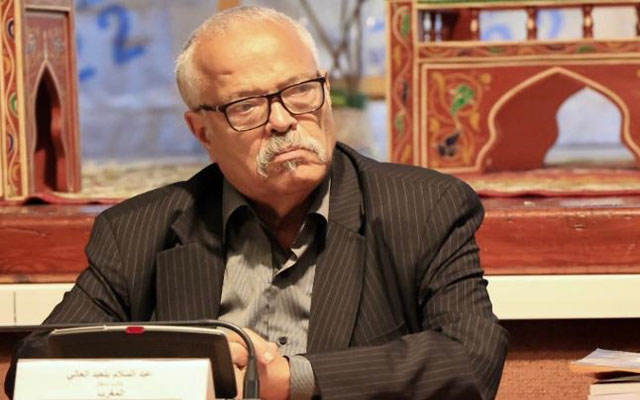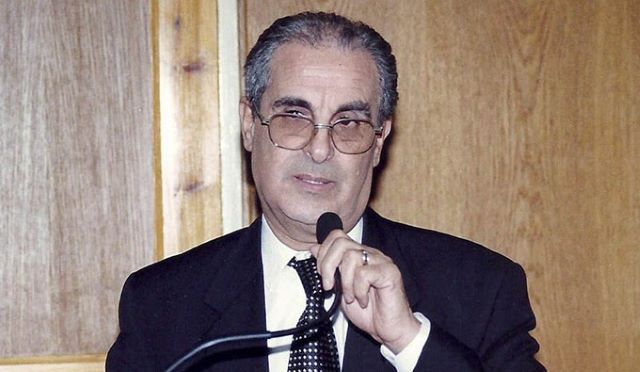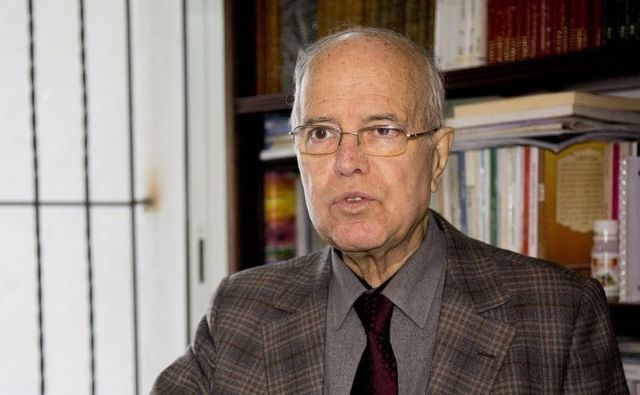عالم بلا مرجعيات ولا ألوان
عالم يموت، وعالم جديد تأخر في الظهور، وفي خضم هذا النور الغامض ينبعث ما يرعب" - أنطونيو غرامشي
كتب الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز: "إذا كنا نشعر أن وضع الفكر اليوم ليس على ما يرام، فذلك عائد إلى أننا، وتحت مسمى الحداثة، ارتددنا إلى التجريدات، وعدنا من جديد، إلى طرح سؤال الأصول وما شابه، وبالتالي انسد، بفعل ذلك، أفق التحليلات التي كانت تعتمد مفهومات الحركة والاندفاع. إننا نحيا فترة شديدة الضحالة، نحيا مرحلة رجعية، هذا على الرغم من أننا كنا اعتقدنا لفترة أن الفلسفة قطعت مع نقاش الأصول. في فترة القطع هذه توارت أسئلة الأصول والوصول، وبدا أن ما يهم هو بالأولى سؤال: ما الذي يحصل "بين بين؟".
البين بين
قبل أن نبين أهمية هذا "البين-بين" بالنسبة إلينا نحن كذلك، لا بد أن نقر بأننا لا نستطيع أن نتبنى محتوى ما يقوله الفيلسوف الفرنسي بكامله، لأننا لم نقطع يوما ما مع الأصول، وحتى إن كنا لا ننفك ننفتح على "الآخر" بمختلف التسميات التي أطلقناها عليه، فإننا سرعان ما كنا نعود إلى ذواتنا، ونحتمي بـ"أصولنا" ونركن إلى "خصوصيتنا". فلم نكن نرى عيبا ولا صعوبة في التساؤل عما يميزنا ويحددنا، عما ومن يطابقنا، ما ومن يخالفنا. كنا نحدد ذواتنا، فرديا وقوميا، داخل عالم محدد المعالم، وجغرافيا واضحة، فنبحث عن مكان في رقعة مرسومة مبوبة، رقعة "معقولة"، لم يكن من المتعذر علينا أن نتخذ مكاننا فيها، فكنا شرق غرب، أو جنوب شمال أو ثالث اثنين.
إلا أن هذه الأشكال من التمييز السياسي والحضاري والثقافي غدت اليوم من قبيل المتعذرات، أو، على الأقل، أصبحت من الصعوبة بمكان، حيث صرنا نشعر أننا نتساءل عن الحدود في عالم بلا حدود، ونبحث عن مرجعية في فضاء بلا مرجعيات، وعن لون خاص في عالم بلا ألوان. ولست أعني هنا فحسب الألوان الجغرافية والتجارية والسياسية، وإنما أساسا الألوان الثقافية والفكرية.
ذلك أن ما يميز عالم اليوم، أي العالم وقد اكتسحته التقنية والإعلام، هو غياب الاختلاف، وسيادة التبسيط والأحادية والتنميط الثقافي على الخصوص. وبما أننا محشورون في هذا العالم، لا مفر لنا من أن نحشر في هذا التنميط الكوكبي الذي لا يخفى ما للإعلام من دور فيه. كتب ميلان كونديرا في "فن الرواية": "تعمل وسائل الإعلام في خدمة توحيد تاريخ الكرة الأرضية، فهي تضخم عملية التقليص وتوجهها، إنها توزع في العالم كله التبسيطات نفسها، والصيغ الجاهزة التي يمكن أن تقبلها البشرية جمعاء، ولا يهم أن تعلن مختلف المصالح السياسية عن ذاتها في مختلف وسائلها، فوراء هذا الاختلاف السطحي تسود روح مشتركة. يكفي تصفح الأسبوعيات السياسية الأميركية والأوروبية، سواء أسبوعيات اليسار أو أسبوعيات اليمين، من "تايمز" إلى "شبيغل": فهي تملك جميعها الرؤية عن الحياة ذاتها، وهي رؤية تنعكس من خلال السلم الذي تنتظم المواد المنشورة فيها بموجبه، في الأبواب ذاتها، في الصيغ الصحافية عينها، المفردات نفسها، الأسلوب ذاته، الأذواق الفنية عينها، وجميعها في نفس مراتبية ما تجده مهما أو ما تجده عديم الأهمية. هذه الروح المشتركة هي روح عصرنا".
لقد أصبحنا ننهل من ثقافة جارية نحو التوحيد: نتغذى الغذاء ذاته، ونرى الصورة عينها، وننفعل الانفعال نفسه، ونسمع الأنغام ذاتها. أصبحنا موحدي المظاهر والأذواق والإحساسات والانفعالات. ولا يمكن أن نستثني جهة أو بلدا يكون موجها للعبة متحكما فيها، واعيا بخفاياها، حائكا خيوطها، فكلنا في النمطية الثقافية سواء.
وحدة ظاهرة وتعدد مستتر
قد يقال إن هذه الوحدة الظاهرة تخفي من ورائها تعددا متسترا واختلافا دفينا، بله غليانا وصراعا صامتين. وعلى أي حال، يبدو أن هذا الصراع "الصامت"، لم يعد أساسا صراعا بين معسكرات سياسية ولا بين مناطق جغرافية، وبالأولى فهو ليس صراعا بين "آلهة الخير" و"شياطين الشر"، وليس حتى صراعا بين داخل وخارج، وإنما هو صراع بين ثقافتين قد تتجسدان في الموطن الواحد، بل وعند الفرد الواحد: ثقافة تتغذى على النموذج الذي يفرض نفسه، وأخرى تريد أن تبني نموذجا مغايرا. ذلك أن مواجهة الآخر غدت اليوم أساسا مواجهة مع الذات، لأن مظاهر الجدة تتخذ اليوم طابعا عضويا يرغم الفكر على ألا ينفك عن الانسلاخ من التنميط. إذ إن التخشب لم يعد يلحقنا من ترسخ مقولاتنا في الماضي، ولا من ترديد مقولات استوردناها، وإنما أساسا، مما نتشربه لحظيا من أشكال اللافكر التي نتغذى عليها، ومما لا ينفك "مجتمع الفرجة" يرسخه فينا.
ذلك أن سيادة التنميط والأحادية جعلت الفكر اليوم، ولأول مرة في التاريخ، فكرا كوكبيا كونيا، وهذا ليس لافتراض كونية ميتافيزيقية وفكر شمولي، وإنما للتغير الذي لحق الوجود بفضل اكتساح التقنية فأصاب، تبعا لذلك، مفهوم العالم. فما يطبع عالم اليوم هو انتشار موحد وموحد لنماذج التنمية والمخططات، وتطور متواصل لأدوات التواصل، وفرض لمفهوم جديد عن الزمان، وكل هذا لم يعد يخص منطقة من مناطق العالم دون أخرى. فالكونية لا هوية لها، بل إنها هي التي تحدد اليوم كل هوية. على هذا النحو يغدو الانخراط فيها أو عدم الانخراط ليس وليد قرار إرادي يتخذه فاعل سيكولوجي أو هوية ثقافية، وإنما هو قدر تاريخي يرمي بإنسان اليوم في الكون، وبالفكر في الكونية.
يتعذر علينا، والحالة هذه، أن نعمل، على غرار ما كنا نفعل، على التمييز بين خصوصية تحن إلى العالمية وأخرى تهابها أو ترفضها. بل إن ما دأبنا عليه من تمييز بين "أصالة ومعاصرة" ربما حتى هو نفسه، قد أخذ يفقد كل معنى، إذ يظهر أن كل أصالة لا يمكنها اليوم أن تكون إلا كيفية من كيفيات المعاصرة. وربما غدا من المتعذر حتى تمييز الأصيل عن غير الأصيل بإطلاق، كل ما هناك هو كيفيات أصيلة للمساهمة في الكونية والمشاركة في العالمية. إلا أن أصالة هاته الكيفيات لا تستمد من تجذر زمني وتعلق بنماذج "عريقة"، بل هي كيفيات أصيلة لأنها تسعى نحو خلق شبكات مقاومة تحاول التخلص من النموذج المفروض، والانفلات من التنميط، سعيا وراء خلق الفروق وإثباتا للاختلاف.
شبكات مقاومة
هذا الانفلات يستلزم بناء نموذج ثقافي مغاير، ونسج شبكات مقاومة تعلنها حربا شعواء على التنميط والأحادية. هذه الشبكات هي النسيج الذي يمكن المثقف اليوم أن ينصهر فيه تحررا من النموذج التقليدي للمثقف الذي كانت الأيديولوجيات السابقة بمختلف لويناتها رسمت معالمه الكبرى، حيث جعلت الصراع يدور بين "أصحاب اليمين" و"أصحاب الشمال"، وحيث حددت المقاومة على أنها في الأساس صراع بين قوى متضادة، وحيث نظرت إلى الفكر باعتباره "انعكاسا" لبنيات، و"تعبيرا" عن تلك القوى المتصارعة، وإلى المقاومات باعتبارها انضواء للفكر وانخراطا له دفاعا عن مصالح الفئات المتضاربة.
في هذا السياق ترعرعت نظريات عن المثقف كنظرية المثقف الواعي بحركة التاريخ المدافع عن المصالح الطبقية، والمثقف العضوي، والمثقف الملتزم، والمثقف المتكلم باسم المستضعفين، والمثقف ضمير التاريخ، والمثقف المتياسر بالطبع. فلو أننا حاولنا التخلي عن هذا النموذج التقليدي، فلن تعود مهمة المثقف مهمة "تبشيرية"، تعمل في خدمة أيديولوجية بعينها، وتكرس قيما بذاتها، لن تعود مهمته الدخول في صراع مع قوى "خارجية"، وإنما تحرير قوى الحياة، والسماح لحياة قوية بالتفتح. حينئذ لن تنصب المقاومات نفسها قوة "تقف" إلى جانب الخير، فتعلنها حربا على "قوى الشر"، وإنما ستتشابك في علاقة مع ذاتها.
وهنا يأخذ الفكر معناه الاشتقاقي كانعكاس ومراجعة للذات Réflexion، وتغدو نقاط ارتكاز المقاومة باطنية، فلا يعود الفكر تعبيرا عن قيم خارجة عنه، ولا التزاما بأيديولوجية، ولا تطبيقا لنظرية، ولا نضالا في خدمة مؤسسة. لا ثابت هنا يتخشب وينمط ويتوحد فينجو من المقاومة. كل ما هناك أشكال متفردة لقمع قوى الحياة ومحاصرتها وتضييق الخناق عليها، فأشكال ملائمة للمقاومة وتحرير تلك القوى.
ذلك أن الاختلاف بين المثقفين لم يعد اليوم يدور حول حقائق بعينها، وإنما غدا يمتد إلى مقومات الحقيقة. أصبح الصراع الثقافي يدور اليوم حول إقرار نظام بعينه لإنتاج الحقيقة كما بيّن فوكو. إنه صراع بين من يحاولون أن يرسخوا في الأذهان أن الحقيقة ليست بنت هذه الأرض، وبين من يسعون إلى أن يبينوا أن الحقائق ليست طاهرة نقية، وإنما هي ملطخة بالزمن، عالقة بالتاريخ.
بناء على ذلك لن تتحدد المقاومات هنا بلونها ومضمونها وهويتها وخصوصيتها، بقدر ما ستتعين بـحركتها وبما تقوم به. فهي لا يمكن أن تعرف إلا إجرائيا واستراتيجيا. وستصبح مثل "دروب" هايدغر، تتعين بالمسار الذي تخطه أكثر مما تتحدد بالأهداف التي تتوخاها، لذا فهي لا يمكن أن تتشابك في مواقف ومدارس واتجاهات ومذاهب وتيارات، ولا أن تلتئم ضمن "عائلات" أيديولوجية. كل ما في إمكانها هو أن تشكل "شبكات" هي بالضبط شبكات مقاومة النمطية لإبداع هوية ما تفتأ تتجدد، وسن نموذج ثقافي مغاير، وكيفية أصيلة للمساهمة في المعاصرة.
عن مجلة: المجلة