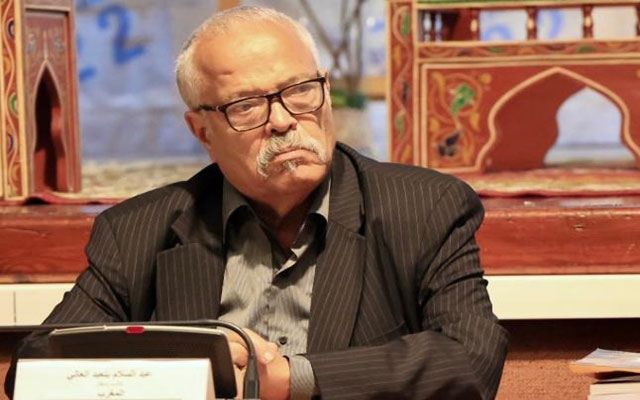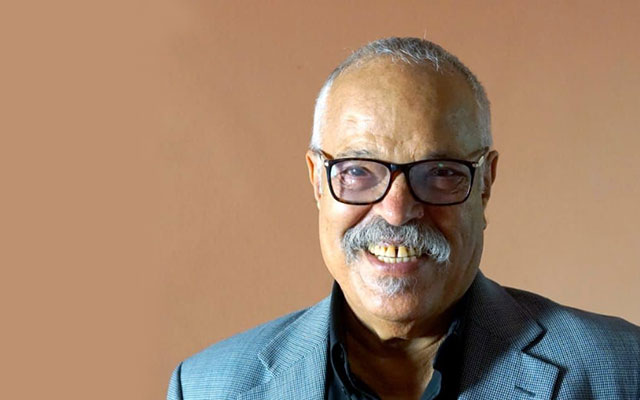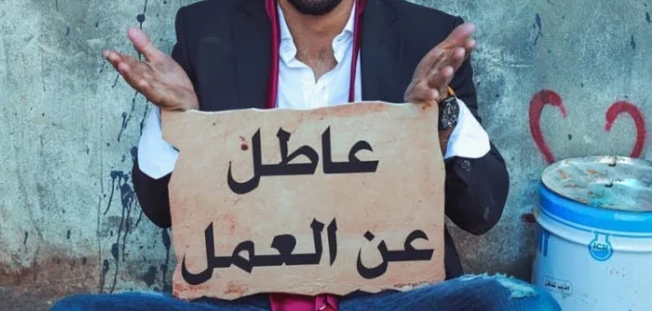اللغة الصغرى التي جعلها دولوز معادلا للغة الأجنبية
يقول الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز في "الأبجدية": "أنا لا أعرف ما إذا كنت أعتبر نفسي كاتبا في الفلسفة، ما أعرفه هو أن كل فيلسوف عظيم هو كاتب عظيم". يلتقي الكاتب والفيلسوف عند دولوز في نقطة واحدة: كلاهما مبدع، الكاتب مبدع في اللغة، والفيلسوف مبدع مفاهيم. لكن إبداع المفاهيم يتطلب عملا على اللغة، مثلما تقتضيه الكتابة. كلاهما يدخل على اللغة تحويلا.
لغة داخل اللغة
الكتابة تحول في اللغة، واستخدام فريد لها. في هذا المعنى يؤكد القسم الثالث من الفصل الرابع من كتاب "ألف بساط" أن الأدب "لغة داخل اللغة". كيف نفهم هذه الأطروحة؟ عند كثير من الأدباء العظام تعدد لغوي، وغالبيتهم تعيش، بدرجات متفاوتة، وضعية ازدواجية لغوية: كافكا اليهودي التشيكي يكتب بالألمانية، وبيكيت الأيرلندي يكتب بالإنكليزية والفرنسية معا، ناهيك عن بورخيس وكونديرا، والقائمة طويلة. هذه الازدواجية ليست عند هؤلاء كثرة من اللغات وتساكنا مهادنا بينها، إذ سرعان ما "يدخل الكاتب الضيم على هذه اللغات لأن كل واحدة منها تجذب الأخرى وتأخذ منها وتعترض عليها"، بل وتفضحها.
في مناسبات عديدة، يعود دولوز إلى أطروحة مارسيل بروست التي تؤكد أن الروائع الأدبية تكتب بلغة أجنبية. لكنه سيجعلها أطروحته الخاصة، معادلا اللغة الأجنبية بما يطلق عليه "لغة صغرى"، ومعادلا اللغة الأم باللغة الكبرى. ستكون الكتابة هي قيادة اللغة الكبرى نحو شكلها الأقلي، وإدخال الفروق إلى لغة رسمية.
قيادة اللغة المهيمنة أو المعيارية في سياقها الاجتماعي والسياسي نحو "لغـة صغـرى" langue mineure تعبر عن الاستخدام التحويلي للغة. هذا شأن ألمانية كافكا على سبيل المثل، فهي لغة مهجنة ومقوضة من الداخل. إنها "لغة غريبة داخل اللغة" وانزياح عن المعيار اللغوي السائد. في هذا المعنى تتخذ الكتابة قيمة سياسية. إنها نوع مما يطلق عليه دولوز "مقاومة جزيئية"، وهي تختلف كل الاختلاف عن أشكال المقاومات المعهودة، والتي هي مقاومات ضد السلطة، والتي غالبا ما تنتهي بأن تعيد إنتاج النظم التي تسعى إلى تجاوزها.
صيرورة
تبدع الكتابة لغات صغرى داخل اللغات المعيارية الكبرى فترسم خطوط انفلات تغير الدلالات، وتفكك الثنائيات، وتحول البنيات، فتخلق "صيرورات في اللغة"، وتعمل ضد نظامها السلطوي المعياري. كتب دولوز: "إنها صيرورة أقلية للغة الأغلبية. لا تكمن الأهمية في التمييز بين اللغة الأغلبية وبين اللغة الأقلية، وإنما هي قائمة في الصيرورة. ليست المسألة في إعادة التوطن في لغة محلية أو لهجة، وإنما هي في إخراج اللغة الأغلبية عن توطنها. لا يرفع الزنوج الأميركيون لغة الزنج ضد الإنكليزية، وإنما يجعلون من الأميركية التي هي لغتهم إنكليزية زنوج".
فاللغة الأقل لا توجد إلا نسبة إلى لغة أغلبية، وهي "تشكل استثمارات لهذه اللغة كي تغدو هي ذاتها أقلية. سيتجه كل واحد نحو اللغة الأقلية، اللغة المحلية أو اللهجة، وينطلق منها بحيث يجعل من لغته الأغلبية لغة أقلية. تلك هي قوة الكتاب الذين ندعوهم "أقليين"، والذين هم أعظم الكتاب، بل هم وحدهم العظماء".
بورخيس
يكون على هؤلاء أن يكتسحوا لغتهم الخاصة، أي أن يدركوا درجة الزهد في استعمال اللغة الأغلبية، بحيث يجعلونها تتحول باستمرار، ويدفعون اللغة إلى نوع من الـ"تأتأة" bégaiement ، وإلى ترحيل اللغة خارج ذاتها لتكوين "توليفات" جديدة في النطق، وإدخال الحركة والحياة في ما هو قائم، وقلب العلاقات المؤسسية، وإعلان الثورة على أدب االسلطة وقيمها، وعلى "نموذج الرجل الأبيض البالغ العاقل" الذي يطرح نفسه معيارا، وتجـريب توليفـات جديدة فـي العلاقات القـديمة.
هـذه هي ميزة أدب الأقـلية، بل هي ميزة "الأدب الصغير"، بل هي ميزة الأدب وكفى، إذ لا وجود لـ"أدب كبير" عند دولوز، فكل أدب قوي هو بالضرورة "صغير" من حيث إنه هو يخلق معياره الخاص، و"هو ما يكسر أدب السادة"، ويحرر اللغة والفكر، وهو ما يجدد اللغة ويفتحها ممكنات غير مسبوقة.
ازدواجية
في هذا المعنى، فإن الازدواجية ليست علاقة "خارجية" بين اللغات. "فنحن لا نكون مزدوجي اللغة أو متعدديها إلا في لغتنا. يكون علينا حينئذ أن نكتسح اللغة الأغلبية كي نعين عليها لغات أقلية لا زالت مجهولة". فالكاتب الأقلي هو ذاك الغريب في لغته. وإذا كان ابنا غير شرعي، إذا كان يرى نفسه كذلك ويحياه، "فليس بفعل المزج بين اللغات والخلط بينها، وإنما بالأحرى بفعل الحذف وإدخال التحولات على لغته، وبفعل شد الحبل الذي يمارسه عليها".
هذا البعد السياسي للكتابة لا يعني مطلقا التزاما سياسيا للكاتب بالمعنى المتداول. إذ أن مواجهة "اللغة الأغلبية" ليست انضواء ضمن يسار ضد اليمين، وما ذلك إلا لأن الأغلبية التي يعنيها دولوز ليست أغلبية عددية. فالأغلبية، من حيث إنها تدخل ضمن النموذج المجرد، لا تكون قط أحدا. إنها دائما لاأحد، في حين أن الأقلية، هي صيرورة الجميع، صيرورتهم الممكنة من حيث إنها تبتعد عن النموذج وتنحرف عنه. هناك "واقع" أغلبي، إلا أنه الواقع التحليلي للاأحد، الذي يقابل الصيرورة الأقلية للجميع. لذا علينا أن نميز بين الأغلبية كمنظومة متناسقة وثابتة، وبين الأقليات كمنظومات صغرى، وبين الأقلي كصيرورة ممكنة مبتدعة وخلاقة.
لا يتعلق الأمر بإحلال نموذج جديد محل آخر، ولا تكمن المسألة قط في التمكن من الأغلبية، حتى ولو بفرض ثابت جديد. إذ لا وجود لصيرورة أغلبية، لا تكون الأغلبية قط صيرورة، لا صيرورة إلا للأقلي. كتب دولوز: "هناك صيرورة كونية للوعي الأقلي، كصيرورة للجميع، وهذه الصيرورة هي الإبداع. ولا يتم بلوغها بإدراك الأغلبية واللحاق بها. هذه الصيرورة هي بالضبط التحول المستمر، كسعة لا تنفك تفيض وتتجاوز العتبة التي تمثل النموذج الأغلبي. إنه التحول الدائم هو الذي يشكل صيرورة-الأقلية للجميع، في مقابل الواقع الأغلبي للاأحد".
تفكيك
لا يعني الاستخدام الأقلي للغة إذن ما يدعى أدب الهامش أو أدب الشعب أو ما إلى ذلك، وإنما الأدب الذي يفكك القواعد القائمة. ولهذا فإن "تحويل هذه القواعد الأخلاقية للغة"، هو أحد أرقى أشكال المقاومة، ما دامت اللغة عند دولوز، كما هي عند فوكو وبارت، معقل السلطة وعشها.
ليس الأسلوب إلا هذا الإخضاع للغة للتحول، وبناء لغة غريبة داخل اللغة، كتب دولوز: "ما نسميه أسلوبا هو بالضبط آلية التحول المستمر". وهو تحول مستمر لا يتوقف، لأنه عملية دائمة من الانزياح والتجريب".
ما نقوله هنا عن الإبداع الأدبي يصدق كذلك على إبداع المفاهيم الفلسفية. المسألة دائما هي صنع شيء جديد من عناصر قديمة، شيء مختلف باستخدام مكونات معطاة سلفا. لذا فالفلاسفة الكبار هم أيضا كتاب كبار، فهم أيضا يخضعون اللغة للتحول، و"هذا يتطلب ألا تكون اللغة نظاما متجانسا، بل اختلالا، كيانا غير متوازن على الدوام".
لا يبتكر الفيلسوف كلمات غير مألوفة، ولا يمنح الكلمات العادية معاني جديدة بشكل اعتباطي أو بهدف تزيين الخطاب أو تعميقه. إنما يخضع اللغة للتحول فقط عندما تعجز هذه الأخيرة عن التعبير عن إبداع مفاهيمي جديد. إذا كانت اللغة في الفلسفة تخضع للتحول، فذلك لأن مفاهيم جديدة تبتكر. كل مفهوم جديد ستوافقه كلمة جديدة، أو معنى جديد لكلمة قديمة، أو تركيب جديد. وعليه، يمكننا القول إن الإبداع المفاهيمي يستلزم عملا أدبيا.
يمثل الخطاب الفلسفي مكان هذا الإبداع ومادته: ففي اللغة، وفي مواجهتها، وباستخدام الكلمات، نبتكر المفاهيم. وبالتالي، فإن المصطلحات الجديدة، والكلمات الدخيلة، والمفردات القديمة، تشكل استراتيجيات مختلفة للتوقيع. ولكن من الذي يوقع؟ وما هي سلطة الإفصاح في الفلسفة؟ تماما مثل بلانشو وفوكو، سيعمل دولوز على انتزاع الإفصاح الأدبي بشكل عام، والفلسفي بشكل خاص، من قبضة ضمير المتكلم: "من هو أنا؟ إنه دائما شخص ثالث".
إذا كان دولوز يضع الشخصية المفاهيمية كعنصر ثالث في الفلسفة، بين المفهوم ومستوى الوجود المتجانس، فإن ذلك يتم تحديدا لتعيين سلطة إفصاح غير ذاتية. "في الإفصاح الفلسفي، لا نقوم بشيء بقولنا له، بل نصنع الحركة بالتفكير فيه، من خلال وساطة شخصية مفاهيمية. وبالتالي، فإن الشخصيات المفاهيمية هي وكلاء الإفصاح الحقيقيون"، وهي التي تولد المعنى، إذ ليس المعنى عند دولوز أفقا للفهم يمنح للأشياء من الخارج بواسطة ذات (إلهية أو بشرية)، بل "هو سطح عليه تجد تحولات الأشياء التعبير عن نفسها".
عن مجلة المجلة