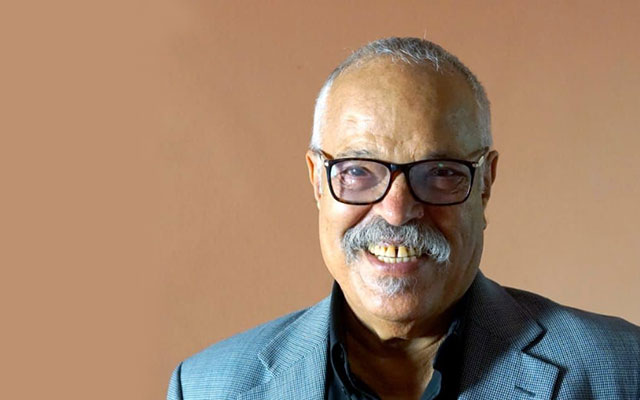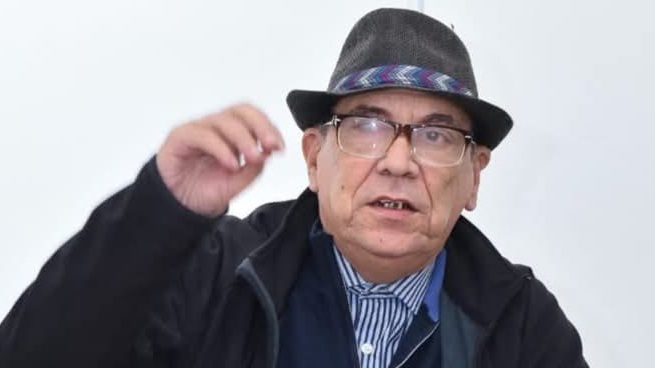يشهد المغرب في السنوات الأخيرة تحوّلاً ديموغرافياً عميقاً يهدد توازناته الاقتصادية والاجتماعية، ويطرح تساؤلات كبرى حول مستقبل التنمية. فبينما تتطلع المملكة إلى تحقيق نمو اقتصادي يفوق 4% سنوياً في أفق 2025، بدأت المؤشرات السكانية تُنذر بانعكاسات خطيرة: انخفاض معدلات الخصوبة إلى حدود 2 طفل لكل امرأة، وتزايد العزوبة بين النساء فوق سن الثلاثين إلى أكثر من 3.6 ملايين، وتقلص تدريجي في حجم الفئة النشيطة اقتصادياً.
إنه إنذار ديموغرافي حقيقي قد يحوّل “الرأسمال البشري” الذي شكّل ركيزة النمو إلى “نقطة ضعف” تُعرقل الطموحات الكبرى للمغرب في مجالات التصنيع، والاستثمار، والتحول الأخضر. هذه ليست مجرد إحصاءات جامدة، بل مؤشرات على تحوّل سوسيولوجي عميق في قيم المجتمع وأنماط الأسرة ودينامية الأدوار الاجتماعية.
أولاً: ملامح التحوّل الديموغرافي بالأرقام
تشير تقارير المندوبية السامية للتخطيط والأمم المتحدة إلى أن معدل الخصوبة في المغرب انخفض من 2.2 طفل لكل امرأة سنة 2014 إلى 1.97 سنة 2024، وهي نسبة تقترب من عتبة الإحلال السكاني (2.1). كما تراجع معدل نمو السكان إلى 0.85% فقط، بعد أن كان 2.6% في سبعينيات القرن الماضي.
أما العزوبة فصارت ظاهرة سوسيولوجية لافتة: أكثر من 3.6 ملايين امرأة فوق الثلاثين غير متزوجات، ونسبة العزوبة بين النساء المتراوحة أعمارهن بين 30 و34 سنة تبلغ نحو 24%. كما ارتفع متوسط سن الزواج الأول إلى 25.7 سنة لدى النساء و31.3 سنة لدى الرجال. هذه الأرقام تترجم تغيرًا بنيويًا في مفهوم الزواج والأسرة داخل المجتمع المغربي.
ثانياً: التحليل السوسيولوجي – من الأسرة التقليدية إلى الفرد الحديث
لفهم هذا التحول، لا بد من العودة إلى التحولات الاجتماعية والثقافية التي مست المغرب خلال العقود الأخيرة. فمنذ التسعينيات، عرف المجتمع المغربي توسعاً حضرياً سريعاً، إذ بلغت نسبة التمدن أكثر من 67% سنة 2025. هذا التحضر ترافق مع انتشار التعليم العالي وولوج المرأة سوق الشغل، مما غيّر بنية التوقعات والأدوار داخل الأسرة.
في الماضي، كانت الأسرة المغربية الممتدة تمثل الإطار المركزي للتنشئة الاجتماعية والتكافل الاقتصادي، وكان الزواج يتم في سن مبكرة بوصفه انتقالاً طبيعياً إلى المسؤولية الاجتماعية. أما اليوم، فقد تراجعت الأسرة الممتدة لصالح الأسرة النووية، بل أصبح الفرد ذاته هو الوحدة المركزية في التنظيم الاجتماعي. هذا ما يسميه علماء الاجتماع بـ “الفردنة الاجتماعية”، أي انتقال المجتمع من منطق الجماعة إلى منطق الاختيار الفردي، حيث تتقدم قيم الحرية والاستقلالية على قيم الانتماء الجمعي.
العوامل الاقتصادية لعبت دوراً محورياً أيضاً: ارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبة الحصول على السكن، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب (حوالي 37.7%)، كلها تجعل من الزواج والإنجاب مشاريع مؤجلة. في المقابل، أصبحت المرأة المتعلمة والعاملة ترى في تأخير الزواج وسيلة للحفاظ على الاستقلالية وتحقيق الذات، وليس تمرداً على القيم، بل تكيفاً عقلانياً مع واقع اقتصادي واجتماعي جديد.
ومن الزاوية الثقافية، يتعايش في المجتمع المغربي نظامان قيميّان متوازيان:
1. منظومة تقليدية تُقدّس الزواج والأسرة كقيم دينية واجتماعية أساسية.
2. منظومة حديثة تميل إلى تأجيل الزواج وربطه بالاستقرار الاقتصادي والنضج الذاتي.
هذا التعايش يولّد نوعاً من التوتر الرمزي والاجتماعي، خاصة لدى النساء العازبات فوق سن الثلاثين، اللواتي يجدن أنفسهن بين ضغط التقاليد وتطلعات الحداثة.
ثالثاً: الآثار الاجتماعية والاقتصادية للانخفاض الديموغرافي
تراجع الخصوبة وارتفاع سن الزواج لا ينعكسان فقط على البنية الأسرية، بل يؤثران بشكل مباشر في الهيكل العمري للقوة العاملة. فالمغرب يتجه تدريجياً نحو شيخوخة سكانية واضحة، حيث يُتوقّع أن يتضاعف عدد من تجاوزوا الستين سنة بحلول 2050.
هذا التحول سيؤدي إلى ضغوط كبيرة على صناديق التقاعد ونظام الرعاية الصحية، وإلى تقلص قاعدة المساهمين في الاقتصاد النشيط. في المقابل، تهاجر فئات شابة ومتعلمة نحو الخارج، مما يُعمّق أزمة “نزيف الكفاءات”.
بهذا المعنى، فإن التحدي الديموغرافي لا يقل خطورة عن التحديات الاقتصادية، لأن كل نموذج تنموي يحتاج إلى قاعدة بشرية شابة قادرة على الإنتاج والابتكار. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يجد المغرب نفسه مضطراً إلى تعويض نقص اليد العاملة بآليات تكنولوجية أو هجرة مدروسة، وهو ما يتطلب استعدادًا مؤسساتيًا وثقافيًا مسبقًا.
رابعاً: في الحاجة إلى سياسة ديموغرافية شاملة ومتوازنة
إن التعامل مع هذا الإنذار لا يمر عبر شعارات “تشجيع الإنجاب” فحسب، بل عبر سياسات متكاملة تستهدف الإنسان في مختلف مراحل حياته. من بين المداخل الممكنة:
1. دعم التوازن بين العمل والأسرة:
توفير حضانات في أماكن العمل، وإقرار إجازات أبوة وأمومة مدفوعة الأجر، حتى لا يكون الإنجاب عائقاً أمام المشاركة الاقتصادية للنساء.
2. تشجيع الزواج عبر دعم مادي وسكني:
برامج موجهة للشباب المقبلين على الزواج، تشمل تسهيلات سكنية أو قروض ميسّرة، لرفع العائق الاقتصادي دون المساس بقيم الأسرة.
3. تمكين المرأة ضمن رؤية قيمية متوازنة:
تعزيز ولوج النساء لسوق الشغل في إطار تكافؤ الفرص، دون المساس بالثوابت الدينية أو التماسك الأسري الذي يشكل إحدى ركائز إمارة المؤمنين.
4. استثمار الكفاءات المغربية بالخارج:
تشجيع عودة الكفاءات الشابة المهاجرة عبر تحفيزات ضريبية وبرامج اندماج مهني، لاستعادة جزء من الطاقة البشرية المفقودة.
5. تربية أسرية وتوجيه مجتمعي:
إدراج برامج تربوية في المناهج الدراسية والإعلامية تعزز ثقافة الأسرة، والمسؤولية المشتركة بين الزوجين، والتخطيط الأسري الرشيد.
خلاصة:
إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية: فبين طموح اقتصادي متصاعد وتحول ديموغرافي متسارع، يبرز التحدي الحقيقي في إعادة بناء التوازن بين النمو الاقتصادي والخصوبة الاجتماعية. إن مستقبل المملكة لن يُقاس فقط بمعدلات الاستثمار أو نسب النمو، بل بقدرتها على الحفاظ على تماسكها الديموغرافي والاجتماعي في ظل التحولات العالمية.
إنه إنذار يجب أن يُؤخذ بجدية علمية ومسؤولية وطنية، لأن الوقت ليس في صالحنا: فإما أن نتدارك التراجع برؤية شمولية ذكية، أو نترك التحول الديموغرافي يُحوّل طموحاتنا التنموية إلى الى معادلة ناقصة.
فؤاد بن المير دكتور في علم الاجتماع والقانون العام