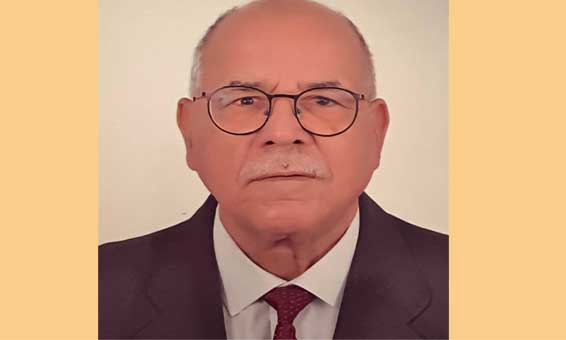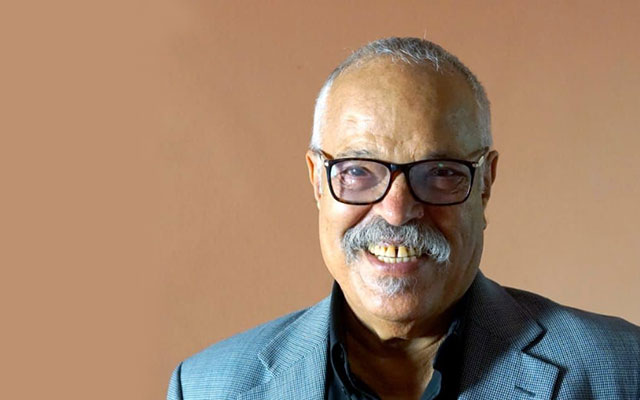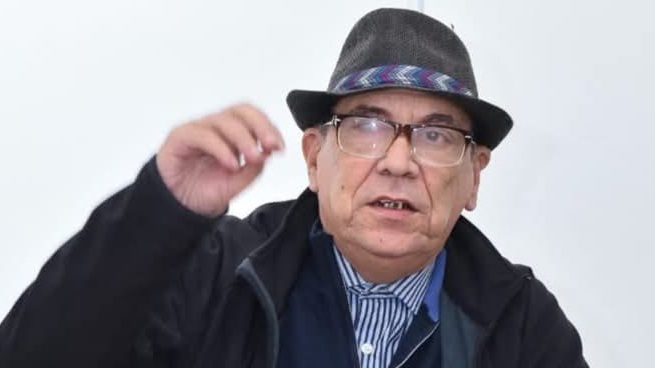صدر عن منشورات "دفاتر وجهات نظر" سنة 2003، مؤلف تحت عنوان: "المخزن في الثقافة السياسية المغربية"، للباحثة المغربية في العلوم السياسية هند عَرُّوب، في حوالي 158 صفحة. والكتاب في مَبناه مُناولة سياسية جريئة وجادة بقلم باحثة سياسية حفرت اسمها بإقتدار كبير في تخصص العلوم السياسية.
في البدء، تُجري هند عروب حفرًا سوسيو-سياسيا في مسار تاريخانية تشكل المؤسسة المخزنية، وعَبر هذا الحفر تُشرك القارئ في عملية تحليل بِنيته الفوقية التي استدمجت ممارستين متضادتين: ممارسة تقليدية تستثمر رصيد التاريخ والدين والأعراف...؛ وممارسة حديثة انفتحت قسرا تحت ضغط الاستعمار على مُستحدثات الحماية الفرنسية، وهياكلها الإدارية التي شيَّدها هوبير ليوطي...وصولا إلى اللحظة التي أفرزت عُنف التجاذبات السياسية حول غياب التوافق من أجل إنتاج الوثيقة الدستورية بين الفاعلين السياسيين بعد الاستقلال.
غداة الاستقلال طُرح سؤال حارق جدا: من يجب أن يُحرر الدستور؟ وماهو نوع الدستور الواجب ارتضاؤه؟ وهو في العمق، سؤال صاغه الباحث وليام زارتمان، ويكاد يُمثل السؤال أعلاه جوهر الكتاب وبِنية انشغاله...حسب ريمي لوفو، المتخصص في الموضوع، تتلمذت المَلكية من مدرسة الحماية، وراهنت على تقزيم النخب السياسية، ذات التوجه الحداثي، من خلال اقتحام الهوامش والأطراف والتوغل في عُمق البوادي المغربية، والعمل على تغيير تراتبياتها الاجتماعية والسياسية بتوظيف العناصر التالية: الولاء، الخدمة، الخضوع، الطاعة...بهدف تزكية شرعية المخزن الجديد...
من يَملك البادية والجبال و"البربرية" يَملك المغرب برمته؟ بهذا، تمكنت المَلكية من ترسيخ سلطتها في عمق البادية، مستعينة بقوة الجيش كقوة مادية، ووزارة الداخلية كقوة سياسية وإدارية. ستعمد المَلكية إلى ضرب القواد الكبار والأعيان القرويين سياسيا، لكن، ستترك لهم النفوذ الاقتصادي، وهي محاولة لاستمالة نخب قروية قادرة على صد زحف نفوذ النخبة الوطنية التي طغى عليها الانقسام كخطيئة لازمت تشكلها في الزمن الاستعماري. هذا الاستقطاب الجديد للنخبة القروية والأعيان الجدد -عَرَّابي المخزن الجديد- هو الذي سيرسم نجاحات الإستفتاءات والدساتيير، وسيكرس منطق الثيولوجية في تدبير السلطة، وسيضخم من صورة الملك، كشخص روحي ومادي مقدس متعال عن تناقضات النسق السياسي.
استدمج المخزن حسب ريمي لوفو، ممارسات سياسية تقليدية بأخرى حديثة. قوانين مخزنية بمضمون طقوسي ورمزي ظلت تسير جنبا إلى جنب مع مقتضيات دستورية جادت بها لحظة الحماية. هذا الاستدماج المثير، لخَّصه كلود بلازولي، حينما وصف الحسن الثاني ب"الحازم والمتحدي"، وهي الإفادة التي نقلتها أيضا إيناس دال حينما وظفت شهادة للحسن الثاني يقول فيها: "إني أعلم الثقل الحقيقي للقلم، وهو بين يدي وزير أول، فإذا ما استخدم في غير وقته يمكن أن يَجُرَّ الأمور بعيدا، وهذه إحدى الأسباب التي جعلتني أنشئ دستورا، إذ قلت لنفسي، إنك لا تستطيع مراقبة وزيرك الأول دائما، ولكن إن روقب من قبل ثلاثمائة أو مائتين فإنه لن يُقدم على حماقات كثيرة، وهذه التجربة أبانت لي عن السلطة التي يمكن أن تكون لوزير غير مراقب...".
المخزن الجديد عَمد إلى دسترة الإرث المخزني. نجد تأكيدا لذلك في شهادات عدة فاعلين مغاربة مثل محمد باحنيني وأحمد رضا اكديرة من خلال القول: "من الصعب أن نفهم بلادنا دون أن نعرف تاريخ ملوكنا". هذا التحليل السياسي، دفع الباحث المغربي عبد اللطيف أݣنوش إلى أن يعتبر الدستور المغربي مُشكلاًّ من طابقين: طابق علوي، يمثل روح الغرب، وطابق سفلي، يجسد عمق الموروث.
وبالعودة إلى الدراسة، تثير دراسة هند عروب حول "المخزن في الثقافة السياسية" جُملة من النقاشات الخصبة حول آلية اشتغال النسق السياسي المغربي ومخاضاته الملتبسة، وطبيعة العلاقات التي تربط بين فاعليه، وكيفية تأطير الوثيقة الدستورية لممارسة اللعبة السياسية. ومن بين الملاحظات التي تثار من داخل الكتاب، نذكر:
أولا: التأكيد على الطبيعة الانقسامية للنسق السياسي المغربي، وهي فكرة أكدها الباحث الأمريكي جون واتربوري في دراسته حول "المَلكية وأمير المؤمنين" بالمغرب، وقد استوحيت من عمق تحليلات ارنست ݣلنير وقبله افنس بريتشارد حول أنساق البِنيات القبلية التقليدية.
ثانيا: التركيز في تحليل النسق السياسي على صورة استدماج المخيال السياسي للجسد السلطوي، كجسد روحي ومادي، ميثولوجي وميتافيزيقي، وهي تحليلات مستوحاة من تنظيرات الفيلسوف الألماني ارنست كونترفيتش في دراسته حول "الجسد السياسي" من خلال كتابه المرجعي "جسدا الملك".
ثالثا: التأكيد على وظيفة التحكيم والتعالي عن الانقسامات السياسية، وتعزيز قوة السلطة من خلال بث الخلافات بين الفرقاء، بهدف إضعاف وتفتيت المعارضة، وهي فكرة مستوحاة من أعمال المؤرخ المغربي جرمان عياش.
رابعا: التسابق بين المؤسسة الملكية والتيارات السياسية حول كسب رهان البادية المغربية كخزان انتخابي، عبر تدجين النخب وصناعة الأعيان الجدد، وهي تحليلات تتوافق مع تصور ريمي لوفو حول الفلاح المغربي المدافع عن العرش.
بالنهاية، يمكن استكمال حلقة فهم المخزن والثقافة السياسية فيما كتبه محمد الطوزي ورحمة بورقية وآخرون، والكتاب يظل حلقة من حلقات فهم جانب من جوانب المؤسسة المخزنية في تدبيرها للنسق السياسي، وفي رؤيتها للأشياء، وخاصة في المزاوجة بين التقليد والتحديث لا الحداثة، وفي تعطيل المسارات التاريخية، بهدف تقوية جهاز المخزن، على حساب إجهاض مسلسل الديموقراطية...وهي إسهامات خِصبة وحيَّة لا تزال تفتح الأقواس الكبرى حول علاقة الدولة بالمجتمع، وحول إشكالية التحول المعاق بينهما.
عبد الحكيم الزاوي
باحث وناقد
باحث وناقد