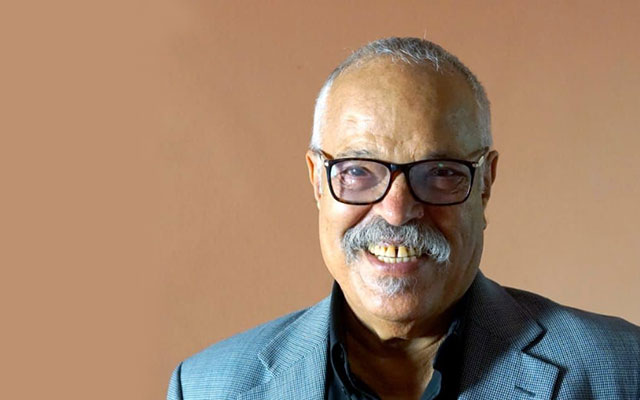قلقٌ غامرٌ ينتابني هذه الأيام، حتى ونحن على أبواب العيد..
الأصح هو أن القلق كان دائما حاضرا بين ضيوفي وزُوَّاري، لكنه زياراته المتواترة لي تعددت في الفترات الأخيرة، وطالت أكثر مما يفترض، أو أطول مما ينبغي!...
غالبًا ما أجد نفسي قلقًا.. قلق بشأن الآتي، قلق بشأن أشياء كان بالإمكان تجاوز حدوثها، وأشياء أخرى لم تحدث بعد...
يملؤني قلق من المستوى غير الضروري.. أو الصنف غير المفهوم، لأن أسبابه ومصادره توزعت وتشتت بين الخاص والعام...
كيف بالإمكان السيطرة على حالات مماثلة لهذا القلق المجهول، وهذا التوتر المفرط، الذي من علاماته قضم الأظافر.. والشرود وعدم التركيز، ومن نتائجه الأرق والانفعال والتعب النفسي...
غالبا ما أتلقى نصحا بتناول مضادات القلق ومهدئات التوتر، وهي متوفرة في الصيدليات.. أو استهلاك قليل من القهوة، أي الكافيين، أو ما تيسر من مشروبات روحية..
يقولون: جرِّبْ.. لعلك حينها ستهدأ وتنسى...
لكني لا أنسى ولا أهدأ...
***
أستحضر رائعة من روائع الحسين بن أحمد، أبو الطيب المتنبي، في إحدى قصائده في مدح أمير صور وصيدا ومرجعيون، الأمير بدر بن عمار الأسدي.. وكان المتنبي، كما تروي المراجع التراثية، نظمها في طبرية بعد تجوال في لبنان، مروراً بالفراديس في حمص..
يقول المتنبي: "على قلقٍ كأنّ الرِّيح تحتي … أوجهها جنوبا أو شمالا"...
***
أتأمل في سيرة ومسيرة الإخفاقات التي واجهتني، وأتساءل هل كل هذا فقط من سوء الحظ...!!
أم إنها هي جزء من حياة اخترتها وخُيّرت لي في الآن والمكان... أو من "المكتوب على الجبين..."..
مهما يكن، سأعترف إنها اختيارات لم تكن تماما صحيحة دائما..
وقد رمت بي إلى صحاري موحشة وفيافي مقفرة، تحالفت علي ذئابها وأفاعيها لتبقيني في مكاني قلقا متوترا... آيلا للنهاية وللسقوط... وللسكن بمدافن الرمل...
وإذا ما توفرت فرص الإعادة المستحيلة فالأرجح سأمشي على الممشى ذاته وأرتاد الطريق نفسها.
***
وأنا أمشي في الشوارع، أمر بأناس كثيرين أصادفهم. في طريقي..
أتقاسم الجلوس في المقاهي مع آخرين لا أعرفهم..
في السابق كانت مقاهينا عبارة عن أندية ضاجَّةٍ بالأُلفة وبعلاقات الصداقات الجميلة، وكل الزبائن هم من معارفي وأصحابي وخلاني..
اليوم تضيق بنا الأمكنة، ويتسع حجم الغربة ومسافات الاغتراب تزيد..
ما الذي تبدل وأنا أتنقل في فضاء مدينتي ودروب مسقط رأسي.. ؟!
...
جلهم انتقلوا للعيش في البوادي والضواحي والمدن البعيدة، أو صاروا متقاعدين قابعين في البيوت.. يوارون جملة من أمراض موصوفة بالمزمنة... وأكثرهم اختفوا وغابوا عن الأنظار.. ومنهم من غادروا بالمرة وراحوا... وسبقونا إلى العالم الآخر...
في المقهى القديم أجلس وحيدا، أسترق النظر إلى الطاولات القريبة، طاولات امتلأت بالثرثرة واللغو وبالصخب.. أتوعد في سري أصحابها من الشباب الصغار بلوثة الصمت.. بما هو مقدر لهم بعد أعوام.. ثم سرعان ما أنتبه لما اقترفته من ذنب تجاه أشخاص أبرياء.. أناس لا أعرفهم ولا يعرفونني، وما بيني وبينهم كما يقال "إلا الخير والإحسان".. ومن الخير والإحسان أن أتركهم لحالهم ولا أفكر في مصائر سيئة وغير مستحبة لهم...
ثمّ أُعيد النظر في كلّ ما حدث، في الأشخاص الذين ما زالوا على تواصل معي.. وفي كلّ الأحداث التي مررتُ بها معهم... في من تعلمت منهم الكثير.. من علّموني تقدير الأشياء واحترام كلّ لحظة، وإدراك أن الوقت أو الزمن غالبًا ما تمضي لحظاته بسرعة وتتلاشى، لتتحول إلى مجرّد ذكرى...
إذن لم تبق بين أيدينا سوى الذكريات.. والذكريات لا تموت، بل تظل عالقة في مخيلتِنا، تستمر تنبض حية في الأرواحِ...
***
لكي يعيش التاريخ، كما في أغنية فرنسية، لا بد من الاحتفاظ بمفاتيح أبوابه، وهي الذكريات وحقائبها المثقلة باللوعة وبالقلق والحنين...
***
الجميع يعرف ما هو الغضب أو معنى الفرح والحزن، لكن يبدو أن لا أحد يستطيع التمييز بدقة بين مفاهيم القلق والخوف ومعاني الرعب والضيق.
وتجد في بعض اللغات المتقدمة أنها لا تمتلك مفردات خاصة تحتوي على تمييز واضح بين الخوف والقلق.
القلق باعتباره استعدادًا عاطفيًا، ربما هو القلق ذاته الموصوف بملهم الفنانين والأدباء الكبار... إنه القلق المرضي، الذي لولاه، مثلا، ما كان هناك مبدع إنساني خالد اسمه فيوديور دوستويفسكي..
***
لم أعد أذكر لمن قرأت هذه العبارة الفلسفية حول القلق: "القلق هو خوف بلا هدف".
ذاك هو قلقي ربما.. سيقول لي هذا من يعرفني..
ولأني لست فيلسوفا، بل مجرد نصف مجنون، سأتساءل دائما عن هدفي وأخاف عليه..
هكذا.. وبعدما بدأت السكينة تتسرب إلى نفسي وخاطري سيعود إلي القلق، وليس أي قلق.. إنه قلقي الخاص الذي يشبهني... فالقلق مثل البصمات...
هكذا أبقى "على قلقٍ كأنّ الرِّيح تحتي … أوجهها جنوبا أو شمالا"...