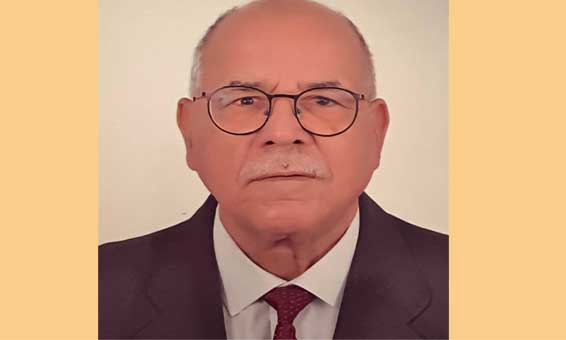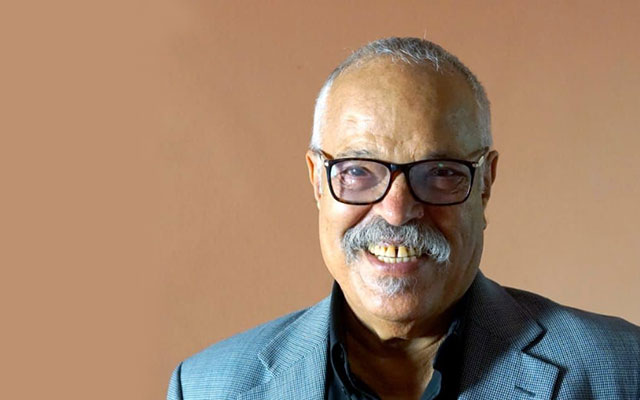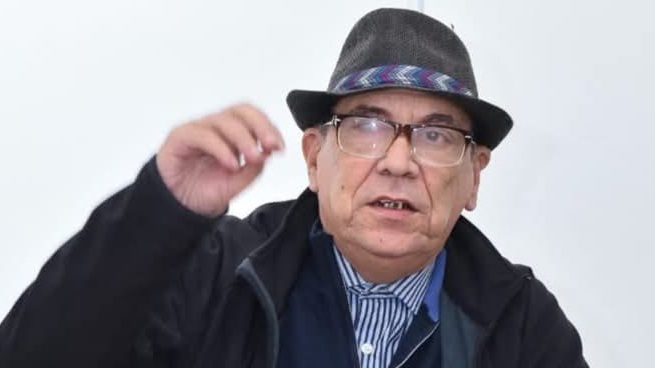حين يُذكر الفساد، يُستدعى إلى الذهن ذلك المعنى السلبي المرتبط بالانحراف عن القوانين والأخلاقيات، واستنزاف الموارد العامة، وتقويض الثقة بين المواطنين والدولة. غير أن نظرة أعمق، تستند إلى دراسة متأنية لتاريخ الدول والحضارات، تفضي إلى نتيجة أكثر تعقيدًا: الفساد لم يكن يومًا حالة شاذة في النظام السياسي، بل كان ـ ولا يزال ـ جزءًا من بنيته العميقة، يتلوّن لكنه لا يختفي، يُلعن علنًا ويُدار به الواقع سرًا.
من روما القديمة إلى بغداد العباسية، ومن البلاطات الأوروبية في العصور الوسطى إلى الأنظمة المعاصرة، كانت للفساد وظيفة واضحة في تثبيت مراكز النفوذ وتوزيع الامتيازات. لم تكن الرشوة آنذاك مجرّد سلوك فردي منحرف، بل وسيلة لضبط العلاقات بين المركز والأطراف، أو لإسكات الطامحين ودمجهم ضمن دوائر الحكم. لقد كانت العطايا والإكراميات أدوات سياسية بامتياز، استخدمتها النخب للحفاظ على التوازنات الهشة داخل الإمبراطوريات. وحتى في الأنظمة التي حاولت بناء مؤسسات بيروقراطية “نزيهة”، كالصين في عهد السلالات الحاكمة، لم تختفِ شبكات النفوذ غير الرسمية، بل تأقلمت مع القواعد وابتكرت طرقًا موازية.
في الدولة الحديثة، ومع صعود الخطاب القانوني والمؤسساتي، أخذ الفساد شكلًا جديدًا. لم يختفِ، بل أعاد إنتاج نفسه في صور أكثر تعقيدًا، وأصبح جزءًا من اللعبة التشريعية نفسها. فكم من القوانين سُنّت لتخدم مصالح فئات بعينها؟ وكم من الإعفاءات والصفقات تم تمريرها تحت غطاء المصلحة العامة، بينما هي في جوهرها عمليات إعادة توزيع للريع تحت رعاية الدولة؟ هنا، لم يعد السؤال كيف نحارب الفساد، بل من يملك سلطة تعريفه، ومن يربح من تحديد معاييره.
الذين لا يستفيدون من دورة الامتيازات يسمّون المستفيدين “فاسدين”. أما الذين داخل الدائرة، فيرون أن ما يحصلون عليه هو استحقاق أو “خدمة عامة”. هكذا، يتحول مفهوم الفساد نفسه إلى مساحة رمادية، تحددها السلطة وليس الأخلاق. تتغير قوانين الضرائب، وتُعاد صياغة أنظمة الصفقات العمومية، ليس باسم المساواة، بل خدمةً لفئات محددة ترتبط بالسلطة الاقتصادية أو السياسية. في هذا السياق، يصبح الفساد أكثر من مجرد خلل، بل أداة لإدارة المجتمع.
والأكثر إدهاشًا أن الفساد، في بعض الحالات، لعب دورًا في إنتاج الاستقرار. تمرير المشاريع الكبرى، وبناء التحالفات، وتسكين التوترات الاجتماعية، كلها تمت أحيانًا بوسائل لا تمر عبر القنوات الرسمية. بل إن بعض الدول التي شهدت معدلات نمو عالية ـ مثل الصين والهند ونيجيريا ـ لم تفعل ذلك عبر محاربة الفساد، بل عبر “تأطيره”: تقنينه، توجيهه، والسكوت عنه في حدود معينة. لقد أصبح الفساد، في حالات معينة، أداة للتسريع الإداري، وتليين البيروقراطية، وتسهيل التفاوض غير الرسمي بين مراكز القوى.
من هنا، تبرز المفارقة الكبرى: الدولة تدين الفساد نظريًا، لكنها تشتغل به عمليًا. هناك من اقترح ساخرًا إنشاء “وزارة للفساد”، لكنها لم تر النور، ليس لأنها فكرة عبثية، بل لأنها تكشف الحقيقة التي لا تريد الدولة أن تعترف بها. فالاعتراف بوجود الفساد كآلية رسمية للحكم ينسف أسس الخطاب الأخلاقي الذي تعتمد عليه الدولة لتبرير سلطتها.
بل إن محاربة الفساد نفسها قد تُستخدم كأداة سياسية لإقصاء الخصوم، أو إعادة ترتيب دوائر السلطة. فحين يشرع مسؤول في محاربة الفساد، دون أن يفهم قواعد اللعبة السياسية، غالبًا ما يُقصى أو يُهمَّش. الفساد ليس عدوًا يُحارَب ببراءة، بل قوة متجذّرة تُفهم وتُدار. إنه ليس عارضًا، بل ديناميكية تشكّل جزءًا من كيفية اشتغال السلطة.
في ضوء هذه القراءة، ربما آن الأوان للتفكير في الفساد بطريقة مختلفة: ليس كشر مطلق يجب اجتثاثه، بل كأداة قابلة للتأطير والتقنين. إذا كانت محاربته تؤدي فقط إلى استبداله بصيغ جديدة أكثر دهاءً، فهل يجدر بنا أن نحلم بمجتمع “بلا فساد”؟ أم أن الطرح الواقعي هو التفكير في “فساد نظيف”، أو على الأقل، فساد يخضع للمراقبة والضبط، بدلًا من الإنكار والتمويه؟
قد يبدو هذا الطرح صادمًا، لكن وظيفته ليست تبرير الفساد، بل إخراج النقاش من ثنائيته الساذجة. فالفساد ليس مجرد جريمة تُرتكب في الظلام، بل نظام معقد من العلاقات والمصالح، يشكل جزءًا من فن الحكم في أكثر أشكاله واقعية.