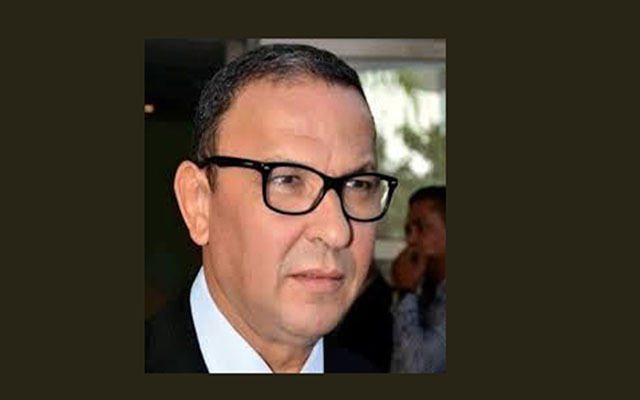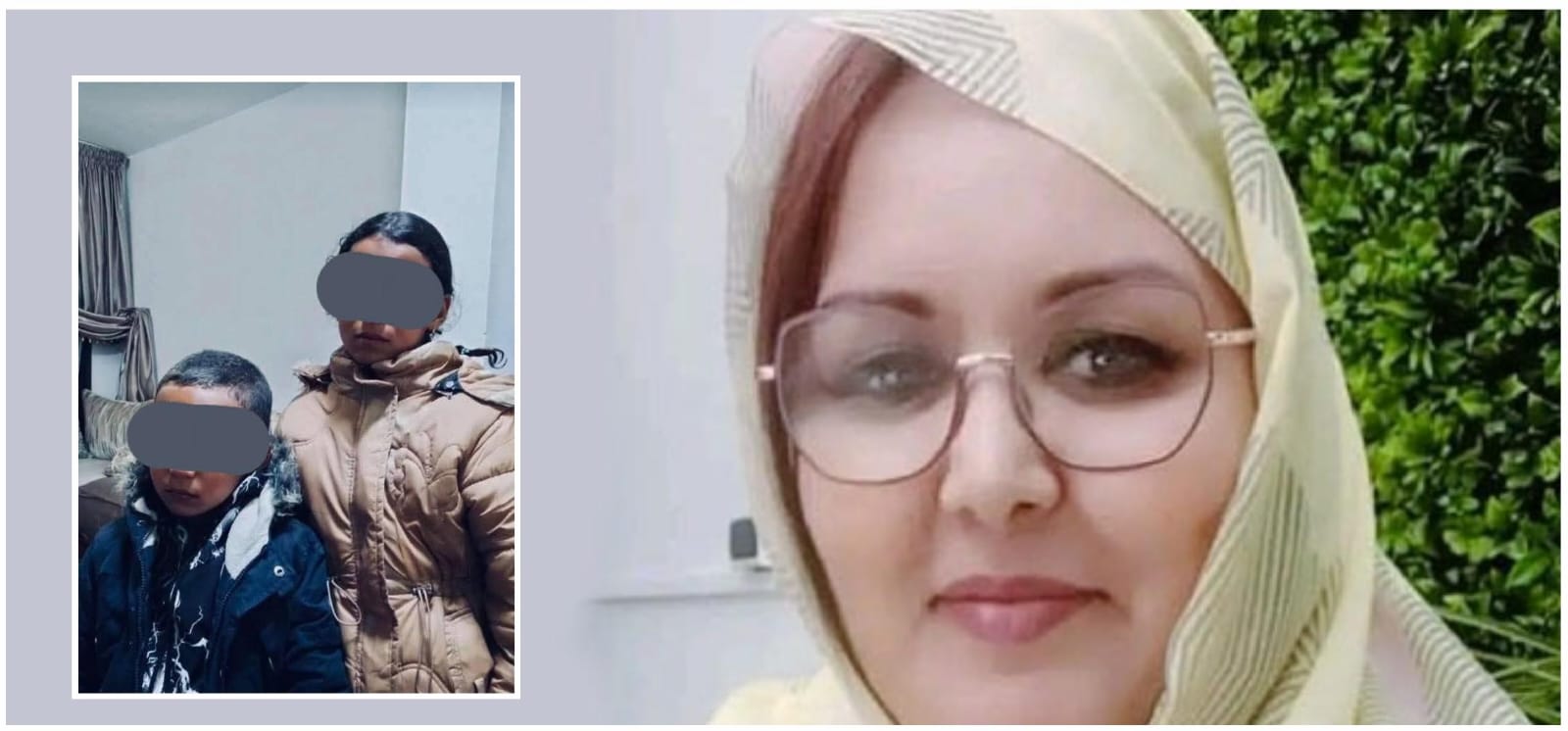سبق وأن أبرز الكتاب الأبيض حول الموارد المائية في المغرب والعديد من مقالاتي اللاحقة الفجوات المتعلقة بالمياه، من حيث البيانات الكمية والنوعية، وكذلك التوزيع المكاني والتطور الزمني. فغالباً ما تكون البيانات المتعلقة بهذه الجوانب غير متاحة أو غير معروفة بشكل جيد، وخاصة تلك المتعلقة بالإمكانات المتجددة للمياه الجوفية والكميات المستغلة، سواء من المياه الجوفية أو المياه السطحية، والتي غالباً ما تكون عرضة لقدر كبير من عدم اليقين. وتتعلق البيانات المتاحة في معظمها بتقديرات قديمة وعامة، وغير متسقة أو حتى متناقضة في بعض الأحيان، وبالتالي لا تلبي متطلبات التشخيص والتخطيط والاستغلال المدقق لهذه المياه، ناهيك عن متطلبات البحوث ذات الصلة.
واليوم نتطرق إلى المياه السطحية، لنسلط الضوء بشكل خاص على السدود الكبيرة والغموض المحيط ببياناتها. لكن قبل ذلك، لا بد من التأكيد على أهمية السدود، والإشارة إلى الدور الأساسي الذي لعبته سياسة السدود في المغرب، وهو الدور الذي لا يزال ساري المفعول اليوم، بل أصبح أكثر أهمية، بعد أن صارت تأثيرات التغير المناخي تشكل الواقع المعاش.
أول ما يلفت الانتباه في البيانات المتعلقة بالسدود الكبيرة هو الفارق الهائل بين عددها الإجمالي والنسبة الصغيرة نسبيا من هذا العدد التي تساهم في التخزين الفعلي للمياه. وبحسب قطاع المياه، يتوفر المغرب على 154 سدًا كبيرًا تبلغ طاقتها الإجمالية نحو 20 مليار متر مكعب، لكن عندما يتعلق الأمر بمعرفة ومراقبة واردات المياه من السدود، أو بعبارة أخرى المخزون المائي الفعلي للسدود، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك من قبل قطاع المياه، نجد حاليا 64 سداً فقط بسعة إجمالية تقل عن 17 مليار متر مكعب، من بينها خمسة سدود تعويضية (barrages de compensation)، تتجاوز سعتها الإجمالية ثلاثين مليون متر مكعب، لا تساهم هي أيضا في الزيادة في المخزون الإجمالي للسدود. وبالتالي فإن 95 سدا كبيرا، أو أكثر من 61.7 في المائة من إجمالي عدد السدود الكبيرة، تمثل طاقتها التخزينية حوالي 16 بالمائة من الطاقة الإجمالية، لا تساهم ولو بالقليل في التخزين الفعلي للمياه.
تجدر الإشارة إلى دخول عشرة سدود جديدة في التشغيل خلال الست سنوات الأخيرة بطاقة تخزينية تزيد عن مليار وستمائة ألف متر مكعب مما رفع عدد السدود التي تساهم في المخزون الفعلي للمياه إلى ال59 السالفة الذكر. لكن العدد الكبير من السدود غير الفعالة وتوزيعها في معظم أنحاء البلاد يثيران التساؤل خاصة وأن السدود الكبيرة يتم تصميمها لكي تدوم مائة سنة على الأقل، عدا إذا كانت سدودا ترابية فتنحصر مدتها في ثلاثين إلى خمسين سنة، من جهة، ومن جهة أخرى فإن معظم ال154 سدود الحالية لا يزال عمرها أقل من خمسين سنة، حيث أن 16 منها فقط يتراوح عمرها بين 50 و 80 سنة و7 يتراوح عمرها بين 80 و 95 سنة. لكن ضمان استمرار تشغيل السدود طيلة المدة المتوقعة خلال التصميم يتطلب الصيانة الدقيقة وفقا لتعليمات الموصي بها لذلك. لذا حبذا لو يقوم قطاع الماء بتوضيح هذا الوضع الغامض عبر تصنيف السدود الكبيرة بناء على عوامل مناسبة مثل الفعالية في تأدية مهامها. فالتصريح بأن لدينا 154 سدا يعطي الانطباع بأننا في مأمن من العطش لكن لما نعلم أن 95 من هذه السدود لا تساهم في الواردات المخزنة من المياه يجعلنا نغير ذلك الانطباع، وهو شعور يساهم في رفع مستوى التوعية بندرة المياه وشبح العطش وبالحاجة إلى الحفاظ على ما توفر من المياه وكذا تثمينها وايلائها الأهمية التي تستحق.
والأسباب التي يمكن أن تجعل السدود الكبيرة لا تشتغل كما ينبغي كثيرة نذكر منها على سبيل المثال التوحل الكامل، خاصة بالنسبة للسدود القديمة، والاعطاب مثل تشققات أرضية السد والتسربات العالية، أو تصدعات في المنشأة الرئيسية أو فقط بسبب الإهمال وعدم القيام بالصيانة، لكن من المرجع أن يكون السبب الأكثر حدوثا هو توقف جريان الماء في الوديان التي بنيت عليها السدود. ومما يؤكد هذا الترجيح هو كون أزيد من 25 سد غير شغالة عمرها أقل من 25 سنة‘ فيما أزيد من خمسين سدا آخريتراوح عمرها فقط بين 25 و 50 سنة.
هذه النسبة العالية من السدود الحديثة العهد التي ليست فعالة، أيا كان سبب ذلك، تثير العديد من التساؤلات وعلى رأسها مدى نجاعة السدود الأخرى التي هي في طور البناء سواء في إطار البرنامج الاستعجالي للتزويد بمياه الشرب والري 2020-2027، أو تلك المبرمجة في أفق 2050، حيث تشير المعلومات المتاحة من قطاع المياه أن عددها يفوق الخمسين، بهدف رفع الطاقة التخزينية الإجمالية إلى 30 مليار متر مكعب، أي بزيادة 50 بالمائة من الطاقة الحالية.
ومما لا شك فيه أن هذه الوتيرة لبناء المزيد من السدود لا يمكن تبريرها كما ينبغي، وذلك باعتبار العدد الكبير من السدود التي كانت متواجدة قبل سنة 2018 من جهة، والنقص الذي شهدته التساقطات المطرية والواردات المائية في المغرب نتيجة التغيرات المناخية، وبما هو متوقع من تأثيرات إضافية لهذه التغيرات في المستقبل غير البعيد، من جهة أخرى. ومن المعلوم أن هذه التأثيرات تؤدي إلى تعطيل نماذج التنبؤ بالإمدادات المائية المستقبلية مما يسفر على تقليل دقتها ، خاصة لتصميم السدود، ويجعل من الصعب التأكد من ضمان نجاعة وفعالية الاستثمار في الكثير من هذه المنشآت. كما أن جل الأحواض المائية صارت مغلقة أي أنها لا تفقد ولو القليل من مياها الى البحر أو الصحراء وبالتالي فإن كميات المياه التي لا زالت تفقد ضعيفة جدا وتوجد أساسا في أحواض صغيرة وذات منحدرات عالية، غالبا نحو البحر، يصعب التحكم فيها ولا توجد فيها أماكن مناسبة للسدود. كل هذه الظروف يؤدي تظافرها إلى ترجيح الاحتمال القاضي بإنجاز سدود كبيرة تبقى فارغة أو شبه فارغة معظم الوقت، لا تحقق إلا مخزونات مائية ضئيلة تتجاوز تكلفة المتر المكعب منها تكلفة تحلية مياه البحر.
وبحسب رأيي الشخصي فإن على الأقل ما بين خمسين و ستيتن بالمائة من السدود التي تم البدء في بناءها خلال الخمس أو ست سنوات الماضة وتلك التي هي في طور البناء أو المبرمجة إلى أفق 2050، من المحتمل جدا أن تكون مبرراتها ضعيفة.
وبناء على ما سبق، يستحسن أن تنحصر السدود المبرمجة على تلك التي يثبت تبريرها على أسس معقولة بما فيها توفر المياه في الحاضر والمستقبل والموقع والتأثير على السدود القائمة وكذا على الاستعمالات القائمة للمياه إن اقتضى الحال، مع اعتبار التأثيرات الفعلية والمتوقعة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين من أجل الوصول إلى الدراسات المتعلقة بهذه السدود وتنظيم مشاورات حولها للأطراف المعنية قبل اتخاذ قرار بنائها. وما زاد على ذلك من السدود سوف تكون تكلفتها مجرد هدر للأموال، كان من الأفضل أن يتم تسخيرها لأهداف ومشاريع أخرى متعلقة بالمياه وذات فعالية ومردودية أعلى. ومن بين الأولويات في هذا الصدد، نذكر على وجه الخصوص مشاريع تعمل على رفع مستوى الحكامة الفعلية للمياه، من خلال تطبيق قانون الماء 36.15 كاملا، وكذا تقوية وكالات الأحواض المائية بالموارد البشرية والإمكانات العملية من أجل التنفيذ الفعلي لنفس القانون على أرض الواقع. فالمشاريع من هذا النوع سوف تمكن ليس فقط من توفير تكاليف السدود ذات الاحتمالات الضعيفة للتمكن من تخزين المياه، بل كذلك سد ثغرة كبيرة في الميزانيات المخصصة لوكالات الأحواض المائية من أجل أن تؤدي المهام المنوطة بها والتي ليست أقل أهمية من السدود.