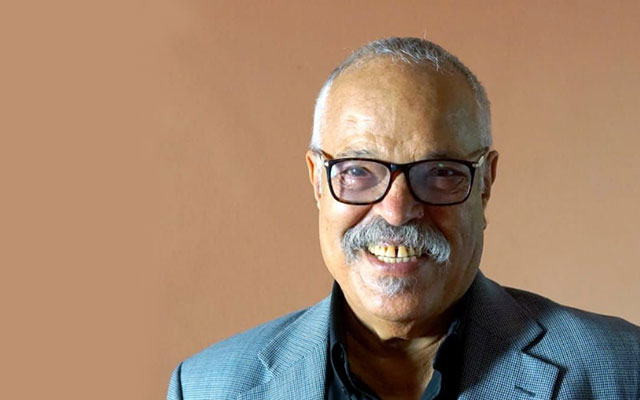مما لا شك فيه أن الحديث عن مؤسسة الحالة المدنية هو في العمق حديث عن مسار سياسي للمغرب المستقل، حديث يسائل كل الفاعلين الرسميين وغير الرسميين الذين تعاقبوا على تحمل المسؤولية السياسية في مختلف مراكز المسؤوليات الإدارية والتمثيلية، وانخرطوا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في بناء المؤسسات ومقومات المواطنة في بلادنا. لقد أثرت في هذا المقال مفهوم المواطنة ومقوماتها، لكون "لا مواطنة بدون هوية"، و"لا تنمية بدون تقوية الانتماء إلى الأسرة والمجتمع". فنعت أي مغربي ب"المواطن" يتطلب إجباريا تمتيعه برسم ولادة خال من الشوائب والأخطاء، وهوية ثابتة لا يجادله فيها أحد كيف ما كان انتماءه أو مركزه المؤسساتي أو الاجتماعي. فبعد ولادته يجب أن يسجل فورا في سجلات الحالة المدنية، ليبقى حقه في معرفة والديه، والعيش في كنفهما وتحت رعايتهما من الأولويات المنمية للشعور بالحماية والأمن، وشرطا أساسيا لبداية الإحساس بالانتماء إلى وطن (عكس التشرد). بهذين الانتماءين، يترعرع مواطن المستقبل في فضاء إنساني يكتسب فيه، أولا كل المعلومات التي تعرف به (من اسم شخصي، واسم عائلي، وتاريخ ومكان ولادته)، وثانيا يراكم فيه بالتدرج مقومات العيش الكريم.
وعليه، ونظرا لهذه الأهمية القصوى، تم ارتقاء مؤسسة الحالة المدنية إلى مكون أساسي من مكونات الأمن العام للدولة والأمة على السواء. إنها المنطلق الذي تتأسس عليه باقي الحقوق الحيوية الضامنة للكينونة الإنسانية الكريمة كالتربية والتعليم والصحة والترفيه والتشغيل.
أما دوافع إدراجي لعبارتي "واقع" و "آفاق" في عنوان المقال، فليس من باب الصدفة، بل مرده كوني من المدافعين على تحويل العبارتين إلى شعارين لمشروعين كبيرين ومتكاملين، الأول يتعلق بترميم شوائب وأخطاء الماضي التي تميز عدد كبير من رسوم المواطنين وسجلاتهم، والثاني تحويل مشروع رقمنة القطاع وطنيا (منظومة تدبير الحالة المدنية) إلى محطة تحول كبرى تجعل الحق في الهوية الثابتة ركنا محوريا في الثقافة المؤسساتية المغربية، ومؤهلا للفرد للسعي لتحقيق مقومات حقوق الإنسان الأخرى بشقيها السياسي والاقتصادي.
ولكي لا أطيل عليكم كثيرا في هذا المقال، الذي أعتبره مجرد مدخل لسلسلة مستقبلية من الكتابات، التي سأحاول من خلالها الربط ما بين الماضي والحاضر، وما بين التنظير التشريعي والواقع، وما بين الأهداف النبيلة لهذه المؤسسة والمنطق السياسي أو الثقافي أو العقليات السائدة، سأقتصر على إبراز كون الرسوم الهوياتية لهذه المؤسسة وطريقة التعاطي مع تدبير مكاتب الحالة المدنية في الماضي، خلق متاعب كثيرة للعديد من المواطنين. فابتداء من سنة 2002، وخاصة بعد سنة 2007، وفرض الإجبارية القانونية للعودة إلى رسوم السجلات من أجل إنجاز بطاقة التعريف الوطنية البيوميترية، وتحويلها إلى مرجع وحيد وواحد لتمكين المرتفقين من النسخ الكاملة والموجزة أبرز بالواضح عن وجود نسبة كبيرة من التباين ما بين الوثائق الرسمية للعديد من المواطنين التي ترتب عنها كل الحقوق المكتسبة للمعنيين بها، والتي تراكمت عبر مسار حياتهم، وأصبحت تشكل مورد رزقهم واستقرارهم وانتمائهم لهذا الوطن (دبلومات، أملاك عقارية، شواهد المسار المهني، بطاقات إقامة بالخارج، جوازات سفر أجنبية بعد اكتساب جنسية بلد الإقامة، ....)، وبين ما ضمن برسوم ولادتهم وهوامشها.
إن تدقيق هوية المواطنين وتحيينها من خلال مستجدات أحوالهم الشخصية يعد من ركائز استقرار الدولة والمجتمع، ليبقى هاجس تحري الدقة في هوية العقارات والممتلكات المكون الثاني المرسخ لمقومات السلم الاجتماعي وتقوية اللحمة الوطنية.
وعليه، فإنجاح تعميم منظومة تدبير الحالة المدنية وطنيا، وتحويله إلى مصدر ثري للمعلومات الهوياتية والإحصائية التخطيطية، لا يمكن أن يحقق أهدافه بالكامل ما لم تقم الدولة بتعبئة شاملة من خلال حملة وطنية من أجل ترميم أخطاء الماضي وإعادة تأسيس السجلات والرسوم غير القابلة للاستغلال والاستعمال. وهنا أبشر سكان إقليم سيدي سليمان أن تعميم هذه المنظومة في مختلف مكاتب الحالة المدنية التابعة له في بداية سنة 2020، يعد، بالرغم من الصعوبات، إنجازا كبيرا يستحق الدعم والتعبئة الشاملة.