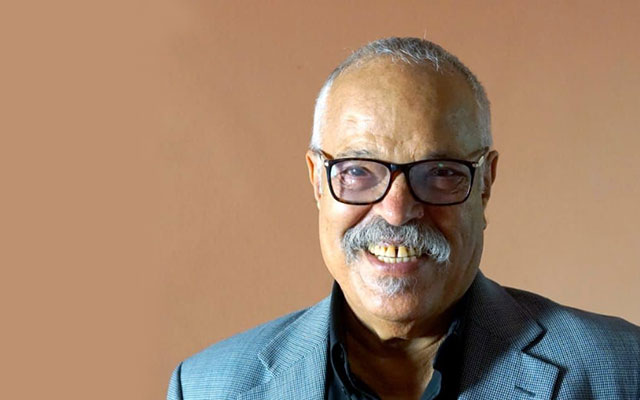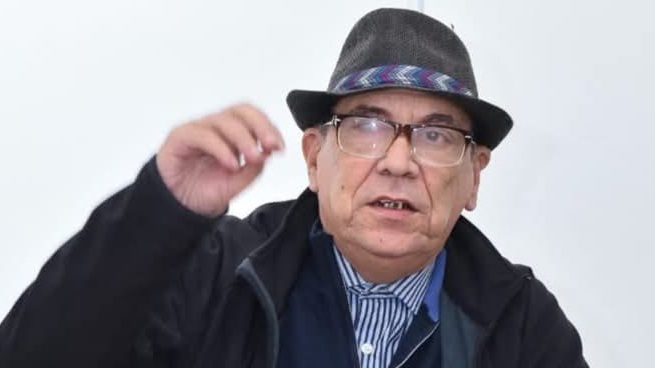لا يمكن لأي قارئ منصف أن يتجاهل القيمة التحليلية العالية التي حملها مقال الأستاذ شكيب الرغاي المعنون بـ “الفروع المزيفة تهدد العمل الجمعوي الجاد”.
لقد قدّم الرجل تشخيصا دقيقا لظاهرة متفشية داخل الجسم الجمعوي التربوي، وهي ظاهرة “الفروع الوهمية” التي تفتقد المقومات التربوية والهيكلية والشفافية، وتضر بجودة العمل التربوي وبثقة المجتمع في الجمعيات.
إلا أن هذا المقال، رغم أهميته، ظل أسير المقاربة التقنية والأخلاقية، بينما سنحاول تسليط الضوء على الزوايا الفكرية والتربوية والسياسية والاجتماعية التي أنتجت هذه الظاهرة في الأصل.
لقد قدّم الرجل تشخيصا دقيقا لظاهرة متفشية داخل الجسم الجمعوي التربوي، وهي ظاهرة “الفروع الوهمية” التي تفتقد المقومات التربوية والهيكلية والشفافية، وتضر بجودة العمل التربوي وبثقة المجتمع في الجمعيات.
إلا أن هذا المقال، رغم أهميته، ظل أسير المقاربة التقنية والأخلاقية، بينما سنحاول تسليط الضوء على الزوايا الفكرية والتربوية والسياسية والاجتماعية التي أنتجت هذه الظاهرة في الأصل.
نكتب ونحن ندرك تماما أن هذه الاسطر لن تكون محط اجماع الفاعلين، ونتفاعل لكوننا أبناء فروع أحد أعرق المدارس التربوية التقدمية بالبلاد.
من هذا المنطلق يأتي هذا المقال على شكل ورقة تفاعلية تقترح قراءة نقدية موازية تتقاطع مع الأستاذ شكيب الرغاي في جوهر الإشكال، لكنها تفتح آفاقا أعمق لفهمه، وتقدّم بدائل عملية لإصلاح المنظومة من داخلها.
من هذا المنطلق يأتي هذا المقال على شكل ورقة تفاعلية تقترح قراءة نقدية موازية تتقاطع مع الأستاذ شكيب الرغاي في جوهر الإشكال، لكنها تفتح آفاقا أعمق لفهمه، وتقدّم بدائل عملية لإصلاح المنظومة من داخلها.
أولا: بين نظرية توكمان وأزمة الفعل الجماعي
علينا أن نعترف أنه قد أصبح العمل الجماعي داخل الفروع التربوية أكثر صعوبة خصوصا في ظل تنامي الفردانية التي عمّقتها الرقمنة وأضعفت روح الانتماء والالتزام الجماعي.
ولكوننا ننتمي الى مدرسة تقدمية تؤمن بالانفتاح على النظريات التربوية، استعنا هنا بـنظرية توكمان التي تشرح بعمق مراحل تطور الجماعات من مرحلة التشكيل إلى الصراع مرورا بالتنظيم ثم الأداء في الميدان.
يبدو أنه في ظل غياب دراسات علمية، معظم جماعات فروع المنظمات التربوية وقياداتها لا تستطيع تجاوز المرحلة الثانية، أي مرحلة الصراعات والمواجهات وهو ما يفسر برودة الميدان داخل دور الشباب والمؤسسات الاجتماعية والساحات والغابات والدواوير عبر ربوع الوطن. ومن هنا نطرح السؤال الاشكالي هل الأجهزة القيادية الوطنية تنخرط لتدبر صراعات الفروع أم تساهم فيها؟ أم تتركها للزمن ؟
ولكوننا ننتمي الى مدرسة تقدمية تؤمن بالانفتاح على النظريات التربوية، استعنا هنا بـنظرية توكمان التي تشرح بعمق مراحل تطور الجماعات من مرحلة التشكيل إلى الصراع مرورا بالتنظيم ثم الأداء في الميدان.
يبدو أنه في ظل غياب دراسات علمية، معظم جماعات فروع المنظمات التربوية وقياداتها لا تستطيع تجاوز المرحلة الثانية، أي مرحلة الصراعات والمواجهات وهو ما يفسر برودة الميدان داخل دور الشباب والمؤسسات الاجتماعية والساحات والغابات والدواوير عبر ربوع الوطن. ومن هنا نطرح السؤال الاشكالي هل الأجهزة القيادية الوطنية تنخرط لتدبر صراعات الفروع أم تساهم فيها؟ أم تتركها للزمن ؟
إن المرحلة الثانية حسب توكمان تتفجر فيها الخلافات حول الأدوار والقيادة والرؤية، وتغيب القدرة على بناء الثقة والضبط الجماعي، مما يمنع الوصول إلى مرحلة التنظيم الداخلي التي تُنتج الانسجام والالتزام. وهكذا، يبقى الفعل التربوي أسير توترات وعلاقات فردية هشة، فيفشل في بلوغ مرحلة الأداء الجماعي التي تُجسّد فيها المردودية والفعالية والتكامل (performance ).
إن هذه الإشكالية العميقة تجعل الفروع التربوية تدور في حلقة مفرغة من الانفعال بدل البناء، ومن المبادرات الفردية بدل المشاريع الجماعية. فالعمل التطوعي اليوم لم يعد يواجه فقط ضعف الإمكانيات، بل يواجه أزمة ثقافة جماعية في زمن أصبحت فيه الرقمنة تُغري الفرد بالظهور أكثر مما تدفعه إلى العطاء المشترك.
ثانيا: تبني مبدأ الجهوية / الإقليمية على حساب اللجان الإدارية
أولى الزوايا التي يجب مناقشتها ونحن نتحدث عن فاعلية الفروع من عدمها هي الإطار البنيوي الذي أصبح يفرزها اليوم أو تشتغل في ظله داخل المنظمات التربوية الوطنية.
فالخلل لا يكمن فقط في غياب الشفافية أو ضعف التأطير... ، بل في التحول غير المؤصل الذي عرفته التنظيمات التربوية الوطنية حين تبنّت “الجهوية” و“الإقليمية” كمبدأ إداري دون تأصيل تربوي وفلسفي يتماشى مع خصوصية الميدان في مجال الطفولة والشباب.
لقد تم استنساخ منطق الدولة في التنظيمات الجمعوية، فظهرت أجهزة جهوية وإقليمية صارت حواجز إدارية بيروقراطية بدل أن تكون جسورا للقرب التربوي.
وبدل أن تُسهم الجهوية أو الإقليمية في توسيع المشاركة وتعزيز الفعل الميداني، تحولت إلى آلية للوصاية والتمركز عطّلت دينامية الفروع وجعلتها تابعة إداريا بدل أن تكون مستقلة تربويا.
وبدل أن تُسهم الجهوية أو الإقليمية في توسيع المشاركة وتعزيز الفعل الميداني، تحولت إلى آلية للوصاية والتمركز عطّلت دينامية الفروع وجعلتها تابعة إداريا بدل أن تكون مستقلة تربويا.
الأخطر من ذلك أن الوضع التنظيمي الحالي للفروع في ظل هذه البنية الجديدة ساهم في هوة التواصل الأفقي والعمودي، مما يجعل المناضل الميداني يشعر وكأنه في علاقة تراتبية دونية مع مراكز القرار التي تنظر اليه من زاوية فوقية.
أمام هذا الوضع، فلا عجب ان تُخلق فروع لأغراض انتخابية أو تفاوضية، تُستعمل كأدوات ضغط، بينما الفروع النشيطة أو المستقلة في قراراتها بسبب الهوة ترى أن القيادات تستفيد وتفاوض من عرقها الميداني دون تواصل أو اعتراف...
بهذا، يصبح مبدأ الجهوية / الإقليمية أداة تمييع لا تمكين، وتتحول الفروع من فضاءات للتربية إلى وحدات بيروقراطية تنتج الإحباط بدل الانتماء.
أمام هذا الوضع، فلا عجب ان تُخلق فروع لأغراض انتخابية أو تفاوضية، تُستعمل كأدوات ضغط، بينما الفروع النشيطة أو المستقلة في قراراتها بسبب الهوة ترى أن القيادات تستفيد وتفاوض من عرقها الميداني دون تواصل أو اعتراف...
بهذا، يصبح مبدأ الجهوية / الإقليمية أداة تمييع لا تمكين، وتتحول الفروع من فضاءات للتربية إلى وحدات بيروقراطية تنتج الإحباط بدل الانتماء.
ثالثا: تصنيف الفروع بين الميدان والمناسبة والورق
إن أي مقاربة إصلاحية جادة تستوجب التمييز بين أصناف الفروع داخل التنظيمات التربوية حتى لا تختلط الأوراق، ويمكن تصنيفها على النحو الآتي:
1- الفروع الميدانية:
هي الفروع التي تمتلك امتدادا حقيقيا مع الأسر والمجتمع، ولها قاعدة أطفال ويافعين قارة تستفيد من برامج أسبوعية منتظمة ومشروع سنوي واضح المعالم، وأطر تربوية شابة وأخرى متمرسة قادرة على مواجهة مختلف التحديات.
تشتغل هذه الفروع في دور الشباب و المؤسسات التعليمية والاجتماعية، ولها خلية فكرية أو لجنة موضوعاتية تُبدع في صناعة المحتوى التربوي، وتجدد فعلها عبر التكوينات المستمرة وطنيا أو محليا.
غالبا ما تبحث باستمرار أن يكون لها مداخيل قارة أو شراكات ودعم سنوي، مما يجعلها عماد الفعل التربوي ومرجع الممارسة الميدانية الأصيلة.
تشتغل هذه الفروع في دور الشباب و المؤسسات التعليمية والاجتماعية، ولها خلية فكرية أو لجنة موضوعاتية تُبدع في صناعة المحتوى التربوي، وتجدد فعلها عبر التكوينات المستمرة وطنيا أو محليا.
غالبا ما تبحث باستمرار أن يكون لها مداخيل قارة أو شراكات ودعم سنوي، مما يجعلها عماد الفعل التربوي ومرجع الممارسة الميدانية الأصيلة.
2- الفروع المناسباتية
وهي نوعان حسب تقديرنا:
أ- الفروع المرحلية
يقودها أطر متمرسة ذات تجربة غنية ميدانيا، لا تمتلك دعما خارجيا ولا شراكات دائمة، لكنها تستند إلى الحس النضالي وروح التطوع النبيل وحب الرسالة التربوية.
يعيقها ضعف قدرتها على تجديد الفعل التربوي واستقطاب أطر شابة قارة لحمل المشعل من جيل لجيل، غير أنها قادرة على الإبداع والصمود إن رفعت سقف التحدي واستثمرت رصيدها الميداني.
يعيقها ضعف قدرتها على تجديد الفعل التربوي واستقطاب أطر شابة قارة لحمل المشعل من جيل لجيل، غير أنها قادرة على الإبداع والصمود إن رفعت سقف التحدي واستثمرت رصيدها الميداني.
ب. الفروع المقاولاتية
فروع فقدت بوصلتها النضالية، لا تستند إلى مبادئ واضحة ولا إلى مشروع تربوي قيمي، ولكنها توظف الكفايات المقاولاتية و تستثمر في السياقات والفرص المتاحة للحصول شركات قوية ودعم خارجي.
أطر هذه الفروع التربوية لا يربطون استمراريتهم بمبدأ التطوع المطلق، يغلب عليها دائما منطق التسويق والصورة أكثر من صدقية اللحظة التربوية، نتيجة ضغط المانحين وتوجه السوق نحو النشاط المناسباتي بدل الفعل المستمر.
أطر هذه الفروع التربوية لا يربطون استمراريتهم بمبدأ التطوع المطلق، يغلب عليها دائما منطق التسويق والصورة أكثر من صدقية اللحظة التربوية، نتيجة ضغط المانحين وتوجه السوق نحو النشاط المناسباتي بدل الفعل المستمر.
3- فروع من ورق
هي فروع ليست بالضرورة وهمية كما وصفها الاستاذ شكيب بل على الورق تُخلق لأغراض تنظيمية أو انتخابية أو لخدمة أجندات آنية، غالبا لا علاقة لأعضائها بالفعل التربوي أو بقضايا الطفولة والشباب.
تظهر هذه الفروع في المؤتمرات والمجالس واللقاءات التنظيمية الوطنية وفي موسم المخيمات كمصدر رزق أو واجهة شكلية، دون أي أثر ميداني حقيقي أو امتداد اجتماعي.
تظهر هذه الفروع في المؤتمرات والمجالس واللقاءات التنظيمية الوطنية وفي موسم المخيمات كمصدر رزق أو واجهة شكلية، دون أي أثر ميداني حقيقي أو امتداد اجتماعي.
رابعا: الفروع الورقية صناعة تنظيمية لا مجرد انحراف
الفروع الوهمية أو المزيفة أو من ورق ليست نتاج تهاون أو غياب وعي فحسب، بل نتيجة هندسة تنظيمية واعية تخدم منطق السيطرة والتوازنات وموازين القوى.
إنها صناعة مُخطط لها تهدف إلى توسيع الخريطة التنظيمية للجمعيات لتُستعمل في المؤتمرات واللقاءات كأوراق ضغط وانتخاب، وتُبرَّر بها طلبات الدعم والمنح.
بهذا المعنى، يتحول العمل الجمعوي من فضاء للتربية إلى سوق للمشروعية الشكلية، يُقاس فيه الحضور بعدد الأختام لا بعدد الأطفال المؤطرين، وتُمنح المقاعد حسب الولاء لا الفعل.
إنها صناعة مُخطط لها تهدف إلى توسيع الخريطة التنظيمية للجمعيات لتُستعمل في المؤتمرات واللقاءات كأوراق ضغط وانتخاب، وتُبرَّر بها طلبات الدعم والمنح.
بهذا المعنى، يتحول العمل الجمعوي من فضاء للتربية إلى سوق للمشروعية الشكلية، يُقاس فيه الحضور بعدد الأختام لا بعدد الأطفال المؤطرين، وتُمنح المقاعد حسب الولاء لا الفعل.
بل إن بعض التنظيمات الوطنية قد تُفرّخ الفروع الورقية أو حتى النشيطة مناسباتيا بغية الحصول على تصنيف من جمعيات محلية إلى جهوية إلى متعددة الفروع فـوطنية، فقط للاستفادة من منح القطاع الوصي.
وهنا نطرح أسئلة جوهرية :
هل تصل هذه المنح فعلا إلى الفروع؟
وما مدى نجاح التنظيمات التربوية الوطنية في بناء شراكات حقيقية تُنعش خزينتها خارج المنح الرسمية لتدعم وتواكب وتسهر على استمرارية فروعها ميدانيا؟
أم تُركت هذه الفروع لتواجه مصيرها وحدها؟
وهنا نطرح أسئلة جوهرية :
هل تصل هذه المنح فعلا إلى الفروع؟
وما مدى نجاح التنظيمات التربوية الوطنية في بناء شراكات حقيقية تُنعش خزينتها خارج المنح الرسمية لتدعم وتواكب وتسهر على استمرارية فروعها ميدانيا؟
أم تُركت هذه الفروع لتواجه مصيرها وحدها؟
خامسا: أزمة القيادة أم أزمة تربية؟
إن اختزال الأزمة في الجانب التقني يُغفل بُعدها الثقافي والتربوي. فنحن أمام تحول عميق في ثقافة العمل الجمعوي:
تراجعت فكرة الرسالة لصالح فكرة الكرسي، وتقدّم منطق الولاء والانتهازية والوصولية على حساب الكفاءة والمد النضالي، وانسحب المربون الحقيقيون أمام تصاعد الإداريين والمدبرين.
إنها ليست أزمة قيادة لا امتداد لها ميدانيا مع الفروع فقط ، بل أزمة رؤية تربوية فقدت البوصلة بين ما يخدم الطفولة والشباب وما يخدم الجهاز التنظيمي.
وفي المقابل، لا تزال هناك فروع ميدانية تشتغل بصمت، تُربّي وتبدع رغم التهميش وقساوة الظروف، وتُصر على أن التربية ليست وظيفة فقط بل رسالة تربوية من جيل لجيل ومسؤولية (ما يحملها من ولى).
تراجعت فكرة الرسالة لصالح فكرة الكرسي، وتقدّم منطق الولاء والانتهازية والوصولية على حساب الكفاءة والمد النضالي، وانسحب المربون الحقيقيون أمام تصاعد الإداريين والمدبرين.
إنها ليست أزمة قيادة لا امتداد لها ميدانيا مع الفروع فقط ، بل أزمة رؤية تربوية فقدت البوصلة بين ما يخدم الطفولة والشباب وما يخدم الجهاز التنظيمي.
وفي المقابل، لا تزال هناك فروع ميدانية تشتغل بصمت، تُربّي وتبدع رغم التهميش وقساوة الظروف، وتُصر على أن التربية ليست وظيفة فقط بل رسالة تربوية من جيل لجيل ومسؤولية (ما يحملها من ولى).
سادسا : الزوايا الفكرية والتربوية والسوسيولوجية لأزمة الفعل الميداني.
- الزاوية التربوية:
لم يُعَد تعريف مفهوم “الفرع” في ضوء التربية الشعبية كفضاء تعلم جماعي قائم على المشاركة والمواطنة والعمل التطوعي الحر، لا كمجرد وحدة تنظيمية إدارية.
لم يُعَد تعريف مفهوم “الفرع” في ضوء التربية الشعبية كفضاء تعلم جماعي قائم على المشاركة والمواطنة والعمل التطوعي الحر، لا كمجرد وحدة تنظيمية إدارية.
- الزاوية السوسيولوجية:
تحوّلت العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني إلى علاقة “دعم ومردودية”، مما شوّه منطق الفعل التربوي، وخلق سباقا نحو المنح بدل التنافس في الإبداع والمضمون
تحوّلت العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني إلى علاقة “دعم ومردودية”، مما شوّه منطق الفعل التربوي، وخلق سباقا نحو المنح بدل التنافس في الإبداع والمضمون
- الزاوية الفلسفية:
غاب السؤال الجوهري: هل لا تزال التنظيمات التربوية تعتبر الطفل غاية الفعل التربوي، أم أصبح وسيلة لتبرير وجودها؟
غاب السؤال الجوهري: هل لا تزال التنظيمات التربوية تعتبر الطفل غاية الفعل التربوي، أم أصبح وسيلة لتبرير وجودها؟
- زاوية الإنسانية الجديدة:
فقدت التنظيمات التربوية الحميمية والعلاقات الإنسانية الحية. لم تعد القضايا المشتركة والنقاشات الفكرية تُناقش، بل أصبحت اللقاءات الافتراضية تطغى على الواقعية بعد جائحة كورونا، في سياق يسوده التراتبية والبرود العلائقي أحيانا.
إن العمل التربوي لا يمكن أن يعيش دون دفء الميدان ودينامية الاختلاف الجماعي، فالميدان هو الذي يصنع التربية لا “الوسائط الافتراضية”.
إن العمل التربوي لا يمكن أن يعيش دون دفء الميدان ودينامية الاختلاف الجماعي، فالميدان هو الذي يصنع التربية لا “الوسائط الافتراضية”.
سابعا: التحولات الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على الفعل التربوي
ضعُف الفعل التطوعي بسبب تراجع جاذبية دور الشباب التي أصبحت معظمها متهالكة ومغلقة، وجيل اليوم لم يعرفها ولم يتذوق عشقها لا كطفل ولا كشاب.
هذا الجيل المرقمن لا يقبل بسهولة منطق العطاء التطوعي دون مقابل مادي، لأن الرقمنة أعادت تشكيل العلاقات الاجتماعية والأسرية وزادت من عزلة الأفراد.
كما أن تنامي القطاع التربوي الخاص (التعليم الخصوصي، شركات التنشيط، مؤسسات الأعمال الاجتماعية...) ساهم في إضعاف الفعل التطوعي داخل الفروع، إذ أصبحت الرحلات والمخيمات والورشات تتخضع لمنطق السوق لا بمنطق الرسالة.
فكيف يمكن للفروع الميدانية الحفاظ على الاستمرارية بطاقمها البشري في ظل هذا الواقع؟
وكيف يمكنها تسطير مشاريع سنوية تستجيب لانتظارات الأطفال وتُكافأ في النهاية بمشاركة تخييمية شكلية لا تليق بجهدها ولا بقاعدتها التربوية ؟
هذا الجيل المرقمن لا يقبل بسهولة منطق العطاء التطوعي دون مقابل مادي، لأن الرقمنة أعادت تشكيل العلاقات الاجتماعية والأسرية وزادت من عزلة الأفراد.
كما أن تنامي القطاع التربوي الخاص (التعليم الخصوصي، شركات التنشيط، مؤسسات الأعمال الاجتماعية...) ساهم في إضعاف الفعل التطوعي داخل الفروع، إذ أصبحت الرحلات والمخيمات والورشات تتخضع لمنطق السوق لا بمنطق الرسالة.
فكيف يمكن للفروع الميدانية الحفاظ على الاستمرارية بطاقمها البشري في ظل هذا الواقع؟
وكيف يمكنها تسطير مشاريع سنوية تستجيب لانتظارات الأطفال وتُكافأ في النهاية بمشاركة تخييمية شكلية لا تليق بجهدها ولا بقاعدتها التربوية ؟
ورغم كل ذلك، ما زال هناك مناضلون حقيقيون ومربون وعاشقون لحمل الرسالة التربوية يقاومون بذلك الأمواج العاتية، تعودوا أن ينفقوا من إمكانياتهم الخاصة ويواصلون حمل الرسالة التربوية جيلا بعد جيل، مؤمنين أن الفرع ليس بناية ولا لافتة بل علاقات حية بين مكوناته أولا والطفل والمدرسة والأسرة والمجتمع.
ثامنا: استمرارية الفعل التربوي في زمن التحول الرقمي
رغم كل التحولات، علينا أن نعترف أننا مقبلون على مناظرة وطنية للتخييم بينما لا تزال المناهج والمضامين التربوية جامدة لم تواكب التطور الرقمي ولا التحولات التي تلبي حاجات الطفولة الجديدة.
ما زالت العديد من الجمعيات تشتغل بنفس أنماط “الصبحيات” الكلاسيكية: نشيد لم يتطور / لعب لم نستطع جعلها موضوعاتية حسب السياق والتحولات / معمل تربوي لا يتماشى مع مستجدات الديكور المنزلي مثلا والتكنولوجي الحالي ... وكأن الزمن توقف عند مرحلة ما بعد الاستقلال.
الطفل اليوم مرقمن، ذكي، متصل بالعالم، وهاتفه أصبح وسيلته للترفيه والتعلم، بينما تفتقد فروع كثيرة لقيادات تملك رؤية حول إدماج الوسائل الرقمية في التنشيط ونفتقد إلى القدرة على إبداع مشاريع تربوية ترفيهية وابداعية جديدة نتيجة غياب استثمارات في البحث العلمي التربوي ونتيجة عدم انفتاحنا داخل القطاع على تجارب ومشاريع ونظريات دول أخرى وراجع أيضا إلى جمود مضامين التكوين والتأطير.
ما زالت العديد من الجمعيات تشتغل بنفس أنماط “الصبحيات” الكلاسيكية: نشيد لم يتطور / لعب لم نستطع جعلها موضوعاتية حسب السياق والتحولات / معمل تربوي لا يتماشى مع مستجدات الديكور المنزلي مثلا والتكنولوجي الحالي ... وكأن الزمن توقف عند مرحلة ما بعد الاستقلال.
الطفل اليوم مرقمن، ذكي، متصل بالعالم، وهاتفه أصبح وسيلته للترفيه والتعلم، بينما تفتقد فروع كثيرة لقيادات تملك رؤية حول إدماج الوسائل الرقمية في التنشيط ونفتقد إلى القدرة على إبداع مشاريع تربوية ترفيهية وابداعية جديدة نتيجة غياب استثمارات في البحث العلمي التربوي ونتيجة عدم انفتاحنا داخل القطاع على تجارب ومشاريع ونظريات دول أخرى وراجع أيضا إلى جمود مضامين التكوين والتأطير.
نحتاج اليوم إلى دراسات ميدانية تُظهر مدى قدرة فِرق التأطير التربوي المتطوعة على الصمود أمام ضغوط الحياة اليومية في المدن الكبرى، مقابل معرفة ما مدى مقاومة هذا الفعل التربوي في القرى والمدن الصغرى التي طالما نستشعر أنه ما يزال الفعل الجمعوي التنشيطي يحتفظ بدفئه وبساطته.
وهنا يبقى السؤال:
أين هو الفريق التربوي المتطوع داخل الفروع القادر على اقتحام المدارس والمؤسسات الاجتماعية وخوض مختلف التحديات والورشات الموضوعاتية؟
وهنا يبقى السؤال:
أين هو الفريق التربوي المتطوع داخل الفروع القادر على اقتحام المدارس والمؤسسات الاجتماعية وخوض مختلف التحديات والورشات الموضوعاتية؟
من يملك اليوم ( في ظل قساوة وغلاء الحياة وضيق الوقت والتباعد بين الأفراد / الغزو التكنولوجي /صعوبة مهمة التنشيط التربوي مع طفل اليوم ) العزم والايمان بالرسالة التربوية لمنح الفرحة والسعادة للطفولة ....؟
إن الأزمة ليست في الهياكل فقط، بل في ندرة الإنسان التربوي المتطوع المؤمن بالفعل.
ولهذا وجب على القيادات أن تنزل من منطقة راحتها لتساهم مع اخوانها في الفروع من أجل اعطاء الروح والدفئ للميدان عوض التجريح وانتقاد وضعية الفروع باختلاف واقعهم وإمكانياتهم...
إن الأزمة ليست في الهياكل فقط، بل في ندرة الإنسان التربوي المتطوع المؤمن بالفعل.
ولهذا وجب على القيادات أن تنزل من منطقة راحتها لتساهم مع اخوانها في الفروع من أجل اعطاء الروح والدفئ للميدان عوض التجريح وانتقاد وضعية الفروع باختلاف واقعهم وإمكانياتهم...
نعم نحتاج إلى قيادات تربوية تكون معادلة ميدانية في الحل وليست طرفا في تشخيص الأزمة.
تاسعا: نحو تصحيح البوصلة لحمل الرسالة التربوية
إن الفكر الكشفي والتربية الشعبية يقدّمان اليوم أفقا تجديديا لبناء تنظيمات قائمة على الإنسان لا على الهياكل، وعلى الفعل لا على التقارير.
مقترحات استراتيجية:
- وزارة الشباب والثقافة والتواصل
- إنشاء منصات رقمية تشاركية لتبادل الخبرات أفقيا، لا لخلق تراتبية جديدة.
- إحداث مرصد وطني للفعل التربوي يتتبع الأداء ويقيس الأثر الاجتماعي
- إنشاء مراكز تكوين جهوية لتأهيل القيادات التربوية الميدانية.
- إنشاء منصات رقمية تشاركية لتبادل الخبرات أفقيا، لا لخلق تراتبية جديدة.
- إحداث مرصد وطني للفعل التربوي يتتبع الأداء ويقيس الأثر الاجتماعي
- إنشاء مراكز تكوين جهوية لتأهيل القيادات التربوية الميدانية.
- الجمعيات التربوية الوطنية
- وضع نظام تحفيزي للفروع النشيطة (دعم مالي، تكوينات ممهننة، تمثيلية وطنية عادلة).
- التسابق نحو كسب الملفات وليس المسؤوليات
- العقلنة في التأسيس والجرأة في التجميد
- دعم الفروع المحلية ومواكبتها أفقيا وعموديا باعتبارها نواة التربية الشعبية.
- ابتكار قوانين تقوى عمل اللجان الإدارية الموضوعاتية وتستوعب الكفاءات التي تعتبر أداة وصل بين عشق الميدان واكراهاته ورؤية القيادات في خضم التحولات المجتمعية في مجال الطفولة والشباب.
في الختام، لقد فتح الأستاذ شكيب الرغاي نقاشا شجاعا حول الفروع المزيفة، لكن التحدي الحقيقي اليوم هو الانتقال من التشخيص إلى التأسيس.
فهل نحن مستعدون لإعادة بناء التنظيمات التربوية على أساس تربوي وإنساني يعيد الاعتبار للميدان وللمناضل معا؟
وكيف نحول الفروع الورقية من علامة أزمة إلى فرصة لإعادة ميلاد العمل الجمعوي التربوي المغربي في زمن التحول الرقمي؟
وكيف نحول الفروع الورقية من علامة أزمة إلى فرصة لإعادة ميلاد العمل الجمعوي التربوي المغربي في زمن التحول الرقمي؟
إننا لسنا أمام فروع مزيفة فقط، بل أيضا أمام أزمة معنى يعيشها الفعل التربوي في زمن النيوليبرالية والرقمنة.
لقد حوّلت النيوليبرالية الجمعيات إلى مقاولات صغيرة، والرقمنة إلى فضاء بارد يفتقر للدفء الإنساني الذي تصنعه لحظة تربوية صادقة بين مؤطر وطفل وبين رفقاء الدرب أيضا.
فالرهان الحقيقي اليوم ليس على الهياكل ولا على المؤتمرات لوحدها، بل على إحياء الإنسان التربوي الذي يجمع بين عشق الميدان ورؤية المستقبل.
إن الفروع الميدانية الأصيلة التي تواصل العطاء رغم قساوة الظروف هي آخر قلاع التربية الشعبية المغربية، وهي التي تمنحنا الأمل في أن البعث ممكن، إذا ما عادت البوصلة إلى موقعها الطبيعي:
حيث الميدان هو الأصل، والطفل هو الغاية.
حيث الميدان هو الأصل، والطفل هو الغاية.