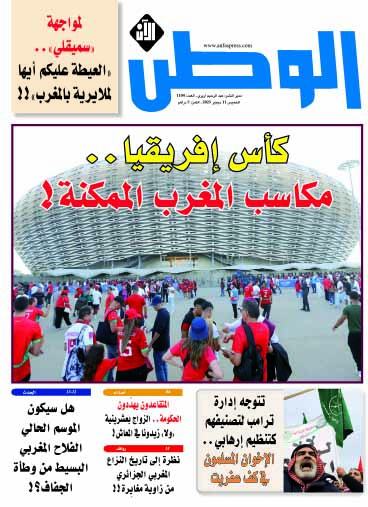يحلل عبد الله بادو، وهو باحث في السياسات التربوية والثقافية تمظهرات فشل الإصلاحات التربوية الذي بوشرات في المغرب لأكثر من40عاما، ويقترح مفاتيح ستة حتى يتحول التعليم إلى رافعة للتنمية.
المغرب دائما يشكو منذ التقويم الهيكلي من مشاكل في قطاع التعليم. ما الوصفة لتجاوز هذا الوضع وحلّ المشكل؟
منذ عقود والمغرب يعاني من أزمة عميقة في مجال التعليم رغم الجهود والاستثمارات التي عبأتها الدولة لتطويره وتجويده، حيث فشلت كل المحاولات الإصلاحية ولم تبلغ أهدافها وبقي واقع المنظومة التعليمية كما هو، ويحتل المرتبة 63 عالمياً في جودة التعليم بين 72 دولة في تقرير التعليم العالمي لعام 2025، بمجموع نقاط 70.212 صنفته منصات أخرى في المرتبة الثانية إفريقيا وفي المرتبة 55 عالمياً وفق World Population Review. بينما تشير مؤشرات أخرى إلى تراجع المغرب إلى المرتبة 110 عالمياً من أصل 182 دولة حسب مؤشر العدالة العالمية لسنة 2025. وعرفت المنظومة التعليمية تدهورا خطيرا بسب السياسات المعتمدة منذ تطبيق برنامج التقويم الهيكلي في ثمانينيات القرن الماضي، والتي نتج عنها أزمات بنيوية عميقة أبرزها ضعف جودة التعليم، استمرار الهدر المدرسي، عدم ارتباط المنظومة التعليمية بسوق الشغل، وتفاقم الفوارق الجغرافية والاجتماعية.
منذ عقود والمغرب يعاني من أزمة عميقة في مجال التعليم رغم الجهود والاستثمارات التي عبأتها الدولة لتطويره وتجويده، حيث فشلت كل المحاولات الإصلاحية ولم تبلغ أهدافها وبقي واقع المنظومة التعليمية كما هو، ويحتل المرتبة 63 عالمياً في جودة التعليم بين 72 دولة في تقرير التعليم العالمي لعام 2025، بمجموع نقاط 70.212 صنفته منصات أخرى في المرتبة الثانية إفريقيا وفي المرتبة 55 عالمياً وفق World Population Review. بينما تشير مؤشرات أخرى إلى تراجع المغرب إلى المرتبة 110 عالمياً من أصل 182 دولة حسب مؤشر العدالة العالمية لسنة 2025. وعرفت المنظومة التعليمية تدهورا خطيرا بسب السياسات المعتمدة منذ تطبيق برنامج التقويم الهيكلي في ثمانينيات القرن الماضي، والتي نتج عنها أزمات بنيوية عميقة أبرزها ضعف جودة التعليم، استمرار الهدر المدرسي، عدم ارتباط المنظومة التعليمية بسوق الشغل، وتفاقم الفوارق الجغرافية والاجتماعية.
ومن مظاهر الأزمة بعد التقويم الهيكلي يمكن تلخيصها على سبيل الذكر لا الحصر في:
* ضعف البنية التحتية والتجهيزات وضعف تأهيل المؤسسات التعليمية، حيث عانت المدارس المغربية من الإهمال وقلة الاستثمارات، مما أدى إلى تدهور المعدات وتراجع جودة البيئة التعليمية، خاصة في المناطق القروية.
* هدر مدرسي مرتفع :تغادر أعداد ضخمة من التلاميذ مقاعد الدراسة سنوياً، خاصة بسبب الهشاشة الاجتماعية وصعوبة المناهج وعدم ملاءمتها مع واقع التلميذ المغربي. عدد المنقطعين عن الدراسة عام 2024 بلغ 280 ألف تلميذ وتلميذة، بنسبة 8.5% من مجموع المسجلين في التعليم الأساسي. كما كشفت الإحصائيات الرسمية عن انخفاض معدل الهدر المدرسي بنسبة 12% بين موسمي 2021-2022 و2022-2023، حيث تراجع عدد المنقطعين من 334,664 إلى 294,458 تلميذًا.
* انخفاض التحصيل والكفايات الأساسية: تشير دراسات وطنية ودولية إلى تراجع مستويات التحصيل الدراسي، خاصة في اللغات والتفكير النقدي، إضافة إلى التصنيف المتدني على المستوى الدولي. حيث تشير أحدث الدراسات الوطنية والدولية إلى تراجع مقلق في مستويات التحصيل الدراسي والكفايات الأساسية لتلاميذ المغرب، خاصة في مواد اللغات والتفكير النقدي والرياضيات، مع تصنيف دولي متدنٍ في اختبارات معيارية كـ PISA و TIMSSوPIRLS. وقد صرح البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات أن 30% فقط من التلاميذ المغاربة العموميين يتحكمون في المقرر عند نهاية المرحلة الابتدائية، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 10% في نهاية التعليم الإعدادي. نسب التحكم في الكفايات الأساسية بالابتدائي وفق آخر دراسة وطنية: العربية 42%، الفرنسية 27%، الرياضيات 24%والكفايات الأساسية في الإعدادي تدخل وضعية حرجة: فقط 9% يتحكمون في المواد الثلاث، مقابل نسب أعلى في التعليم الخصوصي: الفرنسية 62%، الرياضيات 49%.
* تبعية في المناهج والبرامج التعليمية: استمرت النظم والمقاربات الموروثة عن الحقبة الاستعمارية وما بعدها، دون ملاءمة مع الهوية والثقافة المحلية، ما أضعف ارتباط المدرسة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.
* ضعف تكوين الأساتذة والمشرفين: معظم الموارد المالية توجه للأجور وإدارة القطاع، بينما تغيب برامج التكوين المستمر التجديدية للمدرسين والعاملين في القطاع.
وتعود أسباب استمرار الأزمة الى مجموعة من العوامل لعل من أبرزها:
* غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح: رغم تعاقب المشاريع والمخططات، غالباً ما تبقى القرارات الإصلاحية شكلية أو غير مكتملة، وتحكمها حسابات سياسية واقتصادية.
* استبعاد الفاعلين التربويين الحقيقيين: يتم غالباً استبعاد الأساتذة والفاعلين الميدانيين من وضع السياسات التعليمية، لصالح لجان حكومية أو سياسية.
* عدم الربط الفعال بين التعليم وسوق الشغل: لم تتم مواءمة البرامج الدراسية مع احتياجات الاقتصاد الوطني، ما ساهم في ارتفاع البطالة وسط حاملي الشهادات.
لدينا واقع وجود مدرسة عمومية وخصوصية. ما السبيل إلى ذلك؟ هل يتعين تأميم التعليم الخاص أم كناش تحملات ؟ وإذا أردنا أن نبقي على الخاص ما الذي ينبغي أن نفعله هل نتجه إلى شراكات أم ماذا؟
في المغرب، وجود تعليم عمومي وخصوصي هو واقع قائم يعكس تعددية العرض التربوي، وهو نتيجة تراكمات تاريخية واقتصادية واجتماعية. من خلال السياسات المعتمدة يمكن القول ان الدولة ليس لديها توجه رسمي واضح نحو تأميم التعليم الخصوصي، بل بالعكس تتعامل معه كمكون أساسي للنظام التعليمي لكونه يوفر خياراً متعدد الجودة للأسر، خاصة التي تسعى لجودة أفضل، وفي هذا الاتجاه هناك توجه لإدارته وتنظيمه لضمان تكامله مع التعليم العمومي، عبر قوانين جديدة ومذكرات وزارية تهدف إلى تحسين جودة وشفافية التعليم الخاص، وتقوية نظام المراقبة والتأطير. وهناك جهود لفرض شروط ومراقبة أشد على المؤسسات الخصوصية، خاصة من حيث مطابقة البرامج والمناهج، وضمان استعمال الكتب المدرسية الوطنية، لتجنب التأثير السلبي على القيم الوطنية والدينية والهوية التعليمية والتربوية.
ولتدبير هذه التعددية تطرح إمكانية عقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق استفادة مشتركة، وتعزيز جودة التعليم. هذه الشراكات تشمل تبادل الموارد، تبني الابتكار، وتطوير المناهج، فضلاً عن شراكات مالية وتقنية. وتم الإشارة الى ذلك في القانون الإطار 51-17 والذي يشكل إطارًا تنظيميًا للشراكة الحقيقية والفعالة مع دعم الحكامة الجيدة والشفافية. ويمكن لتلك الشراكات أن تسهم في تعزيز التمويل، تطوير البنية التحتية، تحسين جودة التكوين المستمر للأساتذة، وتبني تكنولوجيات حديثة في المناهج.
في نظري، في ظل الإبقاء على التعليم العمومي والخصوصي كنظام مزدوج يحتاج الى تطوير وإدارة ذكية للشراكة بينهما، إذ هو السبيل الأنسب لتعزيز جودة التعليم وضمان تنوع العرض مع كفاءة الموارد وعدم تهميش الفئات الضعيفة، بدلاً من التوجه الى خوصصة التعليم او لتأميم القطاع الخاص أو تجاهله.
على مستوى التضريب. الأسر تتطلع نحو استرجاع جزء من الضرائب مادام أنها لا تسفيد من التعليم العمومي وتؤدي فاتورة التعليم الخصوصي؟ كيف تقرأ ذلك؟
بالفعل مسألة التضريب تطرح سؤالا جوهريا مرتبطا بجدوى أداء الضرائب مقابل عدم قدرة الدولة على تأمين خدمات اجتماعية أساسية كالصحة والتعليم مثلا. مما دفع نسبة مهمة من الأسر الى التوجه الى خدمات مؤسسات التعليم الخصوصي الشيء الذي جعل الاسر تدفع فاتورة فشل الدولة في التعليم مما يثقل كاهلها وميزانيتها نظرا للرسوم المرتفعة التي يتم تأديتها، حيث تصل أقساط المدارس الخاصة إلى 3000 درهم شهرياً، إضافةً إلى مصاريف التأمين، والنقل والإطعام والكتب وغيرها، وسط محدودية تدخل الدولة لضبط الأسعار في هذا القطاع. وفي هدا السياق نما توجه داخل هذه الأسر للمطالبة بضرورة تحمل الدولة عبء هذه التكاليف المالية المرتفعة جزئيا، مادام أبناؤهم لا يستفيد من جودة التعليم العمومي، من خلال استرجاع جزء من الضرائب التي يدفعونها. هذا التوجه يعكس استياءً واضحاً من واقع التعليم العمومي واعتبار الأسر أن مساهمتها من خلال الضرائب غير مجدية لأنها لا تحقق لهم ولأبنائهم التعليم اللائق.
الأمر يتجاوز مجرد رغبة في استرجاع أموال إلى مطالب اجتماعية بإنصاف ضريبي واعتراف بمأزق الأسر التي تضغط تحت ثقل الضرائب وتكاليف التعليم الخصوصي، خاصة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع كلفة الاستهلاك العام. ويبرز ذلك كمحور لحوار وطني حول إعادة هيكلة نظام التمويل التربوي ليشمل دعما مباشرا للأسر وتحسين الخدمات العمومية.
بالتالي، هذه المطالب تعبر عن تصدع في عقد المسؤولية بين الدولة والمواطنين فيما يخص التعليم، وتعكس ضرورة إصلاحات إيكو-سياسية تتجاوز تخصيص الميزانيات إلى تحقيق عدالة ضريبية وفعالية اجتماعية حقيقية.
نحن الآن على مشارف 2026، بعض الدول اعتمدت العداد الصفر: كانت مثل المغرب أو أقل منه، الاستثمار في الوافدين الجدد وبعد 12 سنة ليعطوا قيمة مضافة في القطاعات التي سيلجونها، وفي نفس الوقت إصلاح ما يمكن إصلاحه، حتى يمكن أن نبلغ المطلوب. كيف وبم يمكن أن نحقق المراد؟
ورش اصلاح التعليم بالمغرب يحتاج الى إرادة سياسية حقيقة من اجل النهوض بالقطاع ومن اجل تنمية وتطوير الإمكان البشري لتأهيله ليكون رافعة ودعامة أساسية للتنمية. ومن بين الحلول التي يمكن الاشتغال عليها وفق ما جاء بالعديد من الدراسات العلمية، أذكر النقط الست التالية:
* تجديد وتطوير المناهج وربطها بمتطلبات العصر والتحولات الرقمية من خلال تحديث مضامين التعليم، وطرق ومنهجيات التعليم لإدماج المهارات الحديثة، مثل التفكير النقدي، الإبداع، التقنيات الرقمية، واللغات مع تعزيز مكانة ودور اللغات الوطنية في المنظومة التربوية والانفتاح على اللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية والاسبانية.
* إدماج التعليم المهني والحرفي في المناهج: بدءاً من مراحل مبكرة في التعليم، لكسر النظرة الدونية للمهن اليدوية وتعزيز فرص تشغيلية واقتصادية.
* اعتماد التعليم الرقمي والمدارس الذكية: إدخال التكنولوجيا والبرمجيات التعليمية الحديثة، وتعميم التربية الرقمية على جميع الأسلاك، وتمكين جميع المتعلمين/ات من الولوج اليها بتوفير بنيات استقبال مؤهلة ومجهزة ومرتبطة بالشبكات.
* رفع مستوى تكوين الموارد البشرية وتفعيل التكوين المستمر: تقوية البرامج التكوينية والتدريبية، وإعادة تأهيل الأساتذة بما يناسب روح التحولات التربوية الحديثة.
* زيادة الاستثمارات في البنية التحتية التربوية جعل التعليم أولوية وطنية تحظى بالأهمية القصوى بتخصيص ميزانيات أكبر لتأهيل الفضاءات المدرسية وتوفير المعدات الحديثة، خاصة في المناطق المهمشة.
* إشراك الفاعلين التربويين وأصحاب الخبرات: إشراك الأساتذة والباحثين والخبراء في رسم السياسات وتنفيذ الإصلاحات لضمان واقعية الحلول وتملّكها من الفاعلين على الأرض وتشجيع البحث التربوي وتثمينه.
كل هذه التدخلات تتطلب إرادة سياسية واضحة، وتفعيل آليات التقييم المستمر، والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي.
المغرب يخصص ميزانية كبرى للتعليم لماذا وكيف؟ هل الفاعل السياسي ضعيف لا يقوى على مواجهة اللوبي أم ماذا؟
يرصد المغرب ميزانية ضخمة لقطاع التعليم بلغت سنة 2025 حوالي 85,6 مليار درهم (أكثر من 8 مليارات دولار)، وهو ما يمثل نسبة تفوق 11% من إجمالي النفقات العمومية، ويضع المملكة ضمن أكثر الدول العربية إنفاقاً على التعليم. توضح الحكومة أن هذه الزيادات تهدف لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، توسيع العرض المدرسي، رفع كتلة أجور المدرسين، ودعم البرامج الاجتماعية لتعميم التعليم ومحاربة الهدر المدرسي. الا ان هذا الاستثمار لا تظهر نتائجه على ارض الواقع حيث مازلنا نرصد.
يرصد المغرب ميزانية ضخمة لقطاع التعليم بلغت سنة 2025 حوالي 85,6 مليار درهم (أكثر من 8 مليارات دولار)، وهو ما يمثل نسبة تفوق 11% من إجمالي النفقات العمومية، ويضع المملكة ضمن أكثر الدول العربية إنفاقاً على التعليم. توضح الحكومة أن هذه الزيادات تهدف لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، توسيع العرض المدرسي، رفع كتلة أجور المدرسين، ودعم البرامج الاجتماعية لتعميم التعليم ومحاربة الهدر المدرسي. الا ان هذا الاستثمار لا تظهر نتائجه على ارض الواقع حيث مازلنا نرصد.
* تدني نوعية التعليم بسبب ضعف التخطيط الاستراتيجي، وعدم تباث وتغير السياسات الحكومية في مجال التعليم منذ عقود، الهيمنة البيروقراطية وضعف تنسيق المتدخلين العموميين، وهو ما يخلق تشتتاً للإصلاحات وعدم فعاليتها.
* رغم المبلغ الضخم المخصص للتعليم إلا أن جزءا مهما من الميزانية يُصرف على الأجور والتسيير، مع محدودية الإنجاز في تجهيز المدارس، وتأهيل الأساتذة، أو تحديث المناهج والمقاربات البيداغوجية.
* تفاوت توزيع الموارد وغياب العدالة المجالية في الإنفاق، مما يؤدي إلى استمرار فوارق مجالية واضحة بين الوسطين الحضري والقروي وبين الجهات.
دون أن ننسى أن قطاع التعليم مثله مثل باقي القطاعات يكون رهينة حسابات ومصالح الفاعل السياسي واللوبيات، حيث يلاحظ ان:
* الفاعل السياسي غالباً ما يكون رهينة لارتهانات الجهاز البيروقراطي وثقل الإدارة، حيث يُقر التشريع والتخطيط في القمة، لكن التنفيذ يخضع لمنطق المصالح، شبكات الولاءات، ونوعية القيادة الإدارية الوسطى وهي الالية التي تتحكم في التعيينات وتوزيع السلط داخل القطاع والتي لا تخضع غالبا لمنطق الكفاءة والأهلية بل تدبر بالولاءات.
* الإصلاح الحقيقي بحاجة لحكامة قوية واستقلال في القرار، بينما تظل لوبيات القطاع الخاص وبعض النقابات وبعض مصالح الإدارة حاضرة ومؤثرة، مما يحد من قدرة السياسات على كسر الحلقة المفرغة للصعوبات البنيوية، وهو القطاع الذي لا يتوفر على آليات تقييم جيدة وفعالة في ظل عدم استقلالية المفتشية العامة ومحدودية أدوارها ووظائفها.
* ضعف المحاسبة والمساءلة، كثرة التغييرات غير المدروسة، وتضارب مصالح الفاعلين تفرمل مفعول الميزانية الضخمة وتجعل مردودها المجتمعي محدوداً رغم الجهود الحكومية.
الخلاصة أن إشكالية التعليم تظل معقدة بنيوياً وإدارياً؛ لا يكفي رصد الموارد المالية بل يستدعي إصلاح حكامة القطاع، محاربة الفساد، وتكريس الشفافية، كي تنعكس الميزانية الكبيرة فعلياً على جودة التحصيل وتقليص الهدر وضمان العدالة المجالية.