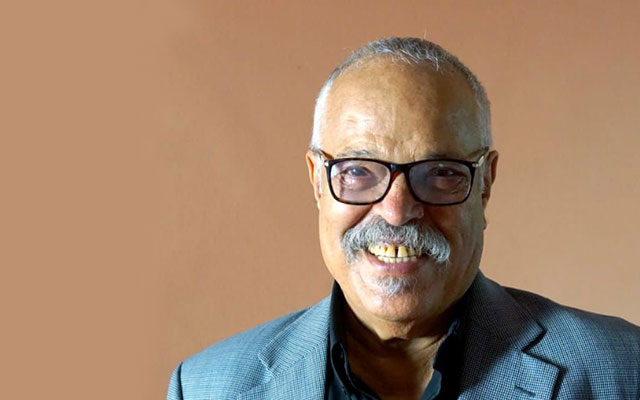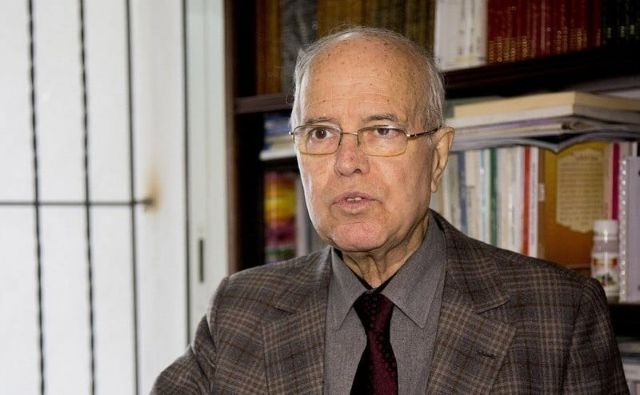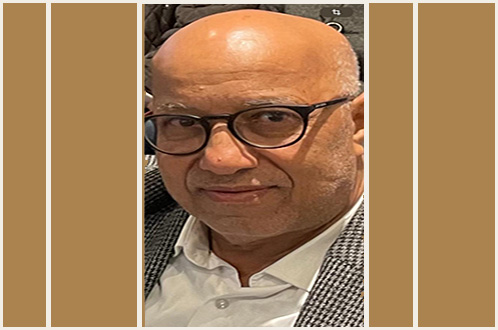1- من الدولة الوطنية إلى الدولة الشبكية: تحوّل في مفهوم الجيل
لقد تشكلت الدولة المغربية الحديثة على أنقاض تجربة الاستعمار، أي في زمنٍ كان فيه مفهوم الجيل مرتبطا بالتحرر وبالوطن وبالتاريخ. كانت الأجيال تُقاس بمدى مساهمتها في بناء الدولة أو الدفاع عن سيادتها كأن نقول: جيل المقاومة، جيل الاستقلال، جيل المسيرة الخضراء.
لكن ابتداءً من العقدين الأخيرين، تغيرت البنية التكوينية لمفهوم الجيل. لم يعد الجيل يُعرّف عبر الذاكرة الجماعية، بل عبر الوسائط التواصلية. لقد أصبحنا أمام انتقال من الزمن السياسي إلى الزمن الشبكي، ومن الجيل التاريخي إلى الجيل الافتراضي.
يعكس هذا الانتقال ما يمكن تسميته بـ انزياح المرجعية الأنطولوجية للإنسان: فبعد أن كان الإنسان يرى ذاته في علاقته بالأرض والتاريخ والجماعة، صار يرى نفسه من خلال الشاشة، أي من خلال تمثيله الافتراضي لذاته. هنا تتحوّل الهوية من هوية واقعية إلى "هوية معروضة" (identité exposée) أكثر منها "هوية معاشة".
2- الجيل Z كحدث فلسفي-اجتماعي: الذات الرقمية والهوية المتشظية
لا يمكن أن نعتبر الجيل Z المغربي مجرد تصنيف ديمغرافي والذي يصل إلى 9,8 مليون شاب وشابة، بل هو تحول أنطولوجي في بنية الذات. إذ يعيش هذا الجيل العالم من منظور آخر يمر عبر الوسائط التواصلية، أي: العالم كفضاء رقمي، بعيدا كل البعد عن العالم الطبيعي الذي كنا ندركه بحواسنا المباشرة وبخيالنا وتأملاتنا. ويكفي أن نشير إلى أن العلاقات الاجتماعية فيه لا تمر عبر اللقاءات المتكررة، والاتصالات المباشرة، والانتظارات المشوقة، بل عبر الربط (connexion) .
في ضوء هذا التحول، يصبح السؤال الفلسفي:
هل ما زال ممكناً الحديث عن “فاعل سياسي” في ظل تفتت الذات إلى صور وتمثيلات رقمية؟ نعلم من خلال تجربتنا المخضرمة في الحياة بين جيلين الرقمي وما قبل الرقمي، أن الذات السياسية التقليدية كانت تتأسس على الوعي والمشاركة والانتماء، أما الذات الرقمية فتعتمد على الظهور والانتشار والتموقع. ولم تعد السياسة فعلاً جماعياً منظما، بل أصبحت أداءً رقمياً (performance numérique)، حيث الفعل السياسي يُختزل في “هاشتاغ” أو “مقطع فيديو” أو "منصة رقمية"، مما يخلق ديمقراطية انفعالية (émocratie) بديلا عن الديمقراطية التداولية التي تقوم على النقاش الفكري والتحليل النقدي والمؤسسات السياسية والاجتماعية.
3- الدولة والمجتمع في زمن الرقمنة: المراقبة بدل المشاركة
ليس غريبا أن نجد كيف تتعامل الدول التي لم تكتمل فيها بعد المؤسسات الديمقراطية مع الوسائط التواصلية الإعلامية والاجتماعية، فبدل أن تتحول هذه الوسائط الرقمية إلى أداة تحرّر ومشاركة وفضاء حر للنقاش والتداول والنقد، تتحوّل إلى أداة ضبط ومراقبة. ولقد رأينا ذلك مع الاعتقالات التي واكبت وتواكب المدونين والمتفاعلين في العالم الافتراضي. وعلى عكس ذلك نجد أن الثورة الرقمية في الديمقراطيات الراسخة شكلت وسيلة لتوسيع المشاركة والمساءلة.
وعليه، يمكن استخلاص الاستنتاج الآتي، الذي سنبني عليه تحليلنا لظاهرة حركة جيل Z المغربية: إن الوسائط التواصلية الرقمية تصبح وسيلة لإعادة إنتاج السيطرة والهيمنة والاحتواء بطرق ناعمة، ونقصد بذلك الاختراق والتحكم عبر البيانات بدل التحكم عبر الإيديولوجيا. ويمكن قراءة هذا التحول في ضوء مفهوم "المجتمعات المراقَبة" للفيلسوف جيل دولوز، حيث لا يعود الضبط مؤسسيا من خلال السجن والمدرسة والحزب، بل ضبطا شبكيا عبر خوارزميات تقيس الرأي وتوجه المزاج العام.
وفي ظل هذا التصور يمكن طرح الفرضية الآتية: هل يمكن أن تتحول حركة جيل Z المغربية إلى مختبر تجريب سياسي جديد لبدائل ممكنة؟
لقد أشرنا فيما قبل أن القاعدة الديمغرافية لمغرب الغد التي ستشغل مناصب المسؤولية في المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتشكل القوة المنتجة في المجتمع هي هذه الفئة التي تتكون من 9,8 مليون شاب وشابة. بمعنى أن هذا الجيل سيشكل القاعدة الديمغرافية النشطة للدولة والمجتمع معا. ولكن كيف يمكن تأمين الدولة سياسيا في ظل جيل يتكلم في السياسة ولا يجد طريقا إلى التأطير والتكوين؟
4- أزمة التأطير السياسي: فراغ المعنى وغياب القنوات
لقد بُني تاريخ الدولة المغربية منذ الاستقلال على شكل سياسي قائم على التنظيمات الاجتماعية: نقابات وجمعيات، وعلى التنظيمات السياسية: أحزاب وجماعات. وكانت تؤدي هذه البنيات وظيفة مزدوجة: النضال على المطالب والمصالح ضمن أشكال مؤسساتية وتنظيمية، وتكوين المواطن على الفعل السياسي المنظم.
لكن مع ضعف هذه البنيات وتراجع الثقة فيها، نشأ فراغ سياسي يُملأ اليوم بالشبكات الاجتماعية، إلا أن هذه الشبكات الاجتماعية لا تنتج فاعلين سياسيين بل مؤثرين رقميين (influenceurs politiques)، أي ذوات تتكلم لا لتؤطر وتنظم وتفكر، بل لتظهر وتنفعل وتؤثر. ويشكل هذا التحول من “التأطير والتنظيم” إلى “الظهور والمرئية” في جوهره تحول في بنية الخطاب السياسي نفسه، حيث لم تعد السياسة تُمارس كفعل عمومي واعٍ، بل كعرض فرجوي قائم على الصورة والانفعال والترند.
5- التكوين السياسي الممكن لجيل Z: بين الاحتواء وإعادة التأهيل
لقد علمنا التاريخ السياسي للدولة المغربية أن الهاجس الذي يحكم النظام السياسي هو ضمان شرعية الحكم، وإذا كانت الأجيال السابقة قد تعلمت كيف تمارس السياسة في ظل معادلات سياسية معقدة جدا تتركب من الاحتواء والإقصاء والاستقطاب والاحتضان والتفاوض والتنازع تصل بالسلطة والمجتمع إلى تسويات ممكنة من أجل أمن الوطن واستقراره، فإن الأجيال اللاحقة وعلى رأسها جيل Z لم يمر من هذه البنيات التقليدية السياسية ليتعلم كيف يتعامل مع معادلات سياسية، تحتاج إلى الكثير من الفهم والاستيعاب لإدراك طبيعة التوازنات الممكنة في تحقيق التقدم والازدهار المطلوبين، ضمن تحولات عالمية دائمة. والدولة التي لم تكتمل فيها بعد المؤسسات الديمقراطية، ولم تستطع بعد تحقيق توازن ممكن بين الحقوق والواجبات، ولم تجد بعد صيغة للتعاقد حول السلطة والثروة، لا يمكنها أن تراهن على جيل يتكلم في السياسة، ولا يثق في المؤسسات، ولا يعرف كيف الطريق إلى ممارسة السياسة سوى العالم الافتراضي والاحتجاج. وإذا كان هذا الجيل يمتلك اللغة السياسية، فإنه يفتقد إلى الخطاب السياسي؛ وإذا كان يدافع عن ثوابت الدولة، فإنه يجهل أن هذه الثوابت تقوم على المشروعية الدستورية وليس على العواطف الجياشة، وبقدر ما يبدو أن ما يمتلكونه يتماشى مع أسلوب الدولة في الممارسة السياسية الراهنة، إلا أن هذا كان ممكنا عندما كانت تتحكم الدولة في آليات الضبط والمراقبة التقليدية، أما الآن وفي المستقبل بات التحكم في آليات الضبط والمراقبة يستحيل أمام التطور المعلوماتي المتسارع. ولهذا تصبح الحاجة ماسة إلى توظيف ما يمتلكونه من اللغة السياسية والعواطف الجياشة لإشراكهم في إنتاج المعنى السياسي، الذي يجدد من شرعيتها في عصر الجيل الرقمي أو عصر المواطن الرقمي. ولن يتم هذا إلا بعد أن يتمرنوا من خلال الانتقال من الرقمي إلى الواقعي على امتلاك الخطاب السياسي والممارسة الدستورية.
الدولة المغربية، مثلها مثل دول عديدة في الجنوب، تُدرك أهمية الفضاء الرقمي، لكنها لا تزال تتعامل معه بوعي أمني–سياسي مزدوج: من جهة، تراقبه وتخترقه، ومن جهة أخرى، تُعيد إنتاج شرعيتها من خلاله. فحضور بعض الوجوه الشابة من جيل Z في القنوات الرسمية، يعكس استراتيجية احتواء ذكية: فبعد الصدام أو القمع الذي رسمت من خلاله السلطة الأمنية قواعد الاحتجاج، عملت على الانتقال بشباب من هذا الجيل إلى القنوات الإعلامية كعلامات شرعية على انفتاح الدولة السياسي. لكن هذا الانفتاح لا يغيّر بنية السلطة، بل يُعيد تسويغها سياسيا عبر خطاب الشباب والمستقبل، وقد تستكمل عملية التسويغ السياسي بالتسويغ القانوني في أعلى مستويات استكمال التشريع من خلال مجالس وهيئات. إنها بالضبط ما سماه ميشيل فوكو بـالسياسة الحيوية (biopolitique)، أي إدارة الحياة الاجتماعية والرمزية عبر آليات ناعمة للضبط والمشاركة المراقبة. وعليه، فإن السلطة لم تعد تمنع، بل تُتيح ضمن شروطها حرية التعبير والاحتجاج. وهذا ما سيجعل بعض الشباب يتحولون إلى نخب رمزية داخل منظومة لا تسمح لهم فعليا بصناعة القرار.
خاتمة: نحو صناعة نخب جديدة لمغرب الغد
إنّ مستقبل الدولة المغربية سيتوقف على قدرتها على إعادة بناء علاقتها التكوينية بالجيل الرقمي، لا من خلال التوجيه الفوقي، بل من خلال إعادة التفكير في الفعل السياسي ذاته كفعل تربوي، تأويلي، وتشاركي، والفعل انطلق منذ الآن....
أحمد الفرحان/ أستاذ التعليم العالي في الفلسفة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة ابن طفيل