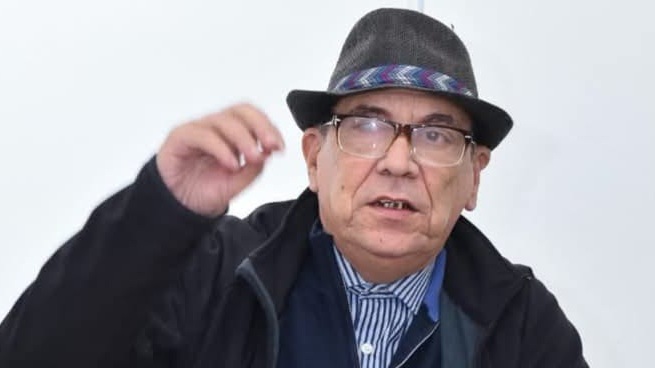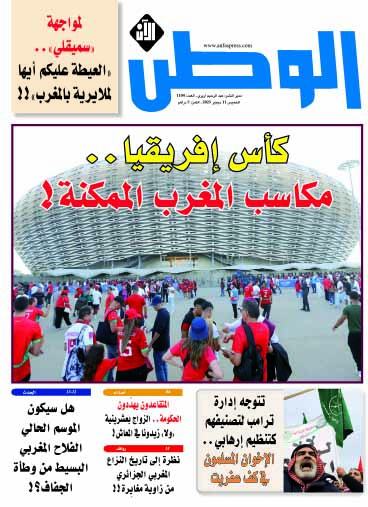مع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، ينشغل المغرب بتوازناته السياسية المقبلة وحسابات التحالفات الحزبية التي قد ترسم الخريطة المقبلة للسلطة. غير أن جبال الريف وسواحله البعيدة تفرض سؤالاً آخر أكثر إلحاحاً وعمقاً: ما جدوى ورقة الاقتراع حين تنسحب الثقة من المجال العام ويُختزل التصويت في طقس متكرر بلا أثر ملموس على حياة الناس؟ هنا يتجاوز السؤال مجرد المشاركة الانتخابية ليطال أساس العقد بين الدولة والمجتمع.
الريف لا ينسى: أحداث القمع الدامي في سنتي 1958 و1959، بُعيد الاستقلال، تركت ندبة غائرة عبر الأجيال، وما زالت تحدد ملامح العلاقة مع المركز. وفي ثمانينيات القرن الماضي، زادت المتابعات القضائية التي طالت بعض النخب الريفية من منسوب الإحباط العميق في المنطقة، إذ ترسخت قناعة بأن الانتماء إلى النخبة لا يحمي من الاستهداف بل قد يتحول إلى عبء إضافي. وفي 2016، فجّر موت بائع السمك محسن فكري حراكاً واسعاً عُرف بـ"حراك الريف"، رفع خلاله المتظاهرون شعارات الكرامة والتنمية ورفض التهميش، فقوبلوا بالاعتقالات والأحكام القاسية. كل ذلك عمّق الإحساس بأن المنطقة محكومة بالعيش على هامش التنمية وصنع القرار، وأن ذاكرة الجراح لم تتحول بعد إلى مشروع مصالحة حقيقية.
هذه التراكمات صنعت لدى الإنسان الريفي نفسية خاصة في تعامله مع الدولة. فكل حدث جديد أعاد إنتاج حذر جماعي وشعور عميق بالريبة تجاه كل ما يصدر عن "المخزن" أو "الدولة". وقد عبّر حراك الريف عن هذه الحقيقة حين رفض المحتجون الشعارات الرسمية وعدّوها مجرد وعود بلا مضمون. من هنا يمكن القول إن مشكلة الريف مع الدولة ليست فقط في السياسات العمومية، بل أيضاً في الخطاب ذاته، حيث غاب البعد التربوي-البيداغوجي المستند إلى فهم سوسيولوجي ونفسي للإنسان الريفي، وحضر بدلاً منه منطق سلطوي قائم على المعالجة بـ"الزرواطة". الدولة، إذا أرادت استرجاع ثقة المواطن الريفي، مطالبة بإنتاج مقاربة جديدة تتجاوز الأمني إلى الاجتماعي والثقافي، وتمنح معنى ملموساً لكلمة "الثقة".
الريف لا ينسى: أحداث القمع الدامي في سنتي 1958 و1959، بُعيد الاستقلال، تركت ندبة غائرة عبر الأجيال، وما زالت تحدد ملامح العلاقة مع المركز. وفي ثمانينيات القرن الماضي، زادت المتابعات القضائية التي طالت بعض النخب الريفية من منسوب الإحباط العميق في المنطقة، إذ ترسخت قناعة بأن الانتماء إلى النخبة لا يحمي من الاستهداف بل قد يتحول إلى عبء إضافي. وفي 2016، فجّر موت بائع السمك محسن فكري حراكاً واسعاً عُرف بـ"حراك الريف"، رفع خلاله المتظاهرون شعارات الكرامة والتنمية ورفض التهميش، فقوبلوا بالاعتقالات والأحكام القاسية. كل ذلك عمّق الإحساس بأن المنطقة محكومة بالعيش على هامش التنمية وصنع القرار، وأن ذاكرة الجراح لم تتحول بعد إلى مشروع مصالحة حقيقية.
هذه التراكمات صنعت لدى الإنسان الريفي نفسية خاصة في تعامله مع الدولة. فكل حدث جديد أعاد إنتاج حذر جماعي وشعور عميق بالريبة تجاه كل ما يصدر عن "المخزن" أو "الدولة". وقد عبّر حراك الريف عن هذه الحقيقة حين رفض المحتجون الشعارات الرسمية وعدّوها مجرد وعود بلا مضمون. من هنا يمكن القول إن مشكلة الريف مع الدولة ليست فقط في السياسات العمومية، بل أيضاً في الخطاب ذاته، حيث غاب البعد التربوي-البيداغوجي المستند إلى فهم سوسيولوجي ونفسي للإنسان الريفي، وحضر بدلاً منه منطق سلطوي قائم على المعالجة بـ"الزرواطة". الدولة، إذا أرادت استرجاع ثقة المواطن الريفي، مطالبة بإنتاج مقاربة جديدة تتجاوز الأمني إلى الاجتماعي والثقافي، وتمنح معنى ملموساً لكلمة "الثقة".
في هذا السياق التاريخي المثقل بالتجارب المريرة، يصبح التصويت أقل من فعل مدني حر، وأكثر من تردّد دائم بين الاستسلام للتهميش أو تحديه بوسائل رمزية. الناخب في الريف لا ينظر إلى صناديق الاقتراع باعتبارها مساراً يفضي إلى تغيير فعلي، بل كطقس سياسي متكرر لا يبدّد خيبات الماضي. ومن هنا يُفهم لماذا يختار كثيرون المقاطعة أو المشاركة المشروطة بالحصول على منفعة فورية، كأن العملية الانتخابية فقدت بعدها الجماعي لتتحول إلى تبادل محدود المنافع.
في الريف، الزبونية والمال الانتخابي ليست مجرد ممارسات عابرة أو انحرافات فردية، بل تكاد تشكّل "اقتصاداً أخلاقياً للتصويت". المرشّح يوزّع الخدمات أو يسدّد الفواتير أو يقدم مبالغ مالية صغيرة، والناخب يقبل لأنه فقد الإيمان بسلسلة طويلة من الوعود العمومية التي لم تتحقق. هذا المنطق الواقعي للبقاء لا يعكس رفضاً للديمقراطية كقيمة، بل يفضح غياب الثقة في جدواها العملية. وهنا تتحول العملية الانتخابية من أداة للمشاركة إلى مسرح لتبادل المنافع القصيرة الأمد.
الحديث عن "تخلّف ديمقراطي" يضلّل النقاش العام ويختزل المشكلة في الثقافة السياسية للمجتمع. القضية الجوهرية ليست ضعف الوعي السياسي بقدر ما هي غياب الثقة في جدوى المؤسسات. وحين تغيب الثقة، تفقد الديمقراطية روحها، وتتحوّل المقاطعة من عزوف سلبي إلى لغة سياسية قائمة بذاتها. فالمقاطعة في الريف ليست كسلاً جماعياً، بل رسالة احتجاج تقول: العرض السياسي المطروح لا يستحق العناء، والوعود الانتخابية لم تعد وسيلة فعّالة لإقناع الناس. وهذه الرسالة تتسرب تدريجياً من الريف إلى مدن كبرى مرهقة بالأزمات الاقتصادية وإلى أرياف أخرى مثقلة بالضغوط اليومية.
في المغرب، حيث يُنظر إلى المؤسسة الملكية باعتبارها الضامنة العليا للاستقرار، يزداد التناقض وضوحاً: المواطنون الذين يفقدون ثقتهم في المؤسسات المنتخبة يتطلعون أكثر إلى الإشارات والتوجيهات الملكية باعتبارها المرجعية الأخيرة. غير أن هذا الوضع، وإن كان يحافظ على التوازن العام، يعمّق الهوة بين الدولة والمجتمع إذا لم تُترجم تلك التوجيهات إلى سياسات ملموسة عبر القنوات الحزبية والمؤسساتية. هنا يظهر خطر أن يتحول الاستقرار إلى مجرد غطاء خارجي يخفي هشاشة العقد السياسي.
في الرباط والدار البيضاء، تُدار الحسابات على أساس التحالفات الممكنة، وحظوظ هذا الحزب أو ذاك، ودور وزارة الداخلية في ضبط قواعد اللعبة. غير أن هذه النقاشات التقنية تغفل التشخيص الأعمق: ديمقراطية بلا ناخبين تفقد معناها. فالمشاركة ليست مجرد رقم في تقارير رسمية، بل عقد رمزي يربط المواطن بالدولة. وهذا العقد تآكل في الريف بفعل تراكم وعود منقوضة وتجارب يومية مع إدارة يُنظر إليها على أنها بعيدة ومنفصلة عن المجتمع. النتيجة هي شعور متزايد بأن التصويت لا يغير شيئاً في جوهر العلاقة بين الفرد والسلطة.
هناك تيار نقدي يرى أن المغرب يعيش نهاية دورة سياسية متهالكة، وأنّ الخطر الحقيقي لا يكمن في هوية الحزب الفائز أو الخاسر، بل في اتساع رقعة المقاطعة وضعف الإيمان بالعملية الانتخابية برمتها. الشباب المنهكون من البطالة، والطبقات الوسطى المرهقة من التضخم، جميعهم معرضون للانسحاب من المشاركة السياسية. وتأتي شواهد عديدة لتغذية هذا الانطباع: إضرابات طويلة للأساتذة، صراع مفتوح بين طلاب كليات الطب والحكومة، احتجاجات حول مباراة المحاماة وما رافقها من اتهامات بالفساد، إضافة إلى فضائح سوق المحروقات وما أثارته من شبهات تواطؤ بين الشركات والسلطة التنظيمية.
وفي الآونة الأخيرة، أضيف عنصر آخر أكثر خطورة إلى هذه الصورة القاتمة: أزمة المستشفيات العمومية. فقد شهد مستشفى الحسن الثاني بأكادير احتجاجات واسعة بعد وفاة نساء في جناح الولادة، حيث تحدث المحتجون عن "شروط كارثية"، نقص في المعدات، وعجز فادح في الطواقم الطبية. هذه المأساة كشفت عمق التدهور في قطاع حيوي يُفترض أن يجسد صورة "الدولة الاجتماعية". وهنا يتأكد شعور عام بأنّ السلطة التنفيذية تدير الأزمات يوماً بيوم، وتؤجل القرارات المؤلمة، بدلاً من معالجتها جذرياً. في ظل هذا المناخ، يكثر الحديث عن احتمال مجيء شخصية تكنوقراطية هادئة إلى رئاسة الحكومة، لا لحل التوترات بل للعب دور الوسيط المهدّئ وتأجيل الانفجار.
النقد ذاته يطاول البنية الاقتصادية. فشعار "الدولة الاجتماعية" يبدو أشبه برقعة تُلصق على نموذج ليبرالي ريعي، تتركّز فيه الأرباح في أيدي قلة من الفاعلين. المنافسة ناقصة، التوزيع ضعيف، والإنتاجية غير كافية لخلق فرص عمل بالوتيرة المطلوبة. ومع استمرار الجفاف الذي يضرب الفلاحة، وتراكم الديون، وتضخم جاثم على الأسعار، تتآكل الثقة بشكل آلي. المواطن لا ينتظر خطابات، بل ينتظر انخفاضاً ملموساً في كلفة المعيشة، مدرسة عمومية تؤدي دورها، ومستشفى يقدم العلاج بكرامة. غياب هذه العناصر يفتح الطريق أمام خطاب يائس لا يثق في قدرة المؤسسات على التغيير.
في الريف، تتخذ هذه المتغيرات طابعاً أكثر قسوة وحدة. الفقر البنيوي يجعل شراء الأصوات ممارسة فعّالة، والجغرافيا المعزولة تزيد من تكاليف الحياة وتضاعف الحاجة إلى وساطات محلية، والإدارة التي يُنظر إليها كجسم بعيد تفضل التفرج بدل التدخل المباشر. النتيجة هي حلقة مفرغة: الانتخابات تتحول إلى سوق ولاءات مؤقتة، ثم تعود الحياة اليومية بأزماتها الثقيلة، ومعها يزداد فقدان الثقة. هذا التكرار المستمر يجعل صناديق الاقتراع تبدو مثل طقس بلا مضمون.
كسر هذه الحلقة يتطلب أكثر من خطاب أخلاقي أو دعوات فضفاضة للإصلاح. لا بد من دلائل ملموسة تترجم الوعود إلى واقع: استثمار عمومي حقيقي حيث تنقص البنية التحتية، خدمات متاحة وذات جودة، منافسة عادلة في القطاعات المحمية، حياد إداري صارم أثناء الحملات، وعقوبات جدية ضد شراء الأصوات. دون هذه العلامات العملية، ستظل المقاطعة هي القاعدة والزبونية هي اللغة السائدة في العملية الانتخابية. والإصرار على الشكل دون المضمون لن يؤدي إلا إلى توسيع الهوة بين المواطن والدولة.
انتخابات 2026 قد تُشكّل واجهة دولية، خصوصاً مع استضافة المغرب جزءاً من كأس العالم لكرة القدم، وهو حدث يسلط الأضواء العالمية على البلاد. لكن هذه الواجهة لا تكفي ما لم يُفتح ورش داخلي لإصلاح الثقة بين المواطن ومؤسساته. فالاستقرار لا يُفرض من أعلى، بل يُبنى عبر آليات للمحاسبة، وميزانيات شفافة، وأولويات قابلة للقياس والتقييم. والريف، بوضوحه القاسي، يذكّر بأنّ كل وعد بلا جدول زمني ولا تمويل ولا متابعة جادة، يتبخر سريعاً إلى مجرد خطابات.
في النهاية، تظلّ المؤسسة الملكية الفاعل المركزي في الحياة السياسية المغربية. فمهما تغيّرت الحكومات، تبقى المؤسسة الملكية المرجعية الثابتة التي تمنح الشرعية النهائية للمسار. غير أن التحدي الأكبر هو إعادة وصل الخيط بين هذه المرجعية العليا وصناديق الاقتراع، حتى لا تبقى الديمقراطية مجرد واجهة شكلية. فالديمقراطية المغربية لا يمكن أن تستعيد حيويتها إلا إذا تحوّلت التوجيهات العليا إلى سياسات ملموسة عبر المؤسسات المنتخبة، بما يعيد للمواطن ثقته ويمنح لصوته قيمة فعلية. وهكذا، فإنّ التحدي الأعمق أمام انتخابات 2026 لا يقتصر على نسب المشاركة أو أسماء الفائزين، بل يتمثل في قدرتها على فتح ورش حقيقي للمصالحة بين الدولة والريف. ولا تقتصر المسؤولية على الدولة وحدها، بل تمتد أيضاً إلى النخب الثقافية والفكرية في الريف. فهذه النخب مطالبة بالانخراط الجاد في الدينامية المجتمعية والسياسية للمنطقة، والعمل على رفع منسوب الوعي الحقوقي المندمج، بما يعزز ثقافة المشاركة والمسؤولية. كما يقع على عاتقها ممارسة الرقابة المواطِنة على أداء الفاعلين السياسيين ومواكبة مساراتهم بقراءة نقدية بنّاءة. إن استعادة الثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات لا يمكن أن يتحقق من دون هذا الدور الموازي للنخب، الذي يشكّل ضمانة حقيقية لإمكانية التغيير وتحقيق العدالة المجالية. فالريف لا يطلب المستحيل، بل يطلب اعترافاً بذاكرته ووفاءً بوعود قابلة للقياس، ومن دون هذه المصالحة ستظل الديمقراطية معلقة، وستبقى الهوة بين المركز والهامش تتسع جيلاً بعد جيل.
في الريف، الزبونية والمال الانتخابي ليست مجرد ممارسات عابرة أو انحرافات فردية، بل تكاد تشكّل "اقتصاداً أخلاقياً للتصويت". المرشّح يوزّع الخدمات أو يسدّد الفواتير أو يقدم مبالغ مالية صغيرة، والناخب يقبل لأنه فقد الإيمان بسلسلة طويلة من الوعود العمومية التي لم تتحقق. هذا المنطق الواقعي للبقاء لا يعكس رفضاً للديمقراطية كقيمة، بل يفضح غياب الثقة في جدواها العملية. وهنا تتحول العملية الانتخابية من أداة للمشاركة إلى مسرح لتبادل المنافع القصيرة الأمد.
الحديث عن "تخلّف ديمقراطي" يضلّل النقاش العام ويختزل المشكلة في الثقافة السياسية للمجتمع. القضية الجوهرية ليست ضعف الوعي السياسي بقدر ما هي غياب الثقة في جدوى المؤسسات. وحين تغيب الثقة، تفقد الديمقراطية روحها، وتتحوّل المقاطعة من عزوف سلبي إلى لغة سياسية قائمة بذاتها. فالمقاطعة في الريف ليست كسلاً جماعياً، بل رسالة احتجاج تقول: العرض السياسي المطروح لا يستحق العناء، والوعود الانتخابية لم تعد وسيلة فعّالة لإقناع الناس. وهذه الرسالة تتسرب تدريجياً من الريف إلى مدن كبرى مرهقة بالأزمات الاقتصادية وإلى أرياف أخرى مثقلة بالضغوط اليومية.
في المغرب، حيث يُنظر إلى المؤسسة الملكية باعتبارها الضامنة العليا للاستقرار، يزداد التناقض وضوحاً: المواطنون الذين يفقدون ثقتهم في المؤسسات المنتخبة يتطلعون أكثر إلى الإشارات والتوجيهات الملكية باعتبارها المرجعية الأخيرة. غير أن هذا الوضع، وإن كان يحافظ على التوازن العام، يعمّق الهوة بين الدولة والمجتمع إذا لم تُترجم تلك التوجيهات إلى سياسات ملموسة عبر القنوات الحزبية والمؤسساتية. هنا يظهر خطر أن يتحول الاستقرار إلى مجرد غطاء خارجي يخفي هشاشة العقد السياسي.
في الرباط والدار البيضاء، تُدار الحسابات على أساس التحالفات الممكنة، وحظوظ هذا الحزب أو ذاك، ودور وزارة الداخلية في ضبط قواعد اللعبة. غير أن هذه النقاشات التقنية تغفل التشخيص الأعمق: ديمقراطية بلا ناخبين تفقد معناها. فالمشاركة ليست مجرد رقم في تقارير رسمية، بل عقد رمزي يربط المواطن بالدولة. وهذا العقد تآكل في الريف بفعل تراكم وعود منقوضة وتجارب يومية مع إدارة يُنظر إليها على أنها بعيدة ومنفصلة عن المجتمع. النتيجة هي شعور متزايد بأن التصويت لا يغير شيئاً في جوهر العلاقة بين الفرد والسلطة.
هناك تيار نقدي يرى أن المغرب يعيش نهاية دورة سياسية متهالكة، وأنّ الخطر الحقيقي لا يكمن في هوية الحزب الفائز أو الخاسر، بل في اتساع رقعة المقاطعة وضعف الإيمان بالعملية الانتخابية برمتها. الشباب المنهكون من البطالة، والطبقات الوسطى المرهقة من التضخم، جميعهم معرضون للانسحاب من المشاركة السياسية. وتأتي شواهد عديدة لتغذية هذا الانطباع: إضرابات طويلة للأساتذة، صراع مفتوح بين طلاب كليات الطب والحكومة، احتجاجات حول مباراة المحاماة وما رافقها من اتهامات بالفساد، إضافة إلى فضائح سوق المحروقات وما أثارته من شبهات تواطؤ بين الشركات والسلطة التنظيمية.
وفي الآونة الأخيرة، أضيف عنصر آخر أكثر خطورة إلى هذه الصورة القاتمة: أزمة المستشفيات العمومية. فقد شهد مستشفى الحسن الثاني بأكادير احتجاجات واسعة بعد وفاة نساء في جناح الولادة، حيث تحدث المحتجون عن "شروط كارثية"، نقص في المعدات، وعجز فادح في الطواقم الطبية. هذه المأساة كشفت عمق التدهور في قطاع حيوي يُفترض أن يجسد صورة "الدولة الاجتماعية". وهنا يتأكد شعور عام بأنّ السلطة التنفيذية تدير الأزمات يوماً بيوم، وتؤجل القرارات المؤلمة، بدلاً من معالجتها جذرياً. في ظل هذا المناخ، يكثر الحديث عن احتمال مجيء شخصية تكنوقراطية هادئة إلى رئاسة الحكومة، لا لحل التوترات بل للعب دور الوسيط المهدّئ وتأجيل الانفجار.
النقد ذاته يطاول البنية الاقتصادية. فشعار "الدولة الاجتماعية" يبدو أشبه برقعة تُلصق على نموذج ليبرالي ريعي، تتركّز فيه الأرباح في أيدي قلة من الفاعلين. المنافسة ناقصة، التوزيع ضعيف، والإنتاجية غير كافية لخلق فرص عمل بالوتيرة المطلوبة. ومع استمرار الجفاف الذي يضرب الفلاحة، وتراكم الديون، وتضخم جاثم على الأسعار، تتآكل الثقة بشكل آلي. المواطن لا ينتظر خطابات، بل ينتظر انخفاضاً ملموساً في كلفة المعيشة، مدرسة عمومية تؤدي دورها، ومستشفى يقدم العلاج بكرامة. غياب هذه العناصر يفتح الطريق أمام خطاب يائس لا يثق في قدرة المؤسسات على التغيير.
في الريف، تتخذ هذه المتغيرات طابعاً أكثر قسوة وحدة. الفقر البنيوي يجعل شراء الأصوات ممارسة فعّالة، والجغرافيا المعزولة تزيد من تكاليف الحياة وتضاعف الحاجة إلى وساطات محلية، والإدارة التي يُنظر إليها كجسم بعيد تفضل التفرج بدل التدخل المباشر. النتيجة هي حلقة مفرغة: الانتخابات تتحول إلى سوق ولاءات مؤقتة، ثم تعود الحياة اليومية بأزماتها الثقيلة، ومعها يزداد فقدان الثقة. هذا التكرار المستمر يجعل صناديق الاقتراع تبدو مثل طقس بلا مضمون.
كسر هذه الحلقة يتطلب أكثر من خطاب أخلاقي أو دعوات فضفاضة للإصلاح. لا بد من دلائل ملموسة تترجم الوعود إلى واقع: استثمار عمومي حقيقي حيث تنقص البنية التحتية، خدمات متاحة وذات جودة، منافسة عادلة في القطاعات المحمية، حياد إداري صارم أثناء الحملات، وعقوبات جدية ضد شراء الأصوات. دون هذه العلامات العملية، ستظل المقاطعة هي القاعدة والزبونية هي اللغة السائدة في العملية الانتخابية. والإصرار على الشكل دون المضمون لن يؤدي إلا إلى توسيع الهوة بين المواطن والدولة.
انتخابات 2026 قد تُشكّل واجهة دولية، خصوصاً مع استضافة المغرب جزءاً من كأس العالم لكرة القدم، وهو حدث يسلط الأضواء العالمية على البلاد. لكن هذه الواجهة لا تكفي ما لم يُفتح ورش داخلي لإصلاح الثقة بين المواطن ومؤسساته. فالاستقرار لا يُفرض من أعلى، بل يُبنى عبر آليات للمحاسبة، وميزانيات شفافة، وأولويات قابلة للقياس والتقييم. والريف، بوضوحه القاسي، يذكّر بأنّ كل وعد بلا جدول زمني ولا تمويل ولا متابعة جادة، يتبخر سريعاً إلى مجرد خطابات.
في النهاية، تظلّ المؤسسة الملكية الفاعل المركزي في الحياة السياسية المغربية. فمهما تغيّرت الحكومات، تبقى المؤسسة الملكية المرجعية الثابتة التي تمنح الشرعية النهائية للمسار. غير أن التحدي الأكبر هو إعادة وصل الخيط بين هذه المرجعية العليا وصناديق الاقتراع، حتى لا تبقى الديمقراطية مجرد واجهة شكلية. فالديمقراطية المغربية لا يمكن أن تستعيد حيويتها إلا إذا تحوّلت التوجيهات العليا إلى سياسات ملموسة عبر المؤسسات المنتخبة، بما يعيد للمواطن ثقته ويمنح لصوته قيمة فعلية. وهكذا، فإنّ التحدي الأعمق أمام انتخابات 2026 لا يقتصر على نسب المشاركة أو أسماء الفائزين، بل يتمثل في قدرتها على فتح ورش حقيقي للمصالحة بين الدولة والريف. ولا تقتصر المسؤولية على الدولة وحدها، بل تمتد أيضاً إلى النخب الثقافية والفكرية في الريف. فهذه النخب مطالبة بالانخراط الجاد في الدينامية المجتمعية والسياسية للمنطقة، والعمل على رفع منسوب الوعي الحقوقي المندمج، بما يعزز ثقافة المشاركة والمسؤولية. كما يقع على عاتقها ممارسة الرقابة المواطِنة على أداء الفاعلين السياسيين ومواكبة مساراتهم بقراءة نقدية بنّاءة. إن استعادة الثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات لا يمكن أن يتحقق من دون هذا الدور الموازي للنخب، الذي يشكّل ضمانة حقيقية لإمكانية التغيير وتحقيق العدالة المجالية. فالريف لا يطلب المستحيل، بل يطلب اعترافاً بذاكرته ووفاءً بوعود قابلة للقياس، ومن دون هذه المصالحة ستظل الديمقراطية معلقة، وستبقى الهوة بين المركز والهامش تتسع جيلاً بعد جيل.
د فكري سوسان، استاذ باحث