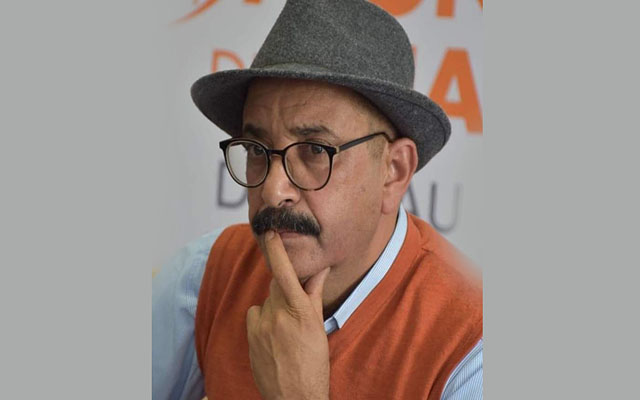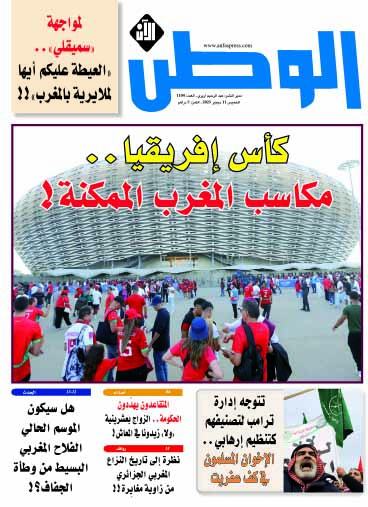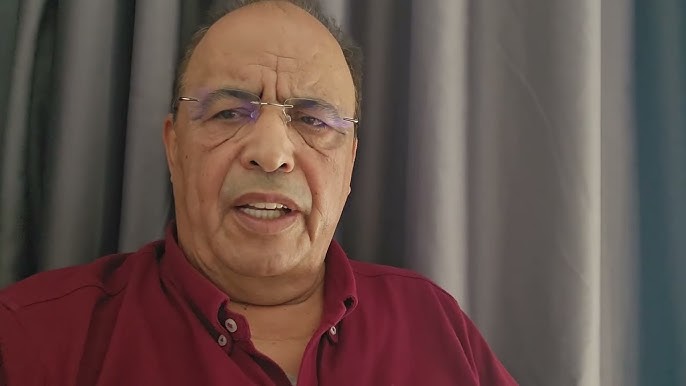تطوى ملفات الطلاق داخل المحاكم، لكن فصولها الأكثر قسوة تبدأ حيث يقف الأبناء كضحايا أبرياء في ساحة خلفية لتصفية حسابات لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
في واقعنا المغربي، يتجاوز غياب الأب بعد الانفصال مجرد فراغ عاطفي ليصبح أزمة مركبة، تستغل فيها براءة الصغار كورقة ضغط وانتقام، في ظل غياب شبه تام لثقافة تدبير الخلاف وآليات الحماية التي تضع مصلحة الناشئة فوق كل اعتبار. هذا الشرخ الأسري لا يزرع الارتباك في هوية الأبناء النفسية والاجتماعية فحسب، بل يشعل فتيل صراعاتهم المستقبلية.
إن أخطر ما يواجه فلذات الأكباد في هذه المرحلة هو تحويلهم إلى أداة في صراع الكبار. فكثيرا ما يتم شحن الابن أو البنت ضد والدهم، وتحاك قصص سلبية تشوه صورته في ذهن لا يملك القدرة على التمييز، مما يضعه في صراع ولاء معيب. هذا السلوك، الذي يصفه الأخصائيون النفسيون بـالأذى النفسي المتعمد، لا يقطع صلة الأبناء بوالدهم فحسب، بل يدمر إحساسهم بالأمان والثقة. وفي المقابل، يختار بعض الآباء ممارسة أقسى أنواع الهجر، متخلين كليا عن مسؤولياتهم المادية والتربوية، ليتركوا خلفهم جرحا مزدوجا من الغياب والحرمان.
وحتى عندما يلتزم الأب بواجب النفقة، فإن غياب آليات الرقابة يجعل مصير تلك الأموال مجهولا في كثير من الحالات. فبدلا من أن تصرف لتغطية حاجيات الصغار الأساسية، قد تحول لتلبية نفقات أخرى، ليظلوا في حرمان رغم وصول المستحقات. هذا الوضع يحول حقا قانونيا إلى مصدر جديد للنزاع، ويكرس لدى الأبناء شعورا عميقا بالظلم والإهمال.
ويؤكد خبراء الاجتماع أن أزمة الهوية لا تنبع فقط من الغياب الجسدي للأب، بل من تحطيم صورته المعنوية وإهدار قيمة دوره، وهو ما يحدث تماما حين تبدد مساهمته المادية وتشوه صورته.
يشدد المتخصصون في التربية على أن دور الأب يقدم مدخلات تنموية فريدة لا يمكن تعويضها بالكامل. فالأب كمرجع ذكوري يساهم في بناء شخصية أكثر استقلالية وقدرة على مواجهة التحديات. وعندما يغيب هذا النموذج، يكافح الأبناء الذكور لتكوين هوية واضحة، وقد يبحثون عن بدائل مشوهة في الشارع أو بين رفاق السوء، مما يفسر بشكل كبير العلاقة التي ترصدها التقارير بين التفكك الأسري وانحراف الشباب. إنها مشكلة اجتماعية حقيقية، وليست مجرد مجموعة من القصص العائلية الحزينة.
في حالات أخرى، لا يكون الأب غائبا تماما، لكنه يتحول إلى أب للمناسبات، يحصر علاقته بأبنائه في عطلات نهاية الأسبوع المليئة بالترفيه والهدايا، ويتجنب أي انخراط في تفاصيل حياتهم اليومية التي تتطلب توجيها وانضباطا. هذه العلاقة السطحية، رغم مظهرها الجذاب، تفقد بريقها بسرعة وتترك لدى الأبناء إحساسا بأنهم مجرد زوار في حياة والدهم، مما يعمق شعورهم بالرفض ويهز ثقتهم بأنفسهم وبقدرتهم على بناء علاقات متينة في المستقبل.
إن تداعيات هذا الواقع لا تتوقف عند ضحايا اليوم، بل تهدد بخلق حلقة مفرغة من انعدام الاستقرار الأسري. فالأجيال التي تنشأ في ظل هذا الغياب وهذه الصراعات، تكون أكثر عرضة لتكرار نفس المأساة في حياتها. إن مواجهة هذه الأزمة تتطلب ما هو أكثر من النصوص القانونية، إنما تستدعي ثورة ثقافية في كيفية تعاملنا مع الطلاق، وتفعيل آليات الوساطة الأسرية، وإنشاء أجهزة رقابة صارمة تضمن أن المصلحة الفضلى للأبناء ليست مجرد شعار، بل هي المبدأ الأوحد الذي يحكم قرارات وسلوكيات الكبار بعد الانفصال.