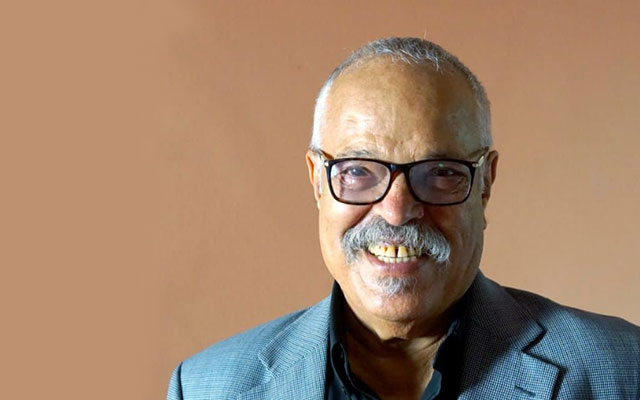في الثقافة المغربية، لا يكاد شيء يختفي تماماً. كل ممارسة، كل عادة، كل أداة لو تسلّلت إلى الظل تترك خلفها ما يكفي من الروائح والصور والذكريات لتظلّ حاضرة في الوجدان الجمعي. ومع ذلك، هناك موروث ظلّ على هامش النقاش الثقافي، رغم رسوخه في التاريخ وارتباطه بطبقات اجتماعية متعددة، ورغم حضوره في الحكايات الشعبية وفي الذاكرة اليومية للمغاربة. أتحدث هنا عن السبسي، الغليون الخشبي الطويل الذي ارتبط عبر قرون بتدخين الكيف. ورغم أنّ المغاربة خاضوا معارك ثقافية وإعلامية للدفاع عن موروثات كثيرة—من الكسكس إلى القفطان، ومن الزليج إلى الطاجين—فإنّ هذا العنصر التراثي ظلّ منسيّاً، يُتداول همساً ويُحكى عنه بجرعة من الحرج.
"السبسي"، ليس مجرد أداة تدخين. هو “كائن ثقافي” تشكّل حوله جزء من الاجتماع المغربي: جلسات السمر، حلقات الحكي، مواسم الفلاحة، وحتى مجالس العلم التي كانت تختلط فيها الثقافة الشعبية بثقافة النخبة.
في كثير من الروايات التاريخية، نجد إشارات إلى أن الكيف لم يكن حكراً على الطبقات الشعبية ولا على المناطق الجبلية، بل استعمله فقهاء وتجار، بل وبعض سلاطين ما قبل الحقبة الاستعمارية ، كجزء من طقوس الضيافة أو الاسترخاء أو المصاحبة للجلسات الشعرية.
كان "السبسي" قطعة فنية، تُنحت وتُزخرف بالخشب والعظام والمعادن، وتُهدى في المناسبات الخاصة. كان بالإمكان أن تتحول إلى رمز مادي لتراثٍ منسي، لو لم يُخَيَّم عليه ستارُ التحفّظ الأخلاقي والقانوني.
لكن لماذا لا يحتفى المغاربة بالسبسي، كما يحتفون بغيره من رموزهم؟ لماذا لا يُستحضر في النقاش الثقافي، ولا يُعامل كجزء من تاريخنا الاجتماعي؟ السبب الأول هو السهولة المغرية لوضعه في خانة “المحظور”. ومع تراكم التشريعات المقيدة للكيف في القرن الماضي، أصبح من الصعب الفصل بين العنصر الثقافي والعنصر القانوني. تحوّل "السبسي"، من أداة تراثية إلى شبهة. ومع هذا التحول، اختفت قصته من السردية الرسمية، وكأنّ تراثاً كاملاً انقطع فجأة عن جذوره.
السبب الثاني هو النظرة الأخلاقية التي ترفض الربط بين الثقافة وأي ممارسة يعتبرها المجتمع سلبية. وهذه النظرة، رغم وجاهتها في سياق حماية الصحة العامة، كثيراً ما تدفع إلى دفن جزء مهم من التاريخ. فالتراث ليس دائماً مثالياً أو مريحاً؛ أحياناً يكون مزعجاً، متناقضاً، أو مرتبطاً بعادات لم تعد مقبولة اليوم. ومع ذلك، تظل قيمته كامنة في كونه مرآة لحياة الذين سبقونا، بما لهم وما عليهم.
ثم هناك سبب ثالث، لا يقل قوة: غياب التوثيق الأكاديمي. فباستثناء بعض الدراسات الأنثروبولوجية المتفرقة التي ترصد اقتصاديات الكيف أو ظواهره الاجتماعية، لا نجد اهتماماً حقيقياً بمسار “السبسي” كأداة، ولا بالدلالات الاجتماعية المرتبطة به. وهكذا ظلّ جزء كامل من التاريخ الثقافي مُهملاً، لم تدافع عنه النخب الثقافية كما فعلت مع عناصر أخرى، ولم تتبنّه المؤسسات الرسمية لأنه يمثل منطقة رمادية.
ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً: ألا يستحق "السبسي" مكاناً في الذاكرة الثقافية، بعيداً عن أي ترويج للاستهلاك أو تطبيع مع الممنوع؟ ألا يستحق أن يُقرأ باعتباره شاهداً على ممارسات اجتماعية امتدت قروناً، وباعتباره أداة لعبت دوراً في الفن الشعبي والطقوس الصوفية وحياة الأسواق والقرى؟ إنّ التعامل معه كتراث لا يعني مباركة استخدامه، بل مجرد الاعتراف بحقه في الوجود في سجلّ الذاكرة، مثلما تفعل شعوب كثيرة عندما توثّق تراثها المرتبط بالتبغ والنبيذ وحتى أدوات استهلاك الأفيون—لا تشجيعاً، بل فهماً للتاريخ وسياقاته.
ربما حان الوقت لأن نتصالح مع ذاكرتنا كما هي، لا كما نفضّل أن تكون. فالتراث ليس قطعة ديكور تُلمّع لتناسب هوى العصر، بل سجلّ حياةٍ عاشها الناس في لحظاتهم اليومية، في ضعفهم وقوتهم، في بحثهم عن المتعة كما في بحثهم عن الصفاء.
إنّ استعادة "السبسي" كجزء من الذاكرة الثقافية ليس انحيازاً لمادة ممنوعة، بل انحياز للحقيقة التاريخية التي حاولنا طمسها. فالهويات لا تُكتب بالممحاة، بل بالاعتراف بعمق التجربة الإنسانية بكل ما تحمله من تناقض ونور وظلال.
وهكذا، يبقى "السبسي"،بصرف النظر عن المواقف الأخلاقية، جزءاً من حكاية المغرب. يكفي أن نستمع إلى الذاكرة الشعبية لنعرف أنه كان حاضراً، وأن صوته لم يخفت إلا لأننا خفّضنا صوته.
وربما يكون الاعتراف به اليوم بداية لقراءة أكثر نضجاً لتراثنا، قراءة لا تخشى التقاط تلك التفاصيل الصغيرة التي صنعت حياة الناس حقاً، والتي تكشف أن التاريخ ليس دائماً شاهداً على الفخر فقط، بل أيضاً على الإنسان كما هو.السبسي في الثقافة المغربية: تراث منسي بين الذاكرة والمحظور