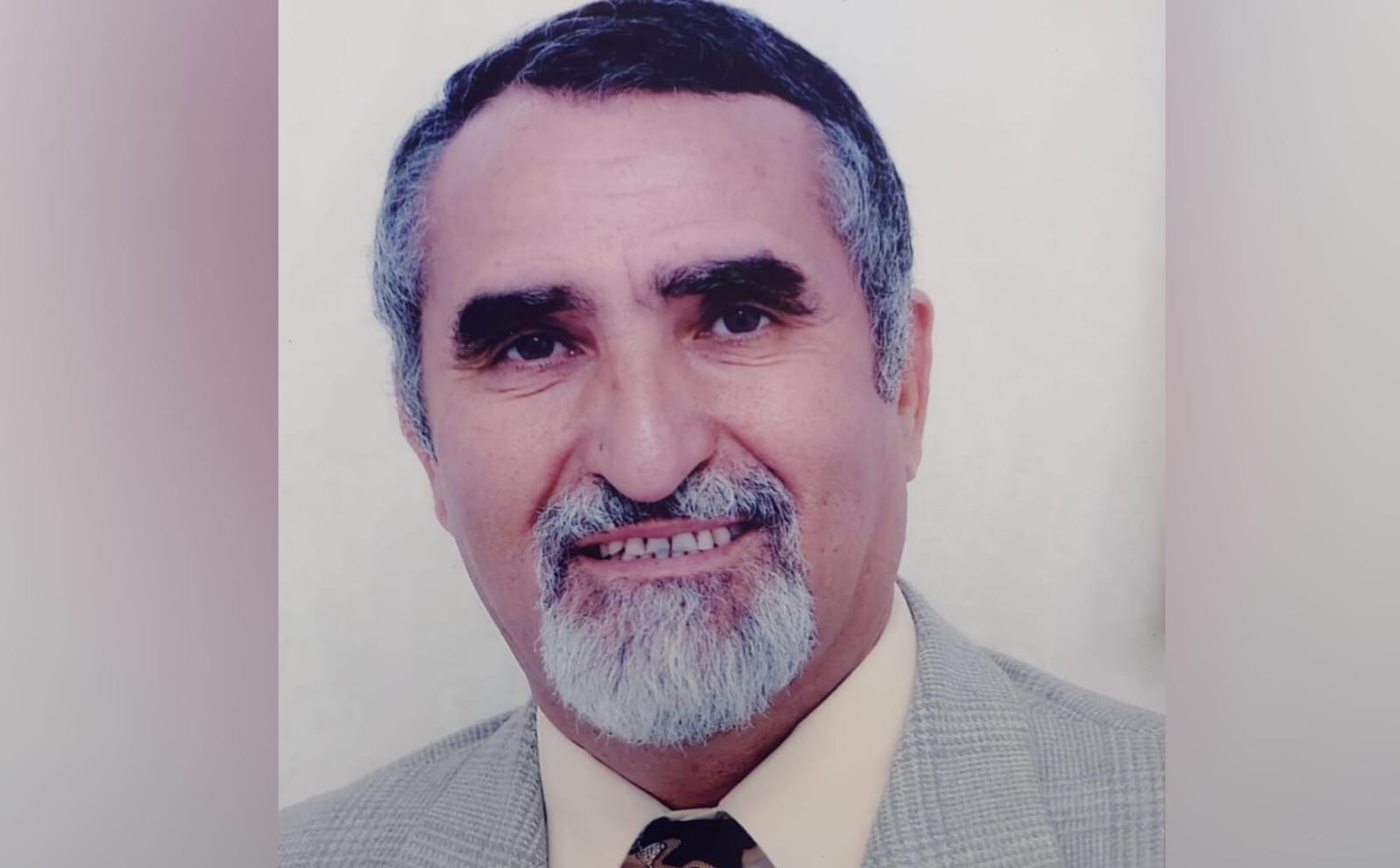حينما قررت الخوض في هذا الموضوع الشائك، لم يخطر ببالي أن أجازف في سبر أغوار مجال له علاقة بالقانون الدستوري، لأنني لست مختصا في هذا المجال، وليست لي دراية أكاديمية بعلومه النظرية.
كما أني لست كاتبا محترفا يسعى إلى ملء الفراغ بكتابات إنشائية جوفاء. فأنا بكل بساطة كاتب هاو أكتب في مواضيع عايشتها عن قرب، وأعرف كواليسها وخباياها بحكم تجربتي الطويلة في مجال السياسة بصفة عامة، وفي تدبير الشأن المحلي بصفة خاصة، كقيدوم المنتخبين بإقليم من أقاليم المملكة لمدة دامت زهاء نصف قرن بدون انقطاع (1976-2021) توليت خلالها رئاسة الجماعة لثلاث ولايات، وشغلت عضوية المجلس الإقليمي لثلاث ولايات أخرى. كما كنت عضو المكتب السياسي في حزب كان له وزنه في إبانه (2005-2009).
هذه المسيرة هي ما شجّعني على الإدلاء بدلوي في هذا الشأن، آملاً أن يجد هذا المقال صدى لدى من يهمهم الأمر.
لا يخفى على أحد أن "التزكيات" هي جمع "تزكية"، ولا داعي للخوض في متاهات التفسيرات اللغوية لهذه الكلمة، فذلك من اختصاص أهل اللغة ويمكن الاطلاع عليه بالمعاجم. يكفينا أن نوضّح المقصود بها في سياقنا هذا، عملا بمبدأ "ما قل ودل".
أما ما يهمنا فهو الكلمة الواردة بعنوان الموضوع الذي نحن بصدده.
إن التزكيات باللغة المبسطة وبالمفهوم المتداول عند عامة الناس هي تلك التي تمنحها الأحزاب السياسية للمرشحين الراغبين في خوض الانتخابات الخاصة بالجماعات الترابية والغرف المهنية وبالاستحقاقات البرلمانية.
ومصطلح التزكية، في جوهره، يعني شهادة معنوية يفترض فيها المصداقية، تشير إلى أن المستفيد منها يتحلى بخصال حميدة من قَبِيل المروءة والنزاهة والكفاءة العلمية، مما يجعله مؤهلا لتحمل مسؤولية تمثيل المواطنين والمواطنات لتسيير وتدبير شؤونهم عن جدارة واستحقاق.
إنها، في الواقع، بمثابة تعهّد من الجهة المانحة – أي الجهاز الحزبي المختص – أمام الله والوطن، بأن الشخص الممنوح له التزكية معروف لديها معرفة دقيقة، وأنه مناسب وصالح لهذا الغرض، وبالتالي قد يصبح مانح التزكية مسؤولا عن نتائج شهادته وعواقبها، وإلا صار مانحها شاهد زورٍ سياسي، وشريكًا محتملًا في ما قد يُعدّ "معصية" إذا أخفق المترشح في أداء المهمة المنوطة به، إذ كما يُقال: "ما بُني على باطل فهو باطل".
ولقد صدق من قال بأن : "الحاجة أم الاختراع"..
ففي بداية التجربة الديمقراطية بالمغرب، كانت العملية الانتخابية تعتمد في الترشيحات على الألوان فحسب، حيث كانت تتيح لمترشحَين اثنين أو أكثر التنافس ضمن نفس الحزب بألوان مختلفة. لكن، من الناحية العملية، سرعان ما تبين أن هذا الأسلوب لم يعد صالحا للنهج الديمقراطي السليم، ولم يعد يخدم حتى الأحزاب السياسية نفسها، خاصة مع استفحال ظاهرة "الترحال السياسي" التي كادت أن تعصف ببعض الأحزاب، بل وأن تهدد بزوالها..
فكان ذلك، في نظري، بداية انزلاق خطير، ساهم في تلويث المشهد السياسي، مما استدعى تدخل المشرّع من خلال القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (11 نونبر 2011) كما تم تعديله وتتميمه، وخاصة منه الفصل الأول من الفرع الثاني المتعلق بإيداع التصريحات بالترشيح بالمادة 7 التي تنص على ما يلي:
" ... يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشح المقدمة من طرف المترشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب السياسية الذي تقدم باسمه اللائحة أو المترشح ..".
فهل نجح هذا القانون فعلا في الحد من ظاهرة الترحال السياسي وآثاره على العمل الحزبي؟
ألم تصبح التزكيات الانتخابية بابًا من أبواب الفساد، تُفتح لكل من "هبّ ودبّ" لولوج مواقع القرار، دون تحرّ ميداني وتمحيص كافٍ في كفاءته وسمعته؟
ألا يُفترض أن يتم التأكد مسبقا من ملاءمة المرشح للمسؤولية على أساس "الشخص المناسب في المكان المناسب"، وليس فقط بناءً على شهادة السوابق العدلية؟
ألا يجدر بنا اليوم أن نعيد النظر في بعض النصوص القانونية الفضفاضة المرتبطة بهذا المجال، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
أليس من المثير للسخرية أن نسمع بعض المسؤولين والمهتمين بالشأن الحزبي يرددون – بعد كل هذه العقود من الممارسة– أن ديمقراطيتنا لا تزال "فتية" وفي طور التجربة، وكأنها كائن معاق لا يقوى على النمو، كذريعة منهم للتملص من مسؤولياتهم، ناسين أو متناسين بأنهم يمارسونها (أو تمارس عليهم) منذ ما يناهز نصف القرن على الأقل منذ 1976؟
ألا يُعدّ هذا هدرًا للزمن السياسي؟
أما آن الأوان للمرور من مرحلة التجريب إلى مرحلة الممارسة الديمقراطية الفعلية السليمة، كي تصبح أداة لمحاربة الفساد المستشري الذي يعرقل المسيرة الديمقراطية وينخر جسد المجتمع في أكثر من مجال؟
فإذا حاولنا الإجابة عن كل هذه الأسئلة أو عن بعضها على الأقل، فلا بدّ من إجراء تشخيص دقيق لمعاينة الأوضاع التي آلت إليها الممارسة السياسية ببلادنا، وخاصة ما يتعلق بالديمقراطية التمثيلية، وذلك بالارتكاز على العناصر الأساسية التالية:
دور القيم والتربية الأخلاقية في الممارسة السياسية
عندما تغيب القيم ويسود الانحلال الأخلاقي في أمة ما، وتزيغ عن طريق الصلاح والإصلاح لتنغمس في الفساد والإفساد، فإن ذلك من علامات الانحطاط، فيصبح المجتمع حينها عرضة مجتمعها للعبث والتفكك وفقدان الصواب والبوصلة - لا قدر الله، مصداقا لقوله تعالى:
"ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون"..
واعتبارا لقول أمير الشعراء أحمد شوقي:
"إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا"..
واستنادا إلى الخطب السامية لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وخاصة منها، على سبيل المثال لا الحصر، خطاب العرش في 30 يوليوز 2004 الداعي إلى تأهيل العمل الحزبي، حيث قال جلالته في إحدى فقرات الخطاب ما يلي:
"...فمنظورنا للإصلاح المؤسسي يستهدف عقلنة وتجديد المؤسسات، على درب توطيد دعائم دولة عصرية، وترسيخ ثقافة المواطنة التي تتلازم فيها حقوق الإنسان بواجباته وبأجهزة حمايتهما من التجاوزات المنافية للقانون. بيد أن المواطنة الفاعلة لا تستقيم إلا بالتنشئة الصالحة، المرتكزة على الأركان الثلاثة المتكاملة: العقيدة السمحة، والثقافة المنفتحة، والتربية السليمة"...
فبالرجوع إلى دور القيم في تخليق الحياة العامة، لا بد من الإشارة إلى أن أمتنا المغربية أمة ضاربة بجذورها في التاريخ، على الأقل منذ اثني عشر قرنا، قاومت خلالها، بحزم وثبات، كل التحديات التي وقفت في طريقها نحو التطور والنمو والازدهار، بفعل الأطماع الاستعمارية المتتالية، والتحولات الظرفية التي عانت منها جل شعوب العالم.
ورغم كل هذه التحديات القاهرة، لم يستسلم الشعب المغربي يوما أمامها، بفضل تشبثه بالقيم والثوابت، وبالتعايش الحضاري لأفراده فيما بينهم وما بين غيرهم، بالتسامح والتعاون والانفتاح، رغم بعض الصراعات الظرفية التي كانت تقض مضجعهم بين الفينة والأخرى؛ كما كان معظم الناس يتعففون "ولو كانت بهم خصاصة" ويتورعون عن كثير من ضروب الجشع الدنيء، والإثراء غير المشروع وغير المستحق بغير كدّ أو جهد.
فلولا التزام المغاربة بهذه القيم وبهذه الثوابت، لما استطاعوا أن يصمدوا، خلال قرون من الزمن، أمام العواصف التي ضربت المغرب عدة مرات.
فماذا وقع للمجتمع المغربي المعاصر؟
وما الذي يمنعه من أن يكون خير خلف لخير سلف؟
وهل يلعب القانون دورا في تثبيت أسس البناء الديمقراطي وتجويد الأداء الحزبي؟
وضعية القوانين المؤطرة للفعل السياسي
لا شك أن القوانين المؤطرة لسلوك المواطنات والمواطنين تشوبها مجموعة من النواقص والاختلالات، لا تتيح لهؤلاء التصرف بشكل إيجابي من جهة، ثم إن هنالك أسبابا أخرى قاهرة تتعلق بصعوبة التكيف مع ظروف العيش في زماننا الراهن من جهة أخرى.
وهذه الظروف الصعبة بالذات، هي التي تدفع بأغلبهم إلى مواجهتها بكل الوسائل المتاحة، ولو كانت غير مشروعة في بعض الأحيان.
فأما النقص الذي تعرفه الترسانة القانونية ببلادنا، بل أحيانا انعدامها تماما، كالقانون الخاص بالإثراء غير المشروع مثلا، جوابا على سؤال "من أين لك هذا؟"، فقد ظلت الحكومة تتلكأ عن إخراجه إلى حيز التنفيذ لأسباب تكاد تكون مجهولة لدى الذين لا يفقهون في الشأن السياسي.
فقد تكون الحكومة متريثة لأخذ الوقت الكافي من أجل دراسة القانون في عمقه ومن كل جوانبه، حتى لا تكون متسرعة وتقع في حرج بعد صدوره، فيستحيل التراجع عنه. أو ربما لأنها تتخوف من العواقب التي قد تنتج عن هذا القانون في حالة تطبيقه على أرض الواقع، نظرا لصعوبة ضبط التجاوزات الممكن حدوثها عند متابعة محتملة لمتهمين مفترضين لهم علاقة بهذا الموضوع.
وهذا هاجس مشروع، لكنه غير كافٍ للإقناع، طبقا للمقولة "العذر أكبر من الزلة"، إذا علمنا أن مؤسساتنا القضائية والأمنية والإدارية تزخر بأطر كفؤة ونزيهة، تتوفر في معظمها على مؤهلات عالية الجودة ومعرفة عميقة بالمجال الذي تشتغل فيه، فلا تترك إلا حيزا ضيقا للخطأ في حالات جد استثنائية.
فلو تم إصدار هذا القانون مع تطبيقه تطبيقا سليما وفق مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، لوضعنا حدا لظاهرة الجشع والإثراء غير المشروع، عملا بالمقولة الشعبية: "الخوف كيورث الحياء"..
قد يقول قائل: ما علاقة هذا القانون بموضوع التزكيات؟ لنجيب عليه بأن الطبيب البارع في تخصصه لا يكتفي بتشخيص المرض، بل يبحث هنا وهناك عن الأسباب الحقيقية والخفية لظهور هذا الداء، حتى لا يعتمد فقط على الأعراض الظاهرة التي قد تخفي أسبابا باطنية لا تنفع معها أي وصفة طبية يقترحها على مريضه. ولذلك وجب التعمق في البحث تجنبا للوقوع في الخطأ..
وكذلك الشأن بالنسبة للموضوع الذي نناقشه والمتعلق بالتزكيات الانتخابية كمصدر للفساد السياسي وأسباب انتشاره، بغية استئصاله من جذوره، ليسهل على الدولة معالجة بعض المظاهر التي تسيء للعمل السياسي، كالتصدي لمستعملي المال "المشبوه" من أجل الفوز في الاستحقاقات الانتخابية، والوصول إلى مراكز القرار لقضاء مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة.
فلما نقارب موضوع الجشع، لا بد أن نفصح عن أسبابه الكامنة، التي يوجد في مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة التي أصبحت تثقل كاهل معظم الناس، كمصاريف الأكل والشراب واللباس، والالتزامات الأخرى المرتبطة بها كمصاريف السكن، وتمدرس الأطفال، والسيارات الشخصية، أو التنقل عبر وسائل النقل العمومي، ومصاريف العلاج، وغيرها.. كلها نفقات كثيرة وجد باهظة، لا تستطيع تحملها حتى الفئة المسماة بالميسورة والموظفون الذين يتقاضون أجورا قارة.
صحيح أن الدولة ما فتئت تقوم بمجهودات جبارة لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية في كثير من الميادين، وخاصة ما يتعلق بالمشاريع المهيكلة الكبرى، بتوجيه وتتبع من جلالة الملك؛ وهذه حقيقة لا ينكرها إلا جاحد؛ غير أن هناك اختلالات في عدة مجالات تعرقل المسيرة التنموية في بعض القطاعات الاجتماعية التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن ببلادنا، كالتعليم والتشغيل والصحة والسكن والعدل.
هذه القطاعات الحساسة لم ترق بعد إلى ما يطمح إليه أغلبية المغاربة، نظرا لما يشوبها من سوء التسيير والتدبير، وسوء التخطيط، والفساد في بعض الأحيان.
وإذا ركزنا فقط على قطاع التعليم مثلا، ولو قيل لنا مرة أخرى: ما علاقة التعليم بقضية التزكيات؟ فسنرد بأن التعليم هو الأساس، وقمة المرتكزات، ومنبع النور في ازدهار الأمم والشعوب، وبانعدامه يَعُمُّ الظلام، ومعه الجهل، فيتخذ المجتمع مرتعا خصبا له.
قيمة التربية والتعليم في توعية المواطن
لما كنا نحن جيل الخمسينيات وبداية الستينيات ندرس في المدارس الابتدائية، كنا نقرأ في كتابين اثنين: كتاب "القراءة المصورة" في مادة اللغة العربية، وكتاب "Bonjour Ali, Bonjour Fatima" في مادة اللغة الفرنسية، وكنا نكتب في دفترين من صنف 24 ورقة، على طول السنة الدراسية. وكانت أدوات الكتابة المتوفرة آنذاك هي الحبر الأرجواني الداكن، ومحبرة مثبتة على الطاولة، وريشة، وقلم رصاص، وممحاة..
هذه الأدوات البسيطة وكتابان للقراءة كنا نضعها في خِزانات القسم في آخر الدرس، ولا نحملها معنا إلى بيوتنا..
وكان ضمن المقررات الدراسية دروس في التربية الوطنية، والتربية الإسلامية، والتربية الأخلاقية، وكنا نردد النشيد الوطني كل صباح قبل الدخول إلى الأقسام.
تلك هي المدرسة المغربية العمومية الأصيلة التي أنجبت لنا علماء في جميع التخصصات.
فهل من مقارنة مع مدرسة اليوم؟
وما هو ثمن المدرسة الحديثة، خاصة بالمدارس الخصوصية؟
وكيف أصبح واقع التعليم ببلادنا، رغم كل المحاولات الفاشلة في كل إصلاح؟ ..
وبماذا يمكن أن نُجيب؟... "الخبر في راسك" كما يقال باللغة العامية.
وما السبيل لتكوين مواطن واعٍ بحقوقه وواجباته إذا لم يتلقَّ تربية سليمة في بيئة مدرسية حاضنة، تؤطرها قيم المواطنة، وروح النقد البناء، وتكرّس مبادئ النزاهة والاستحقاق والتنافس الشريف؟
ثم كيف ننتظر من هذا المواطن أن ينخرط في الحياة السياسية بصدق ونبل وغيرة على وطنه، وهو لم يتعلم منذ نعومة أظافره كيف يفرّق بين الحق والباطل، وبين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة؟
وكيف له أن يميّز بين من يستحق تمثيله ومن لا يستحق، إذا لم يُلَقَّن أدبيات التفكير المستقل، و محاسبة النفس والغير على أساس من القيم والضمير؟
إن الفاعل السياسي، أو من يتقدم للترشح، هو في النهاية نتاج هذا المجتمع، ثمرة لهذا التعليم، وانعكاس لهذه المنظومة التي أفرزته، فلا يمكن أن نطالبه بالمثالية ونحن نغذيه يوميًا بمفاهيم النفعية والزبونية والانتهازية.
فمن أين تبدأ سلسلة الإصلاح؟
أزمة التزكيات: عرض أم مرض؟
إذا كانت التزكيات تُمنح في كثير من الأحيان وفق معايير غير ديمقراطية، تُقدَّم فيها المصالح الشخصية على المصلحة العامة، وتُغلّب فيها الولاءات الضيقة على الكفاءة والنزاهة، فإننا أمام أزمة بنيوية عميقة لا تتعلق فقط بقانون الأحزاب أو القوانين الانتخابية، بل بغياب ثقافة سياسية راشدة، وضمور الوعي الجماعي بضرورة الإصلاح من الداخل، وانعدام آليات المراقبة الحزبية الداخلية.
فكيف لحزب سياسي يُفترض فيه تأطير المواطنين، وتكوين نخب قادرة على تحمل المسؤولية، أن يزكّي أشخاصًا يُعرف عنهم الفساد أو ضعف المستوى أو غياب المصداقية، فقط لأنهم يملكون المال أو قاعدة انتخابية قائمة على الولاء القبلي أو الزبوني؟
وهل يمكن، في هذه الحالة، الحديث عن تنافس نزيه، أو عن نتائج تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين؟
إن التزكيات في السياق المغربي تحوّلت في العديد من الأحيان إلى صفقات انتخابية مشبوهة، تُباع فيها "التزكية" لمن يدفع أكبر نسبة من المال، أو لمن يضمن أكبر عدد من الأصوات، بصرف النظر عن خلفيته الفكرية، أو تاريخه الشخصي، أو مدى التزامه بخط الحزب.
وهذا ما يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات، وانسحاب عدد كبير من المواطنين، وخاصة الشباب، من العمل السياسي، لأنهم لا يرون فيه إلا مسرحية عبثية تُعاد فصولها عند كل استحقاق انتخابي.
الأمل في الإصلاح: بين الرؤية الملكية والمسؤولية الجماعية
لقد عبّر جلالة الملك محمد السادس، في أكثر من مناسبة، عن ضرورة تخليق الحياة العامة وتجويد العمل السياسي، وذلك بتجديد النخب، وتمكين الشباب والكفاءات من المساهمة في تدبير الشأن العام.
فلم يعد مقبولا اليوم أن نبقى نلقي اللوم دائما على الدولة وحدها علما بأن المسؤولية مسؤولية جماعية مشتركة تضم المؤسسات الحكومية والهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني والمنابر الإعلامية والنخب المثقفة .. وصولا إلى المواطن الذي عليه واجب تحصين نفسه بالأخلاق والضمير الحي وذلك بعدم بيع صوته في الانتخابات. وهكذا يمكن إعادة الاعتبار للفعل السياسي النبيل.
فالإصلاح لا يتمّ بمرسوم، ولا ببيانات وشعارات الأحزاب، ولا بخطب المناسبات، بل يبدأ من لحظة اختيار الممثلين الحقيقيين للمواطنين، على أسس من الكفاءة، والنزاهة، والالتزام الصادق.
وهذا هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا اليوم، إذا أردنا فعلا أن نبني ديمقراطية حقيقية، تستجيب لتطلعات الشعب المغربي، وتحترم ذكاءه، وتُعيد الثقة إلى مؤسساته..
خلاصات واستنتاجات
إن أزمة التزكيات ليست سوى مرآة لأزمة أعمق، تتعلق بفهمنا للديمقراطية، وتصورنا للسياسة، وممارستنا اليومية للشأن العام. وهي أزمة تفضح هشاشة البنية الحزبية، وضعف التأطير، وتَرسُّخ ثقافة الزبونية والمحسوبية في الكثير من الحالات.
ولا يمكن لأي إصلاح حقيقي أن يتحقق ما لم نُعد النظر في التعريف الحقيقي للسياسة في بلادنا على أساس الوعي الجماعي، كفعل نبيل لخدمة الوطن والمواطن، لا كوسيلة للاغتناء أو التسلّق الاجتماعي.
وحتى تكون التزكية أداة لتعزيز الديمقراطية، لا لتكريس الرداءة، لا بد من مراجعة شاملة لمنظومة التزكيات، سواء من حيث الشروط القانونية، أو آليات الترشيح، أو طرق اختيار المرشحين داخل الأحزاب.
كما أن الدولة مدعوّة إلى لعب دور الضامن، عبر وضع قواعد واضحة، وإرساء آليات للرقابة والمساءلة، تمنع الانزلاقات، وتحد من الفساد الانتخابي، دون التدخل في استقلالية الأحزاب.
وفي هذا الإطار، يمكن اقتراح مجموعة من التوصيات:
- إلزام الأحزاب بتبني مساطر داخلية شفافة في منح التزكيات، تنشر بشكل علني، وتخضع للرقابة والمساءلة.
- تمكين الهيئات المختصة داخل الأحزاب من صلاحيات حقيقية، ومنحها الاستقلالية الكافية لاتخاذ القرار بعيدًا عن الضغوطات الشخصية أو المالية..
- اعتماد معايير موضوعية في اختيار المرشحين، تقوم على الكفاءة، والسيرة الذاتية، والنزاهة الأخلاقية، والانخراط الفعلي في العمل الحزبي والمجتمعي، والكف عن استقطاب ما يسمى ب"الكائنات الانتخابية" أو "أصحاب الشكارة" أثناء المواعيد الانتخابية والذين لا تجمعهم مع الأحزاب السياسية في معظمهم إلا "الخير والاحسان" كما يقال باللغة الشعبية. علما بأن جل هذه الأحزاب تشتكي من الفساد الانتخابي. أليس هذا قمة النفاق السياسي؟.. "يأكلون النعمة ويسبون الملة"...
- إعادة النظر في تمويل الحملات الانتخابية، ووضع سقف صارم للنفقات، مع مراقبة صارمة لمصادر التمويل، تفاديًا لشراء الذمم، مع إعادة النظر في الدعم السنوي والدعم المخصص للانتخابات والمؤتمرات وتوزيعه بالمساواة على جميع الأحزاب الجادة.
- تعزيز دور القضاء والمؤسسات الرقابية في تتبع الخروقات، ومحاسبة المتورطين في الفساد الانتخابي، سواء داخل الأحزاب أو خارجها.
- دعم الإعلام المستقل الجاد، وتمكينه من القيام بدوره في التوعية والمساءلة، وكشف الانحرافات، وتقديم مرشحين للرأي العام بناءً على معايير مهنية موضوعية خلافا لما تقوم به بعض المنابر الإعلامية اللامسؤولة، وصفت أصحابها في مقال سابق ب" الصناع الجدد لوقود الفتنة"، أولئك الذين ينشرون أخبارا زائفة ومعلومات مضللة بالتشهير بمواطنين أبرياء لابتزازهم أو للانتقام منهم.
- تحسيس المواطن بدوره المحوري في عملية الإصلاح، انطلاقًا من اختياره في صناديق الاقتراع، ومرورًا بمراقبته للمنتخبين، وانتهاءً بمحاسبتهم عند الإخلال بالمسؤولية.
إن مستقبل الديمقراطية في بلادنا، ونجاح النموذج التنموي الجديد، يعتمدان بالأساس على إعادة الثقة في المؤسسات، وعلى ترسيخ ممارسات سياسية نزيهة، تُعيد للعمل الحزبي معناه، وللانتخابات صدقيتها، وللمواطن كرامته وصوته الحقيقي.