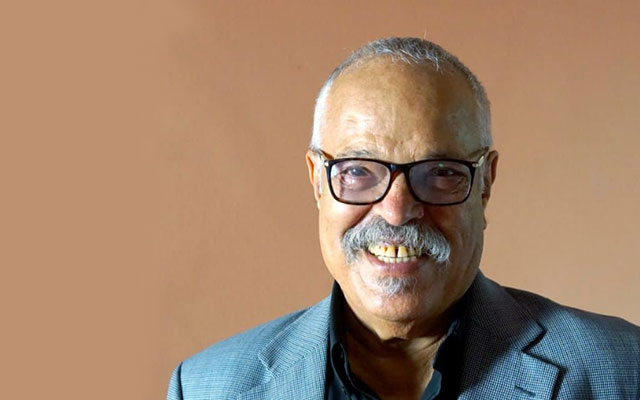تركيا أردوغان، التي كانت في مطلع الألفية مشروعاً طموحاً للنهضة، تدخل اليوم عقدها الثالث تحت قيادة رجل واحد، مثقلة بتركة من الأوهام الاستراتيجية، والعزلة الإقليمية، والضغوط الداخلية المتصاعدة. رجب طيب أردوغان، الذي صاغ شخصه كرمز للانبعاث التركي وقائد للعالم الإسلامي، يبدو اليوم محاصراً بجملة من التحولات الجذرية التي تشق طريقها في الجوار، وعلى رأسها الانهيار المفاجئ للنظام السوري، وعودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، وانطلاق مفاوضات السلام الروسية الأوكرانية في الرياض، لا في أنقرة، بما يرمز إلى استبعاد تركيا من صياغة خرائط القوة في المنطقة.
فرار بشار الأسد من دمشق في فبراير 2025، وسيطرة المعارضة السورية على العاصمة بدعم أمريكي وعربي، شكّل ضربة استراتيجية موجعة لأنقرة التي راهنت طويلاً على أن تكون اللاعب الحاسم في الملف السوري. غير أن الوقائع الجديدة في دمشق كشفت حدود النفوذ التركي، خاصة أن المعارضة السورية التي تتولى اليوم إدارة المرحلة الانتقالية، باتت تتحرك في إطار تحالف دولي تقوده واشنطن والرياض وباريس، دون الحاجة إلى الوصاية التركية. تركيا، التي كانت قبل سنوات تستضيف قيادة الائتلاف السوري، وتفاوض على مصير إدلب، وتبتز أوروبا بورقة اللاجئين، أصبحت اليوم خارج معادلة دمشق الجديدة، بعد أن تجاوزها الحلفاء قبل الأعداء.
الأكثر إيلاماً لأردوغان هو ما جرى في الملف الأوكراني. فبينما كان يتوقع أن تستضيف تركيا مجدداً محادثات السلام بين موسكو وكييف كما فعلت في 2022، جاءت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لتُعيد ترتيب الأوراق بالكامل. ترامب، الذي أعاد رسم أولويات السياسة الخارجية الأمريكية بلمسة صدامية واستراتيجية، اختار المملكة العربية السعودية كمقر حصري لمفاوضات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، في خطوة تعكس تحوّلاً عميقاً في توزيع الأدوار الإقليمية. الرياض، التي باتت تمارس دور الوسيط الجيوسياسي بثقة، انتزعت هذا الامتياز من أنقرة، التي كانت لعقود تقدم نفسها كجسر بين الشرق والغرب. هكذا، وجدت تركيا نفسها مُستبعدة من أحد أهم الملفات الجيوسياسية في العالم، لا بفعل التقصير الدبلوماسي فحسب، بل بفعل انهيار الثقة الدولية في نوايا ومصداقية النظام.
هذا التراجع في المكانة الإقليمية لأنقرة يتزامن مع تصدع داخلي غير مسبوق. الاقتصاد التركي يرزح تحت وطأة تضخم تجاوز 58%، والعملة الوطنية تواصل انهيارها أمام الدولار، والاستثمارات الأجنبية غادرت السوق، بعدما باتت مؤسسات الدولة أداة بيد السلطة التنفيذية. الحملة المتواصلة على الصحافة المستقلة، واعتقال قادة المعارضة، وتهميش القضاء، خلقت مناخاً من القلق العام، يعكسه تفاقم الاحتقان الاجتماعي في المدن الكبرى. الانتخابات البلدية المقبلة، التي كانت في السابق محطة تفوق لحزب العدالة والتنمية، باتت مرشحة لأن تكون بداية النهاية السياسية لحكم الفرد.
في هذه البيئة المتأزمة، يبدو أن خطاب أردوغان القومي والديني لم يعد له التأثير التعبوي الذي امتلكه في السابق. الجمهور الذي كان يُلهب حماسته الحديث عن “أمة قوية” و”مؤامرات خارجية” بات يبحث عن أجوبة ملموسة لأزمة الخبز والطاقة والبطالة. المعارضة، التي توحدت في تحالفات مرنة، تقدم بديلاً واقعياً ومدنياً، فيما باتت قواعد العدالة والتنمية أكثر انقساماً من أي وقت مضى. وتواتر الحديث داخل الحزب نفسه عن الحاجة إلى انتقال داخلي للقيادة، يؤكد أن التصدع لم يعد محصوراً في الخارج، بل يتغلغل في الداخل السياسي للنظام.
أما في العلاقات الدولية، فإن أنقرة تواجه اليوم عزلة متراكمة. أوروبا لم تعد تثق في النظام التركي، وأوقفت فعلياً كل مفاوضات الانضمام، فيما الناتو يشكك في التزام تركيا بتحالفاته، خصوصاً بعد شراء أنظمة الدفاع الروسية والامتناع عن الانخراط الكامل في العقوبات الغربية على موسكو. العلاقة مع موسكو بدورها تراجعت، خاصة بعد أن فقدت تركيا موقعها كوسيط موثوق في الملف الأوكراني. وفي العالم العربي، وعلى الرغم من التطبيع السريع مع دول الخليج، فإن الثقة السياسية الحقيقية لم تُستعد، بسبب مواقف تركيا السابقة الداعمة للتيارات الإسلامية العابرة للحدود.
كل هذه التغيرات تعني شيئاً واحداً: تركيا لم تعد رقماً فاعلاً في معادلات التوازن الإقليمي، ولا في معارك النفوذ الكبرى، بل أصبحت في موقع رد الفعل، تنتظر ما يُرسم في الرياض وواشنطن ودمشق، لتقرر كيف تتكيف معه. لقد انتهى الزمن الذي كانت فيه أنقرة ترسم مستقبل سوريا، وتفاوض باسم أوكرانيا، وتلعب على تناقضات موسكو وبروكسل. إنها الآن خارج المسرح.
إن نهاية أردوغان، التي بدت مستحيلة قبل سنوات، صارت اليوم مرئية وملموسة. إنها ليست مجرد نهاية لرجل، بل نهاية لنموذج حكم بُني على المزاوجة بين الشعبوية والسلطوية، بين الخطاب الإسلامي والتدخلات الخارجية، بين الوعود الاقتصادية والرقابة القمعية. وفي زمن التحولات الكبرى، لا يرحم التاريخ أولئك الذين يرفضون الإصغاء لوقع التغيير. أردوغان لم يعد قائداً إقليمياً، بل تحول إلى زعيم في دولة على الهامش، يطارده ماضٍ من التوسع، ويطوقه حاضر من الانكماش
فرار بشار الأسد من دمشق في فبراير 2025، وسيطرة المعارضة السورية على العاصمة بدعم أمريكي وعربي، شكّل ضربة استراتيجية موجعة لأنقرة التي راهنت طويلاً على أن تكون اللاعب الحاسم في الملف السوري. غير أن الوقائع الجديدة في دمشق كشفت حدود النفوذ التركي، خاصة أن المعارضة السورية التي تتولى اليوم إدارة المرحلة الانتقالية، باتت تتحرك في إطار تحالف دولي تقوده واشنطن والرياض وباريس، دون الحاجة إلى الوصاية التركية. تركيا، التي كانت قبل سنوات تستضيف قيادة الائتلاف السوري، وتفاوض على مصير إدلب، وتبتز أوروبا بورقة اللاجئين، أصبحت اليوم خارج معادلة دمشق الجديدة، بعد أن تجاوزها الحلفاء قبل الأعداء.
الأكثر إيلاماً لأردوغان هو ما جرى في الملف الأوكراني. فبينما كان يتوقع أن تستضيف تركيا مجدداً محادثات السلام بين موسكو وكييف كما فعلت في 2022، جاءت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لتُعيد ترتيب الأوراق بالكامل. ترامب، الذي أعاد رسم أولويات السياسة الخارجية الأمريكية بلمسة صدامية واستراتيجية، اختار المملكة العربية السعودية كمقر حصري لمفاوضات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، في خطوة تعكس تحوّلاً عميقاً في توزيع الأدوار الإقليمية. الرياض، التي باتت تمارس دور الوسيط الجيوسياسي بثقة، انتزعت هذا الامتياز من أنقرة، التي كانت لعقود تقدم نفسها كجسر بين الشرق والغرب. هكذا، وجدت تركيا نفسها مُستبعدة من أحد أهم الملفات الجيوسياسية في العالم، لا بفعل التقصير الدبلوماسي فحسب، بل بفعل انهيار الثقة الدولية في نوايا ومصداقية النظام.
هذا التراجع في المكانة الإقليمية لأنقرة يتزامن مع تصدع داخلي غير مسبوق. الاقتصاد التركي يرزح تحت وطأة تضخم تجاوز 58%، والعملة الوطنية تواصل انهيارها أمام الدولار، والاستثمارات الأجنبية غادرت السوق، بعدما باتت مؤسسات الدولة أداة بيد السلطة التنفيذية. الحملة المتواصلة على الصحافة المستقلة، واعتقال قادة المعارضة، وتهميش القضاء، خلقت مناخاً من القلق العام، يعكسه تفاقم الاحتقان الاجتماعي في المدن الكبرى. الانتخابات البلدية المقبلة، التي كانت في السابق محطة تفوق لحزب العدالة والتنمية، باتت مرشحة لأن تكون بداية النهاية السياسية لحكم الفرد.
في هذه البيئة المتأزمة، يبدو أن خطاب أردوغان القومي والديني لم يعد له التأثير التعبوي الذي امتلكه في السابق. الجمهور الذي كان يُلهب حماسته الحديث عن “أمة قوية” و”مؤامرات خارجية” بات يبحث عن أجوبة ملموسة لأزمة الخبز والطاقة والبطالة. المعارضة، التي توحدت في تحالفات مرنة، تقدم بديلاً واقعياً ومدنياً، فيما باتت قواعد العدالة والتنمية أكثر انقساماً من أي وقت مضى. وتواتر الحديث داخل الحزب نفسه عن الحاجة إلى انتقال داخلي للقيادة، يؤكد أن التصدع لم يعد محصوراً في الخارج، بل يتغلغل في الداخل السياسي للنظام.
أما في العلاقات الدولية، فإن أنقرة تواجه اليوم عزلة متراكمة. أوروبا لم تعد تثق في النظام التركي، وأوقفت فعلياً كل مفاوضات الانضمام، فيما الناتو يشكك في التزام تركيا بتحالفاته، خصوصاً بعد شراء أنظمة الدفاع الروسية والامتناع عن الانخراط الكامل في العقوبات الغربية على موسكو. العلاقة مع موسكو بدورها تراجعت، خاصة بعد أن فقدت تركيا موقعها كوسيط موثوق في الملف الأوكراني. وفي العالم العربي، وعلى الرغم من التطبيع السريع مع دول الخليج، فإن الثقة السياسية الحقيقية لم تُستعد، بسبب مواقف تركيا السابقة الداعمة للتيارات الإسلامية العابرة للحدود.
كل هذه التغيرات تعني شيئاً واحداً: تركيا لم تعد رقماً فاعلاً في معادلات التوازن الإقليمي، ولا في معارك النفوذ الكبرى، بل أصبحت في موقع رد الفعل، تنتظر ما يُرسم في الرياض وواشنطن ودمشق، لتقرر كيف تتكيف معه. لقد انتهى الزمن الذي كانت فيه أنقرة ترسم مستقبل سوريا، وتفاوض باسم أوكرانيا، وتلعب على تناقضات موسكو وبروكسل. إنها الآن خارج المسرح.
إن نهاية أردوغان، التي بدت مستحيلة قبل سنوات، صارت اليوم مرئية وملموسة. إنها ليست مجرد نهاية لرجل، بل نهاية لنموذج حكم بُني على المزاوجة بين الشعبوية والسلطوية، بين الخطاب الإسلامي والتدخلات الخارجية، بين الوعود الاقتصادية والرقابة القمعية. وفي زمن التحولات الكبرى، لا يرحم التاريخ أولئك الذين يرفضون الإصغاء لوقع التغيير. أردوغان لم يعد قائداً إقليمياً، بل تحول إلى زعيم في دولة على الهامش، يطارده ماضٍ من التوسع، ويطوقه حاضر من الانكماش