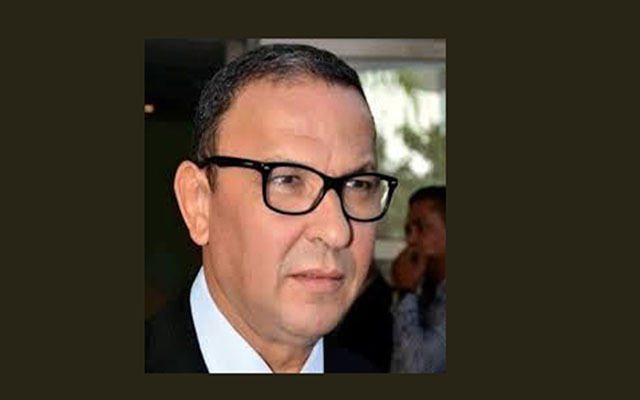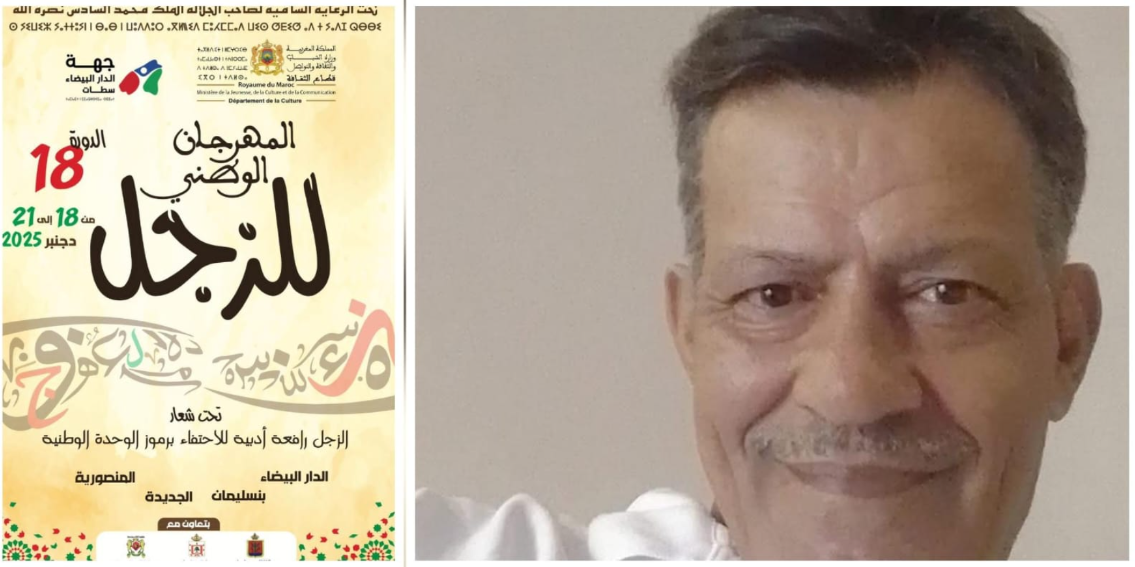قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إن المجلس يواكب النقاشات والقضايا المتعلقة بالتشريع، وينتبه إليها، ولمخرجاتها عند بلوة آرائه الاستشارية حول عدد من القوانين، كما هو الحال مثلا عندما طلب وزير العدل رأي المجلس بخصوص مراجعة مدونة المسطرة المدنية والجنائية، وهو الرأي الذي يمكن الاطلاع عليه بالموقع الإلكتروني للمجلس، كما توصل هذا الأخير الأسبوع الجاري بطلب من رئيس مجلس النواب لإبداء الرأي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
جاء ذلك في كلمة لها خلال الندوة الدولية المنظمة من طرف هيئة المحامين بفاس والاتحاد الدولي للمحامين وجمعية هيئات المحامين بالمغرب يومي 14 و15 فبراير2025 حول "إصلاح المساطر القضائية بالمغرب تحديات الحق في الدفاع وحماية الحقوق".
وأفادت المتحدثة ذاتها أن المجلس في كل هذه الآراء، يجتهد، ويدفع من أجل أن تكون كل المقتضيات ضامنة لفعلية الحقوق والحريات. وقالت: "ونرى في هذا السياق أن الإجراءات القانونية وسيلة أساسية ورئيسية لضمان هذه الفعلية، تُنظّم كيفية حماية الأفراد من التعسف وضمان تحقيق العدالة...؛ لا يجب الاقتصار فقط على التنصيص عليها بنص القانون، بل يتطلب الأمر أيضا توفير آليات تنفيذية فعالة تضمن احترامها وتطبيقها على أرض الواقع".
بوعياش سلطت الضوء مجددا على خمس مبادئ رئيسية يعتبرها المجلس ركائز أساسية في تطبيق الإجراءات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وضمان العدالة، وهي:
أولا، الشرعية: أي الالتزام بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مما يضمن عدم اتخاذ أي إجراء تعسفي أو مخالف للنصوص القانونية المعمول بها.
ثانيا، التناسب: أي ضمان أن تكون الإجراءات القانونية متوازنة وغير مفرطة، بحيث تتناسب العقوبات والتدابير المتخذة مع طبيعة الفعل المرتكب، مما يمنع التعسف في استخدام السلط.
ثالثا، الضرورة: وتقضي أن تكون التدابير القانونية متخذة فقط عند الحاجة الفعلية لحماية النظام العام أو الحقوق الأساسية، ولا يتم اللجوء إلى أي تقييد إلا عند عدم وجود أي بديل آخر أقل حدة منه.
رابعا، الرقابة القضائية: وهي عنصر أساسي لضمان الطعون القانونية ضد أي إجراء قد ينتهك الحقوق الأساسية.
خامسا وأخيرا، إمكانية الوصول أو ولوج الجميع إلى العدالة: من خلال توفير آليات تظلم فعالة، وضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة، بما يعزز الثقة في المنظومة القانونية.
أولا، الشرعية: أي الالتزام بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مما يضمن عدم اتخاذ أي إجراء تعسفي أو مخالف للنصوص القانونية المعمول بها.
ثانيا، التناسب: أي ضمان أن تكون الإجراءات القانونية متوازنة وغير مفرطة، بحيث تتناسب العقوبات والتدابير المتخذة مع طبيعة الفعل المرتكب، مما يمنع التعسف في استخدام السلط.
ثالثا، الضرورة: وتقضي أن تكون التدابير القانونية متخذة فقط عند الحاجة الفعلية لحماية النظام العام أو الحقوق الأساسية، ولا يتم اللجوء إلى أي تقييد إلا عند عدم وجود أي بديل آخر أقل حدة منه.
رابعا، الرقابة القضائية: وهي عنصر أساسي لضمان الطعون القانونية ضد أي إجراء قد ينتهك الحقوق الأساسية.
خامسا وأخيرا، إمكانية الوصول أو ولوج الجميع إلى العدالة: من خلال توفير آليات تظلم فعالة، وضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة، بما يعزز الثقة في المنظومة القانونية.
وأكدت آمنة بوعياش، أن هذا اللقاء، فرصة لتقاسم الأفكار في الإشكاليات المشتركة والتفاعل مع مدافعين عن إعمال القانون، واختبار لحظات تفكير جماعي، ونقاش عميق حول مدى هذا الإعمال، ونطاقاته في قضايا حيوية تتعلق بالحق في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، التي تتطلب ليس فقط نصوص قانونية وإجرائية، ولكن أن تصبح كذلك ممارسة يومية، نتمثلها في قاعات المحاكم، في مكاتب الاستنطاق والبحث، في مرافعات المحاميات والمحامين، وفي كل إجراء ذات صلة بحقوق الأفراد وحرياتهم.
وفي حديثها عن معالجة الشكايات التي يتوصل بها المجلس وملاحظته للمحاكمات، قالت بوعياش:"نقف أحيانا على قضايا، ننكب على التفاعل معها. أستقي منها ستة، نحرص دوما على إثارتها وفعليتها في جميع الحالات:
- الحق في الدفاع وفي المساواة أمام القانون لكل متقاضية ومتقاض.
- استفادة كل متقاضية ومتقاض من المشورة القانونية.
- احترام مبدأ التواجهية في جميع الإجراءات.
- البث في جميع القضايا داخل أجل معقول.
- ضمان وتعزيز ولوج الفئات الهشة إلى المحاكم.
- التفاعل مع القضايا دوما بشكل متيقظ ومتلائم مع روح القانون ومع المعايير الدولية والأخلاقية.
وأضافت أن للمحاميات والمحامون أمثلة أخرى، تعكس تحديات يتم رصدها من خلال العمل الفعلي، والحقوقي الذي تقوم به المؤسسة الوطنية... وذكرت بعض الاشكاليات ذات الصلة بموضوع هذا الجمع، ومنها:
- إشكاليات تتعلق بتدبير الزمن القضائي الناجم عن تأخر الإجراءات القضائية بسبب معضلة التبليغ، بحيث يؤدي طول مدة التقاضي إلى التأثير سلبا على فعالية المحاكمة العادلة.
- إشكاليات تتعلق بنطاق اللايقين القانوني: فرغم الجهود المبذولة من طرف محكمة النقض من أجل توحيد الاجتهادات القضائية بما يكفل توفير الأمن القانوني والقضائي إلا أننا لا زلنا نسجل اتساع سلطة التأويل بسبب بعض الفراغات القانونية، وعدم وضوح بعض النصوص وتفاوت المحاكم في تفسيرها أمام هامش السلطة التقديرية المتاحة للقضاء.
- إشكاليات تتعلق بفعلية الوصول إلى الدفاع: سواء حينما يتعلق الأمر بالمجال الزجري حيث يطرح إشكال حضور الدفاع إلى جانب الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، وكذلك الحال بالنسبة لوصول الضحايا الى الحق في الدفاع، أو في المجال المدني حيث تثار عدة أسئلة حول أهمية الحصول على المساعدة القانونية وضمان الحق في الدفاع في جميع مراحل الإجراءات القضائية، بما يكفل توفير نفس الحقوق أمام العدالة لجميع المتقاضين بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.
- إشكاليات تتعلق بأجرة الحقوق: إذ ينص القانون أحيانا على مجموعة من الحقوق ويغفل التنصيص على طريقة النفاذ إليها، وهو ما قد يتأثر بسبب عدم التوفر على المعلومة القانونية، وبسبب الإمكانيات المادية، كما قد يتأثر أيضا بسبب الفوارق المجالية.
- إشكاليات تتعلق بإعمال المبادئ الدولية لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية: فبالرغم من مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقيات الأساسية بدون تحفظ، وهي التي تشكل النواة الصلبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن الاعتماد عليها من طرف المحاكم الوطنية يبقى ضعيفا وهو ما يعيق من وجهة نظرنا الاجتهاد، خاصة في قضايا قد لا يكون القانون ينص عليها ضمن ظروف وملابسات محددة والتي من شأنها تعزيز العدالة وضمان احترام الحقوق المكفولة دوليًا.
- الحق في الدفاع وفي المساواة أمام القانون لكل متقاضية ومتقاض.
- استفادة كل متقاضية ومتقاض من المشورة القانونية.
- احترام مبدأ التواجهية في جميع الإجراءات.
- البث في جميع القضايا داخل أجل معقول.
- ضمان وتعزيز ولوج الفئات الهشة إلى المحاكم.
- التفاعل مع القضايا دوما بشكل متيقظ ومتلائم مع روح القانون ومع المعايير الدولية والأخلاقية.
وأضافت أن للمحاميات والمحامون أمثلة أخرى، تعكس تحديات يتم رصدها من خلال العمل الفعلي، والحقوقي الذي تقوم به المؤسسة الوطنية... وذكرت بعض الاشكاليات ذات الصلة بموضوع هذا الجمع، ومنها:
- إشكاليات تتعلق بتدبير الزمن القضائي الناجم عن تأخر الإجراءات القضائية بسبب معضلة التبليغ، بحيث يؤدي طول مدة التقاضي إلى التأثير سلبا على فعالية المحاكمة العادلة.
- إشكاليات تتعلق بنطاق اللايقين القانوني: فرغم الجهود المبذولة من طرف محكمة النقض من أجل توحيد الاجتهادات القضائية بما يكفل توفير الأمن القانوني والقضائي إلا أننا لا زلنا نسجل اتساع سلطة التأويل بسبب بعض الفراغات القانونية، وعدم وضوح بعض النصوص وتفاوت المحاكم في تفسيرها أمام هامش السلطة التقديرية المتاحة للقضاء.
- إشكاليات تتعلق بفعلية الوصول إلى الدفاع: سواء حينما يتعلق الأمر بالمجال الزجري حيث يطرح إشكال حضور الدفاع إلى جانب الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، وكذلك الحال بالنسبة لوصول الضحايا الى الحق في الدفاع، أو في المجال المدني حيث تثار عدة أسئلة حول أهمية الحصول على المساعدة القانونية وضمان الحق في الدفاع في جميع مراحل الإجراءات القضائية، بما يكفل توفير نفس الحقوق أمام العدالة لجميع المتقاضين بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.
- إشكاليات تتعلق بأجرة الحقوق: إذ ينص القانون أحيانا على مجموعة من الحقوق ويغفل التنصيص على طريقة النفاذ إليها، وهو ما قد يتأثر بسبب عدم التوفر على المعلومة القانونية، وبسبب الإمكانيات المادية، كما قد يتأثر أيضا بسبب الفوارق المجالية.
- إشكاليات تتعلق بإعمال المبادئ الدولية لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية: فبالرغم من مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقيات الأساسية بدون تحفظ، وهي التي تشكل النواة الصلبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن الاعتماد عليها من طرف المحاكم الوطنية يبقى ضعيفا وهو ما يعيق من وجهة نظرنا الاجتهاد، خاصة في قضايا قد لا يكون القانون ينص عليها ضمن ظروف وملابسات محددة والتي من شأنها تعزيز العدالة وضمان احترام الحقوق المكفولة دوليًا.
وفي سياق هذا الحديث لا بد لنا من تثمين الحالات والممارسات الفضلى التي نسجلها، التي تجعل حقوق الإنسان ومبادئها الدولية نبراسا وركيزة لمقاربة التعاطي مع القضايا المعروضة.