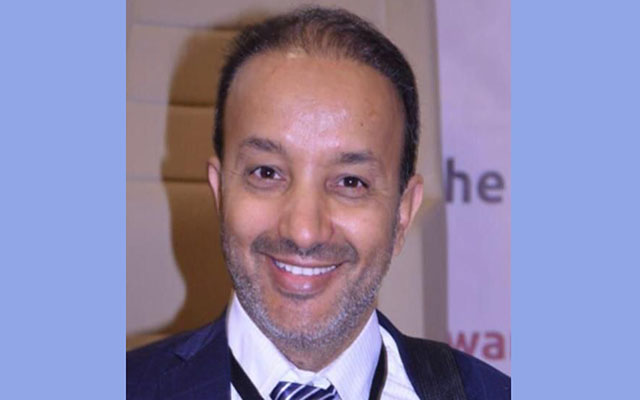لم نكن نتمنى كمغاربة بقلوبنا الطيبة وبيوتنا التي تفتح في وجه الضيوف الأجانب والغرباء، أن يتصدر بلدنا نشرات الأخبار «الدموية» بالقنوات الكبرى العالمية. لم نكن نرجو أن تنتهي رحلة سائحتين إسكندنافيتين مقبلتين على الحياة هنا بالمغرب في منطقة شمهروش بإمليل، وتقتلان بوحشية وسادية من قبل حفنة من «الدواعش» لا يدينون إلا بعقيدة الإرهاب والقتل والاغتصاب، وكل ما لا يمت بصلة إلى الطبيعة البشرية والإنسانية.
هذه الجريمة التي استنكرها كل مغربي له غيرة على بلده ودينه لا يمكن أن تكون إلا حادثا «عرضيا» لا يعكس انفلاتا في الأمن السياحي، ولا اختراقا لجيوب الإرهاب لمسامات شوارعنا وأحيائنا وسهولنا وجبالنا وأنهارنا وبحارنا وغاباتنا، بدليل العمليات الإرهابية التي أجهضت على مدار السنة التي نودعها. هذه اليقظة الأمنية في عهد عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المغربية، بنت جدار صد ضد أي تحرش إرهابي بالمغرب، لذا كانت ردود الفعل الأولى من وزارتي الخارجية الدنماركية والنرويجية «هادئة» وخالية من أي تشنج أو اتهامات متسرعة أو أحكام مسبقة بتصنيف المغرب بلدا غير آمن، ومن ثم تحذير مواطنيهم وإشعارهم بحزم أمتعتهم ومغادرة المغرب. كل تلك السيناريوهات لم تحدث، وقد لعب المغاربة الذين أدانوا بمختلف أطيافهم هذه الفاجعة دورا كبيرا في تكريس هذا الانطباع والإجماع العالمي على أن المغرب كان على مر التاريخ ملتقى الحضارات ومزارا للسياح من شتى الجنسيات.
ربما تأثر المغاربة بمقتل السائحتين الإسكندنافيتين كان أقوى وأبلغ تعبيرا من فواجع أكثر بشاعة عاشها المغرب، قد يكون ذلك بسبب أن الضحيتين أجنبيتان، أو الشعور بالعار لأن الجناة يحملون جينات إرهابية، لذلك كانت عائلاتهم هم أول من تبرأوا منهم قبل المجتمع وطالبوا بتوقيع أعلى درجات القصاص في حقهم عقابا لهم. ولا يوجد إحساس أقوى من أن يتمنى الأب الإعدام لابنه « الإرهابي»، مادام مصطلح «الإرهابي» لوحده كفيلا لأن يسقط أي رابطة دموية أو قرابة عائلية!!
ومن ثم امتزجت أحاسيس الأسى والعزاء تجاه عائلتي الضحيتين بمشاعر الحقد والكراهية والعار نحو القتلة. توحدت كل عبارات الإدانة والتنديد بهذه الجريمة الإرهابية، فسماء المغرب لا تمطر دما وإرهابا وخناجر وسيوفا، والحقول لا يزرع فيها الديناميت والبساتين لا تزهر فيها القنابل وورود الشر، بل كان المغرب بمعابده وكنائسه ومساجده مضرب المثل للتسامح الديني، وبغنى مآثره وأسواره التاريخية ومدنه العتيقة مهدا للحضارات.
هذه الجريمة التي استنكرها كل مغربي له غيرة على بلده ودينه لا يمكن أن تكون إلا حادثا «عرضيا» لا يعكس انفلاتا في الأمن السياحي، ولا اختراقا لجيوب الإرهاب لمسامات شوارعنا وأحيائنا وسهولنا وجبالنا وأنهارنا وبحارنا وغاباتنا، بدليل العمليات الإرهابية التي أجهضت على مدار السنة التي نودعها. هذه اليقظة الأمنية في عهد عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المغربية، بنت جدار صد ضد أي تحرش إرهابي بالمغرب، لذا كانت ردود الفعل الأولى من وزارتي الخارجية الدنماركية والنرويجية «هادئة» وخالية من أي تشنج أو اتهامات متسرعة أو أحكام مسبقة بتصنيف المغرب بلدا غير آمن، ومن ثم تحذير مواطنيهم وإشعارهم بحزم أمتعتهم ومغادرة المغرب. كل تلك السيناريوهات لم تحدث، وقد لعب المغاربة الذين أدانوا بمختلف أطيافهم هذه الفاجعة دورا كبيرا في تكريس هذا الانطباع والإجماع العالمي على أن المغرب كان على مر التاريخ ملتقى الحضارات ومزارا للسياح من شتى الجنسيات.
ربما تأثر المغاربة بمقتل السائحتين الإسكندنافيتين كان أقوى وأبلغ تعبيرا من فواجع أكثر بشاعة عاشها المغرب، قد يكون ذلك بسبب أن الضحيتين أجنبيتان، أو الشعور بالعار لأن الجناة يحملون جينات إرهابية، لذلك كانت عائلاتهم هم أول من تبرأوا منهم قبل المجتمع وطالبوا بتوقيع أعلى درجات القصاص في حقهم عقابا لهم. ولا يوجد إحساس أقوى من أن يتمنى الأب الإعدام لابنه « الإرهابي»، مادام مصطلح «الإرهابي» لوحده كفيلا لأن يسقط أي رابطة دموية أو قرابة عائلية!!
ومن ثم امتزجت أحاسيس الأسى والعزاء تجاه عائلتي الضحيتين بمشاعر الحقد والكراهية والعار نحو القتلة. توحدت كل عبارات الإدانة والتنديد بهذه الجريمة الإرهابية، فسماء المغرب لا تمطر دما وإرهابا وخناجر وسيوفا، والحقول لا يزرع فيها الديناميت والبساتين لا تزهر فيها القنابل وورود الشر، بل كان المغرب بمعابده وكنائسه ومساجده مضرب المثل للتسامح الديني، وبغنى مآثره وأسواره التاريخية ومدنه العتيقة مهدا للحضارات.
تفاصيل أوفى في العدد الجديد من أسبوعية "الوطن الآن" الموجود في الأكشاك.