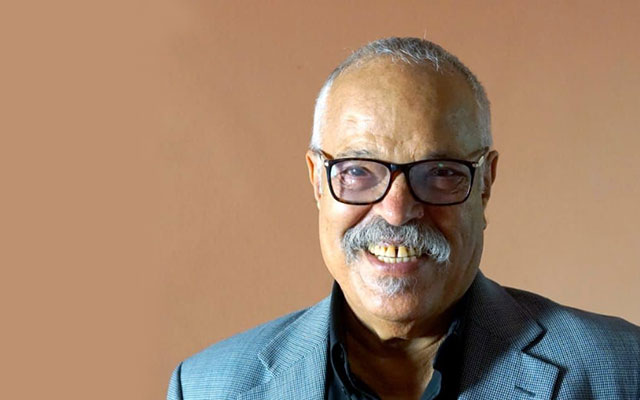يقول حسن أوريد إننا لا نتوفر على دولة وإنما مجرد إدارات تابعة للمخزن.ويقول المصطفى بوعزيز إننا لم نعد نتوفر على «الوطنية»..
وفي انتظار أن تتبلور لدي بعض الأفكار للتفاعل مع ما قيل لأنه مثير للسؤال والرغبة في الحجاج قبل السجال، أتساءل في ظل نمط حكم يسير شؤونه بشؤوننا، هل نتوفر على حيوية حقوقية وثقافية لتساعدنا على تشكيل محصنات في أفق بناء ممانعة لدى هذه الأجهزة الإدارية/ السياسية المعقدة، كشخصيات اعتبارية، لمواجهة تحديات العولمة السياسية والثقافية، وكذا تداعياتها على مستوى تطبيق مشروع الشرق الأوسط العريض؟
وقد راودتني فكرة افتراض أن حسن أوريد على حق، ولربما يقصد أننا لا نتوفر على دولة قوية، أي إنها غير ضعيفة تجاه مواطنيها، بمقارباتها الأمنية والمخيفة، لكنها غير قوية بالشكل المتطلب لمواجهة تدفق وديان الإملاءات والقرارات الدولية. وبنفس الحس الوطني أستشعر موقف المصطفى بوعزيز، فلربما هو يروم رد الاعتبار، من خلال استفهامه الإنكاري، للسيادة الوطنية، وهو توجس يلتقي فيه، المؤرخان معا ربما.. فالمخزن لديهم اهتزت قدراته التدبيرية الوطنية، بل إن قسطا كبيرا من هذه القدرات يمتح من معين القرار الأمني المعولم.
كما انتابني إحساس عميق بأن التاريخ قد يعيد نفسه في شكل «تظلم حمائي» أو «مطلب مظلومية»، أم نغامر بإبراز كل ما تم تخزينه من قوة للانخراط في المواجهة المباشرة، ضمن قواعد لعب مؤطرة بمناورات تدليسية، حيث تهزم الحيلة القوة وفق مقتضيات وتعاليم قانون «أمير» ميكيافيلي. هو نقاش ينبغي أن يكون تشاركيا مع الجميع، بمن فيهم الفاعلين السياسيين الذين لا يؤمنون بوصايا «أمير» غرامشي، والذين يتصيدون كل الفرص لإعادة تحقيق سيناريو خطايا الخيانات التي يجبها الغفران، فيتحول الضحية جلادا والوطني خائنا.
لحظة تأمل لصدمة ما بعد الدولة؟
عشنا لحظة صدمة مع المؤرخ الذي نفى وجود دولة مغربية، فهي في نظره مجرد جهاز لتسيير وتوجيه إدارات تقوم بوظائف محددة. قد نتفق، ولكن أليست تلك الإدارة العليا هي الدولة، مادام الرئيس المدير العام لهذه الإدارة العليا (المسماة مخزنا منذ السعديين) هو السلطان، الذي اجتهدت الحركة الوطنية لتكييف شخصيته مع مطلب «عودة الشرعية» قبل «نيل الاستقلال»، وبالتالي فضلوا لقب «ملك» لينسجم، في آخر التحليل، مع الدور التاريخي الذي لعبه الماريشال ليوطي، كمهندس مفترض لمؤسس إرهاصات الدولة الحديثة؟ لذلك فالدولة هي جهاز تدبيري للشأن العمومي، بتملك القوة العمومية مفوضة من قبل المجتمع، يؤطرها العرف أو القانون، توج خضوعها للدستور الذي صيغ، بعد إلغاء الحماية، وكان مقتضيات حمالة أوجه، عند التطبيق والتأويل، وهما سلطتان مستمدتان من «الوضعي» اقترانا مع «الشرعي/ الديني»، رغم أنه، حسب علماء الاجتماع السياسي وخبراء القانون الدستوري، ليس بدستور، ما دام لا يدقق في فصل السلطات.. فتماهي المسؤوليات وتماهي السلطات والصلاحيات، كان وما زال يشكل قلقا فكريا، ويطرح سؤال المخاطب من حيث إثارة المسؤوليات. فنحن نقر افتراضا بوجود الدولة ومع ذلك تتيه الرقابة والمحاسبة وبالتالي المساءلة السياسية.. فهل يكفي القول بأن «المخزن» هو المسؤول عن كل ما جرى من تخلف وتقهقر وانتهاكات، وهو شيء يثير سؤال اللادولة.
إن وجه الغرابة والمصادفة هو أن السياقات، كما تمت الإشارة سابقا، تذكي الشعور والتوجس، بأن مؤشرات موت الدولة/ الأمة قد أوشكت على استنفاذ دورتها، فالحقوقيون مهووسون بسؤال الدور والمهام لمرحلة ما بعد الدولة، فقد لمحوا في ندوة حقوقية إلى أن بعض الدول، ومنها المغرب نفسه، قد تصير ضحية لحلفاء الأمس. فهل سيحل الحقوقيون محلها، وما هي إمكانية التعاون لاستكمال تنفيذ التعاقدات والالتزامات الدولتية، ذات الصلة بحقوق الإنسان؟ أليس مثال «داعش» صارخا في هذا الصدد، ويبرز مدى خطورة حلول اللادولة والفوضى محل الدولة والقانون؟
ولهذا يطرح سؤال الشرعية والمشروعية، الذي حان الوقت لتمثل أهميتهما، في مرحلة يفترض فيها انتقاء مسار الشرعية، حيث جدوى انسجام تحصين المكتسبات الحقوقية «الوضعية» مع الحرص على تطبيق القوانين في تطابق مع التعليمات والإجراءات التنظيمية، في حين يمكن التريث في استكمال «إبداع» حقوق جديدة، لا يمكن لمجتمع التمثلات التقليدانية أن يتجاوب معها، في ظلال مد محافظ متصاعد؟؟