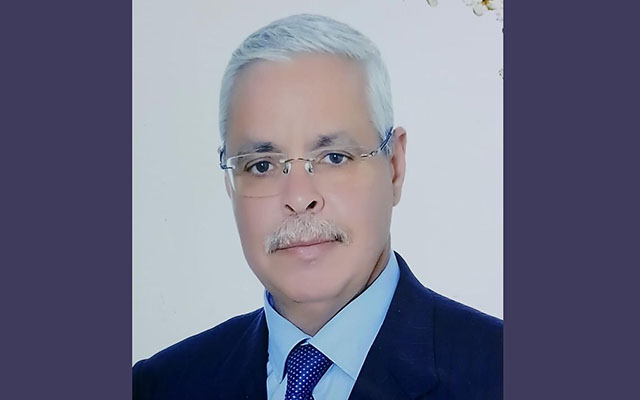لنتأمل الأرقام التالية:
سكان بلدية الدار البيضاء: 3.332.860 نسمة
الكتلة الناخبة: مليونا (2) ناخب
مقاعد المقاطعات 16 بالبلدية: 443 مقعدا
مقاعد مجلس المدينة: 147 مقعدا
الأحزاب المتنافسة: 26 حزبا
المصوتون بالبيضاء في اقتراع 4 شتنبر 2015: 367.534 ناخبا
النسبة العامة للذين صوتوا (لم نحتسب الملغاة): 18.37 في المائة
عمدة الدار البيضاء: عبد العزيز عماري
الحزب: العدالة والتنمية
الأصوات التي حصلت عليها لائحة العمدة: 7121 صوتا
نسبة الأصوات التي حازها العمدة قياسا إلى الكتلة الناخبة بالبيضاء : 0,3 في المائة
نسبة الأصوات التي حصل عليها عمدة الدار البيضاء قياسا إلى عدد السكان: 0.2 في المائة.
السؤال المقلق: هل يحق الحديث عن مشروعية انتخاب عمدة الدار البيضاء، وهو الذي لم يحصل سوى على 0.3 في المائة من أصوات الناخبين؟
أية مصداقية للعملية السياسية والرأي العام يواجه حالة مستفزة تتجلى في كون أكبر مدينة بالمغرب يسيرها عمدة لا يمثل سوى 0,2 في المائة من عدد السكان؟
صحيح، إن الأسئلة الحارقة ليست موجهة للعمدة كشخص، بل كمؤسسة، فصلها المشرع كي تبقى المدينة منفلته من المجتمع. ففي الولاية السابقة كان العمدة فاقدا للمشروعية لأن محمد ساجد صرح بعظمة لسانه أن وزير الداخلية في بداية تطبيق وحدة المدينة هو من أسقطه على الدار البيضاء رغم أنه لم يكن يمثل سوى ستة مقاعد من أصل 147. وفي الوقت الذي كان الرأي العام يتطلع إلى تقطيع انتخابي ونمط اقتراع يراعيان خصوصيات المدن الكبرى بالمغرب أصر المشرع على الإبقاء على نفس الآليات التي تصنع نخبا فاقدة للمشروعية ومحرومة من السند المجتمعي.
إذ من العار أن يكون عمدة الدار البيضاء الحائز على 0.3 في المائة من أصوات الناخبين آمرا بالصرف لميزانية 330 مليار سنتيم سنويا.. علما أن العمدة عبد العزيز عماري، هو وزير العلاقات مع البرلمان وهذه الوزارة لا تتعدى ميزانيتها ثلاثة ملايير سنتيم سنويا (30 مليون درهم)، أي أن الوزن المالي لعمدة الدار البيضاء يساوي 110 مرة الوزن المالي للوزير، لكن المفارقة أن العمدة الوزير يخصص 110 في المائة من وقته للوزارة وليس للعمودية. لكن إذا اضفنا الوكالات والمصالح ذات الامتياز التابعة لمدينة الدار البيضاء فإن المبلغ يصل إلى أرقام فلكية (مثلا رقم معاملات قطاع الماء والكهرباء الخاضع لسلطة الرئيس يصل إلى 6 ملايير درهم سنويا، وفي النقل الحضري يصل إلى 3 ملايير درهم سنويا، وهكذا دواليك في المرافق البلدية الأخرى من مجازر وتثليج وغيرهما).
ليس هذا فحسب، فعمدة الدار البيضاء هو رابع سلطة رئاسية على الموظفين بالمغرب. فإذا أسقطنا التعليم والجيش والبوليس، نجد أن رابع مرفق موظف بالمغرب في القطاع العام هو بلدية الدار البيضاء حوالي (16 ألف موظف بالبلدية زائد 5000 موظف بالمرافق ذات الامتياز).
هذا دون الحديث عن القروض التي تبرم باسم عمدة الدار البيضاء لتمويل المشاريع الضخمة المسطرة، وهي القروض التي تؤخذ إما من صندوق التجهيز الجماعي (FEC) أو من البنك الدولي (حسبنا هنا الاستشهاد فقط بالقرض المزمع أخذه باسم الدار البيضاء من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار (200 مليار سنتيم) بفائدة 1.2 في المائة لمدة 29 سنة).
أبعد كل هذا، هل يحق الإبقاء على نمط اقتراع «مخدوم» وتقطيع انتخابي «ملغوم» لاختيار العمدة لتسيير أكبر مدينة بالبلاد؟
قد ينهض قائل ليقول بأن العمدة لا يختار لذاته بل يختار لهيأته الحزبية؟ هذا قول حق يراد به باطل، لأن الدار البيضاء لا ينبغي التعامل معها كجماعة خميس متوح أو كهف النسور أو الطاح، حيث المداخيل السنوية لمثل هذه الجماعات لا تتعدى بضعة دراهم تستخلص من رسوم الحالة المدنية وساكنة لا تتعدى ساكنة عمارة ببوركون أو فرح السلام بالبيضاء.
فحتى باستحضار مجموع أصوات حزب العمدة عماري، نجد أن هذا الأخير لم يحصل سوى على 156.642 صوتا بكل احياء الدار البيضاء. أي أن حزب المصباح الذي «يحكم» في العاصمة الاقتصادية لم يظفر سوى بـ 8.24 في المائة من مجموع ناخبي المدينة. أما إذا اسقطنا عدد اصواته على مجموع سكان الدار البيضاء، فإننا نجده لا يمثل سوى 4,69 في المائة من المجموع العام للساكنة (انظر صفحة 8).
بل الأخطر من ذلك أن مجموع الأحزاب التي تنافست على مقاعد الدار البيضاء، وعددها 26 حزبا (انظر ص 6) لم تحصل مجتمعة سوى على 367.534 صوتا، وهو رقم جد هزيل بحكم أن 26 حزبا لا يمثل سوى 18.29 في المائة من مجموع ناخبي البيضاء (للتذكير المغني عبد العزيز ستاتي حشد لوحده في مهرجان سوق الغنم بسيدي البرنوصي ما يقرب من 250 ألف شخص في ليلة واحدة حجوا بطواعية من مختلف الأحياء البيضاوية.)
إن الحاجة أضحت ملحة اليوم كي تعكف أطراف الحقل السياسي مجتمعة (وبهدوء) على مراجعة مسارب اختيار النخب السياسية التي تتولى تسيير الشأن العام بالمدن الكبرى (أو على الأقل البدء بالدار البيضاء) لتكون للعمدة المشروعية المجتمعية ولتكون قراراته ترجمة لتطلعات أوسع فئة من سكان المدينة.
ولتحقيق ذلك لابد من أن يكون انتخاب عمدة الدار البيضاء بالاقتراع العام المباشر بكل أحياء المدينة. فطبيعة قانون الجماعات المحلية بالمغرب تجعل نظامنا الجماعي نظاما رئاسيا بقوة الممارسة والاختصاص. فلماذا لا نعلنها صراحة ليكون انتخاب عمدة الدار البيضاء اختيارا حرا وفي دائرة واحدة تمثل المدينة ككل؟
ولي اليقين أننا لو اعتمدنا ثورة في أنماط الاقتراع وفي التقطيع سنصل بالتأكيد إلى فتح شهية الناخبين، وآنذاك سنصل إلى نسبة 60 أو 70 في المائة من المصوتين بمدينة الدار البيضاء، وليس 18 في المائة كما هو الحال اليوم، وسيكون العمدة المنتخب (أيا كان لونه السياسي) مسنودا بـ 600 ألف أو 700 ألف صوت وليس بـ 7100 صوت؟
أمام المسؤولين ست سنوات للتفكير بشكل هادئ في أحسن السبل لضمان مشروعية النخب السياسية وإرجاع التوهج للعملية الانتخابية وإرجاع المصداقية للحكم المحلي. وإن لم يتحقق ذلك فالمؤكد أن الانتخابات «المخدومة» ستبقى لازمة، بل ولعنة تطارد المسلسل السياسي بالمغرب.
أيحق لمسؤول حصل على 0.05 في المائة من مجموع سكان المدينة أن يسمح للدولة بأن «تمطرقنا» بالمشروعية الديمقراطية؟
يظهر الجدول رقم أن الأحزاب الثمانية التي تسير شؤون الدار البيضاء لم تحصل مجتمعة سوى على 17.31 في المائة من مجموع أصوات الناخبين. فهذه الأحزاب التي تقرر في القضايا المصيرية لمدينة يتجاوز سكانها 3 ملايين و300 ألف نسمة لم يصوت عليها مجتمعة سوى 346912 مواطن. أي أن كل مقعد من مقاعد «الحكم المحلي» (وعددها 443 مقعد بمقاطعات البيضاء) تطلب فقط 783 صوت ليصبح المرء هو «الآمر والناهي» في ميتروبول كبير ويصبح هو «صاحب الكلمة الأولى» في مآل ومصير الملايير من الدراهم ويقرر في المخططات الخاصة بالتعمير والتهيئة والمشاريع المديرية المختلفة.
وهذا ما يزكي المطلب الذي ترفعه العديد من الفعاليات بوجوب إعادة النظر في نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي لكي يتم إفراز منتخبين ذوو مشروعية مجتمعية تسمح بأن تكون للسياسة العمومية المحلية انعكاس لتطلعات أوسع فئة من السكان، وليست ترجمة لفئة قليلة جدا.
ليس هذا فحسب، فنمط الاقتراع «المخدوم» يعطينا مشاهد سوريالية في «الديمقراطية المحلية».
خذوا مثلا حزب العدالة والتنمية الذي لم يحصل سوى على 8 في المائة من الأصوات بالدار البيضاء (تحديدا 7.83 في المائة) لكن ذلك مكنه من حيازة 51 في المائة من مجموع مقاعد الدار البيضاء. إذ ظفر بـ226 مقعد من أصل 443 صوتا.
بمعنى أن الأصوات كلها التي حصل عليها حزب «المصباح» بالبيضاء (156642) سمحت له بأن ينتزع مقعدا بمعدل ضعيف جدا من الأصوات، ألا وهو 693 صوت لكل مقعد.
هنا السؤال الحارق؟ من هو الأكثر تمثيلية للسكان: هل سانديك عمارة كبيرة (مثلا نورماندي + إقامة خريبكة + إقامة «طيطانيك» بحي الأزهر + مرجانة بكاليفورنيا إلخ...) صوتت عليه 1300 أو 1800 قاطن بالعمارة أم منتخب يجلس على «عرش الدار البيضاء» مقابل 693 صوتا؟
أما إذا استرسلنا في استنطاق الأرقام فسنصدم بمفاجآت أخرى. مثلا حزب التقدم والاشتراكية الذي لم يحصل سوى على 14.495 صوت بالدار البيضاء (أي 0.7 في المائة من المجموع العام) إلا أنه ظفر ليس فقط بـ11 مقعدا (2.4 في المائة من مجموع المقاعد بالمقاطعات)، بل وأصبح الحزب ممثلا في المكتب المسير لبلدية الدار البيضاء، ومن يدري فغدا أو بعد غد قد يفوض له العمدة قطاعا ما ليسيره ويشرف عليه.
ومما يبرز ملحاحية إصلاح ميكانيزمات اختيار النخب المحلية أن ممثل حزب التقدم والاشتراكية بالمكتب المسير، لم تحصل لائحته سوى على 1827 صوتا، أي 0.09 في المائة من مجموع الناخبين و0.05 في المائة من مجموع سكان الدار البيضاء.
بالله عليكم أيحق لمسؤول حصل على 0.05 في المائة من مجموع سكان المدينة أن يسمح للدولة بأن «تمطرقنا» بالمشروعية الديمقراطية؟
فالدار البيضاء قد تقترض غدا مبلغ 3 أو 4 ملايير درهم لرهن سكان المدينة لعقود طويلة، مثلما اقترضت أمس مبلغ 70 مليار سنتيم من بنك «بلباو» الإسباني لبناء المجازر البلدية، يسدد سكان المدينة أقساطا بقيمة 5 مليار سنتيم سنويا إلى عام 2029 (الأقساط بدأت منذ عام 1998). علما أن القرض طلبته المدينة بمنتخبين حازوا على 0.5 و0.7 في المائة من الأصوات، وهاهي المجازر اليوم «يصوط فيها البرد» ولاتذبح فيها سوى يضع بقرات وبضع خرفان، وهي ذبيحة لا تستدعي ذاك الاستثمار الباهظ المنهك لجيوب البيضاويين.
فبأي حق سيقرر منتخبو الدار البيضاء غدا في مشاريع بالملايير دون استفتاء محلي أو دون فتح قنوات موسعة للحوار والنقاش لضمان المشروعية لهذا الورش أوذاك؟
إن الدولة وهي التي ترفض مراجعة مسارب إنتاج النخب المحلية، عليها، على الأقل، تدارك الأمر بإخراج النصوص حول مشاركة الجمعيات في مراقبة المجالس المحلية وتضمينها بعض الكوابح لترشيد «الديمقراطية المحلية».
من أجل تصور جديد لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
لقد أفرزت التجربة العملية للانتخابات الأخيرة لأعضاء مجالس الجماعات الترابية، العديد من الاختلالات البنيوية، مما يستدعي إيجاد حلول لها وإعطاء مدلول حقيقي للتمثيلية والشرعية الديمقراطية لهذه المجالس.
بالنسبة لمجالس الجماعات والجهات: طرحت انتخابات هذه المجالس عدة اشكاليات: أولا: إشكالية نمط الاقتراع المعتمد، وهو الاقتراع باللائحة على أساس قاعدة أكبر بقية،الذي له بعض الإيجابيات خاصة منها ضمان تمثيلية الأقلية داخل المجالس، إلا أن له في المقابل الكثير من السلبيات، من بين أهمها أنه يعطي الامتياز للوائح التي تحصل على عدد أقل من الأصوات على حساب اللوائح التي تحصل على عدد كبير من الأصوات، مما يؤدي إلى تشتت المقاعد ولايساعد على إبراز أغلبيات واضحة إلا في حالات نادرة جدا. إن هذا النمط يعتبر من بين أكبر المعيقات التي تحول دون بروز أغلبيات واضحة لتسيير المجالس، مما تكون له تبعات أخرى تؤثر على حكامة التدبير داخلها.
ونعتقد أن الفاعلين السياسيين اليوم في المغرب يجب أن يفتحوا نقاشا حول مدى فعالية هذا النمط والتفكير بجدية في اعتماد نمط الاقتراع باللائحة على أساس قاعدة أقوى معدل،لأنه هو الكفيل وحده بضمان توفر المجالس على أغلبيات واضحة.
ثانيا: إشكالية العتبة المعتمدة في الحصول على العضوية داخل المجالس، بحيث أنه وطبقا للقوانين التنظيمية للجماعات والجهات، لا يشارك في عملية توزيع المقاعد إلا لوائح الترشيح التي حصلت على أكثر من 6 % من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية. إن هذه النسبة لا تحل الإشكالية المتمثلة في أن بعض اللوائح التي تحصل على عدد محدود من المقاعد يمكن أن تتمكن من خلال التحالفات أن يحصل وكيلها على منصب الرئاسة مثلا، وذلك في اتجاه مناقض لإرادة الناخبين. وأعتقد أن الحل لهذه الإشكالية هو الرفع من هذه النسبة إلى 10 % على الأقل.
ثالثا: إشكالية حصر الترشيح للرئاسة في رأس اللوائح الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجماعة أو مجلس الجهة، وهو عدد كبير جدا يخل في واقع الأمر بأسس العملية الديمقراطية بحيث أنه يمكن لرأس لائحة حصلت لائحته على عدد قليل من المقاعد أن ينافس على الرئاسة، أمام مترشح آخر فاز بعدد كبير من المقاعد. وأعتقد أن الحل لهذه الإشكالية هو حصر المنافسة في اللائحتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من المقاعد فقط، لإعطاء العملية الانتخابية واختيار الناخبين مدلوله الحقيقي.
بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم: إن نمط الاقتراع غير المباشر المعتمد في انتخاب هذه المجالس والطريقة التي يمر بها الانتخاب والنتائج المحصل عليها والتي تناقض في الغالب نتائج الانتخابات الجماعية داخل العمالة أو الإقليم، كل ذلك يؤثر بشكل سلبي جدا على صورة هذه المؤسسات ويمس في الصميم مشروعيتها الديمقراطية.
وأعتقد أن الحل هو: إما اعتماد نمط انتخاب مباشر لهذه المؤسسات خاصة وأنها أصبحت تتوفر على إطار قانوني متقدم نسبيا، ولعل تجربة تنظيم الانتخاب المباشر لأعضاء المجالس الجهوية يمكن أن تشجع على ذلك، أي تنظيم انتخاب الجماعات الترابية الثلاث بشكل مباشر وبنفس الطريقة.
وإما اعتماد أسلوب جديد في الانتخاب بحيث تكون هذه المجالس تمثل جميع الجماعات داخل العمالة أو الإقليم من خلال انتخاب ممثلين لها داخل هذه المجالس (واحد أو إثنين أو ثلاثة حسب عدد المنتخبين) وفي هذه الحالة ستلعب دورا أساسيا في التنمية البين جماعية التي تحتاجها الجماعات الترابية.
عدنان الزروقي إطار و وباحث في الجماعات الترابية
كيف حول بنكيران توسيع المدار الحضري للبيضاء إلى غنيمة انتخابية
يظهر الجدول قساوة النظام الانتخابي بالمغرب إذ أن حزب العدالة والتنمية رغم أنه لم يحصل سوى على 7.83 في المائة من أصوات الناخبين بالدار البيضاء إلا أنه تمكن من حيازة حوالي 52 في المائة من المقاعد، وبالتالي الهيمنة على القرار المحلي سواء داخل المقاطعات أو داخل مجلس المدينة.
وإذا قارنا أصوات حزب المصباح بين انتخابات 2009 وانتخابات 2015 سنجد أن أتباع عبد الإلاه بنكيران كانوا أكبر مستفيد من توسيع المدار الحضري للدار البيضاء (توسع إلى حدود المدار الجنوبي). فالجدول يكشف أن أكبر نسبة من الأصوات حصل عليها حزب العدالة في مقاطعات الحي الحسني وعين الشق وسيدي مومن، وهي مقاطعات كانت أكبر المجالات التي عرفت إدخال العديد من الجيوب الصفيحية والهشة بلغت في المجموع حوالي 15 كيلومتر مربع (ما يوازي 1500 هكتار، أي أضيفت حوالي 9 في المائة من المساحة المعمرة بالدار البيضاء).
ويظهر ذلك جليا في مقاطعات الحي الحسني وعين الشق التي حصل فيها «المصباح» على 18166 صوت و19964 صوتا على التوالي. فالحي الحسني عرفت إدماج دواوير لوزازنة ومرسيديس وحمارة ولقلالشة وغيرها من التجمعات السكنية الهائلة، فيما عرفت عين الشق إدماج دوار التقلية (أوطوروت المدار الجنوبي قسمت دوار التقلية إلى شطرين: شطر جنوبي تابع لإقليم مديونة وشطر شمالي تابع لعمالة عين الشق) علما أن دوار التقلية يعد أحد أهم الدواوير انتفاخا من الناحية الديمغرافية. وهذا الشطر من الدوار التابع لعين الشق يضم لوحده حوالي 50 ألف نسمة..
أما في سيدي مومن، فالسبب يعود ليس لإدماج دواوير وتجمعات هشة، بل لخطأ استراتيجي ارتكبه حزب البام بتركيزه على تقديم الخدمات لساكنة سيدي مومن القديم والدواوير المجاورة له، في حين تم إهمال مطالب ساكنة المجمعات الضخمة من قبيل سكان «أناسي والأزهر ومدينتي وسكني إلخ..» مما جعل عددا من قاطني هذه الأحياء يمنحون أصواتهم للعدالة أو للأحرار.
وحدها سيدي عثمان التي فلتت من «غزو» حزب المصباح، إذ رغم أن مقاطعة سيدي عثمان عرفت هي الأخرى ضم العديد من التجمعات العشوائية إلى ترابها بعد توسيع المدار الحضري (خاصة دوار الشيشان الذي لوحده يضم حوالي 40 ألف نسمة)، فإن قوة النسيج المجتمعي الذي سبق ونسجه البرلماني محمد حدادي (حزب التجمع الوطني للأحرار) حينما كان رئيسا للمقاطعة في الولاية الجماعية السابقة مكنه من تحصين قلعته الانتخابية ضد أتباع بنكيران.
خارج هذه المقاطعات، فإن حزب العدالة والتنمية حصل على أرقام متواضعة في باقي المقاطعات أو حافظ على نفس الزخم الذي كان يتمتع به (مثلا سيدي بليوط والمعاريف بالنظر إلى أن أهم عمالة كان للمصباح حضورا قويا فيها هي عمالة أنفا منذ انتخابات 2003 إلى اليوم).
لنأخذ مثلا مقاطعة بنمسيك، فهذه الأخيرة تكاد تكون محفظة باسم «محمد جودار» (عن حزب الاتحاد الدستوري). إذ لم يقو حزب العدالة على هزم جودار في هذه المقاطعة بالرغم من كل التحركات التي قام بها «المصباح» على امتداد 10 أعوام.
صحيح أن محمد جودار استغل قربه من محمد ساجد (العمدة السابق) وقام بتحويل معظم اعتمادات الدارالبيضاء لمقاطعة بنمسيك على حساب الأحياء البيضاوية الأخرى (تزفيت + ملاعب + منح الجمعيات + حدائق + مرافق القرب...). صحيح أن محمد جودار وظف كل أسلحته الجمعوية لنصب «القبة الحديدية» القادرة على صد كل «صواريخ» الأصوليين بمقاطعة بن مسيك.
لكن الصحيح أيضا أن «السلاح الفتاك» الذي سبق واستعمله جودار ضد الأصوليين لما كان هو «الحاكم بأمره» في عهد ساجد، قد ينقلب عليه في عهد «البيجيدي» الذي قد ينتقم من محمد جودار و«يسد» عليه «روبيني» الموارد المالية والصفقات بالدار البيضاء حتى يتم تجفيف منابعه. وهنا من المحتمل جدا أن يتحالف محمد حدادي النائب الثالث للعمدة مع مطلب «البيجيدي» بحكم أن حدادي (الأحرار) عانى كثيرا من تهميش سيدي عثمان (في عهد محمد ساجد) على حساب «إغداق» المال والمشاريع على محمد جودار في مقاطعة بنمسيك المجاورة لتراب نفوذ قلعته الانتخابية.
680 درهما كلفة الصوت الواحد بالبيضاء، مقابل 18 درهم بالمغرب!
رصدت الدولة لاقتراع 4 شتنبر 2015 حوالي 53 مليار سنتيم، خصص منها حوالي 25 مليار سنتيم للدار البيضاء (250 مليون درهم).
لكن هزالة النتائج المحصل عليها والنسبة العامة للمصوتين من مجموع الكتلة الناخبة تفيد أن الصوت الواحد (الأصوات المعبر عنها طبعا) كلف خزينة الدولة حوالي 680.2 درهم. فيما بلغ المعدل الوطني للصوت الواحد بباقي مدن وقرى المملكة حوالي 18 درهما، وذلك راجع للتدني الكارثي لنسبة المشاركة في اقتراع 4 شتنبر 2015 بمدينة الدار البيضاء مقارنة مع، ليس مع باقي تراب البلاد، بل ومع تراب جهة الدار البيضاء سطات.
بمعنى أن تعبئة مصوت واحد بالدار البيضاء يعد عملا منهكا للخزينة العامة مقارنة مع باقي مناطق المغرب، حيث بلغت الكلفة بالبيضاء 37 مرة. أي أن الكلفة المالية لتعبئة 37 ناخبا بالمغرب (حضري وقروي) كلفت الدولة تعبئة ناخب واحد فقط بالدار البيضاء.
اقتراع 4 شتنبر 2015 أظهر أن حزب «البام» كان يحكم البيضاء ونواحيها بدون جسور مع المجتمع
كل المناصب القيادية كانت بحوزة «البام» بالدار البيضاء في الولاية الجماعية السابقة. فخمسة من أصل عشرة نواب لعمدة البيضاء كانوا من البام. ومنصب رئيس مجلس العمالة كان من حزب «البام» ومكاتب المقاطعات كلها كانت تحت إمرة «البام» (باستثناء مقاطعة سيدي مومن التي كانت تحت رئاسة البام مباشرة). أما إذا وسعنا الدائرة بالجهة، فسنجد أن المحمدية كانت تحت إبط «البام» وسيدي موسى برئاسة البام، والشلالات خضعت لرئيس من البام، وعين حرودة كانت تستظل بمظلة البام، ودار بوعزة كان يحكمها «البام» وأولاد عزوز لا تدين بالولاء إلا لحزب البام والمجاطية حكمها البام وسيدي حجاج خضعت لسيطرة البام وبوسكورة لم تسلم من حكم البام وتيط مليل بدورها كانت تحت قبضة البام، أي أن كل الطبقات الإدارية التي أحدثها المشرع لتسيير جهة الدار البيضاء كانت من نصيب «البام».
ومعنى ذلك في الدول المتمدنة أن حزبا يسير كل هذا العدد من الجماعات المحلية بميتروبول واحدة أنه ذو قاعدة شعبية واسعة وذو كتلة انتخابية وازنة.
للأسف اقتراع 4 شتنبر 2015 أظهر أن حزب «البام» كان يحكم الدارالبيضاء ونواحيها بدون جسور مع المجتمع. بدليل أنه لم يحصل سوى على 39794 صوتا من أصل 2 مليون ناخب تقريبا، اي أنه لا يمثل سوى 1.9 في المائة من الناخبين (ولا يمثل سوى 1.1 في المائة من سكان العاصمة الاقتصادية).
وهذا واقع يقتضي من الباحثين في الكليات أن يسلطوا كشافات ضوءهم عليهم لمعرفة الأسباب: كيف لحزب «البام» توفرت له كل الموارد الدستورية والقانونية والمالية والرمزية طوال ولاية جماعية بمدينة ونواحيها لم يتمكن من توسيع قاعدته الجماهيرية ويستقطب الناخبين بالدار البيضاء؟ كيف يتم تفسير أن حزب ربط مشروعه الوجودي بمحاربة «المصباح»، وبدل أن يتمطط عرف تقزما خطيرا؟
هل الأمر يرتبط بكون منتخبي «البام» ومسؤوليه المحليين بالدار البيضاء كانوا في «الأبراج العاجية» و«الصالونات المخملية» بدل أن يعيشوا في أوحال المجتمع ويلتصقوا بالمواطنين؟ أم يعود إلى استهتارهم بالمسؤوليات التي أنيطت بهم ولم يوظفوا مناصبهم لتلبية رغبات وتطلعات السكان؟
لنترك هذه الأسئلة للجامعيين، وتعالوا نحلل ما حصل عليه «البام» في اقتراع 4 شتنبر 2015 بالبيضاء. فرغم أنه لا يمثل سوى 1.9 في المائة من أصوات الناخبين إلا أنه حاز على 10.6 في المائة من المقاعد بالمقاطعات (47 مقعدا)، بمعدل 846 صوت لكل مقعد (معدل مشروعية مقاعد البيضاء هي 4514 صوت لكل مقعد). علما أن تمثيلية «البام» تنعدم في مقاطعات بالدارالبيضاء (سباتة - الفداء - بنمسيك وعين الشق) أي أن «البام» لا يتوفر على أي منتخب أو «مسمار جحا» وسط حوض بشري يضم 802.214 نسمة. إلا أن ذلك لا يعني أنه ممثل بشكل جيد في باقي المقاطعات. فإذا أسقطنا سيدي مومن وعين السبع والحي الحسني التي تمكنه مقاعده من حضور نسبي فيها، فإن باقي المقاطعات لا يتوفر فيها سوى على 1 أو2 أو 3 مقاعد، وهي نسبة جد ضعيفة لا تسمح بأن يكون قوة مضادة للخصم الوجودي له، ألا وهو حزب العدالة والتنمية.
لخضر حمداني عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء (عن حزب المصباح)
النظام الانتخابي اللائحي فيه اغتيال لشرعية صناديق الاقتراع

مبدئيا تجب الإشارة إلى أن النموذج المغربي الحالي يتطابق والنموذج الفرنسي في بعض عمومياته باعتبار تشابه نمط الاقتراع اللائحي للمدن الكبرى مثل باريس، والتي تتشكل من مقاطعات مضاف إليها مجلس مدينة باريس، وبالتالي فأوجه التشابه في نمط الاقتراع كبيرة وليست مختلفة كما جاء في الاستنتاج الأول المقدم في إطار تصدير المناقشة.
بخصوص نمط الاقتراع الحالي أعتقد أن حزب العدالة والتنمية يسجل له كحزب بأنه لربما الوحيد الذي تفاعل إيجابيا مع المقترح الأولي لوزارة الداخلية، والذي كان يروم تجميع المقاطعات 16 في 8 مقاطعات مع تقليص لعدد مستشاريه وذلك من أجل منح نظام المقاطعات دورا أكثر إيجابية من الدور الحالي الممنوح لها في إطار القانون التنظيمي لـ 113-14. الإشكالية برأيي المتواضع تكمن في أن النظام الانتخابي يسمح بتولي رئاسة المجالس الجماعية الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة للوائح الخمسة المرتبة تباعا وهذا فيه اغتيال لشرعية صناديق الاقتراع الذي يعبر عنه الرأي العام، فكان من المنطقي احترام هذه الإرادة وتطبيق المقتضى الدستوري على النظام الانتخابي الجماعي بإسناد الرئاسة للهيئة السياسية التي تحصل على أكبر عدد من المقاعد تماشيا مع المعمول به بالنسبة للشأن العام. بالنسبة لمشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي اعتقد أن الميكانيزمات حاليا متوفرة بالقانون التنظيمي ومجسدة نظاميا في إنشاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ولجان تقصي الحقائق والتي أشار إليها القانون التنظيمي، وكل هذه الوسائل تتيح إمكانية إشراك المجتمع المدني تأسيسا على المقتضى الدستوري الخاص بإمكانية إشراك المجتمع المدني في القوة الاقتراحية والقانونية بواسطة تقديم مقترحات قانون، وهذا هو الدور الذي يجب أن يعيد المجتمع المدني حاليا في تدبير الشأن المحلي.
أحمد حبشي الكاتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بالبيضاء
النظام الانتخابي وضرورة الإصلاح لإفراز نخب سياسية متحررة من التحكم

بعد كل انتخابات جماعية أو برلمانية تثار مسألة النظام الانتخابي وتداعياته على الخريطة السياسية وتطرح بحدة مدى صدقيته وديمقراطيته، وهو ما يدعو إلى القول إن الأمر يستحق أن يفتح في شأنه نقاش عام عميق وجدي، وذلك لأهميته بما أصبح يشكل مدخلا أساس لأي عملية إصلاح حقيقية لوسائل تدبير الشأن المحلي والسياسي ببلادنا.
وعلى الرغم من أنه عدل أكثر من مرة، فإن كل التعديلات تمت فقط لتحافظ على التوازنات وضمان الولاءات السياسية للدولة، فمنذ البداية بني على أساس تعميق التحكم وضبط الخارطة السياسية، وتشكيل نخبة سياسية غير مسنودة سياسيا ولا عمق اجتماعي لها، حتى تبقى هي نفسها عرضة للابتزاز والانسياق لرغبات المسؤولين ورهن إشارة مخططات الدولة وسياساتها العمومية .
وبالرجوع إلى تاريخ الانتخابات منذ 1960، يتضح أن كل المراحل التي مرت منها العمليات الانتخابية، اتسمت بهاجس الدولة العميقة في ضبط الخريطة والتضييق على الخصوم السياسيين، مع ما يصاحب ذلك من تزوير وتدخل مباشر في تغيير نتائج الاقتراع واختيار الأشخاص.
ولاشك أن كل متتبع للصراع السياسي ببلادنا منذ 1956، يهتدي إلى الأهمية القصوى التي أولتها الدولة لجهاز الإدارة الترابية، وكيف عملت لإخراجه من دائرة كل مراقبة وخولته كل الصلاحيات ووفرت له الإمكانيات المادية واللوجستيكية لإحكام الضبط، والحد من كل ما من شأنه أن يجعل الحياة السياسية تنفلت من المراقبة الدائمة والتحكم المطلق. فكان ما كان من خلق أحزاب على المقاس وتفريخ الجمعيات كروافد لتزويد هذه الأحزاب بالأطر وتعبئة الأنصار والمساندين، مع اعتماد كل الوسائل لتأمين الولاء للدولة وحدها والخضوع لاختياراتها.
والكل عاين ويعاين أن عملية إعادة التقطيع الانتخابي وتشكيل الدوائر الانتخابية يتم اللجوء إليها، في كل انتخابات جماعية تقريبا، كلما اتضح للدولة أن المجال أصبح يتسع لتجاوز مخططاتها في الضبط والتدبير السياسي.
فمنذ الاستقلال وإلى حدود الانتخابات الأخيرة، ظلت البادية والعالم القروي يلعبان دورا أساسيا في تكريس التوازنات التي تحتاج إليها الدولة، ويمد السلطة الإدارية بالنخب الموالية والقابلة للتفاعل مع كل أشكال التحكم. فالدوائر توزع حسب الحاجة، وتوضع رهن إشارة الأنصار الأكثر ولاء بغض النظر عن القدرة والكفاءة.
وما لاحظه الجميع في الانتخابات الأخيرة لمجلس المستشارين، بغض النظر عما يمكن أن يقال عن هذه الغرفة ومشروعية وجودها، كيف أن المقعد البرلماني بهذه المؤسسة فوت في بعض الجهات بخمسة عشر صوتا، في حين كان في جهات أخرى تم الحسم فيها بأكثر من ذلك بكثير، نفس الأمر حصل في انتخابات رآسة الجماعات أو الجهات، فالأرقام صادمة في هذا المجال، ولا تعكس التمثيلية الحقيقية للسكان في تدبير السلطة المحلية، وهو ما يجعلنا نؤكد على ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي، والدعوة إلى البحث عن وسيلة متوازنة لتحقيق التمثيلية الحقيقية للساكنة وتعكس الإرادة الفعلية للمواطنين وتطلعاتهم، وقد سبق مرارا وان تمت الدعوة إلى اعتماد نظام الدورتين، وفسح المجال للمنافسة السياسية، وتقوية موقع السلطة السياسية بما يمكنها من حماية اختياراتها وتطبيق برامجها ومشاريعها محليا ووطنيا. ولعل اعتماد نظام انتخابي على قاعدة دورتين قد يساعد على الرفع من الأداء السياسي للأحزاب، ويعطي للتحالفات معنى ودلالات اجتماعية وسياسية، ويخرج السلطة السياسية من جبة السلطة الإدارية، وينهي مع التحكم واستعمال الأحزاب في تشديد الخناق على بعضها البعض، وذلك بارتباط شديد مع تعميق الإصلاح السياسي والفصل الفعلي والعملي للسلط واحترام الاختصاصات، مع ربط المحاسبة بالمسؤولية، فتكون بداية النهاية مع كل المهازل الانتخابية التي عشناها حتى اليوم.
محمد الوافي نقابي قيادي بالاتحاد المغربي للشغل رئيس جمعية الشبيبة العاملة المغربية
في الحاجة إلى القطع مع نخب خبرت كيف تؤكل أكتاف المدن

نعرف جميعا أو نحتفظ في ذاكراتنا بصور شخصيات كاريزمية لعمداء مدن يحظون باحترام شرائح واسعة من سكان بعض المدن الكبرى في بلدان الغرب. صور عن عمدة لندن أو نيويورك أو بولون وغيرهم من المدن. وموضوع الاحترام هو ما يثير انتباهي أكثر، قبل الحديث عن نسبة الأصوات التي حصلوا عليها، وهو المعطى الذي لا يتوفر للجميع، بل يتطلب سيرة سياسية مبنية على تاريخ. وهو ما يذهب في نفس روح أرضية جريدة «الوطن الآن» التي تتحدث عن مشروعية عمدة مدينة كالدار البيضاء، قبل طرح موضوع القانونية أو الشرعية.
كما أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية في العديد من البلدان المتقدمة تعرف نسبة أكبر من نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، بالنظر لمعطى القرب، وتغليب مواطني البلدان الديمقراطية لمعطى البراغماتية، لأن المواطنين يسائلون السياسات البلدية في مجالات تهم حياتهم اليومية المباشرة، بل ويشاركون في سنها ومراقبة تنفيذها من حيث الإجراءات التي تهم البيئة والنقل والصحة العمومية والتعليم والترفيه وغيرها من المظاهر التي تنعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين، وهو ما يفسر إلى حد ما انتخاب عمداء تقدميون أو من أحزاب الخضر، في ظل حكومات يمينية أحيانا.
شخصيا يؤسفني أن يكون من يخط سياسات مدينة كبرى، وبالتالي من له القرار الأكبر في صرف ميزانيات بملايير الدراهم، وصاحب القرار في تحريك عشرات آلاف الموظفين والمستخدمين والأطر، دون أن يحظى بدعمهم (حيث أن أغلبهم من سكان هذه المدينة، سواء شاركوا في الانتخابات وصوتوا ضد العمدة الحالي أم لم يشاركوا فيها، وبالتالي لم يصوتوا له). فالموضوع يطرح مشكل الأغلبية والأقلية بشكل درامي، يمزق كل الأسئلة الكلاسيكية حول مشروعية من يتخذ القرار بهذه الحاضرة الكبرى، ويضعنا أمام مفارقة غريبة. ونفس الأمر عشناه مع العمدة السابق للدار البيضاء، وفي باقي كبريات المدن المغربية.
ويعود أصل هذا المشهد التسييري عندنا، كما جاء ضمنيا في أرضية «الوطن الآن»، إلى نمط الإقتراع النسبي باللائحة. ورغم تحديد الحد الأدنى فيما يخص العتبة، فإن النتيجة هي هذا المشهد المتشرذم، بخلاف العواصم التي تخصص انتخابات بلدية خاصة بانتقاء عمدائها، أو التي تختار العمدة في اقتراع من دورتين تسمح باختيار عمدة لا يحصل على دعم أقل من %50 من الناخبين. بل أن بعض البلدان تخصص أنظمة انتخابية خاصة، ومعقدة أحيانا، للمدن الكبرى (فرنسا مثلا)، نظرا لثقلها الديموغرافي والسياسي والإقتصادي.
بالطبع لا يمكننا إلا أن نطالب بتغيير نمط الإقتراع بالمغرب، أو على الأقل بالنسبة للمدن الكبرى، في اتجاه انتخاب عمداء ومجالس محلية وترابية تحظى بدعم نسبة أكبر من السكان. ولا نكتفي بنخب برعت وخبرت كيف تؤكل أكتاف المدن ومواطنيها، خلال خمسة عشر يوما من الحملات الانتخابية، حيث يصير الحزب الذي لم يحصل سوى على أقل من 100 ألف صوت حاكما وآمرا بالصرف في مدينة كتلتها الناخبة أكبر بذلك بـ 25 مرة، وتوصد بعدها الأبواب في وجه المجتمع المدني «المشاكس» ومقابل فتحه في وجه مجتمع مدني مدلل توزع عليه المنح والتسهيلات طيلة ولاية طويلة تدوم 6 سنوات.
ملحوظة: لم تتوصل جمعية الشبيبة العاملة المغربية المؤسسة في 1957 بأية مساعدة من المدينة منذ أكثر من 10 سنوات خلت.
الحسين نصرالله عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال
نمط الاقتراع المعمول به الآن لا يساعد على قيام مؤسسات منتخبة قوية تسهل محاسبتها

لعل من أهم ما يُستخلص من تركيبة مجلس جماعة الدارالبيضاء التي أفرزتها انتخابات الرابع من شتنبر 2015، أن حصول حزب واحد على الأغلبية المطلقة لمجلس جماعي منتخب بنمط الاقتراع الحالي المعمول به في المدن الخاضعة لنظام وحدة المدينة أصبح في حكم الأسطورة.
فرغم هذا النّمط الذين كان يَرَى فيه البعض سبيلا للضبط المسبق للمجالس على الأقل ببلقنتها، حصل حزب العدالة والتنمية على أغلبيته المطلقة، دون الحاجة للتحالف مع أي حزب آخر. و َلَيْه، سقط عمليا من بين أيدي المدافعين عن هذا النمط، أحد أهم المبررات وإن كان مسكوتا عنه.
ولا أرى تبريرا للاستمرار على هذا النمط. إلا أنه يجب أن نتفق، وهذا ما تؤكده الدراسات المقارنة، على أن أنماط الاقتراع على تنوعها فهي تحمل إيجابيات وسلبيات، وبالتالي يمكن القول بأنه ليس هناك نمط اقتراع خال من العيوب، وأنه لابد من التمييز بين الاقتراع الذي له طابع وطني، والاقتراع الذي له طابع محلي. فعلى المستوى الوطني كالانتخابات التشريعية، يكون من المفيد الحفاظ على نمط الاقتراع الذي يحسب له من إيجابياته أنه يضمن لعدد محترم من التعبيرات السياسية في المجتمع أن تقدم وجهات نظر مختلفة في قضايا السياسة والاقتصاد والمجتمع، حتى لا تضطر هذه الأصوات إلى البحث عن فضاءات خارج المؤسسات للتعبير عن مواقفها، وهذا يساهم في الاستقرار بصفة عامة ويبني الثقة داخل النظام السياسي.
أما على المستوى المحلي، حيث لا تكون هناك رهانات تتعلق بالاستقرار والوحدة والوطنية، فإنني أعتقد شخصيا أن نمط الاقتراع يجب أن يعكس رأي الأغلبية المطلقة وليس الأغلبية النسبية، والحال أننا أدمنا نمط اقتراع لا يساعد عموما على تحديد المسؤوليات، فالمواطنون، وأمام التحالفات الجارية لتسيير عدد من المدن، يصعب عليهم مكافئة أو محاسبة من يدبرون الشأن العام المحلي.
بالعودة إلى سؤالك، أعتقد أن القياس على عمدة الدارالبيضاء بخصوص ضعف منسوب الشرعية، قياس مجانب للصواب لأن العمدة هو نتيجة مجموع مقاعد حصلت عليها الهيئة الحزبية التي ينتمي إليها، والذي يدبر شؤون البيضاويين اليوم هو حزب العدالة والتنمية وليس السيد عماري، وهذا ما اختاره البيضاويون اليوم. وربطا للمسؤولية بالمحاسبة لن يحاسب غدا السيد عماري وحده بل الحزب الذي ينتمي إليه.
لكن عموما و بكل وضوح نمط الاقتراع المعمول به الآن لا يساعد على قيام مؤسسات منتخبة قوية تسهل محاسبتها، وتكون لها المشروعية الشعبية الكافية لتدبير كل ما ذكرتم سواء على المستوى المالي أو البشري، لهذا كان هناك نقاش لم يستمر طويلا، ويتعلق بالانتخاب المباشر لرؤساء الجماعات، أو على الأقل نمط اقتراع مزدوج يسمح للناخبين من جهة اختيار عمدة المدينة، ومن جهة أخرى اختيار فريق عمل يرافقه طيلة الولاية الانتخابية، فبالنظر لاختصاصات رؤساء المجالس، يظهر أننا أمام نظام جماعي رئاسي، لكن نمط الاقتراع لا يواكب ذلك.. وهو ما يجب أن يكون موضوع مراجعة مستعجلة بالشكل الذي يحفظ للمؤسسات الجماعية المنتخبة مكانتها ضمن البناء المؤسساتي.
هذه الأسئلة تزداد حدة إذا استحضرنا أن المدينة لا تتوفر على ميكانيزم سياسي يسمح بإشراك المجتمع المدني؟ بالنظر إلى غياب قانون يضبط مشاركة الجمعيات وتحويلها إلى كوابح ضد استفراد حزب أو عمدة بالقرار ضد الأغلبية الساحقة من السكان؟
أعتقد بأن القرار يجب أن يبقى دائما بيد المؤسسات المنتخبة، وما يجب الحرص عليه هو أن تكون هذه المؤسسات نتيجة انتخابات شفافة ونزيهة تعتمد على نمط اقتراع عادل ومنصف، على أن يبقى للمجتمع المدني وللمواطنين عموما حق إبداء الرأي وتقديم مقترحات سواء في شكل عرائض أو ملتمسات، خاصة وأن دستور يوليوز 2011 نص على هذا الحق في الفصل 15، وقد جاءت الحكومة متأخرة -قبل أيام فقط - بمشروع قانون يحدد كيفيات ممارسة هذا الحق، وهو ما يعني تأخرا غير مفهوم و لا مقبول في تنزيل آلية أساسية لمشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، رغم ان هذا المقتضى الدستوري يعد أحد أهم المستجدات في ما يخص الحقوق والحريات.
عبد الغني المرحاني منتخب سابق، باحث في التنمية المجالية
أي نظام انتخابي سيبقى معطوبا ما لم يتم تطهير البيئة المغربية من كل مظاهر الفساد والإفساد
من نافلة القول إن العمليات الانتخابية التي تجرى في بلادنا تتم كالعادة على المقاس وبنوع من الذكاء الزائد أحيانا وبنوع من البساطة والسذاجة في أحايين كثيرة، إذ أصبحنا أمام ديمقراطية متفردة حق لها أن تحمل ماركة مسجلة أنتجت بالمغرب... واختيار ما يسمى بدعا بـ» النخبة السياسية» القادرة على تدبير الشأن المحلي والعام فيه كثير من المزايدات والمفارقات، لأنه اختيار غير علمي ولا دقيق ولا يستند على مناهج رصينة. وقد أثبتت استحقاقات 4 شتنبر 2015 هذه الوضعية المستهجنة، إذ أصبح المواطن البسيط الذي ترشح نضاليا لإكمال لائحة حزبه هنا وهناك بين عشية أو ضحاها منتخبا جماعيا، ولم يكن يمني نفسه بالنجاح ولو خلسة وفي خلوة من أمره، بسبب تسوناميات الاكتساح التي لم تخطر حتى على بال مهندسي الانتخابات الأخيرة، حيث أتت على الأخضر واليابس.. فأصبحنا أمام ممثل للساكنة من درجات متقدمة في الأمية السياسية، لا يعرف «خوعو من بوعو» في الحياة الجماعية التي يراد منها الإشراك والمشاركة تفعيلا لموضة المقاربة التشاركية التي هي إحدى عناصر الحكامة الجيدة.
فالاختيار يجب أن يشمل الجميع ولا يقصي أحدا، إذ الإقصاء في حق الكفاءات والطاقات والشرفاء المجربين يغذي نزوعات التطرف والغلو والكفر باللعبة السياسية السلمية التداولية، ويشكك في مقولة «المغرب للجميع، والجميع للمغرب»، ويرسم صورا قاتمة وآفاقا مسدودة أمام شريحة واسعة من المواطنين الذين ملوا وسئموا من التحكم والهيمنة وذاقوا مرارة سادية وتعسف من يوكل إليهم أمر الإشراف على الانتخابات.
وأصدقكم القول إن اعتماد هذا النمط من الاقتراع من دونه يبقى في البيئة المغربية اجتهادا ظرفيا ومسألة تقنية لا أكثر ولا أقل، ولا تقدم ولا تؤخر نهاية في النظام الانتخابي المغربي شيئا، وذلك لعدة اعتبارات، أولاها عزوف الناخبين بسبب نسبة المشاركة المحدودة والضعيفة في التصويت، ثانيها الارتباك الواضح والجلي في الإعداد لكل محطة انتخابية على جميع الأصعدة القانونية والتنظيمية والإدارية واللوجستية، إذ يصبح لدى صانعي القرار هاجس تمرير الانتخابات وتنظيمها هو الهم الشاغل الذي لا يعلو عليه شيء. وثالث الاعتبارات التمييز والاستثناء الذي تمارسه الحكومة في حق الأحزاب، إن على مستوى الدعم المالي» شي يأخذ الملايير أوشي ياخذ الفقايس»، أو على مستوى الدعاية الإعلامية، أو على المستوى التشريعي وبالتالي فالخريطة السياسية ترسم قبلا وسلفا، وبالتالي لا داعي من حرق أعصاب المناضلين، ولا إجهاد التفكير من أجل الجديد.
ويبقى أخطر الاعتبارات وصمة عار على جبين الديمقراطية المغربية، هو العجز البين عوره والواضح عرجه أمام مفسدي الانتخابات، إذ لا يعقل أن يصرفوا أرقاما فلكية من الأموال الحرام، ويستغلوا الإمكانات والمقدرات والوسائل العامة في حملات محمومة وموبوءة سابقة لأوانها، ولا من رقيب ولا حسيب... والمؤسف حقا أن تتم هذه الخروقات بـ«العلالي» وفي واضحة النهار، بل تقدم لها المسوغات والمبررات لشرعنتها من قبل الكثير ممن يفترض فيهم الحياد الإيجابي، وإبقاء نفس المسافة مع الجميع، وتطبيق القانون، وإعمال الشفافية، وربط المحاسبة بالمسؤولية.
ويزيد من قتامة الوضع الانتخابي ببلادنا التضييق من مساحات الشهود على عمليات التصويت من خلال إغراقها بالتعقيدات الإدارية والاجتهادات الرسمية والمعلنة في آخر ساعة، والتي بموجبها تحرم فئات عريضة من المغاربة من التصويت، وتحرم الأحزاب من ضمان نتائجها وصيانة شعبيتها وفعلها النضالي، فيصبح للصناديق رنينا مشتبه فيه وغير حقيقي.. بالجملة، إن أي نظام انتخابي سيبقى معلولا معطوبا ما لم يتم تنظيف وتطهير البيئة المغربية من كل مظاهر الفساد والإفساد، وسيبقى كذلك إذا ما نظر إليه نظرة ميكانيكية جوفاء لا دماء ساخنة تجري في عروقه..