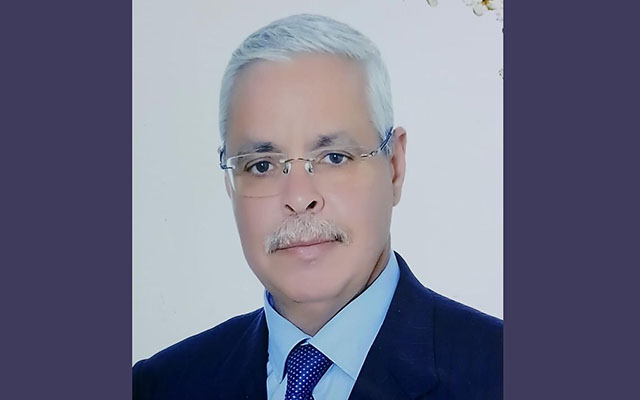ثمة لازمة تعود إلى الواجهة كلما نفّذ "داعش" عملية من النوع الذي يهزّ الوجدان الإسلامي ويكرّر حيرة المسلم بازاء دينه: إنها لازمة مناشدة الفقهاء بتطوير الدين، أو تجديده، أو إصلاحه، أو حتى أحياناً "تثويره"؛ كل بحسب درجة غضبه من "داعش"، أو اشمئزازه من بربريته، أو ارتباكه من كون أعماله نالت من صورة الدين.
أصحاب هذه اللازمة لا يرون، مثلاً، أن الفقيه، أو "رجل الدين"، لم يكن طوال العهد السابق على "داعش" سوى موظف براتب في "دولة"، تحكمها سلطة ناقصة الشرعية تتذاكي بالتلاعب على الدين، بمحاربته أمنياً، ودعمه أيديولوجيا... بحيث تحول الدين إلى مادة سياسية بامتياز، ليس بصفته مندمجا بالدنيا، إنما بصفته كنزاً سياسياً، تُغرف منه كل دعائم التسلّط والاستبداد. ذلك أن توحيد الدين بالدنيا، كما يدعي دعاة الإسلام السياسي والمنافقين السياسيين الحائمين حول خيراته... هذا التوحيد خدعة كبرى، يدرك القائمون على استمرارها كم تدرّ عليهم من خضوع وإذعان. ويعي أصحاب الفطنة من رجال الدين أن الدنيا والدين لم يتوحدا يوماً، إنما كان الدين على الدوام بخدمة الدنيا؛ وهذه الفطنة لا تنفعهم بشيء، إذ تبقى في سريرتهم.
ولكن بصرف النظر عن هذه العقبة المنيعة، كيف يمكن للفقهاء أن يغيروا تفسيرهم للدين، ليعطونا دينا بريئا من كل ما يدعيه "داعش"من حق في القتل والتدمير والتهجير والترويع؟ كيف يمكن لهم أن يجددوا، أن يصلحوا، كي لا نقول أن "يثوّروا"، فيما لم يتغير شيء في أوضاعهم، ولا نشأتهم ولا دراستهم ولا وظيفتهم ولا منهجهم ولا امتيازاتهم؟ باختصار، كيف يمكن لهم أن يغيروا خطابهم طالما أن "شروط إنتاج" هذا الخطاب بقيت على ما كانت قبل عهد "داعش"؟ هل يغيرون لمجرد أنهم تأثروا بمشاهد القتل؟ أم لأن هناك بضعة كتاب يناشدونهم بذلك؟ أم لأن الآمر المباشر على مستحقاتهم ضغطَ عليهم؟ وفي هذه الحالة، أصلا، لو افترضنا أنهم حساسون، عاطفيون، لا يقوون على الظلم والإجرام، ويرفعون محاربتهما إلى مرتبة الأولوية في صياغة رؤاهم... فبماذا يفلحون؟ تصبح قلوبهم أطيب؟ أو عقلهم أرقى؟ أو فضولهم العلمي أقوى من عقيدتهم التي صنعتهم؟ وإذا حصل أن تحوّلوا بين ليلة وضحاها إلى أحفاد ابن رشد، فمن أين يستمدون ذخيرتهم الفكرية؟ هل يعودون فيقرأون المتنورين في تراثهم؟ هل يحيون هذا التراث، والسلام...؟ وهل هذا المطلب إنساني بالأساس؟ أو واقعي؟ هل يكفي عمر واحد، جيل واحد، لاستكشاف متاهات هذه الورشة التاريخية؟ هل يتصور المنكبون على الفقهاء، المطالبون إياهم بتجديد الدين، بأن الطاقات الذهنية والفكرية لكل الفقهاء مجتمعين، أو منفردين، قادرة بين عملية لـ "داعش" وأخرى، أن تكون على مستوى الحدث الذي يهزهم قبل أن يهزنا؟
الفقهاء ليسوا سوى موظفين تحت جناح السلطان، الذي لا يختلف عن "الخليفة" الداعشي أبو بكر البغدادي إلا بأناقة قمعه واستبداده. الفقهاء هم مرآة لحضارتنا المابعد استقلالية. والمهمة التي يلقيها البعض على كاهلهم لا تستقيم مع قدراتهم وطبيعة علاقتهم بحكامهم ومحكوميهم. شروط اندراجهم في عملية الإصلاح المطلوبة منهم، معقدة وطويلة؛ ولكن أمام هذا الاندراج أمرين، يجدر بهم وبمشجعيهم أن يكونوا على بيّنة منهما: أولا، الفقهاء لا يتغيرون، ولن يتغيروا، من دون أن يتغير ما يحولهم وبداخلهم: المجتمع، وهذه كلمة كبيرة، غامضة، مضطربة، معالمها آخذة بالتشوه وربما الانمحاء. ولكنها أيضا كلمة تعنينا كلنا، فقهاء وعامة، تبدأ بيومياتنا، ولا تنتهي عند قضايانا "الكبرى". ثمة أمر غير التهجير القسري يجب أن يتغير في هذه المجتمعات. خيطه الأساسي في الثورات العربية، التي، وإن أجهضت، تبقى علامة إدراك وأمل فكري. والنقطة الأخرى تتعلق، في هذه الأثناء، بالسؤال عن أصحاب الأدوار في تجديد الدين أو إصلاحه: هل يبقى الفقهاء على احتكارهم للدين؟ هل يبقى الدين محروما من مجالات النشاط الذهني الإنساني الأخرى؟ هل يبقى عصيا على الفنانين والروائيين والمؤرخين وعلماء النفس والآثار والفلك والفضاء...؟ وغيرها وغيرها من فروع الإدراك البشري... تجد من بين المسلمين من تخصص به، ولكنه لا يحق له، لا سلطة له في تقاسم علمه مع علم فقهاء الدين، في تنسيق، أو تحاور رؤاهما، في التثاقف بين عالميهما، بحيث يخترعون جميعهم طريقتنا الخاصة في التعايش بين الدين والحرية، بين الدين والجمال، بين الدين والغبطة الروحية.
(عن جريدة "المدن" الإلكترونية اللبنانية)