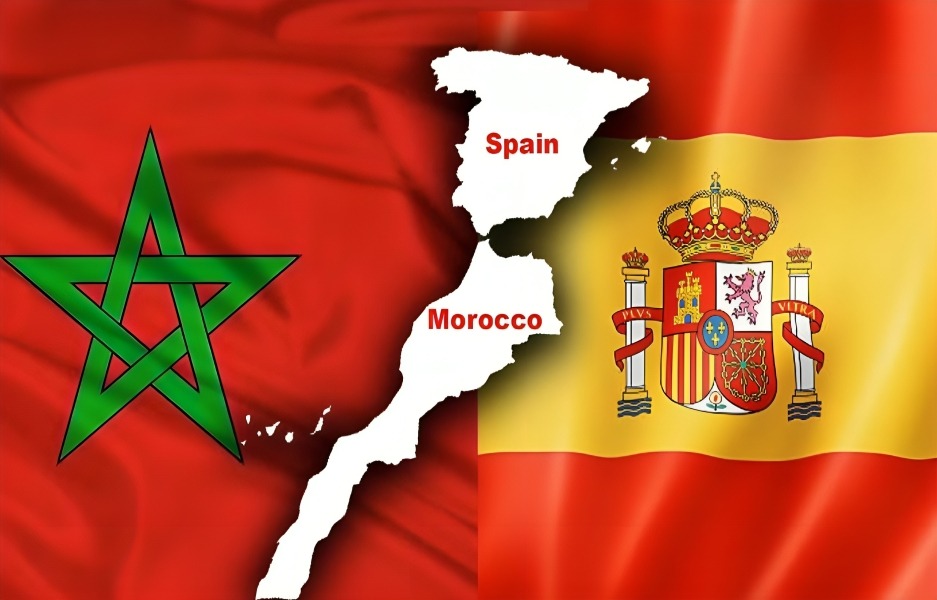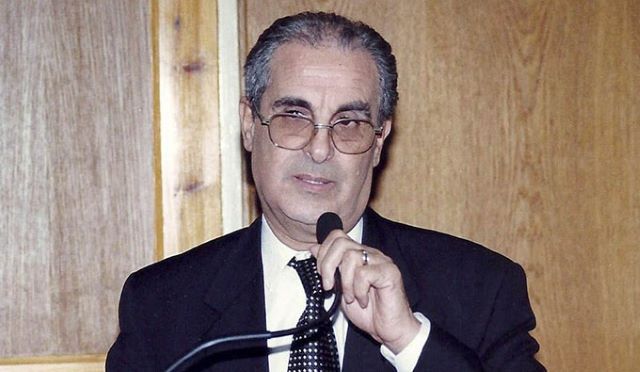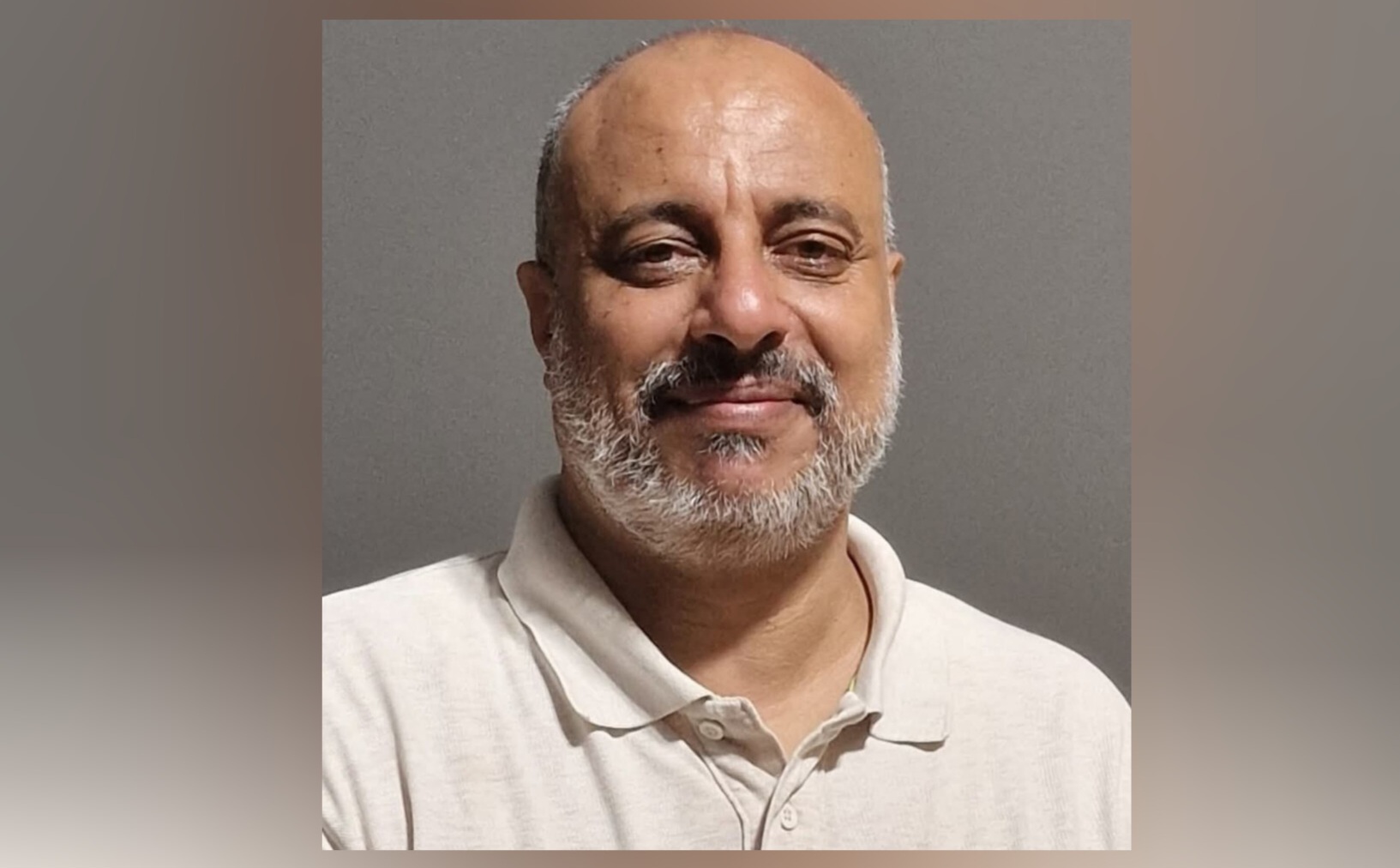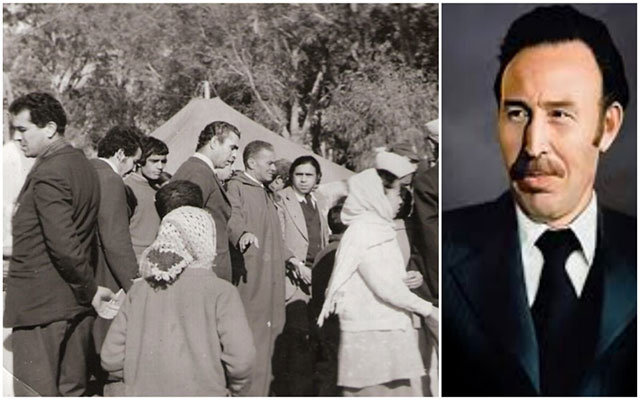يعيش المغاربة علاقة تاريخية وثقافية معقدة يطرحها جواره الصعب مع إسبانيا. فرغم المواجهات الحربية التي اندلعت بين الطرفين عبر القرون، ورغم تراكم العداء الذي استحكم في بينة العقل الاسباني إلى درجة تحول معها «المغربي» إلى «الخصم الموضوعي» للإسباني: وهذا ما يترجمه الإعلام الإسباني، بل ما تكشف عنه بوضوح الأحزاب والجمعيات الإسبانية، بل حتى الأبحاث الأكاديمية التي تتحول إلى منصات لإذكاء الخلاف وتعميق الهوة كلما تعلق الأمر بالعلاقة مع المغرب - نسجل مغربيا أن هناك انبهارا واسعا بكل ما يرتبط بالجارة الشمالية، سواء تعلق الأمر بكرة القدم أو الموسيقى أو اللغة أو حتى أنماط العيش اليومية، فضلا عن الممارسة الديمقراطية والنموذج التنموي. وينطبق هذا الأمر حتى على المؤسسات، حيث «يجتهد» المغاربة من أجل التعاون مع مدريد على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني. وهذا لا ضير فيه مبدئيا مع بلد تحكمنا معه علاقات الجوار.
مقابل هذا الانبهار، يواجه المغاربة في الضفة الأخرى نظرة استعلائية تختزلهم في وصف "المورو"، وهو وصف يعود إلى قرون من الصراع التاريخي ويستعاد بقوة في الإعلام والسياسة الإسبانية كلما اندلعت أزمة عابرة، كما تستعاد معه إرادة تمزيق الوحدة الترابية للمغرب، ومعاكسة طموحاته في تسوية نزاع الصحراء على أساس مقترح الحكم الذاتيـ بل يذهب بعض مسؤولي الأحزاب السياسية المتطرفة، يمينا ويسارا، إلى تصوير المغرب على أنه أرض الشرور ومنبت الكوارث وعش الظلم وموطن التخلف.
في المقاهي المغربية، وفي مختلف المدن، تكاد لا تجد من لا يتابع الدوري الإسباني، على سبيل المثال. مباريات ريال مدريد وبرشلونة تحولت إلى طقس جماعي يخلق انقسامات شبه هوياتية في الفضاء الواحد: هذا مدريدي وذاك برشلوني، كأن الأمر يتعلق بهويتين متقاتلتين. بل إن «الكلاسيكو» صار بمثابة عيد وطني غير معلن، تتوقف فيه أشغال وتتعالى فيه صيحات الفرح أو الخيبة ويعلو الحماس. ولهذا ترسخت في الذاكرة المغربية أسماء مثل ميسي ورونالدو وراؤول وإنييستا ويامال وبيدري وفينيسيوس ورافينيا.. إلخ، أكثر من أسماء لاعبين محليين صنعوا أمجاد الكرة الوطنية، أمثال فرس وسحيتة وبودربالة والظلمي والتيمومي وبصير وكاماتشو والنيبت وحجي.. إلخ. والمفارقة المؤلمة هو أن البطولة المغربية نفسها تفتقر إلى التسويق وإلى قوة الجذب، ما جعل الشاب المغربي يبحث عن انتماء رياضي في الخارج بدل أن يجد ما يغذيه في الداخل، علما أن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل سياسية وثقافة وقوة ناعمة تجسد الطريقة التي تقدم بها كل دولة نفسها على الساعة العالمية، كما صرح مؤخرا النجم الفرنسي السابق إيريك كونتونا.
هناك مستوى آخر في علاقتنا بإسبانيا ينبغي التوقف عنده مليا: اللغة. فالمغرب منذ عقود جعل الإسبانية لغة أجنبية ثانية في مناطق عدة، خصوصًا في الشمال والجنوب، وفتح الباب واسعا أمام معاهد «سرفانتس» التي صارت تعرف إقبالا لافتا، بل هناك شعب مستقلة في العديد من الثانويات والكليات تهم هذه اللغة. كما أخذ آلاف الشباب يتعلمونها بدافع الهجرة أو التجارة أو الدراسة، أو حتى بدافع الفضول الثقافي. كما أصبحت اللغة الإسبانية بالنسبة لكثيرين هي بوابة نحو العالم اللاتيني، وحلم الانتماء إلى فضاء أوسع من الجغرافيا المغربية.
وإذا كنا نفهم أن الانفتاح المغربي على إسبانيا يشكل جزءا من سياسة رسمية تراهن على الجوار والتبادل، وتعتبر أن معرفة لغة الجار ضرورة لا مناص منها، فإن ترك الحبل على الغارب لهذا الجوار والسماح له بالتهام الثقافة المغربية أمر يدعو إلى القلق، خاصة أن الطرف الإسباني لا يتعامل بالمثل. فإسبانيا التي تحتضن جالية مغربية تتجاوز المليون نسمة، لا تلتفت إلى الكرة المغربية، ولا تعترف بأنديتها العريقة إلا بوصفها مشاتل خلفية لتكوين اللاعبين، لأن ما يشد نظرها هو «الأندية الأوروبية» القوية والمتنافسة معها. كما أن إسبانيا لا تعترف باللغة العربية، ولا تفسح لها مكانا في برامجها التعليمية. بل إن حزب «فوكس» اليميني المتطرف نجح، مؤخرا، في الدفع نحو إلغاء حصص تعليم العربية في بعض المدارس الإسبانية، وذلك بمبررات إيديولوجية تعتبر أن هذه اللغة العربية تهدد الهوية الإسبانية، وتشجع الإسلام المتطرف على قضم مساحات إضافية من السلم الوطني الإسباني.
إن هذا السلوك يعكس بوضوح تام خوفًا عميقًا من الآخر، ورغبة في إنكار حضوره الثقافي والتاريخي، كما يعكس في الوجه الآخر منه إحساسا بالعظمة والتفوق، مما يوضح أن التبادل الرياضي والثقافي بين الضفتين غير متكافئ، بل يكشف أن العقدة الاستعمارية متمكنة حتى أخمص القدمين من الجارة الإيبيرية.
تأسيسا على ذلك، يمكن العودة إلى التاريخ لتفسير هذا الخلل. ذلك أن صورة «المورو»، في الوعي الإسباني، تعود إلى لحظة سقوط غرناطة، حين جرى تصوير المسلم القادم من الجنوب باعتباره الغريم الذي هدد الهوية الكاثوليكية. ثم جاءت الحقبة الاستعمارية لتكرس هذه الصورة في الريف والصحراء المغربيين، حيث خاض الإسبان حربا لا هوادة فيها ضد المقاومين، استخدموا فيها الغازات السامة التي يعتبرها القانون الدولي «جريمة ضد الإنسانية». وبعد الاستقلال، لم تتغير الصورة كثيرا، إذ ظل المغربي يُقدَّم في الإعلام الإسباني بوصفه عامل يدويا أو «حراكا» أو متطرفا أو همجيا أو لصا.. إلخ. بل إننا حتى اليوم، تكفي أزمة سياسية بين مدريد والرباط، كما يكفي وقوع حادثة صغيرة معزولة يقف وراء وراها مغربي، لتعود كلمة «مورو» إلى الصفحات الأولى، مُحملة بكل معاني الاحتقار والازدراء والتمييز والعنصرية.
والحق أن المغاربة، الذين يستهلكون الثقافة الإسبانية بحماس شديد ودون أي أساس نقدي، سيصطدمون، إذا ما اطلعوا على ما ينشره الإعلام الإسباني بكل أنواعه، بصورة المغربي الهمجي والمتخلف التي تنعكس في أذهان الإسبان، كما سيكتشفون أن الافتتان بإسبانيا لن يمنحهم أي اعتراف كامل بثقافتهم، مما سيولد لديهم خيبة أمل قاسية من التفاؤل بالجوار أو التعاون المشترك أو الحوار الحضاري.
أمام كل ذلك، يفرض السؤال التالي نفسه: لماذا يصر المغاربة على هذا الانبهار بإسبانيا مع كل ما يأتيهم منها من احتقار؟ الجواب يكمن في عدة عوامل:
أولا: ضعف السياسات الثقافية الوطنية التي لم تستثمر بما يكفي في الرياضة والفنون والإعلام، إذ هناك تغييب فاضح للرموز الوطنية القوية القادرة على شد انتباه الشباب، وإثارة حسهم الوطني من خلال إنجازاتها في كل المجالات، الرياضية والثقافية والعلمية والسياسية.
ثانيا: تراكم الشعور بالنقص أمام الآخر الأوروبي الذي يُنظر إليه باعتباره نموذجا للتنظيم والحداثة والتقدم والنجاح والقوة، مما جعل المغاربة يسعون إلى استهلاك ما ينتجه الجار الشمالي دون الانتباه إلى الهوة السحيقة والساحقة بين الطرفين، بل إن هذا التعلق يتحول تبعا لذلك إلى جزء من هويته التي تبحث دائما عن التميز والارتقاء.
إن استمرار هذه العلاقة غير المتكافئة التي يصنعها الانبهار بالآخر الإسباني يحمل مخاطر واضحة، لعل أخطرها هو أن يتحول هذا الانبهار إلى استلاب تام، أي أن يفقد المغربي ثقته في ثقافته وإمكاناته وإنجازاته، فلا يرى نفسه إلا من خلال مرآة المنجز الإسباني. إذ يصبح الأمر عندئذ أكثر من مجرد تماس خاطئ مع الآخر، وإنما تبعية ثقافية تعيد إنتاج الهيمنة الاستعمارية بشكل جديد.
تأسيسا على كل هذه المخاطر، يتعين على المغرب أن يستثمر في ثقافته ورموزه، كأن يقدم بدائل رمزية جاذبة لشبابه. ففي الرياضة، يجب أن تتحول البطولة الوطنية إلى منتج تنافسي حقيقي، قادر على شد الانتباه وتسويق أسماء محلية تنافس عالميًا. أما في الفن، ينبغي أن يجد المغاربة في أغانيهم وموسيقاهم وسينماهم ومسرحهم وفنونهم التشكيلية ما يفتخرون به كما يفتخر الإسبان بفنهم. بينما علينا، على مستوى الأدب والفكر، أن نعيد الاعتبار لرموز تركوا بصمة عالمية في ساحتنا الثقافية، مثل محمد شكري وفاطمة المرنيسي وعبد الكبير الخطيبي ومحمد برادة وعبد الفتاح كيليطو وعبد الله العروي ومحمد عابد الجابري.. إلخ، بدل أن يظل هؤلاء في الهامش بينما يحتل الإسبان صدارة الاهتمام.
إضافة إلى ذلك، يبغي على المدرسة المغربية أن تتحول إلى فضاء لصناعة الاعتزاز بالذات. ذلك أن التعليم ليس مجرد تلقين للمعارف، بل عنصرا حاسما لبناء وعي جماعي بتاريخه، من يوسف بن تاشفين إلى عبد الكريم الخطابي، مرورا بالمنصور الذهبي والمولى إسماعيل ومحمد بلحسن الوزاني ومحمد الفقيه البصري وعلال الفاسي والمهدي بنبركة وعزيز بلال وعبد الكريم غلاب ومحمد المختار السوسي وعباس الجيراري وابن المؤقت المراكشي وابن بطوطة.. والقائمة طويلة.
على المستوى الرسمي، ينبغي على المغرب وضع سياسة ثقافية ملهمة وقائمة على الاعتزاز بالذات، ذلك أن المغرب ليس بحاجة إلى الاكتفاء بتشجيع «المبادرات الثقافية البانية للجسور بين الضفتين»، بل إلى قوة ناعمة حقيقية، تستثمر في الرياضة واللغة والسينما والموسيقى والتعليم، لخلق صورة عن الذات أكثر جاذبية. كما أن الدبلوماسية الثقافية يجب أن تدافع عن حضور الثقافة المغربية في الضفة الشمالية، وتعمل على فرض الاعتراف برياضيينا وأعلامنا ورموزنا.
صحيح أن العلاقة مع إسبانيا تظل ضرورية بحكم الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة. بيد أن هذه العلاقة لن تستقيم إلا إذا تحرر الإسبان من عقدة «المورو»، مقابل أن يتخلى المغاربة، بوعي تام، وأن يعملوا على تحويل الانبهار إلى تبادل متكافئ من موقع الاعتزاز بالثقافة الوطنية في التعليم والإعلام والفن والرياضة، من خلال دعمها رمزيا في المناهج المدرسية، وتكريس حضورهم في البرامج الثقافية، فضلا عن تعزيز التبادل الثقافي على قاعدة الندية، ليصبح التأثير متبادلا، وليس حبا من جانب واحد، لأن هذا النوع من الحب يؤدي دائما إلى الشعور بالألم والحزب وانخفاض منسوب الثقة في النفس.
تفاصيل أوفى تجدونها في العدد الجديد من جريدة "الوطن الان"


 (1).png)